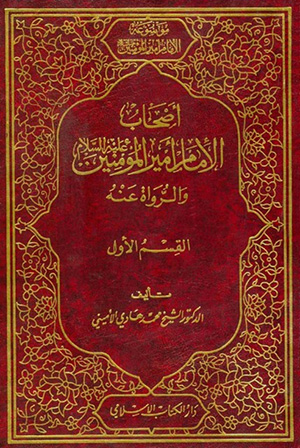الدكتور الشيخ محمّد هادي الأميني
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: دار الغدير للمطبوعات
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٥٦
الحضارة العلمية الإسلامية ، والفكر العربي ، مدينان لتلك المدرسة بالرقيّ والنموّ ، والتطوّر ، والخلود ... ولعميدها وبانيها ، وواضع لبنتها الأولى ... الذي كان ولم يزل باب مدينة علم الرسول الأقدس (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأنّها كانت تحمل في منهجها ، وبرامجها الاستقلال الرّوحيّ النبويّ ... والمجد العلميّ العلويّ ... والتراث الفكريّ الحيدريّ ... وما برحت عن ذلك المنهج الثمين الخالد على امتداد التأريخ.
إنّ أصحاب ، ورواة علي بن أبي طالب (عليه السلام) على اختلاف آرائهم ، وألوانهم ، وجنسياتهم ، وقومياتهم ، كما ستقف على حياتهم ، وتراجمهم ، أكثر مما جاء في الكتاب الذي بين يديك ، أو ما جاء في بقية المواضيع والكتب المؤلفة بهذا الصدد ، إذ يعسر على المتتبع ، ويصعب على الباحث جمعهم وإحصاءهم مع الظروف القاسية التي انتابتهم ، ولكنّك ستجد حملة حديثه ، وعلمه ، وأصحابه ، ومقاتليه ، وفرسانه ، وجنوده ، وخواص أصحابه من الذين كانت لهم اليد الطولى في خوض المجالات العلمية والاجتماعية والمعارك الطاحنة ، والأبعاد السياسية ، ومحاربة القاسطين ، والمارقين ، والناكثين ، وفي مناظرة أهل المعتقدات الكاسدة ، والآراء الشاذة ، والدعاة الظالمة.
ولا شك أنّ الآخذين من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، والرواة عنه هم أكثر مما جاء في الكتاب ، بيد أنّ الأحوال السياسية التي اجتازت الحواضر الإسلامية ، جعلت الناس تبتعد ، عن عليّ بن أبي طالب حبّا للسلامة ، أو استسلاما لعوامل أخرى ، وسيأتي فيما بعد ما له صلة بالموضوع ، ودليل وحجة لصحة ما ذهبنا إليه ، وليس هذا بغريب ، فالسلطات غير الشرعية ، وقفت من آل محمد ، وشيعتهم ، ومدرستهم ، موقف المخرّب العدو ، اللدود ، والخصم الأرعن ، وقاومتهم ، وشجعت العناصر الخبيثة المناوئة لهم ، وكلها خابت بالفشل ، وخانهم النجاح ، لأنّ الله سبحانه شاء أن لا تتمكن قوة أو سلطة أو حكومة من إخماد ذكرهم ، أو إخفاء آثارهم ، فكانوا في كل فترة ، وعصر ، ومرحلة ، ودور ، أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى ، وأعلام التقى ، وذوو النهى ، وأولو الحجى ، وكهف الورى ، وورثة
الأنبياء ، والمثل الأعلى ، والدعوة الحسنى ، وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى.
عدة أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) والرواة عنه :
من العسير جدا على الباحث حصر رواة وأصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، في إطار عدد خاص ، أو جعلهم تحت رقم محدّد ، حتّى ولو بشكل تخميني ، وليس هذا بالنسبة للحروب والقتال يومذاك فحسب ، وحتّى الضحايا والجرحى في وقتنا الحاضر ، لا يمكن تحديدها برقم معين ، لتضارب الأقوال وتباين الإحصائيات فيها ، فكل جانب من المتخاصمين ، أو المتقاتلين في بياناتهما العسكرية ، يبالغ ويسرف في عدد قتلى وجرحى الطرف المخاصم له ، ويقلل من ضحاياه وقتلاه في الوقت نفسه ، ليثبت بذلك انتصاره المحتوم ، وعدّته ، ومناعته ، والإتيان بما فيه تضعيف كيان خصمه ، وتزلزله ، ومقوماته ، وأخيرا فشله وانتكاسه ... وهذه بالذات سنّة مطّردة سارت عليها الدول المتخاصمة على امتداد التأريخ إلى يومنا هذا.
وتتجلّى هذه الظاهرة ، والتفاعل الواضح بصورة واضحة ، لدى الجانب المندحر المتقهقر المنخذل ، فتراه يتشدّق بادعاءات باطلة ، ويتبجح بإعلامات فاشلة واهية ، ويؤمم ويسد انتكاسه وفجوته عن هذا الطريق .... وخشية الإطالة نعود إلى صلب الحديث لأنّ البحث هذا لم يكن من الموضوعات الهينة التي يمكن اجتيازها بالاختصار والتلويح ، أو الاقتناع بالتلميح والإشارة ، وإنّما هو موضوع يستأثر بوعاته ، ويدعو إلى التوسع والإفاضة التي تخرجنا من جادة البحث ، سيما إذا كان الحديث عن طائفة ، وعصابة ، وفرقة ، أصابتها ظلامات تأريخية ، طغت على آثارهم ، وغطت على مآثرهم ، سحب من الدخان والضّباب لإطفاء أنوارهم.
ومهما يكن من أمر فالتاريخ بظلاماته وظلماته ، عفى على آثار فتية مؤمنه موحدة ، تقدمت للشهادة على اسم الله وبركته ، وبذلت في سبيله مهجتها لتتفيّأ جنان غفرانه وتتقيل ظلال رضوانه ... قاتلت برحابة صدر ، وبقلب مجند بالإيمان ومترع بالتوكل على الله ... شرذمة النفاق والعدوان التي أخذت على نفسها أن تستمرئ
الحياة الدنيا الفانية في إقامة أريكة وسلطان ، لا يبالي الواحد منهم إن كان ضاحيا فيه لنار غضب الرّب ، ومؤججا شرارة نقمته ولعنته.
وشتان بين الهدفين والغايتين ... هدف كان الله تعالى في حياته ، وجهاده ، ونضاله ، وصموده الأمل والغاية ... وبين من اتخذ الله ذريعة ، ووسيلة في حياته ، وسلّما للوصول إلى دفة الملك والسلطان ، والسيطرة والتحكم على المجتمع ... فالخصمان اختصما في الله تعالى ، ولكن جعله واحد منهما غاية ونهاية ، والآخر اتخذه واسطة لغاية الملك ، مع اليقين والاعتقاد بأنّ الموازنة بين الغايتين أو الهدفين ، ما هي إلّا من أحداث التأريخ الظالمة ، ومكاره هذه الدنيا التي لا انتهاء في مكارهها.
وحسبك من ظلمات وظلامات الدنيا الحادة ، ما صنعتها في حق رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل ، ولم يمكنهم جحد مناقبه ، ولا كتمان فضائله ، فقد علم التأريخ أنّه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام ، في شرق الأرض وغربها ، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره ، والتحريض عليه ، ووضع المعايب والمثالب له ، ولعنوه على جميع المنابر ، وتوعدوا مادحيه ، بل حبسوهم وقتلوهم ، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا ، حتّى حظروا أن يسمّى أحد باسمه فما زاده ذلك إلّا رفعة وسموّا ، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه ، وكلما كتم تضوّع نشره ، وكالشمس لا تستر بالراح ، وكضوء النّهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة.
رجل تعزى إليه كل فضيلة ، وتنتهي إليه كل فرقة ، وتتجاذبه كلّ طائفة ، فهو رئيس الفضائل وينبوعها ، وأبو عذرها وسابق مضمارها ، ومجلّي حلبتها كلّ من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى (١).
وهكذا كانت الحالة مع أنصاره وأعوانه ، ورجالاته وأصحابه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أقام التأريخ ومصطنعوه لشرذمة لا شأن لهم ، ولا مبرة في الحياة
__________________
(١) شرح ابن أبي الحديد ١ / ١٦.
صروحا وهياكل ، ونفخت باسمهم المزامير ، وطبّلت بذكرهم الطبول ، وانتحلوا لهم المآثر والمفاخر وأضاف إليهم الثناء والمدح ، في غير وزن ... كما قذف رواة ورجال أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بكل شناعة ، واتهمهم بكل وقيعة ، ورماهم بكل نكير ، كما سنحدثك عنهم في الفصل القادم ، لذلك تضاربت الآراء وتباينت الأقوال ، واختلفت الأقاويل ، من المؤرخين حول عدد أصحاب ، ورواة عليّ (عليه السلام) ... وإليك ما جاء في المراجع التأريخية بهذا الشأن :
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : كتب إليّ السري ، عن شعيب ، عن سيف ، عن محمد ، وطلحة ، قالا : كان قتلى الجمل حول الجمل عشرة آلاف ، نصفهم من أصحاب عليّ ، ونصفهم من أصحاب عائشة ، من الأزد ألفان ، ومن سائر اليمن خمسمائة ، ومن مضر ألفان ، وخمسمائة من قيس ، وخمسمائة من تميم ، وألف من بني ضبة ، وخمسمائة من بكر بن وائل. وقيل : قتل من أهل البصرة في المعركة الأولى ، خمسة آلاف وقتل من أهل البصرة في المعركة الثانية ، خمسة آلاف فذلك عشرة آلاف قتيل من أهل البصرة ، ومن أهل الكوفة خمسة آلاف. قالا : وقتل من بني عدي ، يومئذ سبعون شيخا كلّهم قد قرأ القرآن ، سوى الشباب ، ومن لم يقرأ القرآن (١).
وقال عزّ الدّين عليّ بن محمد بن الأثير : وكان جميع القتلى عشرة آلاف ، نصفهم من أصحاب عليّ ، ونصفهم من أصحاب عائشة (٢).
وليس في كتابيهما ، ما يشير إلى عدد قتلى صفين ، والنهروان.
وقال أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري المتوفى ٢١٢ ه :
وأصيب يوم الوقعة العظمى ، أكثر من ذلك ، وأصيب فيها من أصحاب عليّ ، ما بين السبعمائة إلى الألف.
وأصيب بصفين من أهل الشام ، خمسة وأربعون ألفا.
وأصيب بها من أهل العراق ، خمسة وعشرون ألفا.
__________________
(١) تاريخ الطبري ٥ / ٢٢٢.
(٢) الكامل في التاريخ ٣ / ٢٥٥.
وأصيب يوم النهروان على قنطرة البردان من المحكمة ، خمسة آلاف.
وأصيب منهم ألف بالنخيلة بعد مصاب عليّ.
وأصيب من أصحاب عليّ ، يوم النهروان ألف وثلاثمائة (١).
وجاء في مرجع آخر ما لفظه : وكانت القتلى في حرب الجمل ، خمسة عشر ألفا قتل من أهل البصرة في المعركة الأولى خمسة آلاف ، وفي المعركة الثانية مثلها ، وقتل من أهل الكوفة ، خمسة آلاف. وقيل : كان جميع القتلى عشرة آلاف ، نصفهم من أصحاب عليّ ، ونصفهم من أصحاب عائشة (٢).
وقال ابن شهر اشوب الحلبي البغدادي المتوفى ٥٨٨ ه (في حرب الجمل) : فكان مع أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرون ألف رجل. منهم البدريون ثمانون رجلا. وممن بايع تحت الشجرة ، مائتان وخمسون. ومن الصحابة ألف وخمسمائة رجل. وكانت عائشة في ثلاثين ألفا أو يزيدون ، منها المكيون ستمائة رجل. قال قتادة : قتل يوم الجمل عشرون ألفا. وقال الكلبي : قتل من أصحاب عليّ ألف راجل ، وسبعون فارسا (٣).
وقال في حرب صفين : وكان يحمل عليهم مرة بعد مرة ، ويدخل في غمارهم ويقول : الله الله في الحرم والذرية ، فكانوا يقاتلون أصحابهم بالجهل ، فلما أصبح كان قتلى عسكره أربعة آلاف رجل ، وقتلى عسكر معاوية اثنين وثلاثين ألف رجل. فصاحوا : يا معاوية هلكت العرب ، فاستغاث هو بعمرو فأمره برفع المصاحف.
قال قتادة : قتلى يوم صفين ، ستون ألفا. وقال ابن سيرين : سبعون ألفا ، وهو المذكور في أنساب الأشراف. وصنعوا على كل قتيل قصبة ثم عدّوا القصب (٤).
__________________
(١) وقعة صفين / ٥٥٨.
(٢) أعيان الشيعة ٣ / ٥٤ ط عام ١٤٠٠.
(٣) المناقب ٣ / ١٦٢.
(٤) المناقب ٣ / ١٨١.
وقال عليّ بن محمد بن أحمد ابن الصباغ المالكي المتوفى ٨٥٥ ه : إنّ عدة من قتل من أهل الجمل ستة عشرة ألفا ، وسبعمائة ، وتسعون رجلا ، وكانت جملتهم ثلاثين ألفا. وإنّ عدة من قتل من أصحاب عليّ (عليه السلام) ألف وسبعون رجلا ، وكانت عدّتهم عشرين ألفا (١).
وقال في حرب صفين ، في مكان آخر من كتابه : فقتل من أصحاب عليّ خمسة وعشرون ألفا ، منهم عمار بن ياسر (رضي الله عنه) وخمسة وعشرون بدريا ، وكان عدة عسكره تسعون ألفا. وقتل من أصحاب معاوية خمس وأربعون ألفا ، وكان عدّتهم مائة ألف وعشرون ألفا. وذكر أنّهما أقاما بصفين مائة يوم وعشرة أيام ، وكان بينهم سبعون وقعة (٢).
هذا ولم يحفظ التأريخ لنا من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ... المحاربين والمقاتلين في مشاهده من الجمل ، وصفين ، والنهر ... غير هذا النذر اليسير ، من الأسماء المبثوثة على صفحات هذا الكتاب الذي تجده بين يديك ، ولعلها كانت مدونة ومثبتة ، وراحت إثر الحوادث ، والعواصف الزمنية العاتية التي اجتاحت الوطن الإسلامي ، فذهبت بكل قيمة الثقافية ، وتراثه الفكري.
ومهما يكن من أمر فمن الواضح المعلوم ، أنّ عدة القتلى من أصحاب عليّ (عليه السلام) ، على أقل تخمين في الجمل ، كانت خمسة آلاف ، وفي صفين ، خمسة وعشرين ألفا ، وليس في مراجع التأريخ القديمة والحديثة غير أسماء عدد يسير جدّا ، ولعل المستقبل إن شاء الله يكشف لنا القناع عن أسماء رجال أخرى ... إلّا أنّ هناك سؤال يتبادر إلى الذهن وهو : إنّ عساكر أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما كان عليه من السابقة والقدم ، في كافّة القيم والمثل والصحابة والتابعين كانوا على معرفة تامة بكل جوانب هذا العملاق ... فلما ذا كانت جيوشه وعساكره أقل بكثير من عساكر معاوية ، مع عرفان الناس أيضا بنفسية معاوية الجشعة الخبيثة الأموية ، وبمسمع منهم أحاديث النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في معاوية ، والمتداولة في
__________________
(١) الفصول المهمة / ٨٦.
(٢) الفصول المهمة / ١٠٠.
كتب الصحاح والسنن ، وأخيرا مع اليقين الكامل لديهم أنّ في عليّ (عليه السلام) في جميع مراحل الحياة تتمثل الظلامة ... وفي معاوية تتمثل الضلالة ... وأنّ الانتصار كان حليف عليّ (عليه السلام) في كافة المشاهد ، تهيمن عليها النصر والغلبة والفوز لا في عهده فحسب ، وإنما في العهد النبويّ أيضا ...؟
والجواب إنّ قائد المبادئ ، والعقيدة ، وجنود الحق والحقيقة في ساحات الجهاد ، والنضال ، لا يعتمدون على ذخائر وعدة من كثرة العدد والجنود ، أو مضاء السلاح ، كما هو المتعارف المتداول من ذخائر الحرب ، والمقاومة ، وإنّما يعتمدون ذخائر وركائز من جهة كثرة الإيمان ، ووفور العقيدة ورسوخها ، ومضاء الحيوية ومناعتها ، فالمبدأ الذي يزود عساكره بحظّ ونصيب وافر ، من هذه الذخائر يستطيع الصمود والوقوف بوجه خصمه بمقدار حظه ، وتزويده من هذا الزاد المعبّر عنه بالإيمان. وأكثر المبادئ حظّا وأوفاها نصيبا من ذخيرة الإيمان أحراها بالغلبة والنصر والفوز ، والتقدّم ، والنجاح ، وأجدرها في التاريخ ، بالخلود ، والبقاء ، والدوام ، والحياة.
وإلى هذا المعنى ، تشير الآية الكريمة : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (١) ففقدان الفقه في الكفار ، وبالمقابلة ثبوته في المؤمنين ، هو الذي أوجب أن يعدل الواحد من العشرين من المؤمنين ، أكثر من العشرة من المائتين من الذين كفروا ، حتّى يغلب العشرون من هؤلاء المائتين من أولئك على ما بنى الحكم في الآية. فإنّ المؤمنين إنّما يقدمون فيما يقدمون في ساحات الجهاد ، عن إيمان بالله وبسلاح العقيدة. وهو القوة ، والمناعة المعنويّة التي لا تعادله ولا تقاومه ، ولا تشبهه أية قوة أخرى ، لابتنائه وتركيزه على التفقه والإدراك الصحيح الذي يوصفهم بكل سجية نفسانية ، وقيم روحية فاضلة ، كالشهامة ، والشجاعة ، والبطولة ، والمثابرة ، والإقدام ، والاستقامة ، والطمأنينة ،
__________________
(١) سورة الأنفال / ٦٥.
والثقة بالله الواحد الأحد ، واليقين بأنّه على إحدى الحسنيين إن قتل (بالضم) ففي الجنة ، وإن قتل (بالفتح) ففي الجنة ، وإنّ الموت بالمعنى الذي يراه أصحاب المادة ، والمنبعثة من صميم المادة الدنيوية هو الفناء لا مصداق له.
لأنّ جماعة البصرة ، والشام ، والنهروان ... كان اتكاؤهم على هوى النفس الأمارة بالسوء ، واعتمادهم على ظاهر ما يسوّله لهم الشيطان وأذنابه ، والنفوس التي تعتمد على أهوائها لا تتفق للغاية ، ولن ينتهي بها المطاف إلى النصر والخلود والبقاء ، وإن اتفقت في بعض الأحايين فإنّما تدوم عليه ما لم يلح لائح الفناء والموت الذي تراه فناء. وما أندر ما تثبت النفس على هواها حتّى حال ما تهدد بالموت ، وهي على استقامة من الفكر ، بل تميل بأدنى ريح مخالف ، وخاصة في المخاوف العامة ، والمهاول الشاملة ، كما أثبته التأريخ من انهزام المشركين ، يوم بدر وهم ألف بقتل سبعين منهم ، ونسبة السبعين إلى الألف قريبة ، من نسبة الواحد إلى أربعة عشر ، فكان انهزامهم في معنى انهزام الأربعة عشر مقاتلا ، من مقاتل واحد ، وليس ذلك إلّا لفقه المؤمنين الذي يستصحب العلم ، والإيمان ، وجهل الكفار والشياطين الذي يلازمه الكفر والهوى.
والخلاصة إنّ جنود العقيدة ، جنود لا يعتمدون على ذخائر حربية ، من ناحية كثرة العدد أو مضاء السلاح. وإنما يعتمدون على ذخائر من حيث وفور الإيمان ، ومضاء الحيويّة ، وفي مغازي النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حجة ظاهرة في تأييد هذا البحث ...
فهذه غزوة بدر غلب فيها المسلمون ، وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، على ما كانوا عليه من رداءة الحال ، وقلة العدة والسلاح ، والقوّة ، بينما نجد كفار قريش وهم يعدلون ثلاثة أمثال المسلمين أو يزيدون ، على ما كانوا عليه من العزة والشوكة والاستعداد. ثم ما جرى على المسلمين في غزوة أحد ، وفي غزوة الخندق ، وفي غزوة خيبر ، وغزوة حنين ، وهي أعجبها ، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن كي لا يبقى لباحث ريبا فيها فقال : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ) (١).
لهذه العوامل الرئيسية النفسانية الخلاقة ، الباعثة بدوافع الإيمان ، نجد أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، على قلتهم كتب لهم بإذن الله تعالى ، النصر ، والغلبة ، والفوز ، والمضاء ، والحيوية ، والخلود ... ولجماعة معاوية ، وجند عائشة ، والخوارج ، على كثرة ذخائرهم الحربية ، من ناحية النفوس والسلاح ... الخذلان ، والفشل ، والاندحار ، والتقهقر ، بحول الله وقوته ... وحين لاحت لهم لوائح الفناء والدمار ، صاح العسكر بأجمعه ، يا معاوية : هلكت العرب ... فالتجئوا إلى اصطناع مكيدة وخديعة تنجيهم من الهلكة والورطة ، فرفعوا المصاحف على الرماح ، ونادوا ندعوكم لما فيها ، وهذا حكم بيننا وبينكم.
وهنا يقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، في خطبته الشريفة : «ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة إخواننا ، وأهل دعوتنا استقالونا ، واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه ، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم. فقلت لكم : هذا أمر ظاهره إيمان ، وباطنه عدوان ، وأوّله رحمة ، وآخره ندامة. فأقيموا على شأنكم ، والزموا طريقتكم ، وعضوا على الجهاد بنواجذكم. ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق ، إن أجيب أضل ، وإن ترك ذلّ ، وقد كانت هذه الفعلة ، وقد رأيتكم أعطيتموها ، والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها ، ولا حملني الله ذنبها. وو الله إن جئتها إنّي للمحق الذي يتبع ، وإنّ الكتاب لمعي. وما فارقته مذ صحبته. فلقد كنا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وإنّ القتل ليدور على الآباء ، والإخوان ، والقرابات ، فما نزداد على كلّ مصيبة وشدة إلّا إيمانا ومضيّا على الحق ، وتسليما للأمر ، وصبرا على مضض الجراح. ولكنّا إنّما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل ...)».
آراء رجال الحديث في رواة أمير المؤمنين (عليه السلام):
ذكر جميع العاملين في حقلي الرجال ، والدراية ، منذ قدم هذا العلم ليومنا
__________________
(١) سورة التوبة / ٢٥ ـ ٢٦.
هذا في مؤلفاتهم ، الكثير من رواة الشيعة الذين حدثوا عن أئمتهم عليهم السلام ، سواء في ذلك الشيعة والسنّة ، بصورة عامة ... أما كتب رجال الشيعة فإنّ الرواة من الجانبين : العامة ، والخاصة ، دونت فيها من غير قدح وجرح لأنّ نظرتهم بالنسبة للراوي كانت بمنظار الواقع والحقيقة ، بعيدا عن رواسب التعصب الأعمى ، والانحياز الطائفي ، فإذا ما ذكروا محدّثا من السنة ، وكانت شروط الصحة والتوثيق متوفرة فيه ، تلقوه بالقبول والثناء ... كما أنّهم إذا ذكروا راويا شيعيا ، ولم تتوفّر لديه الشروط ، عبّروا عنه بمجهول الحال ، أو الضعيف وغيره ، فهم يأخذون الرواة مهما كان اتجاههم وميلهم وعقيدتهم بمقياس العقل والواقع وبمنطق الحقيقة والإدراك والتفهم.
أما رجال الحديث والدراية من السنة ، فكانت سيرتهم عكس ما سارت عليه رجال الحديث من الشيعة ، فلم يكن نصيب رواة الشيعة منهم أقل من نصيب الأئمة الطاهرة عليهم السلام ، أنفسهم من القدح ، والجرح ، والتنكيل ، والتشنيع ، والنقد ، ورميهم بالمناكير ، والغلو ، والتشيع ، وأخيرا ضربهم عرض الجدار بصورة باتة ... فلو سبرت كتب الرجال ، ودققت البحث في محتوياتها يتضح ذلك بوضوح ، سيّما مؤلفات نفر من المتطفلين على علم الرجال والدراية ، والذين يعتبرون في الرعيل الأول من أئمة الرجال ، فيتناولون أئمة الشيعة الاثنى عشرية ، بالقدح والذمّ ، فكيف الحال بالنسبة إلى الرواة منهم ، من غير ذكر أي دليل علمي على ذلك ، كما هو شأن دعاة السوء ، فذهب عليهم أو تجاهلوا أنّ التعصب البغيض وتباين العقيدة لا مكان له من العلم ، ولا يفسد الواقع والحقيقة ، ولا يمكن له التسرب إلى أعماق العلم ، لأنّ الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام ، أو الرواة من الصحابة والتابعين ، بمثابة أسرة واحدة ، يتناصرون في خدمة شرع الله سبحانه ، يستفيد هذا مما عند ذاك ، وذاك مما عند هذا ، حتّى تطور ونضج الفقه الإسلامي ، والشريعة الإلهية على أيديهم تمام النضج ، بانصرافهم كل الانصراف إلى استقصاء ما ورد في السنة ، قبل أن يدخلها الدخيل بعد القرون الفاضلة. وبإقبالهم أشد إقبال على تفهم ما في كتاب الله ، وسنة رسوله ، من المعاني السامية ، والقيم النبيلة ، والغايات البعيدة ، قبل أن تحدث في اللغة أطوار تبعدها عن المعاني التي كانت تفهم
منها عند التخاطب بها في عهد نزول الوحي.
وكان فضل الله عليهم عظيما حيث أعدهم لهذا العمل القويم ، بقدر ما آتاهم الله من بالغ الذكاء ، وقوة الحفظ ، وحسن الخوض على المعاني ، وبعد النظر في اجتلاء الحقائق من المكامن ، وتمام الشغف بالفقه والتفقيه ، وسرعة الخاطر ، وجودة الإلقاء ، وعذوبة البيان ، وسعة ذات اليد ، والصحة الكاملة ، والعافية الشاملة ، وعظيم الإخلاص ، مع قرب عهدهم من عهد النبيّ الأقدس ... والرواة الذين كانوا بين كل واحد منهم ، وبين الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبين الصحابة ، لا يزيد عددهم في الغالب على راويين اثنين فقط. أو الرواية عن الإمام بصورة مباشرة.
غير أنّه من المؤسف جدّا ، تسرب الحسد ، والبغض ، والغضب ، والهفوات ، والشهوات ، والجهل ، في البعض دون أن يعني بفضائلهم ، وطهارتهم ، وقدسيتهم ، حرم التوفيق ، ودخل في الغيبة ، والنميمة ، وحاد عن مهيع الحق ، والصراط المستقيم ، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم ، الحسد ، والبغضاء».
هنا لا بد لنا من عرض نموذجين على سبيل المثال ، عن بغض وحسد أصحاب الدراية والرجال من السنة ، وأقاويلهم المزيجة بالشحناء ، بالنسبة إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام ... ومن ثم كلماتهم البذيئة ، وتخرصاتهم اللاحقيقية ، بالنسبة لا لرواة الشيعة بصورة عامة ، ولكن بالنسبة للذين حدّثوا ورووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
١ ـ قال محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي المتوفى ٣٥٤ ه ، في كتاب المجروحين ما لفظه : (عليّ بن موسى الرّضا ... يروي عن أبيه العجائب ، روى عنه أبو الصلت وغيره. كأنّه كان يهم ويخطئ ، روى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : السبت لنا ، والأحد لشيعتنا ، والاثنين لبني أمية ، والثلاثاء لشيعتهم ، والأربعاء لبني
العباس ، والخميس لشيعتهم ، والجمعة للناس جميعا وليس فيه سفر.
إلى أن قال : ومات عليّ بن موسى الرّضا ، بطوس يوم السبت آخر يوم من سنة ثلاث ومائتين ، وقد سمّ من ماء الرمان وأسقى قلبه المأمون.
ثم يتصدّى محقق الكتاب ، الهزر ، محمود إبراهيم زائد ... فيعلق في الهامش على قول ابن أبي حاتم فيقول : ـ علي بن موسى بن جعفر بن محمد الهاشمي العلوي الرضا ، أحد الأئمة الاثنى عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم ، ووجوب طاعتهم. ولاه المأمون عهده ، وعقد له الخلافة بعده ، ولما مات شق قبر الرشيد بطوس ودفنه هناك تبركا به. قال ابن طاهر يأتي عن أبيه بعجائب ، ويرى الذهبي أنّ الرجل قد كذب عليه فيما نسب إليه ، فقال إنّما الشأن في ثبوت السند إليه وإلّا فالرجل قد كذب عليه ، ووضع عليه نسخة سائرة. فما كذب على جده جعفر الصادق. فروى عنه أبو الصلت الهروي أحد المتهمين. ولعليّ بن مهدي القاضي عنه نسخة. ولأبي أحمد بن سليمان الطائي عنه نسخة كبيرة. ولداود بن سليمان القزويني عنه نسخة.
وأردف قوله في التعليق على كلام ابن حبان : «من أنّ المأمون سمّه من ماء الرمان» : أورد ابن حبان الخبر مقطوعا به وفي اصطلاح علماء الحديث لا يقطع بخبر هذا القتل إلّا برؤية أو شهادة ، وهو لا يملك من هذا سوى الظن ، وإلّا فكيف ثبت لديه أنّ المأمون فعل ذلك أو أمر به ـ (١).
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون (٢).
أجل هكذا تهيمن الضبابة الأموية المقبورة ، على ذات الأحمق ، وتتحكم في وجود الجاهل الغبي ، وتدفعه إلى أعماق الهاوية فيندفع إلى إنكار الواضحات ، والحقائق ، والمسلمات ، وطمس الواقع بجهله ، ويتشدّق باصطلاح علماء
__________________
(١) كتاب المجروحين ٢ / ١٠٦.
(٢) سورة الجاثية / ٢٣.
الحديث ... وهو المتطفل المخراص الذي لا يتعقل ، من مفاهيم علماء الحديث أي شيء.
أنا لا أتوخى الإجابة على تخرصات ابن أبي حاتم الأفغاني المخرّف ... فقد ألفناها منذ وفاة النبيّ الأقدس (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وسمعناها من أبواق الأمويين ... ووسائل إعلام العباسيين ... ومزامير الوهابية المحطمة ... ومن حذى حذوهم من المتطفلين على موائدهم ، وسار على نهجهم السقيم المنحرف المؤدّي إلى أسوإ المصير ، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة ... لأنّ مادة التقوّل ، والافتراء ، والتهم ، والكذب ، والغضب ، والحسد ، والبغض ، والشنار ، والنميمة ، والنفاق ، والتشنيع ، سائرة في جميع عروق وشرايين ابن أبي حاتم ... ومن لف لفه من أعداء الله سبحانه ، والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والقرآن ، والعترة الطاهرة (عليهم السلام). وخالطت كافة أجزاء وجودهم المادي العفن ، بحيث تراهم لا يتفرغون إلى تأليف بحث أو دراسة موضوع ، وكتاب إلّا لغرض الوقيعة بالشيعة وأئمتهم. لذلك لا يخلو كتاب لهم من التهريج على الشيعة ، الأمة الإسلامية الحقة ... وسبهم وشتمهم وقذف أئمتهم الذين يعتبرون بحق الدعاة إلى الله ، والأدلاء على مرضاة الله ، والمستقرّين في أمر الله ، والتامّين في محبّة الله ، والمخلصين في توحيد الله ، والمظهرين لأمر الله ، ونهيه ، وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
إنّ الشيعة في كافة أدوار التأريخ السالفة والمستقبلة ، لن تفكر ولم يدر بخلدها ، أن تتقرّب إليهم العامة في يوم من أيام حياتهم ، وأن يحبوا عليّا (عليه السلام) والأئمة من ولده ، وشيعتهم ، وأصحابهم ، لأنّ العمل هذا معناه اجتماع الضدين والنقيضين في مكان واحد ، وهو محال وممنوع ، مهما دعا علماء السوء ، ومن ورائهم تلاميذ مدارس الأموية ، والعباسية ، والوهابية إلى التقريب والاتحاد ، والوحدة ، بعد أن أنبأنا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، عنه قبل أربعة عشر قرنا فقال :
والّذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إنّه لعهد النبيّ الأميّ إليّ لا يحبني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق. وقال (عليه السلام) :
لو ضربت خيشوم المؤمن ، بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني ، وذلك أنّه قضى فانقضى على لسان النبيّ الأمي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، أنّه قال : «يا عليّ لا يبغضك مؤمن ، ولا يحبك منافق».
قال ابن أبي الحديد ، في شرحه : «ومراده عليه السلام من هذا الفصل ، إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو : «لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق» وهي كلمة حق ، وذلك لأنّ الإيمان وبغضه لا يجتمعان ، لأنّ بغضه كبيرة ، وصاحب الكبيرة عندنا لا يسمّى مؤمنا ، وأما المنافق فهو الّذي يظهر الإسلام ، ويبطن الكفر ، والكافر بعقيدته لا يحب عليّا (عليه السلام). لأنّ المراد من الخبر المحبة الدينية ، ومن لا يعتقد الإسلام لا يحب أحدا من أهل الإسلام لإسلامه ، وجهاده في الدين ، فقد بان أنّ الكلمة حق. وهذا الخبر مرويّ في الصحاح» (١).
أما تعليق المحقق المضحك ... الدال على جهله بالتأريخ ، وكتب قومه ، وقوله عن قتل الإمام الرّضا (عليه السلام) ، على يد المأمون العباسي : (أورد ابن حبان مقطوعا به وفي اصطلاح علماء الحديث لا يقطع بخبر هذا القتل إلّا برؤية أو شهادة ، وهو لا يملك من هذا سوى الظن ، وإلّا فكيف ثبت لديه أنّ المأمون فعل ذلك أو أمر به» ففي غاية السخافة وفي منتهى الجهالة ، لأنّ استشهاد الإمام الرّضا (عليه السلام) بسم المأمون ، لم يكن بالظنّ الحاصل عند ابن أبي حاتم ... وإنّما هو اليقين الحاصل ، والصدق ، والواقع الذي تناقلته أئمة التأريخ ، من المذاهب الأربعة ، وأجمعت أقوالهم على قتله وذلك سنة ٢٠٣ ه ، من دون استثناء.
فقال أبو الفرج عليّ بن الحسين الأموي الأصبهاني المتوفى ٣٥٦ : ذكر أنّ منصور بن بشير ، قال : إنّ المأمون أمره أن يطوّل أظفاره ففعل ، ثم أخرج إليه شيئا يشبه التمر الهندي ، وقال له افركه ، واعجنه بيديك جميعا ، ففعل.
ثم دخل على الرّضا ، فقال له : ما خبرك؟ قال : أرجو أن أكون صالحا.
__________________
(١) شرح ابن أبي الحديد ١٨ / ١٧٣.
فقال له : هل جاءك أحد من المترفقين اليوم؟ قال : لا ، فغضب وصاح على غلمانه ، وقال له : فخذ ماء الرمان اليوم ، فإنّه مما لا يستغنى عنه. ثم دعا برمان ، فأعطاه ابن بشير ، وقال له : اعصر ماءه بيدك ، ففعل ، وسقاه المأمون الرّضا بيده فشربه ، فكان ذلك سبب وفاته ، ولم يلبث إلّا يومين حتّى مات (١).
وجاء مثله في كتاب (مرآة الجنان) للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكي المتوفى ٧٦٨ ه ، المجلد الثاني ص ١٢. وكتاب (الفصول المهمة) للإمام علي بن محمد بن أحمد بن الصباغ المالكي المكي المتوفى ٨٥٥ ، ص ٢٦٢. وقال المؤرخ علي بن الحسين المسعودي المتوفى ٣٤٦ ه ، في كتاب (مروج الذهب) ٤ ص ٥ : وفي خلافته (المأمون) قبض عليّ بن موسى الرضا مسموما بطوس ، ودفن هنالك وهو يومئذ ابن تسع وأربعين سنة وستة أشهر ـ. وقال سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى ٦٥٤ ه ، في كتابه (تذكرة الخواص) ص ٣٥٥ : فقدم إليه طبق فيه عنب مسموم ، قد ادخلت فيه الأبر المسمومة ، من غير أن يظهر أثرها فأكله فمات. وذكره أيضا السيد الشبلنجي الشافعي في كتاب (نور الأبصار) ص ١٦٠ ، إلى غيره من المراجع التأريخية الهامة.
وهل بعد هذا مجال للظن ، وقد رأينا التواتر في اصطلاح علماء الحديث ـ : فأما الخبر المتواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا ، يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أنّ اتفاق الكذب منهم محال ، وأنّ التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر ، وأنّ ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله ، وأنّ أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم ، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه ، وأوجب وقوع العلم وضرورة. ـ
والّذي ينبغي القول به هنا بالصراحة أنّ حملات وتخرّصات رجال الدراية والحديث ، من العامة على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وعلى رواته ، وأصحابه ، وشيعته ، وليدة الحسد فحسب لأنّ الله سبحانه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين ،
__________________
(١) مقاتل الطالبيين / ٣٧٧.
طأطأ كل شريف لشرفهم ، وبخع كلّ متكبر لطاعتهم ، وخضع كلّ جبار لفضلهم ، وذلّ كلّ شيء لهم ، وأشرقت الأرض بنورهم ، وفاز الفائزون بولايتهم ، بهم يسلك إلى الرضوان ، وعلى من جحد ولا يتهم غضب الرحمن ، كلامهم نور ، وأمرهم رشد ، ووصيتهم التقوى ، وفعلهم الخير ، وعادتهم الإحسان ، وسجيّتهم الكرم ، وشأنهم الحق ، والصدق ، والرفق ، وقولهم حكم ، وحتم ، ورأيهم علم ، وحلم ، وحزم ، إن ذكر الخير ، كانوا أوله ، وأصله ، وفرعه ، ومعدنه ، ومأواه ، ومنتهاه ... خلاف ما عليه أئمة العامة ، ورواتهم لذلك راح الحسد يأكل في وجودهم ، وتلتهب شرارته في نفوسهم ، وظهرت آثاره على فلتات ألسنتهم ، وهو الشتم ، والقدح ، والبذاءة في القول (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (١) (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) (٢) (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها) (٣).
فالحسود لا يخلو لحظة عن الغم والحزن ، لأنّه يتألم ويحزن لكل نعمة يراها في غيره ، ونعم الله تعالى غير متناهية لا تنقطع عن عباده الصالحين ، فيدوم أسفه وكآبته ، وحينئذ يعود عليه وبال حسده ، ولا يضر المحسود شيئا ، وإنّما يوجب ازدياد حسناته ، ورفع درجاته من حيث إنّه يعيبه ويرميه ، ويقذفه بما لا يجوز في مفهوم الشريعة ، فيكون ظالما له ويحمل عليه من أوزاره وعصيانه ، وتنتقل صالحات أعماله إلى صحيفته ، فحسده لا يؤثر فيه إلّا الخير والنفع.
ومن ناحية أخرى يكون في مقام محاربة الله سبحانه ، والتعاند ، والتخاصم مع خالق العباد ، إذ هو الذي أفاض النّعم ، والخيرات ، والفضائل على البرايا ، كما شاء وأراد ، بمقتضى حكمته ومشيته ، فحكمته البالغة الحقة أوجبت بقاء ، ودوام النعمة على هذا العبد المحسود الّذي يعمل ويتشبث الحاسد المسكين لزوالها وإبادتها عنه ، وهل هو إلّا سخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض ،
__________________
(١) سورة النساء / ٥٤.
(٢) سورة البقرة / ١٠٩.
(٣) سورة آل عمران / ١٢٠.
وتوخي انقطاع فيوضات الله التي صدرت عنه بحسب حكمته وإرادته ، عكس ما أراد الله على مقتضى مصلحته؟ وقد جاء عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّ الله قال لموسى بن عمران : يا ابن عمران ، لا تحسدنّ الناس على ما آتيتهم من فضلي ، ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ، ولا تتبعه نفسك فإنّ الحاسد ساخط لنعمي ، صاد لقسمي الّذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّي ـ.
وقد قيل من قبل : الحسود يأخذ نصيبه من غموم الناس ، فينضاف إلى ذلك غمه بسرور الناس ، فهو أبدا مغموم.
والحساد يحسدون أكثر مما في الحسود ، لأنّ بعضهم يظن عند المحسود ما لا يملك فيحسده عليه.
ومهما يكن من أمر فالتخرصات ، والتهم ، والسباب ، والجرح ، والقدح ، وأمثاله وليد الحسد ، وما هذا النزاع والتطاحن الدمويّ القائم بين العترة الطاهرة (عليهم السلام) ، وبني هاشم ... وبين الأمويين ، والعباسيين ، والعامة على امتداد التأريخ ، منذ وفاة الرسول المنقد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وسيبقى إلى ما دامت الحياة ... حاصل وتأتى من الحسد ، وهذا قول يدعمه القرآن ، والسنّة ، والعقل ، وليست فيه أية مغضبة ولجاجة.
* * *
٢ ـ أما بالنسبة لرواة الشيعة ، والذين حدّثوا بفضائل عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، فإنّ نصيبهم من القدح ، والجرح ، والتشنيع ، لم يكن بأقلّ من شأن أئمتهم أهل البيت (عليهم السلام) ، فمعاجم الرجال ، وكتب الحديث طافحة ومشحونة بأسماء رواة الشيعة الاثنى عشرية ، يتلاحقهم القدح ، والافتراء ، والتنكيل ، والتنديد ، بصورة عامة ، والبلية الكبرى إذا ما كان الراوي حدّث بفضيلة أو منقبة أو مأثرة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في شأن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فيرمى بالكذب ، والغلو ، والفسق ، والنكران ، إلى غيره من الكلمات الشنيعة التي يمجها العقل ، ويأباها المنطق ، والوجدان والعرف السليم.
إنّ شنشنة القدح ، والافتراء ، لم تكن محصورة في كتاب ، وكتابين ،
وثلاث ، وإنّما تجدها وتقرأها في كافة معاجم الرجال ، والحديث ، وأدنى كلمة تطلق على الراوي (التشيع) فتسقطه من الاعتبار عندهم ، وتقذفه في سلة المجروحين ، والمتروكين ، والضعفاء ، والمجهولين. فالتشيع في اصطلاحهم الطفل ، ومفهومهم العفك ، من الأمور التي تسقط الراوي من الاعتبار ، وتطرح أحاديثه جانبا ، ويوصف بالمناكير ... عكس ما إذا كان الراوي خمارا ، أو فاسقا ، أو منافقا ، أو لواطا ، أو مرابيا ، أو قاتلا ، أو فاسدا ، أو مفسدا ، أو كذابا ، أو وضاعا ، أو من المتربعين على موائد الظلمة ، وحكام الجور ، وأئمة الضلال ... فهذه السمات لا تفسده ولا تأثر في صدقه ، ولا تزلزل وثاقته في الضبط والعدالة ، مع العلم أنّ الكثيرين منهم صححوا روايات الرجال مجهولين ، متروكين ، رموا بالوضع وسوء العقيدة ، والكذب متهمين بالوضع وفيهم من أقر على نفسه بذلك ، وانتحاله أحاديث غيره ، وهذا كله لا يضر بحال الراوي مثلما يفسده إذا حدّث بفضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإنّه يجرح ، ويبدع ويتهم ويكذب ، وإن تيقن صحة حديثه ومطابقته للواقع وصدق ما أخبر به.
لهذا ولغيره من العوامل ذهب الكثير الكثير ، من الأحاديث مع موت الرواة والمحدّثين ، لأنّهم كانوا يخشون الرواية في المناقب والفضائل ، وهذا ما كان متعارفا وسائدا لدى الرواة ، ومنهم عبد الرزاق بن همام بن نافع الإمام الحميري ، وأحد الذين أجمعت كلمة أئمة الحديث والدراية ، على أنّه في الرعيل الأول ، من أعلام الثقات وكان خزانة علم ... فقال عنه الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه ، إنّه كان يعلم أنّ من حدث بفضائل عليّ بن أبي طالب يجرح ويبدع ، بل يتهم ويكذب. فكان لا يحدث بها إلّا أهلها ، وقد قال في حقه الذهبي : إنّه كان يعرف الأمور فلا يتجاسر أن يحدّث بها ، فكان يسمي التحديث بفضائل عليّ (عليه السلام) ، جسارة.
وقد وقع مثل هذا للحافظ أبي الأزهر النيسابوري المتوفى ٢٦٣ ه ، فإنّه لما حدّث عن عبد الرزاق بحديث في فضل عليّ (عليه السلام) أخبر يحيى بن معين بذلك ، فبينما هو عنده في جماعة أهل الحديث ، إذ قال يحيى بن معين : من هذا
الكذاب النيسابوري الّذي حدّث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر ، فقال : هو ذا أنا ، فتبسم يحيى بن معين ، وقال : أما إنّك لست بكذاب ، ولكن الذنب لغيرك في هذا الحديث. ثم سأله يحيى بن معين كيف خصّك عبد الرزاق ، بهذا الحديث؟ فقال : إنّي خرجت مع عبد الرزاق إلى قريته فكنت معه في الطريق ، فقال لي : يا أبا الأزهر أفيدك حديثا ما حدّثت به غيرك؟ قال : فحدثني بهذا الحديث ، والحديث عن ابن عباس قال : «نظر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى عليّ ، فقال : يا عليّ أنت سيد في الدنيا ، وسيد في الآخرة ، حبيبك حبيبي ، وحبيبي حبيب الله ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ الله ، والويل لمن أبغضك بعدي» (١).
وبهذا الصدد يقول الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن الصدّيق الحسني المغربي : إنّ الجرح بالتشيع ، وردّ الحديث به باطل ، عقلا ونقلا :
أما الأول ، فإنّ مدار صحة الحديث على أمرين لا ثالث لهما ، وهما بالضبط والعدالة ، فمن اتصف بهما وجب أن يكون خبره مقبولا ، وحديثه صحيحا ، لأنّ بالضبط يؤمن الخطأ والخلل ، وبالعدالة يؤمن الكذب والاختلاق :
والضبط : هو أن يكون الرّاوي حافظا متيقظا غير مغفل ، ولا متهوّر ، حتّى لا يحدث من حفظه المختل فيهم ولا من كتابه الّذي تطرّق إليه الخلل وهو لا يشعر.
وأما العدالة ، فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي ، وتجنبه للكذب في حديث رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خاصة ، لا لمطلق الكذب ولا لغيره من المعاصي ، لأنّ العدالة تتجزأ فيكون الرجل عدلا في شيء ، وغير عدل في غيره ، والمطلوب لصحة الحديث إنّما هو عدالته فيه ، وأمانته في نقله إلّا أنّه لما كان هذا القدر لا يتحقق في العموم ، ولا يمكن انضباطه ومعرفته إلّا بملازمة التقوى ، واجتناب سائر المعاصي ، اضطروا إلى اشتراط العدالة الكاملة التي عرّفوها بأنّها «ملكة تحمل على ملازمة التقوى ، واجتناب الأعمال السيئة ، وخوارم المروءة» على خلاف في اشتراط الأخير ، ثم انجرّ بهم هذا التوسّع إلى توسّع آخر ، فصاروا يدخلون تحت كل من
__________________
(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٦٠٩.
هذه القيود ، ما ليس منها كالتفرد والركض على البرذون وكثرة الكلام ، والبول قائما ، وبيع الزيبق ، وتولية أموال الأيتام ، والقراءة بالألحان ، وسماع آلة الطرب المختلف فيها ، والتزيّي بزي الجند ، وخدمة الملوك ، وأخذ الأجرة على السماع ، والاشتغال بالرأي ، وعلم الكلام ، والتصوف ، ومصاحبة الزاقفة ، ورواية الأحاديث المخالفة لهوى المجرح ، أو موافقة المخالف له في بعض الفروع ، والتطفل وإبدال صيغ الإجازة بصيغ الأخبار ، والبدعة ، والخلاف في المعتقد ، كالإرجاء ، والقدر ، والنصب ، والتشيع ، وغيرها من النحل ، وهذا التوسع كاد ينسد معه باب العدالة ، وينعدم به مقبول الرواية خصوصا بالنسبة للشرط الأخير (التشيع) فإنّ غالب ما جاء بعد الصحابة من رواة السنة ، وحملة الشريعة ، في الصدر الأول ، والثاني ، والثالث كانوا من هذا القبيل ، فلم يسلم من التعلق بأذيال نحلة من هذه النحل منهم إلّا القليل ، غير أنّهم كانوا متفاوتين فيها بالوسط ، والتغالي ، والإفراط ، والاعتدال ، فمن كان غالبا في نحلته داعيا إليها عرف بها واشتهر ، ومن كان متوسطا غير داعية لم يشتهر ، فإذا جرح كل هؤلاء ، وردّت رواياتهم ذهبت جملة الآثار النبويّة ، وكاد ينعدم معها المقبول بالكلية ، كما قال ابن جرير ، في جزء جمعه للذب عن عكرمة ، مولى ابن عباس ، لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الردية ثبت عليه ما ادعى فيه ، وسقطت عدالته ، وبطلت شهادته ، بذلك للزم ترك أكثر محدّثي الأمصار لأنّه ما منهم إلّا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه (١).
وقال الذهبي ، في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي ، من الميزان (٢) : هو شيعي جلد ، لكنّه صدوق ، قبلنا صدقه وعليه بدعته ، وقد وثقه أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وأبو حاتم ، وأورده ابن عدي ، وقال : كان غاليا في التشيع. وقال السعدي : زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟
وجوابه : إنّ البدعة على ضربين ، فبدعة صغرى ، كغلوّ التشيع ، أو كالتشيع
__________________
(١) فتح الملك العليّ / ٨٣.
(٢) ميزان الاعتدال ١ / ٥.