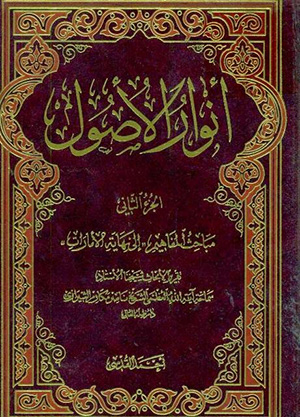الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-8139-14-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
الإنسان بعمل الله تعالى فيلزم الدور المحال.
وثانياً : أنّ مورد الآية خارج عن محلّ النزاع لأنّ حكم العقل بأنّ من قدر على بدأ خلق الشيء قادر على أن يعيده حكم قطعي لا ظنّي فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
ومنها : قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) بتقريب أنّ العدل هو التسوية والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم الآية.
وهذا أيضاً واضح الفساد فإنّ العدل هو القيام بالقسط وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه كما يظهر من العرف واللغة ولا ربط له بالقياس الظنّي.
هذا كلّه في الآيات التي استدلّ بها لجواز القياس.
أمّا الرّوايات ، فقد حكيت روايات من طرقهم في هذا المجال أهمّها :
مرسلة معاذ بن جبل أنّه قال لمّا بعثه النبي صلىاللهعليهوآله إلى اليمن قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله. قال : فبسنّة رسول الله قال : فإن لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله. قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، قال فضرب رسول الله صلىاللهعليهوآله صدره وقال : الحمد لله الذي وفّق رسول الله لما يرضاه رسول الله » (١).
قوله : « لا آلو » أصله « لا أَأْلو » بمعنى لا أترك.
وفيه : أنّه قابل للمناقشة سنداً ودلالة ، أمّا السند فلأنّها مرسلة مضافاً إلى ضعفها من ناحية الحارث بن عمر.
وأمّا الدلالة فتقريب دلالتها : أنّ الظاهر كون الاجتهاد فيها بمعنى تقنين الفقيه وتشريعه من دون الإتّكاء على كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله لأنّ المفروض أنّ الاجتهاد بالرأي فيها يكون بعد عدم ورود الكتاب والسنّة وهو شامل للقياس بإطلاقه.
لكن يرد عليه : أنّ شمول الاجتهاد لمطلق القياس أوّل الكلام.
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله « من أنّه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري : بم تقضيان؟ فقالا : إن لم
__________________
(١) الاصول العامّة : ص ٣٣٨ ؛ ومسند أحمد : ج ٥ ، ص ٢٣٠.
نجد الحكم في الكتاب ولا السنّة قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحقّ عملنا به » (١).
ووجه دلالتها أنّهما صرّحا بالأخذ بالقياس عند فقدان النصّ ، والنبي صلىاللهعليهوآله أقرّهما عليه فكان حجّة.
وفيه : أنّه ضعيف سنداً أيضاً فلا يمكن الاعتماد عليه وإن تمّت دلالتها.
وحديث الجارية الخثعمية أنّها قالت : « يارسول الله إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحجّ إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت : نعم. قال : فدين الله أحقّ بالقضاء ».
وتقريب دلالته أنّه الحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس (٢).
وفيه أوّلاً : أنّ الاستدلال لحجّية قياساتنا بقياس النبي صلىاللهعليهوآله نوع من القياس ، واعتباره أوّل الكلام.
ثانياً : أنّ ظاهر الحديث تمسّكه صلىاللهعليهوآله بالقياس الأولويّة وهو خارج عن محلّ الكلام.
ثمّ أضف إلى ذلك كلّه أنّ هذه الرّوايات لو تمّت سنداً ودلالة لكنّها معارضة بما هو أقوى وأظهر ، أي الرّوايات السابقة الدالّة على بطلان القياس التي نقلنا بعضها عن طرقهم.
هذا كلّه في الاستدلال بالسنّة على حجّية القياس.
أمّا الإجماع ، فقد ادّعى اتّفاق الصحابة على حجّية القياس حيث إن طائفة منهم كانوا عاملين بالقياس وطائفة اخرى سكتوا عنه فلم ينكروا عليهم.
وفيه أوّلاً : أنّ الصغرى ليست بثابتة لأنّ الكثير من الصحابة لم يكونوا في المدينة في ذاك العصر بل كانوا في مختلف بلاد الإسلام.
وثانياً : لا دليل على كون جميع الصحابة داخلين في إحدى هاتين الطائفتين وليس لنا مدرك جمع فيه أقوال كلّ الصحابة.
__________________
(١) الاصول العامّة : ص ٣٣٨.
(٢) المصدر السابق : ص ٣٣٨.
ثالثاً : لعلّ منشأ السكوت هو الخوف عن السوط والسيف أو عدم العلم بذلك.
ورابعاً : أنّ هذا الإجماع على فرض ثبوته معلوم المدرك لا يكشف عن قول المعصوم.
أمّا الاستدلال بالعقل ، فاللائق للطرح من الوجوه العقليّة التي ذكروها في هذا الباب وجهان :
الأوّل : أنّ الأحكام الشرعيّة مستندة إلى مصالح ، وهي الغايات المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة للمصلحة قضت الحكمة والعدالة بتساويهما في الحكم تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع.
وجوابه اتّضح ممّا ذكر ، وهو أنّه إن كان استنباط العلّة استنباطاً ظنّياً فحجّيته أوّل الكلام ، والأصل عدمها ، وإن كان قطعيّاً فلا إشكال في حجّيته لأنّه حينئذٍ إمّا أن يكون من قبيل إلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط أو من قبيل المفهوم الموافق أو المستقلاّت العقليّة ، ولكنّها بأسرها خارجة عن محلّ النزاع.
الثاني : ما يرجع في الحقيقة إلى مقدّمات الانسداد المذكورة سابقاً وقد عبّروا عنها ببيانات مختلفة.
منها : أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كلّ حادثة نص ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، فإذا كانت النصوص متناهيّة ، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ، علم قطعاً أنّ الاجتهاد والقياس معتبر حتّى يكون لكلّ حادثة اجتهاد.
والجواب عنه ما مرّ سابقاً من أنّه لو فرضنا كون باب العلم منسدّاً إلاّ أن باب العلمي مفتوح عندنا لأجل الرّوايات الواردة من ناحية أهل بيت الوحي عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، هذا أوّلاً.
وثانياً : لو سلّمنا انسداد باب العلمي أيضاً لكن لا كلام في بطلان خصوص القياس للروايات الخاصّة الناهيّة عنه.
وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا امور :
الأوّل : أنّ القياس الظنّي لا دليل على حجّيته بل قام الدليل على عدم الحجيّة ، وهو الذي وقع النزاع فيه بين العامّة والخاصّة بل بين العامّة أنفسهم.
الثاني : أنّ القياس القطعي حجّة سواءً سمّي قياساً أو لم يسمّ ، وهو إمّا راجع إلى قياس الأولويّة ، أو قياس المنصوص العلّة ، أو تنقيح المناط ، أو المستقلاّت العقليّة وشبهها.
الثالث : أنّ العلّة المنصوصة في الرّوايات الواردة في علل الشرائع قد يراد بها العلّة التامّة ، وقد يراد بها العلّة الناقصة ، وتسمّى حكمة ، ويتوقّف تعيين أحدهما على ملاحظة لحن الرّوايات وتعبيراتها المختلفة والقرائن الموجودة الحاليّة والمقاليّة.
الثاني : الاستحسان
وهو في اللغة : « عدّ الشيء حسناً » لكنّه ليس المقصود في المقام.
وأمّا في الاصطلاح فقد نقل له عن العامّة معان مختلفة كثيرة :
منها : « إنّ الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس » ، ويستفاد من هذا التعريف أنّهم حاولوا أن يعدّوا الاستحسان كاستثناء من القياس فخرجوا عن القياس فيما إذا كان تركه أوفق بحال الناس ، ولذلك كثيراً ما يقال في كلماتهم « أنّ القياس حجّة إلاّفي مورد الاستحسان » وحينئذٍ لا يعدّ دليلاً مستقلاً في القياس كما يشهد عليه عدم ذكر بعضهم إيّاه في الاصول.
ومنها : « أنّه هو الالتفات إلى المصلحة والعدل » وبناءً على هذا التعريف يعدّ الاستحسان أساساً مستقلاً للتشريع التقنين ، وسيأتي الفرق بينه وبين المصالح المرسلة.
ومنها : ما يشبه التعريف السابق ، وهو « أنّه ما يستحسنه المجتهد بعقله » وغير ذلك من التعاريف التي سيأتي ذكر بعضها في آخر البحث.
ثمّ إنّهم اختلفوا في حجّية الاستحسان وعدمها ، فحكي عن الشافعي والمالك جملتان :
إحديهما : ما حكي عن الشافعي في مذمّة الاستحسان وهو : « من استحسن فقد شرّع » (١) لكن اختلف في المراد من هذه الجملة فحكي عن الفتوحات أنّ المراد منها أنّ للاستحسان مقاماً عالياً كمقام الأنبياء وتشريعاتهم ، لكن الإنصاف أنّ الواضح كونها في مقام المذمّة ، ولذا عدّوا الشافعي من نفاة الاستحسان.
ثانيها : ما نقل عن المالك في مدح الاستحسان وهو « أنّه تسعة أعشار العلم » (٢).
ونسب إلى الظاهريين منهم إنكاره ، والمعروف من مذهب أصحابنا نفيه مطلقاً.
هذه هي الأقوال في المسألة.
ثمّ إنّ الاستحسان على قسمين : قطعي وظنّي.
فالقطعي منه لا كلام في حجّيته بناءً على الحسن والقبح العقليين وقاعدة الملازمة.
والظنّي هو موضع البحث والنزاع. فالقائلون بحجّيته تمسّكوا بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب : فاستدلّوا أوّلاً : بقوله تعالى : ( فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) (٣). وثانياً : بقوله تعالى : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ) (٤) بتقريب أنّ مدح العباد على اتّباع أحسن القول في الآية الاولى وإلزامهم باتّباع أحسن ما انزل إليهم من ربّهم في الآية الثانية أمارة على جعل الحجّية له بالنسبة إلى الأقوال ، ومع إلغاء الخصوصيّة للأقوال تثبت الحجّية للاستحسان في الأفعال أيضاً.
لكن الإنصاف أنّه لا ربط للآيتين بالاستحسان ، فإنّهما مربوطتان بالأحسن الواقعي ، والطريق إلى الواقع إنّما هو القطع أو الظنّ الثابت حجّيته لأنّ الألفاظ وضعت للمعاني الواقعيّة ولم يؤخذ فيها العلم والجهل ، فوضع لفظي « الدم » و « الخمر » مثلاً للدم والخمر الواقعيين ، فإن قطعنا بالواقع فهو حجّة لكون القطع نفس مشاهدة الواقع فيكون حجّة ذاتاً ، وإن ظننا فلا دليل على حجّيته وليست الحجّية ذاتيّة للظنّ ، هذا أوّلاً.
ثانياً : المحتمل في المراد من « القول » في قوله تعالى : « ويستمعون القول » وجهان :
__________________
(١) الاصول العامّة : ص ٣٦٣ ، وفوائد الرحموت حاشية المستصفى : ج ٢ ، ص ٣٢١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) سورة الزمر : الآية ١٨.
(٤) سورة الزمر : الآية ٥٥.
أحدهما : أنّ المراد منه هو قول الناس ، الثاني : أنّ المراد هو آيات القرآن الكريم ، فقد إحتمل المعنى الثاني بعض المفسّرين ببيان أنّ القرآن مشتمل على مستحبّات وواجبات ومكروهات ومباحات ، والواجبات والمستحبّات أحسن من المكروهات والمباحات ، وعباد الله تعالى يتّبعون الواجبات والمستحبّات ، وهذا هو المراد باتّباع الأحسن ، فإن كان هذا هو المراد من الآية فلا دخل لها بما نحن بصدده وهي أجنبية عنه.
وأمّا المعنى الأوّل فلازمه أنّ عباد الله يتّبعون أحسن أقوال الناس ، فإنّها تنقسم إلى الحقّ والباطل ، ومن الناس من يدعوا إلى الجود والسخاء مثلاً ، ومنهم من يدعوا إلى البخل والإقتار.
وعباد الله يتّبعون الأحسن منهما وهو الجود والإيثار ، وحينئذٍ إن قلنا بأنّ المراد من الأحسن هو الأحسن في نظر الشارع فلا ربط للآية أيضاً بمحلّ البحث ، وإن كان المراد منه الأحسن في نظر العقل فهو داخل في المستقلاّت العقليّة ولا يشمل موارد الظنّ.
هذا كلّه بالنسبة إلى الآية الاولى.
أمّا الآية الثانية فلها أيضاً تفسيران : أحدهما : أنّ المراد من الأحسن هو أحسن الآيات التي أُنزل إليكم ، وحينئذٍ لا ربط أيضاً لها بالمقام.
ثانيهما : أنّ المراد منه القرآن وإنّه أحسن من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماويّة وهذا أيضاً لا دخل له بما هو محلّ النزاع كما هو واضح.
هذا كلّه هو الاستدلال بالآيات.
أمّا السنّة : فقد روي عن ابن مسعود أنّه قال : « إنّ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمّد صلىاللهعليهوآله خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته ثمّ نظر في قلوب العباد بعد قلب محمّد صلىاللهعليهوآله فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لنبيّه يقاتلون على دينه ، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رأوا سيّئاً فهو عند الله سييء » (١).
وهذه الرّواية غير تامّة سنداً ودلالة أمّا السند : فهي موقوفة ( أي موقوفة على ابن مسعود ولم يروها أحد عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ) فليست بحجّة.
__________________
(١) مسند أحمد : ج ١ ، ص ٣٧٩.
وأمّا الدلالة فأوّلاً : أنّها إنّما ترتبط بمحلّ الكلام إذا كان المراد من الرؤية في قوله « ما رأوا » الرؤية الظنّية ، والإنصاف أنّ نفس كلمة الرؤية ظاهرة في العلم والقطع ولا فرق في هذه الجهة بين الرؤية القلبيّة والرؤية بالبصر.
وثانياً : قد يرى التهافت بين صدر الحديث وذيله ، لأنّ الذيل ظاهر في أنّ المسلمين إذا رأوا حسناً فهو عند الله حسن مع أنّ صدره يختصّ بخصوص الصحابة.
أمّا الإجماع : فقد ادّعوا أنّه توجد مسائل لا دليل عليها غير الإجماع على الاستحسان ولا تدخل تحت عنوان من العناوين الفقهيّة من العقود والإيقاعات كإجماع الامّة على استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السائقين من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء بالاجرة فلا يدخل شيء منهما تحت العناوين المعروفة من العقود الشرعيّة ، وفي فوائد الرحموت مثّل له بمسألة الاصطناع ، فيطلب من النجّار أو الكفّاش مثلاً اصطناع باب أو نعلين من دون تقدير للوزن أو القيمة ، كما يمكن التمثيل لها في عصرنا هذا بركوب السيارة من دون تقدير للُاجرة.
لكن يرد على الإجماع هذا أوّلاً : أنّه قائم على هذه الأحكام بالخصوص لا على استحسانها ، وهو في الواقع ليس إجماعاً في المصطلح بل سيرة مستمرّة إلى زمن النبي صلىاللهعليهوآله ( لو ثبتت السيرة ) قامت على هذه الأحكام.
وثانياً : أنّه يمكن إدخال هذه الأحكام تحت عناوين معروفة في فقهنا الثابتة بالأدلّة المعتبرة ، فيدخل المثال الأوّل والثاني في عنوان الإباحة مع الضمان الذي له مصاديق كثيرة في الفقه وكذلك مثال ركوب السيارة.
يبقى مثال الاصطناع ، وهو أيضاً يدخل في عنوان البيع ، كما إذا اشترى الأبواب على نحو الكلّي في الذمّة ، نعم أنّه ليس داخلاً في عقد من العقود إذا ذكر للنجّار خصوصيّات للباب ووعده أن يشتري منه فيما بعد ، لكن قد يدخل هذا أيضاً في قاعدة لا ضرر إذا لم يوجد من يشتري ذلك الباب مع تلك الخصوصيّات فيجب على الواعد جبران الخسارة.
هذا في الأدلّة التي استدلّوا بها أنفسهم على حجّية الاستحسان ، ويمكن أيضاً أن يستدلّ لهم بدليل عقلي ، وهو الانسداد حيث إنّه في صورة الانسداد لا يكون الظنّ القياسي كافياً لهم بل لابدّ من التعدّي إلى الظنّ الاستحساني.
والجواب عنه واضح ، وهو ما مرّ من كفاية الكتاب والسنّة ( مع ملاحظة الرّوايات المروية من طرق أهل البيت عليهمالسلام ).
فقد ظهر إلى هنا أنّه إذا كان الاستحسان قطعيّاً فلا إشكال في حجّيته من باب كونها ذاتيّة للقطع ، وإذا كان ظنّياً يكون مشمولاً لأدلّة عدم حجّية الظنّ ، وكلّ واحد من الأدلّة الأربعة التي استدلّ بها لإثبات الحجّية له غير تامّ.
وأمّا دليل النافين فهي أدلّة عدم حجّية مطلق الظنّ كما أشرنا إليه آنفاً ، لكن حكي عن الشافعي دليلاً لنفيه وهو أنّه لو قال المفتي فيما لا نصّ فيه ولا قياس : « استحسن » فلا بدّ أن يزعم جواز استحسان خلافه لغيره ، فيفتي كلّ حاكم في بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا فإن كان هذا جائزاً فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاؤوا ، وإن كان ضيّقاً فلا يجوز أن يدخلوا فيه.
وقد يقال في الردّ عليه : أنّ مثل هذا الكلام غريب على الفنّ لانتهائه ـ لو تمّ ـ إلى حصر الاجتهاد مطلقاً مهما كانت مصادره ، لأنّ الاختلاف واقع في الاستنباط منها إلاّنادراً ولا خصوصيّة للاستحسان في ذلك (١).
لكن الإنصاف أنّه فرق بين الاستحسان وغيره لأنّه في غيره يوجد ضوابط معيّنة من شأنها أن تقلّل وقوع الاختلاف ، بخلاف الاستحسان الذي لا ضابطة محدّدة فيه.
بقي هنا شيء :
وهو أنّ للاستحسان في كلماتهم معانٍ اخرى غير ما ذكر وقد ذكرها في شرح فواتح الرحموت :
منها : أنّ القياس إمّا جلي أو خفي ، والثاني هو الاستحسان كقياس بعضهم سؤر الطيور
__________________
(١) الاصول العامّة ، للفقه المقارن : ص ٣٧٦.
المعلّمة بسؤر الحيوان المفترس ( الذي لا إشكال في نجاسته عندهم ) وحكمه بنجاسته فهو قياس جلي ، وقياس بعض آخر إيّاه بسؤر الإنسان والحكم بطهارته فهو قياس خفي ، وقد ذكروا هنا وجوهاً لرفع التعارض بين القياسين لا طائل تحتها ، وهذا المعنى من الاستحسان مبني على قبول حجّية القياس الظنّي وقد مرّ نفيه.
منها : أنّ الاستحسان بمعنى النصّ كما حكوا عن بعض أئمّتهم أنّه قال : إنّا أثبتنا الرجم بالاستحسان لكونه منصوصاً من طرق الفريقين فاطلق الاستحسان على النصّ.
منها : أنّ الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وهو على أربعة أقسام :
١ ـ الأخذ بأقوى الظهورين مثل تقديم الخاصّ على العام ، أو النصّ على الظاهر ، وهذا داخل في باب حجّية الظواهر ولا كلام فيه.
٢ ـ الأخذ بالمرجّحات المنصوصة كالأخذ بما وافق الكتاب.
٣ ـ الأخذ بالأهمّ القطعي في مقابل المهمّ في باب التزاحم ، وهذا داخل في الدليل العقلي ولا إشكال فيه أيضاً.
٤ ـ الأخذ بالأقوى والأهمّ الظنّي ، وهو ليس حجّة عندنا مطلقاً إلاّما خرج بالدليل.
هذا كلّه في الاستحسان.
الثالث : المصالح المرسلة
وقد ذكر لها معانٍ مختلفة بل لعلّها متضادّة لكن ما يستفاد من أكثر الأدلّة التي ذكرت لها هو أنّ المراد من المصالح هي مصالح العباد ومضارّهم على مذاقّ الشرع ، والمراد من المرسلة هي المصالح التي لم يرد فيها نصّ خاصّ ولا عامّ ، أي أنّها ارسلت واطلقت ولم يرد عليها شرع لا في العمومات ولا في الخصوصات ، ومثّل لها في كلمات الغزالي بتترس الكفّار بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافّة المسلمين ، ثمّ يقتلون الاسارى أيضاً ، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً ، وهذا لا عهد به في الشرع ، فيجوز لقائل أن يقول : هذا الأسير مقتول على كلّ حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ، فيحكم العقل هنا بوجوب رمي الترس من باب تقديم الأهمّ على المهمّ.
فمن هذا المثال أيضاً يستفاد أنّ المراد من المصالح المرسلة هي المصالح على مذاقّ الشرع ، لأنّ المستفاد من مجموع الأحكام الشرعيّة أنّ حفظ كيان الإسلام أهمّ عند الشارع من حفظ النفوس المحترمة.
هذا ـ ولابدّ هنا من إضافة نكتتين غفل عنهما في كلماتهم :
إحديهما : في الفرق بين الاستحسان والمصالح المرسلة ، فالظاهر أنّ في استحسان شيء يكفي مجرّد أن يستحسنه الطبع والفطرة من دون أن يلحظ أنّ فيه مصلحة أو مفسدة ، لأنّ الحسن والقبح في الأفعال كالحسن والقبح في الطبيعة ( كحسن صوت العندليب وقبح صوت الحمار ) له مبدأ فطري لا حاجة فيهما إلى درك المصلحة أو المفسدة ، بينما في المصالح المرسلة الحاكم هو العقل والبرهان لا الطبع والفطرة وإن استعملا ( الاستحسان والمصالح المرسلة ) في بعض الكلمات في معنى واحد.
الثانية : أنّ ما ذكرنا في الاستحسان من تقسيمه إلى القطعي والظنّي يجري هنا أيضاً ، فالمصالح المرسلة أيضاً تارةً يكون حكم العقل بها قطعيّاً ( أي القطع بوجود المقتضي وفقد المانع ) فيكون حجّة بلا ريب ، واخرى يكون ظنّياً فلا دليل على حجّيته.
أمّا الأقوال في المسألة ، فاختلف العامّة في حجّيتها ، وعمدة الأقوال فيها ثلاثة :
الأوّل : قول الشافعي بإنكارها حيث حكى عنه عبارتان معروفتان :
إحديهما : « أنّه من استصلح فقد شرع كمن استحسن ».
ثانيهما : « إنّ الاستصلاح كالاستحسان متابعة الهوى » (١).
الثاني : قول مالك بإثباتها وحكي عنه أيضاً عبارة وهي « أنّ الاستصلاح طريق شرعي للاستنباط فيما لا نصّ فيه ولا إجماع » (٢).
الثالث : ما حكي عن الغزالي من التفصيل بين الضروريات وبين الحاجيات والتحسينيات ، والمراد من الضروريات ما لا يمكن حياة الإنسان إلاّبه ، والمراد من الحاجيات أنواع المعاملات التي توجب رفع بعض الحاجات وإن كانت حياة الإنسان ممكنة بدونها ، والمراد من التحسينيات غير الضروريات والحاجيات من أنواع اللذائذ المشروعة التي
__________________
(١) راجع الاصول العامّة : ص ٣٨٥.
(٢) المصدر السابق : ص ٣٨٤.
توجب الراحة والاشتغالات اللهويّة ، ثمّ قال : الاستصلاح حجّة في القسم الأوّل (١) وذكر هنا مثال التترس الذي حكينا عنه آنفاً.
أمّا الأدلّة في المسألة ، فالقائلون بالحجّية استدلّوا بوجوه عمدتها الإجماع والوجوه العقليّة.
فمنها : ما يرجع في الواقع إلى دليل الانسداد وإن لم يعبّروا به في كلماتهم ، وهو أنّ الحوادث الكثيرة متجدّدة والنصوص قليلة ، ولو اكتفينا بالنصوص ضاقت الشريعة الإسلاميّة مع أنّ الإسلام خاتم الأديان.
والجواب عنه ظهر ممّا مرّ كراراً من أنّه إن كان المراد من الاستصلاح ـ الاستصلاح في موارد القطع فلا ننكره كما سيأتي في الجواب عن الوجه الثاني ، وإن كان المراد منه الاستصلاح في موارد الظنّ ( كما أنّه كذلك ) فلا دليل على حجّيته لما مرّ من عدم تماميّة مقدّمات الانسداد عندنا ، ومنشأ الانسداد على مذهبهم ناشٍ من قلّة نصوصهم مع أنّ سنّة الأئمّة المعصومين عندنا كسنّة النبي صلىاللهعليهوآله وهي تشتمل على الاصول الكلّية والأحكام الجزئيّة معاً ، وتكون كافية في رفع الانسداد.
ومنها : أنّ الأحكام الشرعيّة إنّما شرّعت لتحقيق مصالح العباد وإنّ هذه المصالح التي بنيت عليها الأحكام الشرعيّة معقولة ، أي ممّا يدرك العقل حسنها كما أنّه يدرك قبح ما نهى عنه فإذا حدثت واقعة لا نصّ فيها وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر ، كان حكمه على أساس صحيح معتبر من الشارع.
وفي الجواب نقول : أنّ هذا منبي على الحسن والقبح العقليين وقاعدة الملازمة ، وهي مقبولة عندنا في موارد القطع بالمصلحة والمفسدة التي ليست بنادرة ، لأنّ امّهات الأحكام الشرعيّة قابلة لأن تدرك بالعقل وإن لم يدرك تفاصيلها ، ولذلك نرى أنّه في علل الشرائع ذكرت لأحكام الشرع علل يدركه العقل تفاصيلها ، ولذلك نرى أنّه في علل الشرائع ذكرت لأحكام الشرع علل يدركه العقل ، فلا وجه لما ذكر في مثل الاصول العامّة من أنّ ما كان من قبيل الحسن والقبح الذاتيين فهو نادر جدّاً وأمثلته قد لا تتجاوز العدل والظلم وقليلاً من نظائرهما » (٢).
__________________
(١) راجع الأصول العامّة : ص ٣٨٣.
(٢) الاصول العامّة : ص ٣٨٧.
ومن هنا يظهر أنّ الاستحسان إذا بلغ حدّ المستقلاّت العقليّة وشبهها كان حجّة ، ولكن الاستحسانات الظنّية التي تدور عليها كلماتهم لا دليل على حجّيتها أصلاً ، مضافاً إلى أنّ العدل والظلم لهما مصاديق كثيرة ربّما تشمل شيئاً من أحكام الشرع كالزنا والسرقة والخيانة والكذب والغيبة والسبّ والجناية على الأنفس والأعضاء والغشّ في المعاملة وغير ذلك من أشباههما ، فإنّها تدخل في هذا المعنى.
ومنها : الاستدلال بسيرة الصحابة من زمن النبي صلىاللهعليهوآله القائمة على تشريعهم ما رأوا إنّ فيه تحقيق المصلحة بعد أن طرأت بعد وفاة النبي صلىاللهعليهوآله حوادث وجدت لهم طوارىء ، فأبو بكر جمع القرآن في مجموعة واحدة ، وحارب مانعي الزّكاة ، ودرأ القصاص عن خالد بن الوليد ، وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ووقف تنفيذ حدّ السرقة في عام المجاعة ، وقتل الجماعة في الواحد ، وعثمان جدّد أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة.
وفيه أوّلاً : أنّ هذه السيرة لا تصل إلى زمن النبي صلىاللهعليهوآله.
وثانياً : لا تتكوّن السيرة من مجرّد نقل موارد شخصية من أشخاص معدودين.
وثالثاً : أنّ الموارد المذكورة غالباً تكون من باب الاجتهاد في مقابل النصّ مثل إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع أنّ المفروض كون الاستحسان إستصلاحاً في ما لا نصّ فيه.
هذا في أدلّة المثبتين.
واستدلّ النافون منهم بوجوه عديدة أهمّها ثلاثة أوجه :
الوجه الأوّل : ( وهو أحسن الوجوه ) ما ذكره العضدي والحاجبي ( ابن الحاجب ) في مختصر الاصول (١) وهو « أنّ المصالح المرسلة تقدّمت لنا لا دليل فوجب الردّ » ( أي حيث إنّه لا دليل على حجّية المصالح المرسلة ، فيجب ردّها وليست بحجّة ) ثمّ نقل ما مرّ من الدليل على الحجّية مع الردّ عليه فقال : « قالوا لو لم تعتبر لأدّى إلى خلوّ الوقائع ، قلنا : بعد تسليم أنّها لا تخلو العمومات والأقيسة تأخذها » وقال العضدي في شرح هذا الكلام أوّلاً : إنّا لا نقبل خلوّ
__________________
(١) للحاجبي المتوفّى في القرن السابع ، وشرحه العضدي الشافعي ، وكلّ من المؤلّف والشارح معنون في علم الرجال بعنوان عالم اصولي.
الواقع عن الحكم لأنّ العمومات والأقيسة تكون بمقدار يوجب عدم خلوّ الوقائع ، وثانياً : لو أدّى إلى خلوّ الوقائع عن الحكم فلا بأس به.
وحقّ الجواب عن هذا أنّه لو كان المراد من المصالح المرسلة المصالح القطعيّة التي ترجع بالمآل إلى المستقلاّت العقليّة وشبهها وقاعدة الملازمة فلا إشكال فيه ، وإن كان المراد منها مجرّد العلم بالمقتضي في الجملة من دون إحراز عدم المانع ووجود الشرائط الذي يوجب الظنّ بالحكم فقط فلا دليل على حجّيته كما مرّ كراراً.
الوجه الثاني : ما نقله عنهم في الاصول العامّة وهو « أنّه لو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر ممّا شرّعه وممّا أرشد إلى الإهتداء به لبيّنه ولم يتركه لأنّه سبحانه قال على سبيل الاستنكار : ( أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ) (١).
ويمكن الجواب عنه بناءً على عدم المنافاة بين بيان الأحكام لجميع الوقائع وعدم خلوّها منها وبين أن لا تصل جميعها إلينا فلا بدّ من كشفها والاستدلال عليها بالعقل بالطرق الثلاثة المذكورة سابقاً ( طريق علل الأحكام وطريق معلولاتها وطريق الملازمات ) وهذا يرجع في الواقع إلى خلوّ بعض الأحكام من دليل الكتاب والسنّة فيما وصلت إلينا وهو أمر معقول.
الوجه الثالث : ما يستفاد من كلام الغزالي وحاصله : أنّ المصلحة هي المحافظة على مقاصد الشرع ، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنّة والإجماع ، فلا بدّ في اعتبار المصلحة من كونها موجودة في الكتاب والسنّة والإجماع وإلاّ نستكشف عدم كونها مصلحة عند الشارع فتكون باطلة مطروحة.
والجواب عنه : أنّا نقبل المقدّمة الاولى في كلامه ، وهي ما يعبّر عنها اليوم بأنّا نأخذ القيم من الشرع ، ولكن المقدّمة الثانية في كلامه وهي انحصار طريق استكشافها في الكتاب والسنّة والإجماع فممنوعة لأنّه قد يكون الطريق هو العقل القطعي.
نعم لا اعتبار بالعقل الظنّي ما لم يدلّ عليه دليل شرعي من الكتاب أو السنّة أو الإجماع.
فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ المصالح على قسمين : ما يستكشفه العقل القطعي ويحصل العلم بكونه جامعاً للشرائط وفاقداً للموانع فيكون حجّة ، وما يستكشفه العقل الظنّي ولا يحصل القطع به فليس بحجّة.
__________________
(١) الاصول العامّة : ص ٤٠٠.
إن قلت : إذا أمكن أن تدرك المصالح والمفاسد بالعقل فلا حاجة إلى الشرع.
قلنا : إنّ العقل إنّما يدرك المصالح والمفاسد القطعيّة في دائرة مضيّقة محدودة خاصّة من الامور ، وما يبقى خارجاً من هذه الدائرة هو الأكثر فليس للعقل سبيل إلى المصالح والمفاسد في أحكام الإرث وكثير من مسائل النكاح والنساء والمحرّمات وكثير من المعاملات وما يحلّ وما يحرم من اللحوم والأطعمة والأشربة وغيرها من أشباهها ، والشاهد على ذلك ما نشاهده من التغييرات في القوانين البشريّة في هذه الامور كلّ يوم ، وبالجملة أنّ العقل هو بمنزلة مصباح مضيء في صحراء مظلمة يضيء دائرة محدودة منها فقط ، وأمّا الشرع فهو كالشمس في السماء يضيء كلّ شيء.
الرابع : سدّ الذرائع
« الذريعة » في اللغة تطلق على مطلق الآلة والوسيلة ولكن في الاصطلاح تطلق على وسيلة خاصّة ، فتكون بمعنى التوصّل بما هو مصلحة إلى مفسدة ، وسدّ الذرائع هو المنع عمّا يتوصّل به إلى الحرام ، أي المنع عن مقدّمة الحرام ، فحقيقة الذريعة هي نفس ما يبحث عنه في علم الاصول بعنوان مقدّمة الحرام لكنّها عند بعض بمعنى مطلق المقدّمة ، فتكون الذريعة حينئذٍ مطلق ما كان وسيلة وطريقاً إلى شيء ، ولذلك تجري فيه جميع الأحكام الخمسة ، ولأجله قال بعضهم ، « سدّ الذرائع وفتحها » و « الذريعة كما يجب سدّها ، يجب فتحها وتكره وتندب وتباح ».
والشاهد للتفسير الأوّل عبارة « موافقات الشاطبي » نقلاً عن بعضهم : « الذريعة ربع الدين » (١) حيث إن الدين إمّا أن يكون أمراً أو نهياً ولكلّ منهما مقدّمات تخصّه ، فينقسم الدين حينئذٍ إلى أربعة أقسام : الواجبات ومقدّماتها ، والمحرّمات ومقدّماتها أيضاً ، فيصحّ أن يقال : إنّ الذريعة ربع الدين.
ثمّ إنّ الموافقات نقل عن بعضهم معنىً ثالثاً للذريعة وهو « الحيلة » فسدّ الذرائع بمعنى سدّ
__________________
(١) موافقات الشاطبي : ج ٤ ، ص ١٩٩.
الحيل وحرمة التوصّل بها ، ومثّل له بما إذا باع شيئاً نسيئة بمبلغ ثمّ اشتراه منه بثمن أقلّ منه فأعطاه الأقل لكي يأخذ منه الأكثر عند الأجل ، وهذا من الحيل للخروج عن الربا (١).
واستدلّوا لحجّية سدّ الذرائع بروايات وآيات كثيرة حتّى جمع بعضهم تسع وتسعين آية تدلّ على حرمة مقدّمة الحرام :
منها : قوله تعالى : ( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) (٢).
ومنها : قوله تعالى : ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) (٣).
ومنها : قوله تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (٤).
وهذا معناه إنّهم أرادوا أن يثبتوا حرمة مقدّمة الحرام بالاستقراء ، وهو تامّ فيما إذا حصل منه العلم.
هذا كلّه هو حاصل كلماتهم.
ثمّ إنّه لابدّ لتكميل هذا البحث من ذكر نكات :
الاولى : أنّ الإنصاف أنّ اصول العامّة تكون من جهة العمق والمحتوى في مراحل أوّليّة بالنسبة إلى اصول الشيعة ، ويشهد لذلك خلطهم في المقام بين ثلاث عناوين : عنوان « مقدّمة الحرام » الذي يبحث عنه مستقلاً ، وعنوان « حرمة الإعانة » الذي لا ربط له بمقدّمة الحرام بل هو عنوان مستقلّ محرّم بنفسه كما مرّ في بعض الأبحاث السابقة ، وعنوان « الحيلة » لا ربط له أيضاً بمقدّمة الحرام ولا معنى للمقدّمة وذي المقدّمة فيه بل إذا وقع البيعان المزبوران مثلاً جامعين لأركان البيع شرعاً ولو كان بداعي الفرار عن الربا فلا إشكال في صحّتهما ، وإذا وقعا فاسدين خاليين عن القصد الجدّي للبيع والشراء فلا إشكال أيضاً في حرمتهما وبطلانهما سواء كانت مقدّمة الحرام حراماً أم لم تكن.
الثانية : أنّ عمدة الأدلّة وأحسنها في مبحث مقدّمة الحرام والواجب هو ما مرّ هناك من أنّ الطلب الإنشائي كالطلب التكويني ، والزجر الإنشائي كالزجر التكويني ، وبعبارة
__________________
(١) راجع الموافقات : ص ١٩٩.
(٢) سورة الأنعام : الآية ١٠٨.
(٣) سورة النور : الآية ٣١.
(٤) سورة المائدة : الآية ٢.
اخرى : الطلب الإنشائي أو الزجر الإنشائي نسخة مشابهة للتكويني منه ، فكما أنّه إذا أردنا شيئاً وطلبناه تكويناً طلبنا مقدّماتها أيضاً ، كذلك إذا طلبنا شيئاً تشريعاً نطلب مقدّماتها عن المكلّف ، وهكذا في جانب النهي ، فالعمدة هو دليل الملازمة بين الأمرين أو النهيين.
الثالثة : أنّ العمدة في باب الحيل هو عدم القصد الجدّي إلى الإنشاء غالباً بل ليس قول من يبيع علبة الكبريت بألف تومان مثلاً إلاّلعباً بالألفاظ ولقلقة باللسان من دون قصد جدّي إلى هذه المعاملة وإلاّ لو تحقّق الإنشاء حقيقة وتمشّى واقعاً لا إشكال في الصحّة.
إلى هنا تمّ الكلام
عن المقصد السادس من مباحث الاصول
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
الفهرس
المقصد الثالث : المفاهيم
٣ ـ المفاهيم ................................................................... ٩
الأمر الأوّل : في تعريف المفهوم ................................................... ٩
الأمر الثاني : هل البحث في باب المفاهيم عقلي أو لفظي؟ .......................... ١٠
الأمر الثالث : هل المسألة من المسائل الاصوليّة أو لا؟ ............................. ١١
الأمر الرابع : هل المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول؟ ............................ ١١
الأمر الخامس : هل النزاع في المفاهيم صغروي أو كبروي؟ ......................... ١٢
١ ـ الكلام في مفهوم الشرط .................................................. ١٣
أدلّة المنكرين : ................................................................ ١٩
الأمر الأوّل : هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحكم؟.. ٢١
الأمر الثاني : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ...................................... ٢٤
الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات ..................................... ٢٩
أمّا المقام الأوّل : وهو تداخل الأسباب ........................................... ٣٠
المقام الثاني : في تداخل المسبّبات ................................................. ٣٨
٢ ـ الكلام في مفهوم الوصف ................................................. ٤١
٣ ـ الكلام في مفهوم الغاية .................................................... ٥١
٤ ـ الكلام في مفهوم الحصر ................................................... ٥٧
من أداة الحصر كلمة « إنّما » .................................................. ٦١
ومن أداة الحصر كلمة « بل » .................................................. ٦٣
ومنها تعريف المسند إليه باللام .................................................. ٦٤
٥ ـ الكلام في مفهوم اللقب ................................................... ٦٥
٦ ـ الكلام في مفهوم العدد .................................................... ٦٧
المقصد الرابع : العام والخاصّ
٤ ـ العام والخاصّ ............................................................ ٧٣
الأمر الأوّل : في تعريف العام والخاصّ ........................................... ٧٣
الأمر الثاني : في أقسام العام ..................................................... ٧٥
الأمر الثالث : في الفرق بين العام والمطلق ........................................ ٧٩
الأمر الرابع : في أنّ للعموم صيغة تخصّه .......................................... ٧٩
الفصل الأول : ألفاظ العموم ................................................... ٨١
أمّا الأوّل : أمّا النكرة في سياق النفي أو النهي .................................... ٨١
أمّا الثاني : لفظة كلّ وما شابهها ................................................. ٨٢
أمّا الثالث : الجمع المحلّى باللام .................................................. ٨٣
أمّا الرابع : المفرد المحلّى باللام ................................................... ٨٤
الفصل الثاني : حجّية العام المخصّص في الباقي .................................... ٨٥
الفصل الثالث : التمسّك بالعام في الشبهات المفهوميّة للمخصّص ................... ٩٣
الفصل الرابع : التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص ...................... ٩٧
عدم حجّية استصحاب العدم الأزلي ............................................ ١٠٤
الفصل الخامس : الكلام في مسألة وجوب الفحص وأنّه هل يجوز التمسّك ......... ١١٣
المقام الأوّل : في المخصّص المنفصل ............................................. ١١٣
المقام الثاني : في المخصّص المتّصل .............................................. ١١٦
تذييل : في لزوم الفحص في موارد الاصول العمليّة ............................... ١١٧
الفصل السادس : الكلام في الخطابات الشفاهيّة ................................. ١١٩
تنبيه في ثمرة المسألة : ......................................................... ١٢٦
الفصل السابع : الكلام فيما إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى البعض ............... ١٣١
الفصل الثامن : الكلام في تخصيص العام بالمفهوم ................................ ١٣٧
الفصل التاسع : الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة ....................... ١٤٣
الفصل العاشر : هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟ ................ ١٤٩
الفصل الحادي عشر : الكلام في حالات العام والخاصّ ........................... ١٥٧
الفصل الثاني عشر : الكلام في النسخ والبداء ................................... ١٦٣
مسألة البداء ................................................................. ١٦٨
المقصد الخامس : المطلق والمقيّد
٥ ـ المطلق والمقيّد ........................................................... ١٧٥
المقدمة الاولى : في تعريف المطلق والمقيّد ........................................ ١٧٥
المقدمة الثانية : في شموليّة الإطلاق ............................................. ١٧٦
المقدمة الثالثة : الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة ............................. ١٧٦
المقدّمة الرابعة : في مصبّ الإطلاق ............................................ ١٧٧
المقام الأوّل : في الألفاظ التي يرد عليها الإطلاق ................................. ١٧٧
أحدها : « اسم الجنس » ..................................................... ١٧٧
ثانيها : « علم الجنس » ...................................................... ١٧٩
ثالثها : « المفرد المحلّى باللام » ................................................ ١٨١
رابعها : النكرة .............................................................. ١٨٢
المقام الثاني : في أنّ استعمال المطلق في المقيّد حقيقة أو مجاز؟ ....................... ١٨٤
المقام الثالث : في دلالة المطلق على الشمول والسريان وبيان مقدّمات الحكمة........ ١٨٥
الأوّل : في نتيجة مقدّمات الحكمة؟ ............................................ ١٩٠
الثاني : ما الفرق بين العام والمطلق؟ ............................................ ١٩١
الثالث : فيما إذا شكّ في أنّ المولى هل هو في مقام البيان أو لا؟ ................... ١٩١
الرابع : في أنّ المراد من عدم البيان في ما نحن فيه ................................ ١٩٢
الخامس : في اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة ................................... ١٩٢
المقام الرابع : فيما إذا ورد مطلق ومقيّد ......................................... ١٩٣
الكلام في المجمل والمبيّن ....................................................... ٢٠٠
المقصد السادس : الأمارات المعتبرة
٦ ـ الأمارات المعتبرة ........................................................ ٢٠٧
المقام الأوّل : في مباحث القطع ................................................ ٢٠٧
الأمر الأوّل : في أنّ البحث عن أحكام القطع اصولي أو لا؟ ...................... ٢٠٧
الأمر الثاني : تقسيم الشيخ الأعظم رحمهالله ......................................... ٢٠٩
المسألة الاولى : في حجّية القطع ............................................... ٢١١
المسألة الثانية : في أحكام التجرّي ............................................. ٢١٥
التنبيه الأوّل : في مقتضى هذه الأدلة ........................................... ٢٢١
التنبيه الثاني : الآيات والرّوايات ............................................... ٢٢٢
التنبيه الثالث : الكلام في تفصيل صاحب الفصول ............................... ٢٢٨
التنبيه الرابع : في الإنقياد ..................................................... ٢٢٩
التنبيه الخامس : في سريان حرمة التجرّي بين الأحكام جميعاً ...................... ٢٣٠
المسألة الثالثة : في أقسام القطع ................................................ ٢٣٠
البحث الأوّل : أنّه يستحيل أخذ القطع بعنوان الموضوع .......................... ٢٣٠
البحث الثاني : أخذ القطع موضوعاً ............................................ ٢٣١
البحث الثالث : في أحكام القطع الموضوعي والطريقي وأنّه هل تقوم الطرق والأمارات مقامهما أو لا؟ ٢٣٣
المسألة الرابعة : هل يتصوّر ما ذكر من الأقسام للقطع في الظنّ أيضاً أو لا؟ ........ ٢٣٩
المسألة الخامسة : في وجوب الموافقة الالتزاميّة في الأحكام الفرعيّة وعدمه ........... ٢٤٠
المسألة السادسة : في قطع القطاع ............................................. ٢٤٤
المسألة السابعة : هل القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ، هو حجّة؟ .............. ٢٤٦
أمّا الطائفة الاولى : النهي عن العمل بالرأي ..................................... ٢٥٢
أمّا الطائفة الثانية : ما تدّل على غاية بعد العقول عن دين الله ..................... ٢٥٥
أمّا الطائفة الثالثة : التي تدلّ على انحصار الحجّة الشرعيّة بالنقل ................... ٢٥٦
الكلام في العلم الإجمالي ...................................................... ٢٥٨
أمّا المقام الأوّل : في تنجّز العلم الإجمالي وعدمه .................................. ٢٥٩
أمّا المقام الثاني : في كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال وعدمه ................... ٢٦٢
المقام الثاني في مباحث الظنّ ( حجّية الأمارات الظنّية ) ........................... ٢٦٩
أمّا الأمر الأوّل : أنّ الأمارات الظّنية ليست بحجّة ذاتاً ........................... ٢٦٩
وأمّا الأمر الثاني : في إمكان التعبّد بالظّن ....................................... ٢٧٠
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمهالله : ............................................... ٢٧٥
نقد كلام المحقّق النائيني رحمهالله : ................................................. ٢٨٠