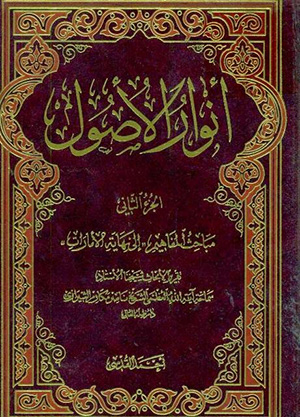الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-8139-14-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
الانسداد كحكمه بحجّية العلم في حال الإنفتاح فيقع الإشكال حينئذٍ من ناحية خروج القياس عن تحت عموم حكم العقل بحجّية الظنّ وأنّه كيف يخرج عن تحت عمومه مع أنّ حكم العقل ممّا لا يخصّص ، ولا يمكن رفع حكمه عن موضوعه ، إلاّ إذا انتفى الموضوع فينتفي الحكم بانتفائه ، أو خرج الفرد عن تحت الحكم موضوعاً فيسمّى بالتخصّص ، وأمّا تخصيص حكم العقل فلا يجوز ، وذلك باعتبار لزوم التناقض فإنّ العقل إذا حكم حكماً عاماً بنحو يشمل هذا الفرد بعينه ثمّ خصّصنا حكمه ورفعناه عن هذا الفرد لزم التناقض بين حكمه وبين التخصيص ، نظير ما إذا خصّصنا نوعاً من القطع عن عموم حجّية القطع في حال الإنفتاح ، وهذا بخلاف التخصيص في العمومات اللفظية فإنّ التناقض فيها صوري لا جدّي.
وقد اجيب عن هذا الإشكال بوجوه عديدة ، وقد ذكر الشيخ الأعظم وجوهاً سبعة في دفعه ( بعضها منه وبعضها من غيره ) وذكر المحقّق الخراساني رحمهالله وجوهاً خمسة في هذا المقام لكن عمدتها ثلاثة :
الوجه الأوّل : أنّ الرّوايات الناهيّة عن القياس منصرفة عن حال الانسداد.
أقول : لقائل أن يقول بهذا الوجه كما سيأتي في البحث التفصيلي عن القياس لكن الإنصاف أنّ هذه الدعوى مشكلة لقوّة إطلاقات الأدلّة.
الوجه الثاني : إنكار موضوع الظنّ القياسي وأنّه لا يوجب القياس الظنّ بالحكم في شيء من الموارد خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الشارع جمع في الحكم بين ما يترائى مخالفه ، وفرّق بين ما يتخيّل متؤالفه ، وكفاك في هذا عموم ما ورد « أنّ دين الله لا يصاب بالعقول » و « إنّ السنّة إذا قيست محق الدين » و « إنّه لا شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله » وغيرها ممّا دلّ على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس وخصوص رواية أبان بن تغلب المشهورة الواردة في ديّة أصابع الرجل والمرأة.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه بشهادة الوجدان بحصول الظنّ من القياس في بعض الأحيان وإن كان ضعيفاً من حيث المرتبة وتقدّم عليه الظنّ الحاصل من غيره عند التعارض.
الوجه الثالث : ( وهو الأساس في الجواب ) أنّ مقدّمات الانسداد ليست علّة تامّة لحجّية الظنّ مطلقاً حتّى لا يمكن تخصيصها بمثل مورد القياس بل إنّها مقتضية لها ، أي يحكم العقل بحجّية الظنّ مطلقاً عند الانسداد لولا المانع ، أي لولا منع الشارع ، ومع ورود النهي عنه لا أثر للمقتضي.
ومنه يعلم أنّ تشبيه الظنّ حال الانسداد بالعلم حال الانفتاح أشبه بالمغالطة لأنّ العلم علّة تامّة للحجّية.
وإن شئت قلت : أنّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجّية الظنّ حال الانسداد وعدم إنفتاح باب العلم والعلمي ، وفي مورد القياس ومثله يكون باب العلم مفتوحاً ، للعلم بأنّ الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الاصول اللفظية أو العمليّة ، فخروج القياس حينئذٍ يكون على وجه التخصّص وخروج الموضوع ، لا التخصيص.
التنبيه الخامس : في الظنّ المانع والممنوع
إذا قامت دليل ظنّي كالشهرة على عدم حجّية ظنّ آخر كالظنّ الحاصل من الاستحسان ، كما إذا قام الاستحسان على وجوب الزّكاة في النقود الورقيّة في يومنا هذا تشبيهاً لها بالدرهم والدينار ، فحصل الظنّ بوجوب الزّكاة من ناحيته في حال الانسداد ( وهذا هو الظنّ الممنوع ) والظنّ الحاصل من جانب قيام الشهرة على عدم حجّية الاستحسان بناءً على عدم العلم بعدم حجّية الاستحسان ، كما قد يقال به في فرض الانسداد ( وهذا هو الظنّ المانع ) فهل مقتضى مقدّمات الانسداد هو الأخذ بالظنّ الممنوع والحكم بوجوب الزّكاة في النقود الورقيّة في المثال ، أو إنّها تقتضي تقديم الظنّ المانع فتصير النتيجة وجوب الأخذ بالظنّ الحاصل من الشهرة والحكم بعدم وجوب الزّكاة؟ وجوه :
الأوّل : تقديم الظنّ المانع.
والثاني : تقديم الظنّ الممنوع.
والثالث : تساقط الظنّين والرجوع إلى الاصول العمليّة.
والرابع : أنّ المسألة مبنية على كون نتيجة مقدّمات الانسداد حجّية الظنّ في الفروع أو الاصول ، فإن قلنا أنّ نتيجتها هي الحجّية في الفروع فالمقدّم هو الظنّ الممنوع ، وإن قلنا أنّ النتيجة هي الحجّية في الاصول فالمقدّم هو الظنّ المانع ، وإن قلنا بحجّية كليهما فيتساقطان.
نعم ، لا يتصوّر هذا الوجه فيما إذا كان كلا الظنّين اصولياً كما إذا حصل الظنّ بعدم حجّية قول اللغوي ، وحصل الظنّ أيضاً بعدم حجّية هذا الظنّ ، فعلى القول بأنّ نتيجة مقدّمات
الانسداد هي حجّية الظنّ في خصوص الاصول لابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى سائر الوجوه.
الخامس : الأخذ بأقوى الظنّين لا سيّما إذا قلنا بأنّ نتيجة مقدّمات الانسداد جزئيّة من ناحية المراتب.
أقول : الحقّ في المسألة هو تقدّم الظنّ المانع وذلك باعتبار ما مرّ من عدم كون مقدّمات الانسداد علّة تامّة لحجّية الظنّ حتّى لا يمكن منع الشارع في مورد خاصّ بل إنّها مقتضية لها ، وحينئذٍ صحّ أن يقال : أنّه لا استقلال للعقل بحجّية ظنّ قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعاً فضلاً عمّا إذا ظنّ المنع عنه كذلك ، وذلك لعدم إحراز فقد المانع في هاتين الصورتين ، فلا بدّ حينئذٍ من الاقتصار على ظنّ نقطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى بمعظم الفقه فهو ، وإلاّ فيضمّ إليه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع.
نعم ، يمكن تقديم الظنّ الممنوع أيضاً فيما إذا كان موافقاً للاحتياط فيكون حينئذٍ مخيّراً بين الأخذ بكلّ واحد منهما.
التنبيه السادس : عدم الفرق بين حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة
لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين حصول الظنّ بالحكم الشرعي من أمارة عليه بلا واسطة كما إذا قامت الشهرة على وجوب شيء أو حرمته ، وبين حصول الظنّ بالحكم الشرعي من أمارة عليه مع الواسطة كالظنّ الحاصل من أمارة قامت على تفسير لفظ من ألفاظ الكتاب أو السنّة ( كما إذا قال اللغوي أنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض فأورث الظنّ في قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) بجواز التيمّم بالحجر مثلاً مع وجود التراب الخالص ) أو على وثاقة راوٍ ينقل الحكم عن الإمام المعصوم عليهالسلام فأورث الظنّ بذلك الحكم.
والوجه في عدم الفرق هو إطلاق حكم العقل بحجّية الظنّ حال الانسداد ، فلا فرق عنده بين ظنّ يوصلنا إلى الحكم الواقعي بلا واسطة أو مع الواسطة فلا حاجة إلى إعمال انسداد آخر صغير في مثل هذه الموارد ( أي موارد الرجوع إلى قول اللغوي وعلماء الرجال ) بل يكفي جريان مقدّمات الانسداد الكبير في معظم أحكام الفقه.
ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من قول اللغوي حجّة إذا كان متعلّقاً بحكم شرعي وليس بحجّة في تشخيص موضوعات الأحكام كالألفاظ الواردة في رسائل الوصيّة أو الوقف لأنّ المفروض هو انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام فتكون مقدّمات الانسداد تامّة في خصوص الأحكام لا الموضوعات.
اللهم إلاّ أن يتمسّك بالإنسداد الصغير في بعض الموارد ، وهو انسداد باب العلم والعلمي في معرفة بعض الموضوعات.
التنبيه السابع : في عدم حجّية الظنّ في مقام الامتثال والتطبيق
إنّ الثابت بمقدّمات الانسداد إنّما هو حجّية الظنّ في تشخيص الأحكام الشرعيّة وتعيينها ، لاختصاص انسداد باب العلم والعلمي به ، لا حجّيته في الإتيان بها وتطبيق المأتي به عليها ، لإمكان تحصيل القطع بتطبيق الحكم المظنون على الخارج فلا تجري فيه تلك المقدّمات ، فإذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظنّ على فرض الانسداد ، وأمّا امتثال هذا الحكم خارجاً فلا بدّ أن يكون بالعلم ولا يكفي فيه الظنّ.
إن قلت : بعد العمل بالظنّ في تعيين الحكم الشرعي يصير الامتثال في النهاية ظنّياً فلا يجدي تحصيل العلم بالتطبيق.
قلنا : الظاهر إنّه وقع الخلط بين الظنّ بالحكم الواقعي والظنّ بأداء الوظيفة ، فإنّه وإن كان الإتيان بالواقع ظنّياً ولكن اليقين حاصل بأداء الوظيفة لا أنّ أدائها ظنّي ، فإذا صلّى صلاة بعنوان الجمعة مثلاً ( المظنون وجوبها ) قاطعاً فقد أدّى ما عليه من الوظيفة قطعاً بخلاف ما إذا أتى بها مظنوناً.
نعم ، ربّما يجري الانسداد الصغير في مقام التطبيق والامتثال بالنسبة إلى بعض الموضوعات فيكون الظنّ حجّة في مقام الامتثال أيضاً ، وهذا كما في موضوع الضرر الذي انيط به أحكام كثيرة من جواز الإفطار والتيمّم وجواز ترك الحجّ وغيرها ، فيقال : أنّ باب العلم بالضرر منسدّ غالباً ، إذ لا يعلم به في الأغلب إلاّبعد تحقّقه ووقوعه فيستلزم من اعتبار العلم به الوقوع في المخالفة الكثيرة.
وإن شئت قلت : إجراء أصل العدم في تلك الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر كثيراً مع العلم بعدم رضا الشارع بذلك لشدّة اهتمامه بالضرر ، ومن جانب آخر : الاحتياط بترك كلّ ما احتمل كونه ضرريّاً يوجب العسر والحرج بل في بعض الموارد غير ممكن عقلاً كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة كصيام شهر رمضان فإن كان ضرريّاً فقد حرم ، وإن لم يكن ضرريّاً فقد وجب ، إذاً فلا محيص من حجّية الظنّ واللزوم اتّباعه في تعيين موارد الضرر ، فكلّ شيء ظنّ كونه ضرريّاً وجب تركه ، وكلّ ما شكّ كونه ضرريّاً جاز فعله ، بل المدار في هذه الموارد هو خوف الضرر وإن لم يكن مظنوناً كما ذكر في محلّه.
خاتمة يبحث فيها عن امور
الأمر الأوّل : في الظنّ بالامور الاعتقاديّة
( المطلوب فيها أوّلاً عمل الجوانح من الاعتقاد والانقياد خلافاً للفروع العمليّة ، المطلوب فيها أوّلاً عمل الجوارح ) فهل تجري مقدّمات الانسداد في اصول الدين على فرض انسداد باب العلم فيها فيكون الظنّ بها حجّة أو لا تجري فلا يكفي الاعتقاد الظنّي؟
قد أنكر الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني رحمهما الله جريان مقدّمات الانسداد في اصول الدين ، وعصارة بيانهما ( ببيان منّا ) : أنّ الامور الاعتقاديّة على أقسام ثلاثة :
القسم الأول : بعدم وجوب تحصيل العلم واليقين به على المكلّف لا عقلاً ولا شرعاً إلاّ إذا حصل له العلم به أحياناً ، ( فيجب بحكم العقل والشرع الاعتقاد به وعقد القلب له ولا يجوز له الإنكار والجحود ، أو الوقف والتأمّل فيه ) كما هو الحال في تفاصيل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والحساب والكتاب والميزان والجنّة والنار وغيرها ، وكذلك في تفاصيل صفات الباري تعالى وصفات الإمام عليهالسلام كعلم الباري وعلم النبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام بعالم الغيب وإنّهم عالمون بجميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة فعلاً ( أو « إذا أرادوا علموا » أو « إذا أرادوا يعلّمهم الله تعالى » أو غير ذلك من الاحتمالات ) ففي هذا القسم من الامور لا تجري مقدّمات الانسداد ولا يكون الظنّ فيها حجّة ، لأنّه إذا انسدّ باب العلم فيها بتفاصيلها يمكن العلم بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالي بما هو واقعها وعقد القلب عليها من
دون عسر ولا شيء آخر ، ولا تقاس بالفروع العمليّة المطلوب فيها مطابقة عمل الجوارح مع الواقع لأنّ الفروع العمليّة إذا انسدّ باب العلم فيها لا يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إلاّبالاحتياط التامّ في الشبهات ، وهذا ما يوجب العسر ، فلا يجب شرعاً ، أو يوجب الإخلال بالنظام فيحرم عقلاً ، وحينئذٍ لا شيء أقرب إلى الواقع من العمل على وفق الظنّ.
القسم الثاني : ما يعلم بوجوب تحصيل العلم به تفصيلاً على المكلّف بحكم العقل ثمّ الاعتقاد به وعقد القلب عليه وهو كما في التوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد.
ففي هذا القسم لا ينبغي التأمّل في عدم جواز الاكتفاء بالظنّ ، لأنّ الواجب عقلاً وشرعاً إنّما هو المعرفة ، والظنّ ليس بمعرفة قطعاً ، فلا بدّ من تحصيل العلم لو أمكن ، ومع العجز عنه يصير معذوراً ، ولا دليل حينئذٍ على جريان مقدّمات الانسداد ، أي لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظنّ مع اليأس عن تحصيل العلم في المقام ، لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه.
القسم الثالث : ما يشكّ في وجوب المعرفة التفصيلية به وعدمه ، فأصالة البراءة من وجوبها محكّمة ( ولا تختصّ أصالة البراءة بالفروع العمليّة لعموم أدلّتها ) ، وحينئذٍ لا معنى لجريان مقدّمات الانسداد.
إن قلت : المرجع عند الشكّ هو عموم وجوب المعرفة المستفاد من قوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي ) (١) الذي فسّرت العبادة فيه بالمعرفة ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة » (٢) وعمومات وجوب التفقّه وطلب العلم من الآيات والرّوايات.
قلنا : لا دلالة لشيء ممّا ذكر من الآيات والرّوايات بالعموم على وجوب المعرفة في جميع المسائل الاعتقاديّة تفصيلاً.
أمّا قوله تعالى : « وما خلقت » فلأنّ المستفاد منه هو خصوص معرفة الله لا معرفة من سواه ، وأمّا النبوي المذكور فلأنّه في مقام بيان فضيلة الصّلاة وأهميّتها ولا يستفاد منه إطلاق ولا عموم لوجوب المعرفة.
__________________
(١) سورة الذاريات : الآية ٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : الباب ١٠ ، من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ١.
وأمّا آية النفر فلأنّها في مقام بيان كيفية النفر للتفقّه لا في مقام بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى.
وأمّا ما دلّ على وجوب طلب العلم فلأنّه في صدد الحثّ على طلب العلم لا في مقام بيان ما يجب علمه.
فظهر ممّا ذكر جميعاً عدم جريان مقدّمات الانسداد في الامور الاعتقاديّة بجميع أقسامها وصورها.
هذا ملخّص كلامهم ومحصّل استدلالهم.
أقول : لا كلام لنا في هذه المقالة إلاّبالنسبة إلى القسم الثاني منها ، حيث إنّهما أنكرا فيه استقلال العقل بحسن تحصيل الظنّ والاعتقاد بالمظنون في الامور الاعتقاديّة في فرض الانسداد ، وبالنتيجة رجّحا عدم الاعتقاد مطلقاً بالمذهب المظنون مع أنّه من المستبعد جدّاً حكم العقل به بل العقل يحكم بعدم التوقّف والسكون واختيار أحد الطرق غير العلمي ( وهو الظنّ لا محالة ) لما يرى في التوقّف الاعتقادي من الضلالة والهلاكة القطعيّة.
ويشهد بذلك شهادة صاحب كلّ مسلك من المسالك وشارع كلّ شريعة من الشرائع بعدم جواز التوقّف مضافاً إلى حكمه بوجوب طيّ طريقه الخاصّ به ، فهم متّفقون على الهلكة على فرض التوقّف.
وهذا نظير السالك الذي قدم إلى مفترق الطرق ، على رأس كلّ منها إنسان يدعو إلى سلوك طريقه وينهى عن سلوك الطرق الاخر مع اتّفاق الجميع على وجوب استمرار المشي ووجود الهلكة والضرر في التوقّف فلا إشكال حينئذٍ في حكم العقل بإدامة الحركة والسلوك في الطريق الذي يظنّ انتهائه إلى المقصود ونيل النجاح.
الأمر الثاني : عدم جواز الاكتفاء بالظنّ في حال الانفتاح
لا إشكال في عدم جواز الاكتفاء بالظنّ فيما يجب معرفته عقلاً أو شرعاً في حال الإنفتاح ، حيث إن الظنّ ليس بمعرفة قطعاً كما مرّ آنفاً في بيان الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني رحمهالله ، فلا بدّ من تحصيل العلم فيما إذا كان المكلّف قادراً عليه ومع العجز يكون معذوراً إن كان عن قصور
لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلّة الإستعداد ، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد والفحص فليس معذوراً بلا ريب.
لكن ربّما يتوهّم أنّه لا يتصوّر هنا العجز عن قصور ، وذلك لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (١) لدلالته على انفتاح الطريق في جميع الحالات ، والطريق هو الجهاد في سبيل الوصول إلى الحقّ ، فقد وعد الله تعالى في هذه الآية أنّ كلّ من جاهد في الحقّ وتفحّص عنه يهتدي إلى سبيل الهداية ويصل إلى مطلوبه وهو الحقّ ، وأكّد على ذلك بتأكيدات عديدة من اللام والنون الواردين في قوله تعالى « لنهدينّهم » وفعل المضارع الدالّ على الاستمرار.
وأجاب بعضهم عن هذا بأنّه ليس المراد من المجاهدة الواردة في الآية النظر والاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة بل هو المجاهدة مع النفس التي هي أكبر من الجهاد مع الكفّار فالآية أجنبية عن المقام.
أقول : قد ذكر في كتب التفاسير في معنى الجهاد الوارد في الآية احتمالات ثلاثة :
أحدها : أنّ المراد منه هو الجهاد مع الكفّار فيكون المعنى « والذين جاهدوا مع عدوّنا لنهدينّهم سبل الفتح والظفر ».
والثاني : أنّ المراد هو الجهاد مع النفس أي العدوّ النفساني كما مرّ.
الثالث : الجهاد في سبيل المعرفة ، أي الجهاد العلمي في قبال الجهاد الأخلاقي والعسكري ، ( وقد وقع الخلط في بعض الكلمات حيث أورد فيها في مقام تفسير الآية بحث فلسفي معروف ، وهو ما قال به بعض الفلاسفة من أنّه ليس التفكّر وسيلة للعلم بل أنّه يوجب استعداد النفس لإفاضة الصور العلمية عليها وقبولها من جانب الفيّاض المطلق ).
قلت : الإنصاف أنّه لا دليل ولا قرينة على تقييد الآية وتحديد مفاد كلمة الجهاد فيها بمعنى خاصّ من المعاني الثلاثة بل مقتضى إطلاقها شمولها لجميع الثلاثة ، فيبقى الإشكال على حاله خصوصاً مع الالتفات إلى ما نشاهده بوجداننا في كثير من الناس من القصور وعدم التقصير في سبيل معرفة الله بين النصارى واليهود وسائر المذاهب وفي سبيل معرفة الإمام بين غير العارفين.
__________________
(١) سورة العنكبوت : الآية ٦٩.
والذي يخطر بالبال في الجواب عن الإشكال ( على العجالة إلى أن يتأمّل فيه ) أحد وجهين :
الوجه الأوّل : أن يخصّص قوله « فينا » بخصوص معرفة الله ونلتزم بعدم تصوّر القصور فيها لشهادة الوجدان وحكم الفطرة في هذا الباب.
الوجه الثاني : أن نقول : أنّ المراد بالجهاد هنا هو نهاية السعي والاجهاد لا مجرّد المقدار الواجب على الإنسان في هذه الامور بل أقصى جهده وآخر ما يمكن منه فيكون معنى الآية كلّ من بذل نهاية مجهوده وأقصى جهده يهتدي إلى سبيل الحقّ ويصل إلى المقصود وليس جميع القاصرين يجهدون هذا المبلغ من الجهاد.
الأمر الثالث : في تأثير الظّنون غير الحجّة في الأدلة الظنيّة
ويتصوّر على خمسة وجوه :
الأوّل : جبران ضعف السند بدليل ظنّي كما إذا قامت الشهرة على العمل برواية ضعيفة.
الثاني : عكس الأوّل ، أي وهن سند معتبر بدليل ظنّي قام على خلافه كإعراض المشهور عن العمل برواية معتبرة بحسب السند.
الثالث : تأثير الظنّ في تقوية الدلالة ، كما إذا قامت الشهرة على أخذ أحد الاحتمالات في مدلول الرّواية.
الرابع : عكس الثالث ، أي وهن الدلالة بإعراض المشهور مثلاً.
الخامس : ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى بدليل ظنّي كالشهرة.
هذه موارد مبتلى بها في الفقه ويبحث عن الصورة الأخيرة في أبواب التعادل والتراجيح ( فانتظر ) ، وقد أشرنا إلى باقي الوجوه إجمالاً في تضاعيف ما مرّت من الأبحاث السابقة ، وينبغي أن يبحث عنها في فصل مستقل وينفتح لها عنوان على حدة ، ولذلك نقول :
أمّا الوجه الأوّل : فالإنصاف أنّه لا إشكال في جبر ضعف الرّواية الضعيفة بعمل مشهور قدماء الأصحاب ، وذلك لما مرّ في مبحث حجّية خبر الواحد من أنّ السيرة العقلائيّة قامت على حجّية الخبر الموثوق به ( ولو لم تكن رواته ثقات ) وأنّ الملاك في الحجّية هو الوثوق بنفس الخبر وصدوره عن المعصوم لا الوثوق بالمخبر ، والإنصاف أنّ الشهرة القدمائيّة توجب
الوثوق بالصدور فتوجب جبر الضعف الناشىء من ناحية السند.
كما أنّها في الوجه الثاني توجب الوهن في السند إذا قامت على خلاف رواية معتبرة كانت بمرأى من الأصحاب ، وهو المقصود من قولهم : « كلّما إزداد صحّة إزداد وهناً » كما أنّ في صورة العكس « كلّما إزداد وهناً إزداد صحّة » وقد مرّ بيانها ، وبين الجواب عمّا ذهب إليه بعض أعاظم العصر من أنّه من قبيل ضمّ العدم إلى العدم فراجع.
أمّا الوجه الثالث : فالصحيح فيه ما هو المشهور من أنّ الشهرة الفتوائيّة لا توجب قوّة في الدلالة لأنّ الملاك في باب الدلالات عبارة عن الظهور العرفي ، ولا إشكال في أنّ عمل المشهور على طبق رواية لا يوجب لها ظهوراً في نظر العرف ، إلاّ أن يكشف هذا عن وجود قرينة وصلت إليهم ولم تصل إلينا.
وأمّا الوجه الرابع : ( وهو عكس الثالث ) فلا بدّ أن تلحظ ما تبنّاه في باب حجّية الظواهر ، فإن قلنا هناك أنّ الظنّ الشخصي على خلاف ظهور دليل يوجب سقوطه عن الحجّية ففي المقام توجب الشهرة الوهن في الدلالة وعدم كون الظاهر حجّة ، لكن الصحيح في باب حجّية الظواهر كفاية الظنّ النوعي وبقاؤها على الحجّية وكونها قابلة للاحتجاج عند العرف والعقلاء وإن حصل الظنّ الشخصي على خلافها.
نعم ، لو كان في البين قرائن تقتضي الظنّ النوعي على الخلاف ، أي الإلتفات إليها موجب للظنّ على الخلاف غالباً بحيث يكون الظنّ على خلاف الظاهر معتمداً على قرينة ، ففي هذه الحالة لا إشكال في عدم قابلية مثل هذا الظهور اللفظي للاحتجاج فيسقط الظهور عن الحجّية.
هذا تمام الكلام في البحث عن حجّية مطلق الظنّ.
٦ ـ حجّية الدليل العقلي الظنّي
ويبحث فيه بالمناسبة أيضاً عن الأدلّة العقليّة القطعيّة ، فيقع البحث في مقامين :
المقام الأوّل ـ الأدلّة العقليّة القطعيّة
وهو من المباحث التي سقطت عن الاصول في الفترة الأخيرة فحذفت من مثل رسائل الشيخ الأعظم وكفاية الاصول للمحقّق الخراساني رحمهما الله مع أنّهم عدّوا من الأدلّة دليل العقل وجعلوه أحد الأدلّة الأربعة للأحكام الشرعيّة ، ( كما أنّهم لم يبحثوا بصورة عامّة عن سائرالأدلّة بل اكتفوا في دليل الكتاب بالبحث عن حجّية ظواهره في قبال الأخباريين القائلين بعدم حجّيتها ، وفي دليل السنّة بالبحث عن حجّية خبر الواحد فقط ، وفي الإجماع بالبحث عن الإجماع المنقول فقط ).
ولعلّ الوجه في ذلك كون حجّية العقل مفروغ عنها في نظرهم ، مع أنّه ليس كذلك كما سيتّضح لك عندما ننقل مقالة الأشاعرة والأخباريين والأدلّة التي استدلّوا بها على نفي حجّية العقل.
وكيف كان : الحقّ أنّ من الأدلّة الفقهيّة في أحكام الشرع دليل العقل وأنّ الملازمة ثابتة بين حكم العقل والشرع ، وفي مقابل هذا القول أقوال اخر :
منها : قول الأشاعرة ، والظاهر أنّهم أنكروا الملازمة في تمام مراحلها الثلاثة التي ستأتي الإشارة إليها عن قريب.
ومنها : قول الأخباريين ، الذين أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح بعد قبولهم حسن الأفعال وقبحها ذاتاً.
ومنها : قول الاصوليين ، الذين فصّلوا في هذه المسألة بما سيأتي البحث عنه.
ثمّ إنّ لدلالة العقل على الأحكام الشرعيّة مراتب ثلاثة :
إحديها : مرتبة علل الأحكام ومباديها.
الثانية : مرتبة معلولاتها.
الثالثة : مرتبة نفس الحكم.
توضيح ذلك : أنّه تارةً يحكم العقل بحسن العدل والاحسان وقبح الظلم ، أي يدرك مصلحة العدل والاحسان ومفسدة الظلم ، ولا يخفى أنّ المصالح والمفاسد بمنزلة علل الأحكام ، فنستكشف من ناحيتها الوجوب الشرعي أو الحرمة الشرعيّة.
واخرى يحكم العقل أوّلاً بقبح العقاب بلا بيان ثمّ يستكشف من ناحية عدم « العقاب » الذي هو من معلولات الأحكام عدم الوجوب والحرمة الفعليين ويسمّى هذا بالبراءة العقليّة الدالّة على نفي حكم إلزامي شرعي ، أو يحكم في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة أولاً بتنجّزه وكونه منجّزاً للعقاب الاخروي ثمّ يستكشف منه فعلية الحكم الشرعي في أطراف الشبهة.
وثالثة : يكشف العقل عن حكم شرعي مجهول من ناحية حكم شرعي آخر معلوم بوجود الملازمة بينهما عند العقل كالملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضدّه أو الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة.
والظاهر أنّ الأشاعرة والأخباريين خالفوا الاصوليين في جميع هذه المراتب ولكن بعض الاصوليين فصّلوا في المسألة بالنسبة إلى المرتبة الاولى كما اشير إليه آنفاً.
الكلام في مسألة الحسن والقبح
إذا عرفت هذا فلنشرع في أصل المسألة فنقول :
أمّا المرحلة الاولى : فيقع الكلام فيها في ثلاث مقامات :
الأوّل : في أنّه هل للأشياء حسن أو قبح ذاتاً قبل ورود الشرع أو لا؟
الثاني : في إمكان إدراك العقل لهما بعد أن ثبتت ذاتيّتهما للأشياء.
الثالث : في أنّه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع.
فلا يخفى أنّ المقامين الأوّلين بمنزلة الصغرى ، والمقام الثالث بمنزلة الكبرى لإثبات الحكم الشرعي.
المقام الأوّل : هل للأشياء حسن وقبح ذاتاً؟
فلا بدّ فيه أوّلاً من تعريف الحسن والقبح إجمالاً ، فنقول : المراد من حسن الفعل وقبحه ما يستحقّ المدح أو الذمّ على إتيانه ، فالنزاع عنهما مقصور في عالم الأفعال ولا يشمل عالم التكوين ، فإنّه لا إشكال في أنّ هناك أشياء حسنة كحسن جمال يوسف وحسن صوت العندليب وحسن كواكب السماء وغيرها ، كما أنّ هناك أشياء قبيحة من قبيل قبح صوت الحمير وغيره ، فالبحث في المقام مرتبط بحسن الأفعال وقبحها لا حسن الأشياء التكوينيّة وقبحها.
نعم ، لا إشكال في أنّ حسن الفعل أو قبحه ناشٍ من شيء تكويني حسن أو شيء تكويني قبيح لا محالة ، فالاحسان حسن لأنّه موجب لكمال الفرد والمجتمع خارجاً ، والظلم قبيح لأنّه موجب لنقصانهما كذلك ، وهذا هو الذي يعبّر عنه في أيّامنا هذه بأنّ لزوم الأفعال ولزوم تركها يرتبطان بالوجودات والاعدام الخارجيّة التكوينيّة ، وينشآن منهما ( ويعبّر عنه أيضاً بإرتباط معرفة الكون والايدئولوجي ) فقتل النفس قبيح لأنّه يوجب حرمان إنسان من الوجود ، وإشباع العطشان بالماء حسن لإيجابه إحياء النفس ، والأوّل نقص والثاني كمال في عالم التكوين.
نعم ، قد يختلف الكمال والنقص بحسب الآراء والأنظار ، فالإنسان الإلهي يرى الكمال في القرب إلى الله تعالى والنقص في البعد عنه حينما يريهما الإنسان المادّي في رفاه العيش وعدمه ، وهناك امور مشتركة بين جميع المذاهب البشريّة مثل حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان.
إذا عرفت ما ذكرنا من معنى الحسن والقبح نقول : لا إشكال في حسن الأفعال وقبحها ذاتاً ويدلّ عليه امور :
الأوّل : الوجدان ، فإنّ وجدان كلّ إنسان يحكم بأنّ هناك أفعالاً حسنة ذاتاً وأفعالاً اخرى قبيحة كذلك ، والمنكر ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان ، نظير ما يقال في باب الجبر والاختيار في علم الكلام في قبال الجبريّة ، وفي باب أصل وجود أشياء في عالم الخارج في الفلسفة من أنّ الوجدان أصدق شاهد على اختيار الإنسان ووجود الواقع الخارجي ، وبالجملة إنّا ندرك حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان ولو لم تكن هناك شريعة.
وإن شئت فاختبر نفسك فيما إذا كنت عابر سبيل ومسافراً لمقصد بعيد فنفد زادك وضللت عن الطريق مضطرباً حيران فإذا رجلان قد مرّا بك ولكن أحدهما استمر في سيرةه ولم يَعتَنِ بك مع قدرته على نجاتك من هذه المهلكة بما عنده من الزاد والمركب ، وتوقّف الآخر وآثر بنفسه بقدر استطاعته وأنجاك من المهلكة ودلّك على الطريق وأوصلك إلى مقصدك ، فهل هما حينئذٍ عندك سيّان؟ أفلا يحكم وجدانك بقبح عمل الأوّل وحسن فعل الثاني؟ وهكذا في رجلين أحدهما أنقذ غريقاً من البحر والآخر ألقى رضيعاً في البحر ، فهل تجد في نفسك إنّهما يستويان من حيث القدر والقيمة؟ كلاّ ، بل يحكم وجدانك بحسن عمل الأوّل وقبح عمل الثاني بلا ريب ، ولا ترتاب ولو للحظة واحدة في هذا الحكم.
الثاني : أنّ إنكار الحسن والقبح يستلزم إنكار الشريعة وعدم إمكان إثباتها لأنّه متوقّف على إظهار المعجزة على يد النبي الصادق صلىاللهعليهوآله وهو لا يدلّ على صحّة النبوّة إلاّ إذا قلنا بقبح إظهارها على يد الكاذب ، وكذلك يستلزم عدم إمكان قبول الوعد والوعيد الواردين في كتاب الله لأنّه يتوقّف على قبح الكذب وعدم الوفاء بالوعد.
الثالث : إنّه يستلزم عدم وجوب النظر في معجزة المدّعى مع أنّه لا إشكال في وجوبه اتّفاقاً بحكم العقل لاحتمال كونه صادقاً ، وهو يوجب احتمال وجود الضرر الاخروي الذي يقبح قبوله ، ولذلك يوجب حكم العقل بالاحتياط ووجوب النظر وهكذا يستلزم عدم وجوب التحقيق في أصل التوحيد لأنّه متوقّف على قبح عدم دفع الضرر المحتمل وحسن شكر المنعم.
الرابع : أنّه يستلزم عدم إمكان إثبات وجوب الطاعة بعد ثبوت أصل وجود الباري تعالى وثبوت نبيّه والذي جاء به من الاصول والفروع لأنّه متفرّع على ثبوت حسن لها في الرتبة السابقة فيحكم العقل بوجوبها ، وأمّا إثباته بالشرع وبقوله تعالى : « أطيعوا » يوجب التسلسل المحال كما مرّ غير مرّة لأنّ وجوب الإطاعة عن نفس هذا الأمر ( أطيعوا ) أيضاً يحتاج إلى أمر آخر بالإطاعة إلى أن يتسلسل.
الخامس : ما يدلّ من الآيات على حسن بعض الأفعال وقبح بعض آخر قبل ورود الشرع من قبيل قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ
الْخَبَائِثَ ) (١) وقوله تعالى : ( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) (٢).
وقوله عزّ شأنه : ( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ) (٣) وقوله جلّ جلاله ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (٤) وقوله عظم قدره : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ) (٥) ففي هذه الآيات وأشباهها دلالة واضحة على ثبوت الحسن والقبح بحكم العقل ، وقبل ورود الشرع ، ولذا يحتجّ بها على إثبات الحقائق الواردة في الكتاب الكريم.
بقي هنا امور :
الأمر الأوّل : قد يقال : إنّ الحسن والقبح وإن كانا عقليين لكنّهما يختلفان بالوجوه والاعتبار ، فإنّ الضرب مثلاً حسن إن كان للتأديب ، وقبيح إن كان للتعذيب ، وكذلك القتل فإنّه حسن باعتبار القصاص ، وقبيح باعتبار الجناية ، وقد نسب هذا إلى قوم من العامّة وهم الجبائيون.
ولكن يرد عليه : أنّه من قبيل الأخذ لما بالعرض مكان ما بالذات ، ففي مثال الضرب ليس عنوان الضرب حسناً أو قبيحاً ذاتاً بل حسنه في صورة التأديب يكون بالعرض ومن باب أنّه مصداق للاحسان ، كما أنّ قبحه في صورة التعذيب عرضي من باب أنّه مصداق للظلم ، فالحسن والقبيح الذاتيان إنّما هما عنوانا الاحسان والظلم لا عنوان الضرب.
وإن شئت قلت : الأفعال على ثلاثة أقسام :
قسم منها يكون بحسب الذات علّة تامّة للحسن أو القبح كالظلم والاحسان.
__________________
(١) سورة الأعراف : الآيّة ١٥٧.
(٢) سورة ص : الآية ٢٨.
(٣) سورة الرحمن : الآية ٦٠.
(٤) سورة الأعراف : الآية ٣٣.
(٥) سورة النحل : الآية ٩٠.
وقسم منها يكون مقتضياً وعلّة ناقصة لأحدهما في حدّ ذاته كالصدق الذي يقتضي الحسن ذاتاً ما لم يمنع مانع كما إذا أوجب القاء النفس في التهلكة.
وقسم ثالث منها ليس علة تامّة للحسن أو القبح في حدّ ذاته ولا علّة ناقصة لأحدهما كذلك كالمباحات العقليّة ، فما يكون حسناً أو قبيحاً بالوجوه والاعتبار إنّما هو القسم الثاني والثالث لا الأوّل.
ومن هنا يظهر الجواب عن كثير من الإشكالات الواردة في المقام التي لا طائل تحتها ولا حاجة إلى ذكرها.
الأمر الثاني : لا إشكال في أنّ حكم العقل بالحسن أو القبح مقبول على حدّ الموجبة الجزئيّة لا الكلّية ، ولا يقول أحد بأنّ العقل يدرك جميع المصالح والمفاسد وما يتبعهما من الحسن والقبح ، ولذلك فإنّ دلالته على الأحكام الشرعيّة تكون في الجملة لا بالجملة.
وإن شئت قلت : أنّ القضايا على ثلاثة أنواع :
نوع منها يدرك العقل الحسن أو القبيح فيها بالضرورة والبداهة كقضيتي « العدل حسن » و « الظلم قبيح ».
ونوع آخر يكون درك العقل للحسن أو القبح فيها بالاستدلال والبرهان كقضية « الصدق حسن » ولو أضرّ بمنفعة الشخص ، فيدرك حسن الصدق الضارّ بالتأمّل والنظر.
ونوع ثالث منها لا يدرك العقل الحسن أو القبح فيها لا بالضرورة ولا بالتأمّل وذلك كما في جزئيات الأحكام الشرعيّة في أبواب العبادات وغيرها ، وبعبارة اخرى : يحتاج العقل في إدراكه للحسن أو القبح فيها إلى توسّط من الشرع لأنّه يتوقّف على درك المصلحة أو المفسدة وعللها ، وهي امور خارجيّة لا طريق للعقل إلى الحصول عليها إلاّمن طريق الشرع ، وهذا نظير إدراك العوام لمضارّ الأدوية ومنافعها فإنّ إدراكهم لها جزئي صادق في جملة من الأدوية ، وأمّا في غيرها فيحتاجون إلى نظر الطبيب.
ومن هنا يظهر الجواب عن استدلال الأخباريين ببعض الرّوايات الدالّة على قصور العقل في إدراكه لمصالح الأحكام ومفاسدها كقوله عليهالسلام « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » أو قوله عليهالسلام « وما أبعد عقول الرجال عن دين الله » فإنّ الظاهر أنّ هذه الرّوايات ناظرة إلى الغالب والقسم الثالث من القضايا ، ولا تدلّ على نفي الإدراك مطلقاً ، كيف والشارع بنفسه يستدلّ بالعقل في
كثير من الموارد ويخاطب الناس بقوله : ( أفلا تتفكّرون ) أو ( أفلا تعقلون ) وبقوله : ( يا اولي الألباب ) و ( هاتوا برهانكم ) ولذلك اعترف كثير من الأخباريين بإدراك العقل للضروريات العقليّة واضطرّوا إلى استثنائها من مقالتهم ، وقد مرّ تفصيل الجواب عنهم في مباحث القطع وحجّية القطع الحاصل من طريق العقل فراجع.
الأمر الثالث : إذا اجتمع عنوانان أو عناوين عديدة بعضها حسن وبعضها قبيح على شيء واحد كالدخول في الأرض المغصوبة (١) لإنقاذ الغريق فإنّه قبيح من جهة انطباق عنوان الغصب عليه ، وحسن من جهة انطباق عنوان الإنقاذ عليه ، فلا إشكال حينئذٍ في أنّ الفعل تابع لأقوى الجهات بعد كسر وانكسار أو يصير خالياً عن الحسن والقبح إذا كانت الجهات متساوية فلا يكون من باب اجتماع النقيضين ( كما توهّمه بعض واستكشف من طريق استحالته عدم حسن الأفعال وقبحها ذاتاً.
أدلّة المنكرين للحسن والقبح :
ثمّ إنّه استدلّ لعدم حسن الأفعال وعدم قبحها ذاتاً بوجوه واهية :
منها : أنّه لو كان الحسن والقبح عقليين لزم الجبر في أفعال الله تعالى ( سواء في ذلك أفعاله التكوينيّة أو التشريعية ) أي لزم أن يكون الشارع الحكيم مقيّداً في تشريعه للأحكام بهذه الأوصاف ، وهذا ينافي اختياره تعالى في أفعاله على الإطلاق.
والجواب عنه واضح ، لأنّ الجبر في فعل شيء ، ووجود الصارف الاختياري عن ذلك الفعل شيء آخر ، فإنّ السلوك على وفق الحكمة وعدم التخطّي عمّا تقتضيه لا ينافي الاختيار ، لأنّ العاقل السويّ لا يقدم على شرب السمّ مثلاً وهو مختار مع أنّه قادر عليه ، فعدم وقوع الشرب منه لصارف لا ينافي قدرته واختياره بل هو بنفسه إختار عدم الشرب ، كما أنّ صدور فعل منه لداعٍ لا ينافي الاختيار ، وكذلك الحكيم تعالى.
__________________
(١) وقد جاء التمثيل لهذا في بعض الكلمات بقول القائل : « سأكذب غداً » فإنّ كذبه غداً قبيح من باب قبح الكذب وحسن من باب الوفاء.
ولكن يرد عليه أنّه مغالطة واضحة فإنّ وجوب الوفاء يختصّ بما إذا كان المتعلّق راجحاً.
ومنها : أنّ أفعال العباد غير صادرة عنهم باختيارهم فلا تتّصف بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه ، وهو استحقاق المدح أو الذمّ على إتيانها ، لأنّ الاستحقاق موقوف على وجود الاختيار.
والجواب عنه حلاًّ : أنّه مبني على مبنى فاسد وهو القول بالجبر.
ونقضاً : أنّ هذا الوجه بعينه جارٍ بعد ورود حكم الشرع بالحسن والقبح مع أنّهم ملتزمون بهما بعد ورودهما في الشرع.
ومنها : أنّ القول بحسن الأفعال وقبحها يستلزم قيام المعنى بالمعنى ، والظاهر أنّ مرادهم العرض بالعرض ، وهو محال ، وجه الملازمة : أنّ الأفعال من مقولة الفعل كما أنّ الحسن والقبح أيضاً من مقولة الكيف.
والجواب عنه أوّلاً : بالنقض بأنّ هذا يرد على الحسن والقبح الشرعيين أيضاً وثانياً : بالحلّ فإنّه لا دليل على استحالة قيام العرض بالعرض ، فكم من عرض قائم بعرض آخر.
أضف إلى ذلك ( وهو العمدة ) أنّ الحسن والقبح ليسا من الصفات التكوينيّة الوجوديّة المتحقّقة في موضوعها بل إنّهما من الامور الاعتباريّة المنتزعة التي لها منشأ للانتزاع في الخارج ، فينتزع الحسن في قولك : « العدل حسن » ممّا يوجبه العدل في الخارج من المنافع ، وينتزع القبح في قولك : « الظلم قبيح » ممّا يوجبه من الفساد والمضارّ.
ويشبه هذا الوجه بالشبهة السوفسطائيّة التي نشأت من وقوع الخطأ في الحواس ، فأوجبت إنكار السوفسطائي لعالم الوجود مع أنّه أمر وجداني لا يمكن إنكاره ، والصحيح في مثل هذه الامور الفطريّة الوجدانيّة النهوض على جواب لحلّ بعض الشبهات الواردة لا إنكار أصل الموضوع الثابت بالوجدان قطعاً.
إلى هنا ظهر الحال في المقام الأوّل وهو ثبوت الحسن والقبح للأشياء ذاتاً.
المقام الثاني : في إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالجملة
وهو إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالعقل في الجملة فالكلام فيه يظهر ممّا مرّ في المقام الأوّل ولا نطيل البحث بتكراره.
المقام الثالث : ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
وهي « أنّه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » فقبل الورود في البحث عنها لابدّ من تفسير كلمة الحكم الوارد في الجملتين فنقول : إنّه فرق بين الحكم في قولنا : « حكم به العقل » والحكم في قولنا : « حكم به الشرع » حيث إن الحكم الأوّل معناه إدراك العقل لا إنشائه وجعله لأنّ إنشاء التكليف من شأن المولى ( نعم للعقلاء بناءات واعتبارات وقوانين إنشائيّة في دائرة أحكامهم العقلائيّة وهي في الحقيقة من سنخ إنشاءات الموالي بالنسبة إلى العبيد ).
وأمّا الحكم الثاني ، فليس هو بمعنى الإدراك بل هو بمعنى التشريع والتقنين لكون الشارع مولى الموالي والناس جميعهم عباده ، هذه نكتة.
والنكتة الثانية : أنّ قضيّة الأصل في هذا العنوان ( أي قضية كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع ) مخالف للعكس ( وهي كلّما حكم به الشرع حكم به العقل ) فإنّ الأولى قضية مطلقة والثانية مشروطة ، لأنّها مشروطة بأن يدرك العقل من جانب الشارع فلسفة الحكم من المصلحة والمفسدة ثمّ يحكم بحسنه أو قبحه فتكون قضية العكس هكذا : « كلّما حكم به الشرع ، حكم به العقل لو اطلع على حكمة حكم الشرع ».
الأقوال في المسألة :
في المسألة أقوال أربعة :
أحدها : أنّ الملازمة ثابتة من جانب الأصل والعكس معاً.
ثانيها : قول الأشاعرة وهو إنكار الملازمة مطلقاً.
ثالثها : قول صاحب الفصول من أنّ الملازمة ثابتة بين حسن التكليف بفعل أو قبحه وبين حكم الشارع ، لا بين حسن الفعل ( المكلّف به ) أو قبحه وبين حكم الشرع.
رابعها : التفصيل بين ما إذا تطابقت آراء العقلاء على حسن فعل أو قبحه وبين ما إذا لم تتطابق آراؤهم عليه ، والملازمة ثابتة في الصورة الاولى لا الثانية ( ويستفاد هذا من تضاعيف ما ذكره في اصول الفقه ) (١).
__________________
(١) اصول الفقه للعلاّمة المظفّر.
والمختار هو القول الأوّل ، لكن المراد من حكم الشارع هو الأعمّ من الإلزامي وغيره ، والدليل على ذلك حكمة الباري تعالى ، فإذا كان الفعل واجداً لمصلحة تامّة أو مفسدة كذلك فكيف يمكن أن لا يكون للشارع فيه حكم مع أنّه قد ثبت عند الإماميّة عدم خلوّ شيء من الأشياء من حكم من الأحكام ، فبعد حكم العقل بالحسن أو القبح يثبت أوّلاً إنقداح إرادة أو كراهة في بعض المبادىء العالية ثمّ بانضمام الكبرى الثابتة في محلّه من عدم خلوّ الأشياء عن الحكم يثبت حكم الشارع ، فالطريق الصحيح عندنا هو حكمة الباري ، ومقتضاها ثبوت الملازمة مطلقاً ، وكيف يعقل ترك التكليف من المولى الحكيم إذا كان في الفعل مصلحة تامّة قطعية أو مفسدة كذلك؟ ومن المعلوم أنّ ترك الأمر والنهي في هذه المقامات منافٍ للحكمة ، فإذا أدرك العقل المصلحة التامّة في أمر ( أي مصلحة لا معارض لها ) وأدرك علّية ذلك للحكم بتبعية الأحكام الشرعيّة للمصالح والمفاسد يكشف أيضاً حكم الشارع به ، كحكمه بقبح اختلال النظام الذي يكون علّة لحكم الشارع بحرمته بلا ريب.
وإن شئت فاختبر نفسك أنّه قبل نزول قوله تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) فهل تحتمل أن لا يكون قتل المؤمن متعمّداً مبغوضاً عند الله وحراماً في حكمه؟ وهل تحتمل أن تتنزّل الآية هكذا : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ الجنّة خَالِداً فِيهَا ) كلاّ ، لا يقول به إلاّ المكابر ، وكذا في أشباهه من الامور التي يدرك العقل حسنها وقبحها ومصالحها ومفاسدها بنحو العلّة التامّة.
واستدلّ المنكرون لعدم الملازمة مطلقاً بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّها مخالفة لقوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (١) فإنّها تدلّ على أنّه لا عقاب من دون إرسال المرسل وقبل صدور الأدلّة السمعيّة.
واجيب عنه بوجوه :
الأوّل : أنّ الظاهر من نفي العذاب في هذه الآية إنّما هو نفي الفعليّة لا نفي الاستحقاق ، ومحلّ النزاع في المقام هو الملازمة بين حكم العقل وبين استحقاق العقاب.
ويرد عليه : إنّ هذا لا يفيد الفقيه والاصولي شيئاً ، فإنّ نتيجته على كلّ حال نفي العقاب ،
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ١٥.