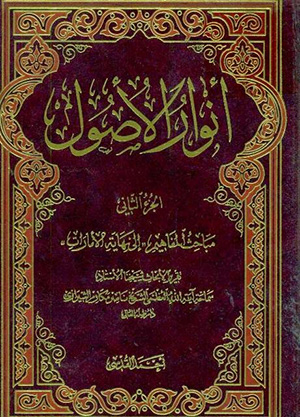الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-8139-14-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
خبر العادل وأنّه لا ندامة في العمل به ولو لم يعلم منشأ هذه الدلالة.
ثمّ نقول : أمّا مفهوم الوصف : فإن قلنا بكبرى مفهوم الوصف فلا إشكال في مفهوم كلمة الفاسق في الآية ، فتدلّ على عدم لزوم التبيّن في خبر العادل وحجّيته ، لكن المشهور عدم حجّية مفهوم الوصف خصوصاً في الوصف غير المعتمد على الموصوف كما في المقام فإنّه حينئذٍ أشبه بمفهوم اللقب عندهم.
لا يقال : فما هو الفائدة في ذكر هذا الوصف ، ولماذا لم يرد في الآية هكذا : « إذا جاءك إنسان بنبأ ... الخ »؟ لأنّه يقال : إنّه ورد للتنبيه على فسق الوليد.
لكن الإنصاف أنّ للوصف مفهوماً كما مرّ في مبحث المفاهيم خصوصاً في مثل ما نحن فيه حيث يكون في مقام إعطاء ضابطة كلّية بملاحظة صدرالآية ( وهو قوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا ... ).
والقول بكونه تنبيهاً على فسق الوليد كلام غير وجيه لأنّ الآيات لا تكون مختصّة بعصر دون عصر وبشخص دون شخص بل إنّها هدى للناس في جميع الأعصار ، ولعلّ هذا هو منشأ الفهم العرفي المذكور آنفاً.
وأمّا مفهوم الشرط : فللقائلين به بيانات مختلفة :
الأوّل : أنّه تعالى علّق وجوب التبيّن على مجيء الفاسق بالنبأ ، فإذا انتفى ذلك سواء انتفى بانتفاء الموضوع أي « إذا لم يجيء أحد بخبر » أو انتفى بانتفاء المحمول أي « إذا جاء شخص بخبر وكان عادلاً » ينتفي وجوب التبيّن فيستدلّ بإطلاق المفهوم لعدم وجوب التبيّن في خبر العادل وأنّه حجّة.
لكن يرد عليه : أنّ القضيّة الشرطيّة هيهنا ليس لها مفهوم لأنّها سيقت لبيان تحقّق الموضوع مثل قولك : « إن رزقت ولداً فسمّه محمّداً » بمعنى أنّ الجزاء موقوف على الشرط عقلاً لا شرعاً وبجعل الشارع من دون توقّف عقلي في البين ، فعند انتفاء الشرط حينئذٍ انتفاء الجزاء عقلي من قبيل قضيّة السالبة بانتفاء الموضوع لا السالبة بانتفاء المحمول مع وجود موضوعه ( وانتفاء المحمول والحكم يكون بواسطة انتفاء ما علّق عليه من شرط أو وصف ).
الثاني : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله وحاصله : أنّ الحكم بوجوب التبيّن عن النبأ الذي جيء به معلّق على كون الجائي به فاسقاً ( لا على نفس مجيء الفاسق بالنبأ ) بحيث يكون
المفهوم هكذا : « إن لم يكن الجائي بالنبأ فاسقاً بل كان عادلاً فلا يجب التبيّن عنه ».
ويمكن الجواب عنه : بأنّه كذلك لو كانت الآية هكذا : « النبأ إن جاء به الفاسق فتبيّنوا » بأن يكون الموضوع القدر المطلق المشترك بين نبأ الفاسق والعادل لأنّ القضيّة حينئذٍ ليست مسوّقة لبيان تحقّق الموضوع ، لكن الإشكال في أنّ مفاد الآية ليس كذلك كما هو ظاهر فالإشكال بعدم المفهوم وارد.
الثالث : ما أشار إليه المحقّق الخراساني رحمهالله أيضاً بقوله : « مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك إلاّ أنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الذي جاء به الفاسق ... ».
وحاصله : أنّ القضيّة الشرطيّة في الآية وإن كانت مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ولكنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن بنبأ الفاسق فقط ، ومقتضاه أنّه إذا انتفى نبأ الفاسق وتحقّق موضوع آخر مكانه كنبأ العادل لم يجب التبيّن عنه.
وهذا البيان والبيان السابق في مخالفتهما لظاهر الآية سيّان.
وأمّا مناسبة الحكم والموضوع : فقد اشير إليها في كلمات الشيخ الأعظم رحمهالله وغيره وتوضيحها : أنّ ظاهر الآية كون الفسق موجباً لعدم الاعتماد والاعتبار ، أي أنّ التبيّن يناسب عدم الاعتبار ، وهذه المناسبة تقتضي عرفاً عدم وجوب التبيّن في خبر العادل المعتبر المعتمد.
هذا كلّه هو طرق الاستدلال بآية النبأ ، وقد ظهر أنّ الطريق الأوّل والثالث تامّ خلافاً للطريق الثاني.
لكن قد أورد على الآيه إشكالات كثيرة ربّما تبلغ إلى نيف وعشرين كما قال به الشيخ الأعظم رحمهالله وقال أيضاً : « إلاّ أنّ كثيراً منها قابلة للدفع » ، واختار المحقّق الخراساني رحمهالله أربعة منها وذكرها في تعليقته على الرسائل وقد أضاف إليها بعض المعاصرين عدّة اخرى ، ونحن نذكر هنا أهمّها وهي خمسة :
الإشكال الأوّل : ما يرتبط بالتعليل الوارد في ذيل الآية ، وهو أنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر ظنّي لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإنّ كان المخبر عادلاً فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل.
بيانه : لو قلنا أنّ الآية الشريفة تدلّ مفهوماً على أنّ خبر العادل حجّة مطلقاً ولو لم يفد
العلم لكن التعليل بقوله تعالى : ( أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) دليل على أنّ الخبر الذي لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به ليس بحجّة ، ولو كان المخبر عادلاً ( لأنّ العلّة قد تعمّم كما أنّها قد تخصّص ) وحينئذٍ الترجيح مع ظهوره التعليل لكونه أقوى وآبياً عن التخصيص مضافاً إلى كونه منطوقاً لا مفهوماً.
واجيب عنه بوجوه :
الوجه الأول : أنّ مقتضى التعليل ليس هو عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع مطلقاً ، لأنّ المراد بالجهالة هنا السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله ، لا ما يقابل العلم ، ولا شبهة في أنّه لا سفاهة في الركون إلى خبر العدل والاعتماد عليه.
إن قلت : يستلزم هذا كون اعتماد الصحابة على خبر الوليد الفاسق سفيهاً ، وهو كما ترى.
قلنا : قد أجاب عن هذا المحقّق النائيني رحمهالله بأنّه ربّما يركن الشخص إلى ما لا ينبغي الركون إليه غفلةً أو لاعتقاده عدالة المخبر ، والآية هنا نزلت للتنبيه على غفلة الصحابة أو لسلب اعتقادهم عن عدالة الوليد ، أي ركون الصحابة إلى خبر الوليد لم يكن من باب الإقدام على أمر سفهي بل من جهة عدم علمهم بفسق الوليد.
أقول : الجهالة في لغة العرب وإن كان قد تأتي بمعنى السفاهة ولكن الأصل في معناها هو ضدّ العلم كما نطقت به كتب اللغة ، فحينئذٍ حمل الآية على المعنى الأوّل مشكل جدّاً ، ويؤيّد ما ذكرنا ملاحظة موارد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم.
الوجه الثاني : « أنّه على فرض أن يكون معنى الجهالة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع لا يعارض عموم التعليل للمفهوم ، بل المفهوم يكون حاكماً على العموم لأنّه يقتضي إلغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله محرزاً له وكاشفاً عنه ، وكأنّه يقول : « نزّل خبر العادل بمنزلة العلم » فلا يشمله عموم التعليل لا لأجل تخصيصه بالمفهوم لكي يقال : إنّه يأبى عن التخصيص بل لحكومة المفهوم عليه » (١).
ويرد عليه : إنّ لسان الآية ليس لسان الدليل الحاكم ولا يساوق مفهومها قولك : « الغ احتمال الخلاف » بل تدلّ على أنّه إذا جاءكم عادل بنبأ فلا يجب التبيّن بل يجب القبول.
__________________
(١) راجع فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ١٧٢.
نعم هذا صادق بالنسبة إلى جملة من سائر الأدلّة لحجّية خبر الواحد كقوله عليهالسلام : « ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان ».
الوجه الثالث : ما أجاب به شيخنا العلاّمة رحمهالله في الدرر وهو : « أنّ التعليل لا يدلّ على عدم جواز الاقدام بغير العلم مطلقاً بل يدلّ على عدم الجواز فيما إذا كان الاقدام في معرض حصول الندامة ، واحتماله منحصر فيما لم يكن الاقدام عن حجّة فلو دلّت الآية بمفهومها على حجّية خبر العادل فلا يحتمل أن يكون الإقدام على العمل به مؤدّياً إلى الندم فلا منافاة بين التعليل ومفهوم الآية أصلاً » (١).
ويمكن أن يقال في توضيح ما أفاده بأنّ الموجب للندم هو ما كان معرضاً للندامة غالباً وخبر العادل ليس كذلك ، ووقوع الخطأ فيه أحياناً كوقوع الخطأ في العلم لا يوجب الندم ولا ترك العمل به.
الوجه الرابع : أنّه فرق بين الجهل والعلم في مصطلح المنطق وفي العرف واللغة فالعلم المصطلح في المنطق هو درجة المائة في المائة من اليقين ، وفي مقابله الجهل المصطلح ، وأمّا العلم العرفي الاصولي فليس بتلك الدرجة بل يعدّ العمل بالظواهر وما أشبهها من العمل بالعلم عند العرف وإن لم يكن علماً قطعيّاً.
هذا كلّه بالنسبة إلى الإشكال الأوّل الوارد على الاستدلال بالآية.
الإشكال الثاني : أنّه على تقدير دلالة الآية على المفهوم يلزم خروج المورد عن مفهوم الآية لأنّ موردها وهو الإخبار عن ارتداد جماعة ( وهم بنو المصطلق ) من الموضوعات فلا يثبت بخبر العدل الواحد ، وخروج المورد أمر مستهجن عند العرف فيكشف عن عدم المفهوم للآية المباركة.
وفيه : أوّلاً : نحن في فسحة عن هذا الإشكال ، لأنّ المختار حجّية خبر الواحد حتّى في الموضوعات ، ( إلاّ في باب القضاء لما ورد فيه من دليل خاصّ بل لابدّ فيه في بعض الموارد من قيام أكثر من اثنين من الشهود ).
ثانياً : أنّ هذا ينافي إطلاق المفهوم لا أصله حيث إنّه يدلّ على حجّية خبر العادل مطلقاً ،
__________________
(١) راجع فوائد الأصول ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، طبع جماعة المدرّسين.
وقد قيّد هذا الإطلاق في موارد الموضوعات بضمّ عدل آخر وعدم الاكتفاء بعدل واحد ، وهذا لا ينافي حجّية أصل المفهوم ، فلو دلّت عليها الآية الشريفة لم يكن تقييد إطلاقه بالنسبة إلى مورده مانعاً عن تحقّقه ، والذي لا يجوز في الكلام إنّما هو خروج المورد برأسه لا ما إذا كان داخلاً مع قيد أو شرط.
الإشكال الثالث : أنّه لو دلّت الآية على حجّية خبر الواحد لكان الإجماع الذي إدّعاه السيّد رحمهالله على عدم حجّية خبر الواحد أيضاً حجّة لأنّه من مصاديق خبر الواحد ، فيلزم من حجّية خبر الواحد عدم حجّيته ، وهو من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه وهو محال.
والجواب عن هذا واضح صغرى وكبرى ، أمّا الكبرى : فلما مرّ من أنّ خبر الواحد لا يعمّ هذا القبيل من الإجماعات لأنّها من أقسام الإجماع الحدسي لا الحسّي.
وأمّا الصغرى : فلأنّا نعلم بأنّ ما إدّعاه السيّد المرتضى رحمهالله من الإجماعات مبنيّة على أصل أو قاعدة ، وليست بمعنى الإجماع على مسألة خاصّة.
الإشكال الرابع : تعارض هذه الآية مع الآيات الناهيّة عن العمل بغير علم ، والنسبة بينهما العموم من وجه فتتعارضان في مورد الاجتماع وهو خبر العادل الذي يوجب الظنّ بالحكم فتقدّم الآيات الناهيّة على هذه الآية لكونها أقوى ظهوراً.
والجواب عن هذا ظهر ممّا سبق في مقام التعرّض للآيات الناهيّة ، فقد قلنا هناك أنّ المقصود من الظنّ الوارد في تلك الآيات هو الأوهام والخرافات التي لا أساس لها وعليه لا تعارض بينهما.
الإشكال الخامس : ( وهو المهمّ ) ما لا يختصّ بآية النبأ بل يرد على جميع أدلّة حجّية خبر الواحد ، وهو عدم شمول أدلّة الحجّية للأخبار مع الواسطة مع أنّ المقصود من حجّية خبر الواحد هو إثبات السنّة بالأخبار التي وصلت إلينا مع الواسطة عن الحجج المعصومين عليهمالسلام.
ويمكن بيانه بوجوه :
الوجه الأوّل : دعوى انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة.
الوجه الثاني : اتّحاد الحكم والموضوع ببيان : أنّ حجّية الخبر التي يعبّر عنها بوجوب تصديق العادل إنّما هي بلحاظ الأثر الشرعي الذي يترتّب على المخبر به ، إذ لو لم يكن له أثر شرعي كانت الحجّية لغواً ولا يصحّ التعبّد به ، ومن المعلوم لزوم تغاير كلّ حكم مع موضوعه
فإذا لم يكن في مورد أثر شرعي للخبر إلاّنفس وجوب التصديق الثابت بدليل حجّية الخبر لم يمكن ترتيب هذا الأثر ، لما سبق من وحدة الحكم والموضوع وهو محال والمقام من هذا القبيل لأنّه إذا أخبرنا الصدوق رحمهالله مثلاً بقوله : « قال الصفّار قال : « الإمام العسكري عليهالسلام ... » لم يترتّب على إخبار الصدوق سوى وجوب تصديق قول الصفّار لأنّ الأثر العملي إنّما يترتّب على قول المعصوم فقط لا غير. وحينئذٍ فوجوب تصديق الصدوق بمقتضى آية النبأ حكم وموضوعه ( أي الأثر المترتّب على خبر الصدوق ) أيضاً وجوب تصديق الصفّار ، فيلزم اتّحاد الحكم والموضوع ، وهو محال.
وإن شئت قلت : يلزم اتّحاد الحكم والموضوع أو كون الحكم ناظراً إلى نفسه.
توضيحه : إذا قلنا بدلالة الآية على حجّية خبر الواحد يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل ( أي الأثر الذي يكون موضوعاً لحكم وجوب التصديق ) نفس تصديقه من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه ، مع أنّ وجوب التعبّد بالشيء لابدّ وأن يكون بلحاظ ما يترتّب على الشيء من الآثار الشرعيّة ، وإلاّ فلو فرضنا خلوّ الشيء عن الأثر الشرعي لما صحّ إيجاب التعبّد الشرعي به ، وعليه فلو كان الراوي حاكياً قول الإمام فوجوب التصديق بلحاظ ما يترتّب على قول الإمام عليهالسلام من الآثار ، كحرمة الشيء ووجوبه ، ولو كان المحكي قول غيره كحكاية الصدوق رحمهالله قول الصفّار فالأثر المترتّب على قول الصفّار ليس إلاّوجوب تصديقه ، فيلزم اتّحاد الحكم ( وجوب التصديق ) والموضوع ( الأثر الشرعي ) وكون الحكم ناظراً إلى نفسه.
الوجه الثالث : لزوم إيجاد الحكم لموضوعه مع أنّه لابدّ من وجود الموضوع في الرتبة السابقة على الحكم ، فإنّ الشيخ إذا أخبر عن المفيد رحمهالله وهو عن الصدوق رحمهالله فالمصداق الوجداني لنا هو قول الشيخ ، فيجب تصديقه ، وأمّا قول المفيد رحمهالله إلى أن ينتهي إلى الإمام فإنّما يصير مصداقاً لموضوع قولنا : « صدق العادل » بعد تصديق الشيخ قدسسره فيلزم إثبات الموضوع بالحكم ، وهو محال.
وقد اجيب عن هذا الإشكال : تارةً بأنّ لزوم وجود الموضوع في الرتبة السابقة على الحكم إنّما هو في القضايا الخارجيّة مع أنّ أدلّة الحجّية من القضايا الحقيقيّة الشاملة للموضوعات المحقّقة والمقدّرة ، ولا مانع فيها من تحقّق الموضوع بها وشمولها لنفسها.
واخرى بأنّه سلّمنا كون منصرف الآية الإخبار بلا واسطة إلاّ أن العرف يلغي الخصوصيّة.
وثالثة : بأنّ الإجماع المركّب قام على أنّ خبر الواحد إمّا حجّة مطلقاً ( سواء كان مع الواسطة أو بلا واسطة ) أو ليس بحجّة كذلك.
وفيه : بما أن هذه المسألة معلومة المدرك فلا فائدة في الإجماع البسيط فيها فضلاً عن الإجماع المركّب.
ورابعة : بأنّ المحال إنّما هو إثبات الحكم موضوع شخص الحكم لا إثباته موضوع فرد آخر من الحكم ، فإنّ خبر الشيخ المحرز بالوجدان يجب تصديقه وبتصديقه يحصل لنا موضوع آخر ، وهو خبر المفيد رحمهالله ، وله وجوب تصديق آخر وهكذا.
وخامسة : بأنّه يكفي في صحّة التعبّد كون المتعبّد به ممّا له دخل في موضوع الحكم ولا دليل على لزوم ترتّب تمام الأثر عليه ، ففي ما نحن فيه حيث تنتهي سلسلة الأخبار إلى قوله عليهالسلام فلكلّ واحد منها دخل في إثبات قوله الذي له الأثر الشرعي ، وهذا المقدار كافٍ في صحّة التعبّد به ، فليس هنا أحكام متعدّدة حتّى يستشكل باتّحاد الحكم والموضوع وغير ذلك بل هنا حكم واحد ، وكلّ ما في سلسلة السند من الرجال جزء لموضوعه.
٢ ـ آية النفر :
قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (١) وقد وقع البحث عنها في ثلاث مقامات : الأوّل : في تفسير الآية ، الثاني : في كيفية الاستدلال بها ، الثالث : في الإشكالات الواردة عليها والجواب عنها.
أمّا المقام الأوّل : فقد ذكر في تفسيرها وجوه خمسة :
الوجه الأوّل : أن يكون المراد من النفر فيها الخروج إلى الجهاد غاية الأمر إنّها تنهى
__________________
(١) سورة التوبة : الآية ١٢٢.
المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد كافّة وتأمرهم بالانقسام إلى طائفتين : فطائفة منهم تنفر إلى الجهاد ، وطائفة اخرى تبقى عند الرسول للتفقّه في الدين.
والقائلون بهذا الوجه استشهدوا له بصدر الآية وهو قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ) فإنّه يدلّ على أنّهم كانوا ينفرون كافّة إلى الجهاد وذلك لكي لا تشملهم الآيات النازلة في المنافقين القاعدين ، فتنهيهم الآية عن هذا النحو من الخروج وتقول : الجهاد مع الجهل واجب كالجهاد مع العدوّ.
وهذا الوجه مخالف لظاهر الآية من بعض الجهات : أوّلاً : أنّه يحتاج إلى تقدير جملة « وتبقى طائفة » وثانياً : لابدّ من رجوع الضمير في قوله « ليتفقّهوا » إلى الطائفة الباقية مع أنّ الظاهر رجوعه إلى الفرقة النافرة المذكورة في الآية ، وثالثاً : من ناحية رجوع الضمير في « ولينذروا » إلى الطائفة الباقية أيضاً مع أنّ ظاهره أيضاً الرجوع إلى النافرة.
الوجه الثاني : أن يكون المراد من النفر النفر إلى الجهاد أيضاً مع عدم التقدير المذكور في الوجه الأوّل ، فيرجع الضميران إلى الطائفة النافرة ، أي التفقّه والإنذار يرجعان إليهم ، والله تعالى حثّهم على التفقه في ميدان الحرب لترجع إلى الفرقة المتخلّفة فتحذّرها.
إن قلت : كيف يمكن التفقّه في ميدان الجهاد.
قلت : يحصل التفقّه هناك بالتبصّر والتيقّن بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين وظهور صدق قوله تعالى : ( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) (١) وكذلك قوله تعالى : ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) (٢).
وهذا الوجه أيضاً مخالف للظاهر من وجهين :
الوجه الأوّل أنّه خلاف ظاهر التفقّه في الدين وخلاف قوله : « ليتفقّهوا » بصيغة المضارع ، فإنّه ظاهر في الاستمرار لا في التفقّه في مقطع خاصّ وزمان معيّن ( هو زمان الجهاد ) كما أنّ كلمة الدين أيضاً ظاهرة في جمّ غفير من المسائل والمعارف الدينيّة لا في خصوص صفة من صفات الباري تعالى كقدرته ونصرته.
الوجه الثاني : أنّه يبقى السؤال في الآية بعدُ من أنّه لماذا منع من نفر الجميع للتفقّه في الدين؟
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٤٩.
(٢) سورة الأنفال : الآية ٦٥.
لأنّ المفروض عدم وجود تقدير في الآية ، فالواجب على الجميع النفر للتفقّه هناك.
الوجه الثالث : أن يكون المراد من النفر النفر إلى محضر الرسول صلىاللهعليهوآله لتحصيل الدين ، ومعنى الآية : لا يجوز لمؤمني البلاد أن يخرجوا كافّة من أوطانهم إلى المدينة للتفقّه للزوم اختلال النظام.
وهذا الوجه وإن يوجب التخلّص من إشكال التقدير ولكن يرد عليه :
أوّلاً : أنّ النهي عن شيء إنّما يصحّ فيما إذا كان الشخص في معرض إرتكاب ذلك الشيء ، وهو ممنوع في مورد الآية ، لأنّا لا نرى من نفر جميع المسلمين إلى محضر الرسول للتفقّه أثراً في الأخبار والتاريخ.
ثانياً : أنّه خلاف اتّحاد سياق هذه الآية مع الآية السابقة واللاحقة لأنّ موردها هو الجهاد.
الوجه الرابع : أن تكون الآية ناظرة إلى جماعة من الصحابة كانوا يتوجّهون من المدينة إلى القبائل لتبليغ الأحكام والناس يهدون إليهم هدايا وعطايا ، وصار هذا الأمر سبباً لإتّهامهم بعدم الخلوص في نيّاتهم فتركوا هذه الرسالة ، فنزلت الآية.
ويرد على هذا الوجه أيضاً أنّه لا يساعد صدر الآية الظاهر في أنّ جميع المؤمنون كانوا يخرجون من المدينة ، بينما المفروض في هذا الوجه خروج جماعة منهم ، هذا أوّلاً.
وثانياً : لازم هذا الوجه أن يكون النفر للتعليم لا للتفقّه.
الوجه الخامس : أن نلتزم بالتفكيك بين النفر الأوّل وبين النفر الثاني ، فيكون الأوّل بمعنى النفر إلى الجهاد ،
والثاني بمعنى النفر إلى التفقّه ، فمعنى الآية : أيّها المؤمنون لا يخرج جميعكم إلى الجهاد بل تخرج طائفة إليه وطائفة إلى التعلّم والتفقّه.
وفيه : أنّه خلاف وحدة السياق فإنّها تقتضي أن يكون النفر في الآية بمعنى واحد.
فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه يلزم إرتكاب خلاف الظاهر على كلّ حال.
لكن الإنصاف أنّ أخفّها مؤونة وأقلّها محذوراً هو التفسير الأوّل كما يؤيّده ما ورد في ذيل الآية من شأن النزول فإنّها وردت بعد نزول آيات الجهاد وذمّ المنافقين لأجل تركهم الجهاد ، فكان المؤمنون يخرجون إلى الجهاد جميعاً لئلا يعمّهم ذمّ الآيات ، فنزلت الآية ونهت عن خروج الجميع ، هذا أوّلاً.
ويؤيّده ثانياً : ما رواه الشيخ الطبرسي رحمهالله في مجمع البيان ( وأسنده إلى الإمام الباقر عليهالسلام
مباشرةً وبقوله : « قال الباقر عليهالسلام » مع أنّه ممّن لا يقول بحجّية خبر الواحد ) قال : قال الباقر عليهالسلام : « كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله سبحانه أن تنفر منهم طائفة وتقيم طائفة للتفقّه وأن يكون الغزو نوباً » (١).
فقد صرّحت هذه الرّواية بما قدّرت في الآية بناءً على هذا التفسير ، أي قوله عليهالسلام : « وتقيم طائفة » وقد اختار هذا التفسير كثير من المفسّرين.
هذا كلّه بالنسبة إلى نفس الآية مع قطع النظر عن الرّوايات الواردة في ذيلها.
وهنا إشكال مهمّ ينشأ من روايات كثيرة تبلغ اثنتا عشرة رواية تشهد بأنّ النفر في الآية بمعنى النفر إلى التفقّه لا الجهاد ، وأكثرها واردة في مورد قوم أخبروا بموت إمامهم المعصوم فيسأل الراوي عن أنّهم كيف يصنعون؟ فيتلو الإمام في الجواب هذه الآية لبيان أنّ الوظيفة حينئذٍ هي الخروج في الطلب والنفر إلى التفقّه في معرفة الإمام اللاحق.
منها : ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ليسوا إذا هلك الإمام فبلغ قوماً له بحضرته؟ قال : « يخرجون في الطلب فإنّهم لا يزالون في عذر ما داموا في الطلب ، قلت : يخرجون كلّهم أو يكفيهم أن يخرجوا بعضهم؟ قال إنّ الله عزّوجلّ يقول : ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) قال هؤلاء المقيمون في السعة حتّى يرجع إليهم أصحابهم » (٢).
ومنها : ما رواه عبدالأعلى قال : قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام بلغنا وفاة الإمام؟ وقال : « عليكم النفر. قلت : جميعاً؟ قال : إنّ الله يقول : ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ) الآية. قلت : نفرنا فمات بعضنا في الطريق؟ قال فقال : ( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ـ إلى قوله ـ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ) قلت : فقدمنا المدينة فوجدنا صاحب هذا الأمر ... الخ » (٣).
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.
ويمكن الجواب عنه بأنّ استدلال الإمام عليهالسلام في هذه الرّوايات ربّما يكون بما يستنتج من
__________________
(١) مجمع البيان : ج ٣ ، ص ٨٣.
(٢) البرهان : ج ٢ ، ص ١٧٢.
(٣) المصدر السابق : ص ١٧٣.
الآية وبملاك يستفاد منها ، وهو أنّ تحصيل العلم والتفقّه في الدين واجب كفائي ( كما أنّ الجهاد واجب كفائي والنفر مقدّمة له ) فالرواية تقول حينئذٍ : إذا كان التعلّم واجباً ووجب امتثال هذا الوجوب فلا فرق بين الإقامة والخروج لأجل تحقّق الامتثال ، ولا يخفى أنّ هذا لا ينافي التفسير الأوّل وكون النفر بمعنى النفر إلى الجهاد ، هذا أوّلاً.
وثانياً : غاية ما تقتضيه هذه الرّوايات كونها قرينة على أنّ النفر في الآية استعمل في النفر إلى الجهاد والنفر إلى التفقّه معاً ، أي أنّه استعمل في أكثر من معنى ، وهو جائز على المختار عند وجود القرينة أو استعمل في معنى جامع بينهما.
هذا كلّه في تفسير الآية ، أي المقام الأوّل من البحث ، وستعرف إن شاء الله أنّ الاختلاف في هذا المقام ليس له أثر كثير في ما نحن بصدده.
أمّا المقام الثاني : فهو في كيفية الاستدلال بهذه الآية لحجّية خبر الواحد ...
فنقول : الاستدلال بها يكون منّا يقوم على أساس دلالة قوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » على وجوب الحذر عند إنذار المتفقّه في الدين مطلقاً سواء حصل منه العلم أو لا ، وهو معنى حجّية خبر الواحد تعبّداً.
وأمّا كيفية دلالة كلمة « لعلّ » على الوجوب فهي من وجوه شتّى :
الوجه الأول : أن يقال : إنّ كلمة « لعلّ » وإن كانت مستعملة في معناها الحقيقي ، وهو إنشاء الترجّي حتّى فيما إذا وقعت في كلامه تعالى ، ولكن بما أن الداعي إلى الترجّي يستحيل في حقّه تعالى لأنّ منشأه عبارة عن الجهل والعجز فلا محالة تكون مستعملة بداعي طلب الحذر ، وإذا ثبت كون الحذر مطلوباً ثبت وجوبه لأنّه لا معنى لحسن الحذر ورجحانه بدون وجوبه ، فإنّ المقتضي للحذر إن كان موجوداً فقد وجب الحذر وإلاّ فلا يحسن من أصله.
أقول : إنّ هذا الوجه تامّ إلاّمن ناحية ما ذكر في مقدّمته من استحالة الترجّي في حقّه تعالى لأنّ المأخوذ في مادّة الترجّي هو الحاجة إلى شرائط غير حاصلة ، وعدم حصول الشرائط تارةً يكون من جانب المتكلّم وهو الله تعالى في الآية ، واخرى من ناحية المخاطب وهو الناس فيها ، ففي ما نحن فيه وإن كانت الشرائط حاصلة من جانبه تعالى إلاّ أنّها غير حاصلة من جانب الناس ، فاستعملت « لعلّ » في معناها الحقيقي.
وعلى كلّ حال يستفاد من كلمة « لعلّ » في الآية مطلوبيّة الحذر ( وهي مساوقة مع
الوجوب ) سواء كانت مستعملة في معناها الحقيقي أو في معناها المجازي.
الوجه الثاني : أنّ الحذر جعل غاية للإنذار الواجب ( لظهور الأمر بالإنذار في قوله تعالى ( وَلِيُنذِرُوا ) في الوجوب ) وغاية الواجب إذا كانت من الأفعال الاختياريّة واجبة كما أنّ مقدّمة الواجب واجبة لوجوب الملازمة بينهما.
الوجه الثالث : أنّ وجوب الإنذار والتفقّه مع عدم وجوب الحذر يستلزم اللغو.
الوجه الرابع : الإجماع المركّب ، فإنّ الامّة بين من لا يقول بحجّية خبر الواحد أصلاً ، وبين من يقول بوجوب العمل به ، فالقول برجحان العمل به دون وجوبه قول بالفصل.
أقول : لا إشكال في بطلان بعض هذه الوجوه أو كونها قابلة للمناقشة ، وهو الوجه الثالث والرابع ، أمّا الرابع فلعدم حجّية الإجماع البسيط في مثل المقام الذي يكون ـ على الأقل ـ محتمل المدرك فضلاً عن الإجماع المركّب.
وأمّا الوجه الثالث : فلعدم لزوم اللغويّة لإمكان أن يكون وجوب الإنذار لغاية حصول العلم ، ويكفي ، في نفي اللغوية ترتّب الأثر في الجملة فيبقى الوجه الأوّل والثاني ، ولا بأس بهما.
لكن يرد على الاستدلال بهذه الآية إشكالات عديدة لا يتمّ الاستدلال بها من دون دفعها :
الأوّل : أنّ الآية وردت في مقام بيان وظيفة المتفقّهين النافرين لا وظيفة قومهم بعد الرجوع إليهم.
ويمكن الذبّ عنه مضافاً إلى عدم وروده على الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في تفسيرها ( لأنّ غاية الواجب واجبة على الباقين ) بأنّ ظاهر الآية أنّها في مقام بيان وظيفة كلتا الطائفتين طائفة المنذرين بالكسر وطائفة المنذرين بالفتح ، فتطلب من الاولى الإنذار لظهور الأمر ( ولينذروا ) في الوجوب ومن الثانية القبول لما مرّفي الوجه الأوّل من دلالة كلمة « لعلّ » على معنى الطلب.
الثاني : أنّ الظاهر من الآية هو حجّية قول المجتهد بالنسبة إلى مقلّديه ، لأنّ التفقّه والإنذار بما تفقّه من وظيفة المجتهد لا الناقل للرواية ، لأنّ وظيفة الناقل النقل والإخبار لا تعيين تكليف المخبر به ، فلا ربط للآية بحجّية خبر الواحد الذي هو محلّ الكلام.
إن قلت : كيف ، مع أنّه لم يكن للفقه والاجتهاد بالمعنى المصطلح في عصر الأئمّة عين ولا أثر؟
قلنا : لا إشكال في وجود هذا المعنى في ذلك الزمان على حدّه البسيط وفي دائرة تخصيص العام وتقييد المطلق وتقديم النصّ على الظاهر وشبه ذلك ، والإنصاف أنّ مفاد الآية ليس على حدّ الاجتهاد المصطلح ولا على حدّ البيان الساذج للخبر ، بل المستفاد منها عرفاً كون الناقلين للأخبار من قبيل ناقلي فتاوي المجتهدين والمنصوبين من قبلهم لنقل المسائل العمليّة وتوضيحها لمقلّديهم في يومنا هذا ، ولا إشكال في قابليتهم للإنذار ولا إشكال أيضاً في تحقّق الإنذار بتوسّطهم أي يتحقّق الإنذار بمجرّد نقل الرواة عن الأئمّة عليهمالسلام ولا يشترط فيه التفقّه بالمعنى المصطلح كما لا يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ريب.
الثالث : أنّ المأخوذ في التفقّه والإنذار في الآية عنوان الطائفة ، وهي عبارة عن الجماعة وإخبار الجماعة يوجب العلم ، فتكون الآية خارجة عن محلّ البحث.
والجواب عنه واضح ، لأنّ المقصود من الطائفة هو معناها الحقيقي نظير المراد في قوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) وفي قولك : « سل العلماء ما جهلت » وقولك : « راجع الأطباء في مرضك » وقوله تعالى : ( وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ) وقوله تعالى : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) ونظيرها ممّا لا شكّ في أنّ المخاطب فيه كلّ واحد من الأفراد والمصاديق مستقلاً لا الجماعة بما هي جماعة.
الرابع : أنّ الآية ناظرة إلى اصول الدين وتحصيل المعارف الدينيّة بقرينة الرّوايات التي وردت في ذيلها الدالّة على وظيفة المؤمنين في تعيين الإمام اللاحق بعد وفاة الإمام السابق ، وقد مرّ بعضها في البحث عن المقام الأوّل ، ولا إشكال في اعتبار حصول العلم في الاصول ، فتكون الآية خارجة عن محلّ البحث.
والجواب عنه : أنّ الآية عامّة تعمّ الفروع أيضاً لأنّه لا وجه لتخصيصها بالاصول ، أمّا الرّوايات فإنّها غاية ما تثبته أنّ اصول الدين مشمولة للآية ولا تدلّ على انحصارها بها.
٣ ـ آية الكتمان
وهي قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ ) (١) ، وقوله : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ... ) (٢).
وتقريب الاستدلال بهما : أنّ حرمة الكتمان ووجوب الإظهار يلازم وجوب القبول وألاّ يكون لغواً.
نعم إنّه تامّ بالنسبة إلى الآية الاولى ، لأنّ الموضوع فيها هو مجرّد الكتمان ، وأمّا الآية الثانية فيمكن الإشكال فيها بأنّ مجرّد الكتمان فيها ليس موضوعاً للحرمة بل أخذ في الموضوع أنّهم يشترون بكتمان الحقّ ثمناً قليلاً ، فالصالح للاستدلال هو الآية الاولى فقط.
وإستشكل فيها أوّلاً : بأنّها واردة في اصول العقائد كما يشهد به شأن نزولهما.
واجيب عنه : بأنّها مطلقة تعمّ الفروع والاصول معاً لأنّ الآية تشمل ما إذا كتم فقيه حرمة الربا مثلاً بالوجدان ، ولا دخل لخصوصيّة المورد لأنّ المورد ليس مخصّصاً.
وثانياً : أنّه من الممكن أن تكون فائدة حرمة الكتمان ووجوب الإظهار هو حصول العلم من قولهم لأجل تعدّدهم لا العمل بقولهم وإن لم يحصل العلم من إخبارهم.
وإن شئت قلت : إنّا فهمنا وجوب القبول من برهان اللغويّة لا من اللفظ حتّى يدّعي الإطلاق بالنسبة إلى مورد عدم حصول العلم.
٤ ـ آية أهل الذكر
وهي قوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ) وقد وردت في موضعين من الكتاب الكريم : أحدهما : سورة النحل : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ) (٣) ، والثاني : سورة الأنبياء : ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ) (٤) ، ( والفرق بين الآيتين منحصر
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ١٥٩.
(٢) سورة البقرة : الآية ١٧٤.
(٣) سورة النحل : الآية ٤٣.
(٤) سورة الأنبياء : الآية ٧.
في كلمة « من » فإنّها وردت في الاولى لا الثانية ).
وهاتان الآيتان بشهادة صدرهما نزلتا في من كانوا يعترضون على النبي صلىاللهعليهوآله بأنّه لِمَ خلق بشراً أو لا يكون معه ملك ، فأجابتا عن هذا الإشكال بأنّ هذا ليس أمراً جديداً بل كان الأمر كذلك في الأنبياء السلف ، وإن أردتم شاهداً على هذا فاسألوا أهل الذكر ، فمورد الآية مسألة من مسائل أصل النبوّة ( الذي هو من جملة اصول الدين ) وهي أنّه هل يمكن أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله بشراً أو لا؟
والاستدلال بهذه الآية لحجّية خبر الواحد يرجع أيضاً إلى برهان اللغويّة ، وتقريبه : أنّ ظاهر الأمر بالسؤال هو وجوبه ، ووجوبه ملازم لوجوب القبول ، وإلاّ يكون وجوب السؤال لغواً ، وإطلاقه يشمل السؤال الذي يحصل من جوابه العلم وما يحصل من جوابه الظنّ ، أي يجب القبول سواء حصل العلم أم لا؟
ولكن يرد عليه :
أوّلاً : ما أورده كثير من الأعلام وهو أنّه يمكن أن تكون فائدة وجوب السؤال هي حصول العلم بالسؤال فيخرج عن اللغويّة.
ويمكن دفع هذا الإشكال بإطلاق وجوب السؤال ، لأنّ لازمه إطلاق وجوب القبول.
وثانياً : أنّ مفادها أخصّ من المدّعى ، لأنّها تدلّ على وجوب القبول في خصوص مورد السؤال ، بينما محلّ النزاع مطلق أخبار الثقة سواء كان في قبال سؤال أم لم يكن.
والجواب عنه واضح وهو أنّ الفهم العرفي يوجب إلغاء الخصوصيّة عن مورد السؤال.
وثالثاً : أنّ قوله تعالى « أهل الذكر » ظاهر في أهل الخبرة ، فيدلّ على حجّية قول أهل الخبرة لوجود تفاسير مختلفة لأهل الذكر في كلمات المفسّرين فبعضهم فسّره بالقرآن لأنّ من أسامي القرآن الذكر كما ورد في قوله تعالى : ( وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ) (١) وبعضهم فسّره بأهل الكتاب من علماء اليهود والنصارى ، والمقصود من السؤال منهم حينئذٍ هو السؤال عن علائم النبوّة الموجودة في التوراة والإنجيل ، وثالث فسّره بأهل العلم بأخبار الماضين ، ورابع فسّره بالأئمّة صلوات الله عليهم لأنّ من أسامي الرسول أيضاً الذكر كما ورد في قوله تعالى :
__________________
(١) سورة الأنبياء : الآية ٥٠.
( قَدْ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً ) (١) وقد أُيّد هذا التفسير بروايات وردت في هذا المعنى.
لكن الصحيح أنّ المراد منه أهل العلم عامّة وأنّ كلّ واحد من هذه الاحتمالات بيان لمصداق من المصاديق وتفسير للآية بالمصداق كما هو المتداول في كثير من كتب التفسير وكذا الرّوايات ، وذلك باعتبار أنّ الذكر في اللغة بمعنى العلم مطلقاً ومن دون تقيّد وخصوصيّة ، ويشهد عليه ملاحظة موارد استعمال هذه المادّة ومشتقّاتها في القرآن الكريم كقوله تعالى : ( لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) فيكون المراد من كلمة « الأهل » كلّ من كان عالماً وخبيراً في موضوع من الموضوعات ومسألة من المسائل ، ولا وجه لتخصيصه بمصداق دون مصداق.
وعليه يكون الاستدلال بهذه الآية في باب التقليد أولى ممّا نحن فيه.
لكن المحقّق الخراساني رحمهالله حاول الجواب عن هذا الإشكال بأنّ مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما من أجلاّء الرواة كانوا من أهل العلم ، فيجب قبول روايتهم ، وإذا وجب قبول روايتهم وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركّب.
والإنصاف أنّه غير تامّ ، لأنّ المستفاد من الآية وجوب السؤال عن مثل زرارة وقبول روايته من حيث إنّه من أهل العلم والخبروية لا بما أنّه راوٍ وناقل للرواية حتّى يتعدّى عنه إلى سائر الرواة.
وإن شئت قلت : هو دليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وإمضاء لبناء العقلاء في هذا الأمر ، وأمّا الإجماع المركّب فلا إشكال في عدم حجّيته في مثل هذه المسألة.
ورابعاً : أنّ الآية وردت في اصول العقائد ولا كلام في عدم حجّية خبر الواحد فيها.
ويمكن الجواب عن هذا أيضاً بأنّ الآية مطلقة تشمل الاصول والفروع ، غاية الأمر لابدّ في الاصول من إضافة قيد من الخارج وهو اعتبار حصول العلم.
فقد ظهر أنّ جميع ما اورد على الاستدلال بهذه الآية مدفوعة إلاّ الإشكال الثالث ، وهو أنّها واردة في حجّية قول أهل الخبرة ، ولهذا استدلّ كثير من العلماء بها في باب الاجتهاد والتقليد بل هي من أهمّ أدلّة ذلك الباب.
هذا كلّه في الإستلال لحجّية خبر الواحد بالكتاب ، وهو الدليل الأوّل.
__________________
(١) سورة الطلاق : الآية ١٠ ـ ١١.
الدليل الثاني : السنّة
ويتضمّن الاستدلال بروايات متواترة وردت أكثرها في الباب التاسع والباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي في الوسائل ، إلاّ أن مضامينها مختلفة ، وهي طوائف :
الطائفة الاولى : الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين من الرواة والأصحاب أو إلى كتبهم :
منها : ما رواه شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ربّما إحتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال : « عليك بالأسدي يعني أبا بصير » (١).
ومنها : ما رواه يونس بن عمّار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال له في حديث : « أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا يجوز لك أن تردّه » (٢).
ومنها : ما رواه المفضّل بن عمر أنّ أبا عبدالله عليهالسلام قال للفيض بن المختار في حديث : « فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومى إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه. فقالوا : زرارة بن أعين » (٣).
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة أنّها وإن لم تصرّح بحجّية خبر الثقة بنحو الكبرى الكلّية ولكن يستفاد ذلك من مجموعها بل من كلّ فرد منها لضرورة عدم خصوصيّة لأشخاصهم فلم توجب حجّية كلامهم إلاّوثاقتهم وأمانتهم على الدين والدنيا ، فمن كان من غير هؤلاء وكان بصفاتهم كان خبره حجّة ومعتبراً.
الطائفة الثانية : الأخبار التي تدلّ على حجّية خبر الثقات بنحو الكبرى الكلّية من دون اختصاص بأشخاص معينين :
منها : ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليهالسلام : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » (٤).
فيستفاد من تعبيره بـ « أصدقهما » أنّ الصدق يوجب الحجّية ولذلك يكون مرجّحاً عند التعارض.
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ١١ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ١٥.
(٢) المصدر السابق : ح ١٧.
(٣) المصدر السابق : ح ١٩.
(٤) المصدر السابق : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ١.
ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال : « إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن » (١).
ومنها : ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : « ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّوجلّ وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا وإن لم يكن يشبههما فليس منّا » ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » (٢).
فلا يخفى أنّ الحكم في هذه الرّوايات تعلّق بعناوين كلّية وهي : « الصادق في الخبر » في الرّواية الاولى ، و « غير المتّهم بالكذب » في الرّواية الثانية ، و « الثقة » في الرّواية الثالثة ، فصدر الحكم على نهج القضيّة الحقيقيّة.
ومنها : ما رواه عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً عن الرضا عليهالسلام : قال : قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : « نعم » (٣).
فقد أمضى الإمام في هذه الرّواية ما كان مرتكزاً في ذهن الراوي من حجّية قول الثقة لأنّ الراوي سأل عن وثاقة يونس بن عبدالرحمن وعن أخذ معالم دينه منه لكونه ثقة ، والإمام عليهالسلام أجاب عن كلا السؤالين بقوله « نعم » ، فكأنّه أمضى الصغرى والكبرى جميعاً.
ومنها : ما ورد في التوقيع الشريف الوارد على القاسم بن العلاء : « فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فما يرويه عنّا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا ونحملهم إيّاه إليهم » (٤).
فإنّ الحكم فيها بعدم جواز التشكيك أيضاً تعلّق بموضوع الثقة.
ومنها : ما رواه أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليهالسلام سألته وقلت : من اعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال : « العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ح ٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) المصدر السابق : ح ٤٠.
(٣) المصدر السابق : الباب ١١ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٣.
(٤) المصدر السابق : ح ٤٠.
فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون » قال : وسألت أبا محمّد عليهالسلام عن مثل ذلك فقال : « العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان » (١).
الإنصاف أنّ قوله عليهالسلام : « فإنّه الثقة المأمون » أو قوله عليهالسلام في ذيل الحديث : « فإنّهما الثقتان المأمونان » بمنزلة تعليق حرمة الخمر بقولك : « لأنّه مسكر » فيدلّ على أنّ الميزان في حجّية خبر الواحد كون المخبر ثقة.
الطائفة الثالثة : روايات اخرى ذات تعابير مختلفة تدلّ على كلّ حال على حجّية خبر الثقة :
منها : ما رواه إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليهالسلام : « أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضى الله عنه وعن أبيه من قبل ، فإنّه ثقتي وكتابه كتابي » (٢).
فهذه الرّواية وإن استدلّ بها في باب التقليد وباب ولاية الفقيه لكن يمكن أن يستدلّ بها أيضاً في باب الحديث والأخبار بالأحاديث خصوصاً مع ملاحظة التعبير الوارد فيها بـ « رواة أحاديثنا » ، فإنّها في الجملة تدلّ على حجّية خبر الواحد وإن اعتبرنا فيها شرائط وخصوصيّات ، ولا يخفى أنّ محلّ النزاع حجّية خبر الواحد في الجملة ، كما يمكن إدراج هذه الرّواية في الطائفة الثانية لما ورد في ذيلها : « فإنّه ثقتي وكتابه كتابي ».
ومنها : ما رواه أبو العبّاس الفضل بن عبدالملك قال سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : « أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً أربعة : يزيد بن معاوية الجبلي ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، والأحول وهم أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً » (٣).
فإنّها تدلّ على حجّية خبر الثقة في الجملة بالدلالة الالتزاميّة كما لا يخفى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ح ٤ ، الباب ١١ ، من أبواب صفات القاضي.
(٢) المصدر السابق : ح ٩.
(٣) المصدر السابق : ح ١٨.
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلّها في المحمل وروى بعضهم لا تصلّها إلاّعلى الأرض ، فوقّع عليهالسلام : « موسّع عليك بأيّة عملت » (١).
هذه هي الطوائف الثلاثة من الأخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد.
وإستشكل فيها أوّلاً : بإمكان المنع عن كونها متواترة لأنها مع كثرتها منقولة عن عدّة كتب خاصّة لا تبلغ حدّ التواتر مع أنّ الشرط في تحقّق التواتر كونها متواترة في جميع الطبقات ، والتواتر في جميعها ممنوع مع ما عرفت.
وثانياً : بأنّه لو سلّمنا كونها متواترة إلاّ أنّه لا يوجد بين الأخبار خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط ، أي دالاً على حجّية قول مطلق الثقة ، لأنّ القدر المتيقّن من تلك الأخبار هو الخبر الحاكي من الإمام بلا واسطة مع كون الراوي من الفقهاء نظراء زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، ومعلوم أنّه ليس بينها خبر واجد لجميع الشرائط حتّى شرط عدم الواسطة.
ولكن يمكن الجواب عن كلا الإشكالين : أمّا عن الأوّل : فبأنّه لو لم تكن الأخبار متواترة فلا أقلّ من وجود خبر بينها محفوف بالقرائن القطعيّة أو الاطمئنانيّة يدلّ على حجّية خبر مطلق الثقة ، وهذا المقدار لا يضرّنا ولا بأس به لأنّ المهمّ هو القطع بالصدور.
وأمّا عن الثاني : فبأنّه أوّلاً : كلّ واحدة من الطوائف الثلاثة للأخبار قطعية الصدور وإن لم يكن بينها مصداق للخبر المتواتر في المصطلح ، ولا إشكال في دلالة بعض هذه الطوائف على حجّية خبر الثقة مطلقاً.
ثانياً : أنّ جميع الرّوايات ( باستثناء روايتين أو ثلاث روايات ممّا ورد فيها نظير مضمون : « ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان » ) ظاهرة في الأعمّ من الأخبار مع الواسطة ويكون القدر المتيقّن حينئذٍ ما كانت سلسلة الرواة فيها من الفقهاء نظراء زرارة من دون فرق بين كونها مع الواسطة أو بلا واسطة ، فلو ظفرنا على رواية جامعة لهذه الشرائط ويكون مفادها حجّية خبر الثقة مطلقاً يثبت المطلوب سواء كانت مع الواسطة أو بدون الواسطة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ح ٤٤ ، الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي.