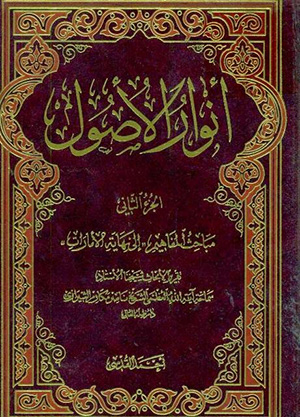الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-8139-14-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
إن قلت : وجود العام ووروده بعد الخاصّ يمنع من جريان مقدّمات الحكمة لكونه بياناً للحكم.
قلنا : أنّ المراد من عدم البيان في مقدّمات الحكمة هو عدم البيان في مقام البيان لا عدم البيان إلى الأبد ، وحيث إن المولى أطلق كلامه حين البيان ولم يقيّده بزمان خاصّ تجري مقدّمات الحكمة وتقتضي الدوام والأبديّة.
ثانيها : العمومات التي وردت في الشرع ومفادها « أنّ حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » أو الأدلّة التي تدلّ على خاتميّة دين النبي صلىاللهعليهوآله فإنّ هذه الأدلّة بعمومها أو إطلاقها دليل على أبديّة الأحكام الشرعيّة كلّها.
ثالثها : ما سيأتي إن شاء الله في باب النسخ أنّ طبيعة الحكم الإلهي والقانون الشرعي تطلب الأبديّة وتدلّ على الدوام والاستمرار إلى أن يرد ناسخ فإنّها نظير طبيعة الأحكام الوضعيّة المجعولة عند العرف والعقلاء كالملكيّة والزوجيّة ، حيث إنّها تقتضي الدوام بطبعها وذاتها إلى أن يرد عليه مزيل كما لا يخفى ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح عن قريب فانتظر.
الفصل الثاني عشر :
الكلام في النسخ والبداء
والوجه في التعرّض لهذه المسألة في ما نحن فيه أمران :
أحدهما : ربط مسائل العام والخاصّ بالنسخ كما ظهر ممّا سبق.
ثانيهما : كونها من المبادىء الأحكاميّة التي تبحث عنها في علم الاصول كالبحث عن تضادّ الأمر والنهي ، هذا بالنسبة إلى النسخ ، وأمّا البداء فلأنّ له صلة قريبة وعلاقة شديدة بالنسخ كما سيتّضح لك إن شاء الله.
وكيف كان : لابدّ أوّلاً : أن نبحث في المعنى اللغوي للنسخ ، قال الراغب في مفرداته : « النسخ إزالة الشيء بشيء يتعقّبه كنسخ الشمس الظلّ والظلّ الشمس والشيب الشباب ، فتارةً يفهم منه الإزالة وتارةً يفهم منه الإثبات وتارةً الأمران » ( أي الإزالة والإثبات كلاهما ) ثمّ قال بعد فصل : « ونسخ الكتاب نقل صورته المجرّدة إلى كتاب آخر وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الاولى بل يقتضي إثبات مثلها في مادّة اخرى كالمناسخة في الميراث » فيستفاد من هذه العبارة إنّه أشرب في ماهيّة النسخ أمران : الإزالة والإثبات ، ولذلك قد يستعمل النسخ في خصوص معنى الإزالة وقد يستعمل في خصوص معنى الإثبات ، ومن هنا أخذ معنى التناسخ في القول بتناسخ الأرواح لأنّ القائل به يقول : أنّ الروح يزول عن بدن ويثبت في بدن آخر. هذا في معنى النسخ لغةً.
وأمّا في الاصطلاح فذكر له معانٍ مختلفة ، فقال المحقّق الخراساني رحمهالله : « إنّ النسخ دفع الحكم الثابت إثباتاً إلاّ أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً ».
وقال المحقّق النائيني رحمهالله : « النسخ انتهاء أمد الحكم المجعول لانتهاء الحكمة الداعية إلى جعله » وقال في المحاضرات : « النسخ رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه ».
أقول : لو حاولنا النقاش في هذه التعاريف فيمكن المناقشة في كلّ منها ، فمثلاً بالنسبة إلى التعريف الأخير ( وهو للمحاضرات ) يمكن أن يقال : إنّ الصحيح هو التعبير برفع الحكم لا رفع الأمر ، وأيضاً لا وجه لتخصيصه النسخ بالشريعة المقدّسة بل إنّه ثابت بين العرف والعقلاء أيضاً في أحكامهم ، كما أنّ هذا الإشكال يرد على تعريف المحقّق الخراساني رحمهالله أيضاً لأنّ تعبيره بالدفع يتصوّر في دائرة الشرع ، وأمّا في دائرة الموالي العرفيّة وعبيدهم فإنّ النسخ هو الرفع لا الدفع كما لا يخفى ، وهكذا بالنسبة إلى كلام المحقّق النائيني رحمهالله حيث إنّه أيضاً خصّص النسخ في تعريفه بدائرة الشرع ، والأحسن أن يقال : النسخ ، رفع حكم تكليفي أو وضعي مع بقاء موضوعه ( ثبوتاً أو إثباتاً ).
ثمّ إنّه هل يجوز النسخ في حكم الله تعالى أو لا؟ المشهور أو المجمع عليه بين المسلمين جوازه ونسب إلى اليهود والنصارى أنّه مستحيل ، واستدلّ لذلك بأنّه إمّا إن كان الحكم المنسوخ ذا مصلحة فلا بدّ من دوامه وبقائه ولا وجه لنسخه وإزالته ، وأمّا إن لم يكن ذا مصلحة فاللازم عدم جعله ابتداءً إلاّ إذا كان الجاعل جاهلاً بحقائق الامور ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، كما أنّ النسخ في الأحكام العرفيّة أيضاً يرجع إلى أحد الأمرين : إمّا إلى جهل الجاهل من أوّل الأمر بعدم وجود المصلحة في الحكم ، وإمّا إلى جهله بعدم دوام المصلحة وعدم كونه عالماً بالمستقبل ، وبما أن الله تعالى لا يتصوّر فيه الجهل بالمستقبل حدوثاً وبقاءً يستحيل النسخ بالنسبة إليه كما لا يخفى.
والجواب عن هذا معروف ، وهو أنّه لا إشكال في أن يكون لشيء مصلحة في زمان دون زمان آخر كالدواء الذي نافع للمريض يوماً وضارّ يوماً آخر ، كما أنّ الرجوع إلى التاريخ وشأن نزول الآيات في قصّة القبلة يرشدنا إلى هذه النكتة ، وحينئذٍ يكون النسخ بمعنى انتهاء أمد الحكم وزوال المصلحة ، ومن هنا ذهب المشهور إلى أنّ النسخ دفع الحكم لا رفعه ، كما أنّ المعروف كون النسخ تخصيصاً للعموم الأزماني لأحكام الشرع ظاهراً ، ولكنّ الإنصاف أنّ بقاء الأحكام مستفاد من طبيعتها وأنّ النسخ في الحقيقة رفع لا دفع.
توضيح ذلك : أنّ الأحكام الإنشائيّة على أقسام فتارةً يكون من الأحكام التكليفيّة كالوجوب والحرمة ، واخرى من قبيل الأحكام الوضعيّة كالملكيّة والزوجيّة ، وثالثة من قبيل المناصب المجعولة كمنصب القضاوة والوزارة ، وكلّ واحد من هذه الثلاثة قد يكون موقتاً
كالواجبات الموقّتة مثل الصّوم والحجّ في القسم الأوّل ، وكالإجارة في القسم الثاني وكبعض مناصب الحكومة في عصرنا هذا في القسم الثالث ، وقد يكون مطلقاً كوجوب تطهير المسجد من النجاسة وأداء الدَين في القسم الأوّل وكالملكيّة الحاصلة من البيع في القسم الثاني حيث إن البيع ينعقد مطلقاً وإن كان البائع أو المشتري عازماً على الفسخ ، ولذا لا يصحّ أن يقول : « ملكتك إلى شهر » ولا أن يقول : « ملكتك إلى الأبد » بل الملكيّة إذا حصلت بقيت بذاتها ، وكالقضاوة والوزارة في القسم الثالث لأنّه ما لم يعزل القاضي أو الوزير عن منصب القضاوة والوزارة يكون باقياً على منصبه بمقتضى طبيعة ذاتهما.
إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في أنّ الحكم الذي انشأ على نحو الإطلاق وكان من القسم الثاني والثالث يدوم ويستمرّ بمقتضى طبعه وذاته ولذلك يعبّر فيهما بالفسخ والعزل ، فإنّ الفسخ أو العزل هو رفع ما يكون ثابتاً باقياً حتّى في مقام الثبوت ، ثمّ نقول : كذلك في القسم الأوّل ، أي الأحكام التكليفيّة التي تصدر وتنشأ من جانب الشارع مطلقاً ويكون مقتضى طبعها وذاتها الدوام والاستمرار بلا فرق بينها وبين الأحكام الوضعيّة والمناصب المجعولة ، وبلا فرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات فيكون وزان النسخ فيها وزان الفسخ والعزل فيهما ، أي أنّ النسخ أيضاً رفع الحكم الثابت لا الدفع ، فكما أنّ الأحكام الوضعيّة المطلقة والمناصب المجعولة المطلقة كان مقتضى طبعها وذاتها الدوام والبقاء فتكون باقية ما لم يفسخ وما لم يعزل كذلك الأحكام التكليفيّة المطلقة يكون مقتضى طبعها الدوام والبقاء وتكون باقيّة ما لم ينسخ ، فوزانها وزانهما كما أنّ وزان النسخ وزان الفسخ والعزل ، ولذلك نقول : كذلك في الشرائع السابقة فإنّ مقتضى طبعها أيضاً الدوام ما لم تأت شريعة اخرى ، فمثلاً شريعة عيسى عليهالسلام لم تكن مقيّدة بمقدار خمسمائة سنة بل إنّها بأحكامها كانت مطلقة في مقام الثبوت والإنشاء ، مقتضية للبقاء والاستمرار ، وهكذا مسألة القبلة في شريعتنا كانت بذاتها مقتضية للدوام والاستمرار ما لم تنسخ من ناحية الشارع.
إن قلت : فما الفرق بين الشارع وغيره في النسخ؟
قلنا : لا فرق بينهما بالنسبة إلى ماهيّة النسخ وحقيقته ، فإنّه رفع الحكم ثبوتاً وإثباتاً في كلا الموردين ، إنّما الفرق من جهتين :
الاولى : جهل العقلاء بعدم المصلحة حدوثاً ومن أوّل الأمر فيما إذا كانت المصلحة مفقودة
منذ البداية ، فقد يستكشف لهم بعد جعل الحكم فقدان المصلحة من بدو الأمر.
الثانية : جهلهم بانتهاء مصلحة الحكم وعدم دوامها فيما إذا انتهت المصلحة بعد فترة ، فيستكشف لهم عدم دوامها ، ولا إشكال في أنّه لا يتصوّر شيء من الأمرين بالنسبة إلى الشارع العليم الحكيم كما لا يخفى ، لكن هذا لا ينافي أن يكون جعل الشارع وإنشائه بحسب الظاهر والواقع مطلقاً كما مرّ بيانه.
وممّا يؤيّد ما ذكرنا أنّه لو كان النسخ تخصيصاً أزمانياً ودفعاً في مقام الثبوت فكان الزمان مأخوذاً في الحكم يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن لأنّ في نسخ حكم واحد يستثنى أكثر الزمان ، هذا أوّلاً.
وثانياً : لا خلاف ولا إشكال في تقديم التخصيص على النسخ عند دوران الأمر بينهما ، وهذا ممّا يشهد بأنّ النسخ عندهم هو نزع الحكم من الأصل والأساس ، ولذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة على التخصيص الذي يكون أساس الحكم فيه باقياً على حاله ، وإلاّ لو لم يكن النسخ هكذا بل كان في الواقع من مصاديق التخصيص فلا وجه لتقيم التخصيص عليه.
ثالثاً : أنّ عدم جواز النسخ بخبر الواحد وجواز التخصيص به أيضاً شاهد لما ذكرنا حيث إنّه أيضاً يدلّ على زيادة المؤونة في النسخ وأنّه رفع الحكم من الأساس.
بقي هنا شيء :
وهو كيف يتصور النسخ في القرآن الكريم؟
لا إشكال في جواز النسخ في القرآن سواء كان الناسخ والمنسوخ كلاهما في القرآن كما في آية النجوى ، أو كان خصوص الناسخ فيه كما في حكم القبلة.
لا يقال : أنّه في القسم الأوّل مشمول لقوله تعالى : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) (١) لأنّ جوابه واضح ، وهو وجود القرينة في هذه الموارد إمّا على أنّ الآية المنسوخة ستنسخ أو على ناسخيّة الآية الناسخة فتكون إحدى الآيتين ناظرة إلى الاخرى ، ولا إشكال حينئذٍ في عدم صدق الاختلاف ، فالأوّل مثل قوله تعالى : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ
__________________
(١) سورة النساء : الآية ٨٢.
الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) (١) قرينة على إمكان النسخ فيها ، كما ورد من طرق الفريقين أنّ المراد من السبيل هو حدّ زناء المحصنة ، فنسخ حكم الإمساك في البيوت للزانيات ، وتبدّل إلى الحدّ المذكور في الرّوايات وهو الرجم ، نعم ليس الناسخ لهذه الآية من القرآن ، فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّ محلّ البحث ما إذا كان كلا الدليلين من القرآن بينما الناسخ هنا روايات وردت من طريق الفريقين.
وأمّا قوله تعالى في سورة النور : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) فهو وارد في غير المحصنات كما ثبت في محلّه ، نعم يمكن الاستشهاد بهذه الآية لإثبات أصل وجود القرينة في الآية المنسوخة.
إن قلت : كيف يكون الرجم بالنسبة إلى المحصنات الزانيات سبيلاً مع كونه أسوأ حالاً من الإمساك؟
قلنا : أنّه كذلك إذا كان الحكم في الدليل الناسخ شاملاً أيضاً لمن إرتكب الزنا قبل صدور الناسخ مع أنّ الثابت في الشرع أنّ حكم الرجم مخصوص لمن يزني بعد صدور هذا الحكم ، وأمّا المرتكب للزنا قبله فهو معفوّ بلا إشكال. وحينئذٍ السبيل في الآية هو العفو بالنسبة إلى من زنى سابقاً ، كما أنّه كذلك في القوانين العقلائيّة العرفيّة ، فإنّها لا تشمل ما سبق ، وحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّ الاعتبار العقلائي هذه بنفسها قرينة لبّية على انصراف القانون الجديد في الشرع إلى زمان الحال والاستقبال.
نعم ، إذا قلنا : أنّ الآية ناظرة إلى غير المحصنات مع القول بأنّ آية الجلد شاملة لمن سبق منه الزنا أيضاً فالمراد من السبيل حينئذٍ هو تبدّل السجن إلى الجلد.
هذا كلّه فيما إذا كانت القرينة موجودة في الدليل المنسوخ ، أمّا الثاني وهو ما إذا كانت القرينة موجودة في الدليل الناسخ فهو نظير قوله تعالى في آية النجوى : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) فإنّ التعبير بـ « أأشفقتم » و « فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم » قرينة على نسخ حكم الصدقة
__________________
(١) سورة النساء : الآية ١٥.
(٢) سورة المجادلة : الآية ١٣.
الوارد في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ... ) (١) كما لا يخفى.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّه لا إشكال في جواز النسخ في القرآن سواء كان الوارد في القرآن خصوص الدليل الناسخ أو خصوص الدليل المنسوخ أو كليهما ، نعم يشترط في الأخير وجود القرينة على النسخ أمّا في الدليل الناسخ أو في الدليل المنسوخ حتّى لا يكون من قبيل الاختلاف.
هذا تمام الكلام في النسخ.
مسألة البداء
ذكرنا مسألة البداء بعد مسألة النسخ لما بينهما من الإرتباط ، ولذلك تذكران معاً في كلمات القوم غالباً ، والمحقّق العلاّمة المجلسي رحمهالله عنون لهما باباً واحداً في المجلّد الرابع من بحار الأنوار بقوله « فصل في البداء والنسخ » وجمع فيه زهاء سبعين رواية في البداء والنسخ.
ووجه الإرتباط بين المسألتين أنّ النسبة بينهما العموم مطلقاً لأنّ البداء يعمّ التكوينيات والتشريعيات معاً لكن النسخ يختصّ بالتشريعيات ، نعم خصّص بعض العلماء أحدها بالتكوينيات والآخر بالتشريعيات ، وقال في مقام تشبيه أحدهما بالآخر : « البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات » وجاء في كلام المحقق الداماد « أنّ البداء النسخ في التكوينيات والنسخ بداء في التشريعيات ».
توضيح المسألة : قال الراغب في مفرداته : البداء ظهور الشيء ظهوراً بيّناً ( ولذلك تسمّى البادية بادية لأنّ كلّ شيء ظاهر هناك ، أو لأنّه يظهر فيها حوادث مختلفة لا تظهر في المدن ) وقال بعض : المراد من البداء في اللغة ظهور الشيء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهل ، نحو قوله تعالى : ( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ) (٢) أو قوله : ( وَبَدَا لَهُمْ
__________________
(١) سورة المجادلة : الآية ١٢.
(٢) سورة يوسف : الآية ٣٥.
سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ) (١) هذا بالنسبة إلى معناه اللغوي ، وأمّا بالنسبة إلى الباري تعالى فقد وردت روايات كثيرة تدلّ على أنّ البداء في أمر الله من الامور المسلّمة التي يترادف الاعتقاد به الاعتقاد بالتوحيد ، ونحن نشير هنا إلى عدد منها :
١ ـ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « ما عبدالله عزّوجلّ شيء مثل البداء » (٢).
٢ ـ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « ما عظّم الله عزّوجلّ بمثل البداء » (٣).
٣ ـ ما رواه مرازم بن حكم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : « ما تنبّأ نبي قطّ حتّى يقرّ لله تعالى بخمس : بالبداء والمشيئة والسجود والعبوديّة والطاعة » (٤).
٤ ـ ما رواه زرارة ومحمّد بن مسم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « ما بعث الله نبيّاً قطّ حتّى يأخذ عليه ثلاثاً : الإقرار لله بالعبوديّة وخلع الأنداد وأنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء » (٥) إلى غير ذلك.
وبالجملة لا إشكال في أصل ثبوت البداء ، إنّما الكلام في تفسيره ، وقد يفترى على الشيعة الإماميّة بأنّهم يعتقدون بأنّ البداء في الله هو أن يظهر له ما كان مجهولاً له ، أي أنّ البداء ظهور الشيء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهل ، أو أنّه بمعنى الندامة ، مع أنّ هذا إفك عظيم وتهمة واضحة وشطط من الكلام لا يقول به من فهم من الإسلام شيئاً ، ولذا أنكر علماؤنا ذلك من الصدر الأوّل إلى اليوم خصوصاً الأكابر منهم كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد رحمهما الله ، ورواياتنا أيضاً تدلّ على امتناع هذا المعنى على الله ، مثل ما رواه أبو بصير وسماعة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « من زعم أنّ الله عزّوجلّ يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه » (٦).
فما هو التفسير الصحيح للبداء؟
إنّ معنى البداء الذي نحن نعتقده مبنيّ على آيتين من سورة الرعد ، وهما قوله تعالى : ( لِكُلِ
__________________
(١) سورة الجاثية : الآية ٣٣.
(٢) بحار الأنوار : ج ٤ ، باب البداء والنسخ ، ح ١٩.
(٣) المصدر السابق : ح ٢٠.
(٤) المصدر السابق : ح ٢٣.
(٥) المصدر السابق : ح ٢٤.
(٦) المصدر السابق : ح ٣٠.
أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) (١) ، وهو يشبه النسخ بناءً على مذهب المشهور من أنّ حقيقته هو الدفع لا الرفع ، أي أنّ النسخ بمعنى انتهاء أمد الحكم وأنّ الله يظهر فيه ما كان مجهولاً للناس وهو يتصوّر بعد حضور وقت العمل بالحكم المنسوخ إلاّفي الأوامر الإمتحانيّة فيتصوّر فيها قبل حضور وقت العمل أيضاً كما مرّ.
فالبداء أيضاً كذلك ، فيتصوّر في الأوامر الإمتحانية قبل العمل كما إذا فرضنا مثلاً أنّ أمر إبراهيم بذبح إبنه صدر على نهج القضيّة الخيريّة ، فكأنّه حينئذٍ صدر بعنوان الإخبار عن أمر تكويني سوف يتحقّق في المستقبل ثمّ بدا له بقوله تعالى : ( قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ) ، وفي غير الإمتحان مثل ما وقع في قضية يونس عليهالسلام من وعده تعالى بالعذاب على قومه ثمّ كشفه عنهم بعد أن آمنوا ، فهو في كلا القسمين ليس بمعنى ظهور ما خفى عليه بل بمعنى إبداء شرط أو مانع أخفاه في بدو الأمر ، فهو تعالى يخبر عن وقوع أمر معلّق على شرط أو عدم مانع من دون التصريح بالمعلّق عليه حين الإخبار ، فلا يحصل المعلّق لعدم حصول المعلّق عليه وذلك لحكمة تقتضي ذلك ، ثمّ يبدي ما لم يذكره أوّلاً ، فالبداء بتعبير عقلي يرجع إلى العلل المركّبة التي تتصوّر فيها علّة تامّة وعلّة ناقصة ، فيرجع إمّا إلى عدم حصول المقتضي أو وجود المانع ، وفي لسان الشرع يرجع إلى مسألة المحو أو الإثبات ، فقد ثبت أنّ لله تعالى كتابين : أحدهما : امّ الكتاب الذي ثبت فيه جميع الامور من دون محو وإثبات ، والآخر : كتاب المحو والإثبات.
وبالجملة ، البداء ليس بمعنى ظهور ما خفى عليه تعالى كما يدلّ عليه قوله : ( وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ) (٢) حيث جاء في التفسير أنّ اليهود قالوا قد فزع الله من الأمر لا يحدث الله غير ما قدّره في التقدير الأوّل ( وأنّه قد جفّ القلم بما هو كائن ) فردّ الله عليهم بقوله : بل يداه مبسوطتان ، ومن الآيات الدالّة على أصل وجود البداء وصحّته قوله تعالى : ( وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ) (٣).
وهذا المعنى تدلّ عليه أيضاً روايات الأئمّة المعصومين عليهمالسلام وهي كما قلنا كثيرة كما مرّت
__________________
(١) سورة الرعد : الآية ٣٨ و ٣٩.
(٢) سورة المائدة : الآية ٦٤.
(٣) سورة فاطر : الآية ١١.
جملة منها في صدر البحث ، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها الآخر التي تشير أيضاً إلى بعض مصاديق البداء الواقعة في الامم الماضية.
١ ـ ما رواه حسن بن محمّد النوفلي قال : قال الرضا لسليمان المروزيّ : ما أنكرت من البداء ياسليمان والله عزّوجلّ يقول : ( أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئاً ) ويقول عزّوجلّ : ( وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ) ويقول : ( بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ) ويقول عزّوجلّ : ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ) ويقول : ( وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ) ويقول عزّوجلّ : ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِامْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) ويقول : ( وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ) قال سليمان : هل رويت فيه عن آبائك شيئاً؟
قال : نعم رويت عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : إنّ لله عزّوجلّ علمين : علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إلاّهو من ذلك يكون البداء ، وعلماً علّمه ملائكته ورسله ، فالعلماء من أهل بيت نبيّك يعلمونه ، قال سليمان : أحبّ أن تنزعه لي من كتاب الله عزّوجلّ ، قال : قول الله عزّوجلّ لنبيّه : ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ) أراد هلاكهم ثمّ بدا فقال : ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) قال سليمان : زدني جعلت فداك ، قال الرضا عليهالسلام : لقد أخبرني أبي عن آبائه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الله عزّوجلّ أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان الملك أنّي متوفّيه إلى كذا وكذا فأتاه ذلك النبي ... إلى آخر الحديث » (١).
٢ ـ ما رواه أبو بصير ( وهو المعروف بقصّة العروس ) قال : سمعت أبا عبدالله الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلام يقول : إنّ عيسى روح الله مرّ بقوم مجلبين فقال : ما لهؤلاء؟ قيل : ياروح الله ، إنّ فلانة بنت فلان تهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه. قال : يجلبون اليوم ويبكون غداً. فقال قائل منهم : ولِمَ يارسول الله؟ قال : لأنّ صاحبتهم ميّتة في ليلتها هذه ، فقال القائلون بمقالته : صدق الله وصدق رسوله ، وقال أهل النفاق ما أقرب غداً. فلمّا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء فقالوا : ياروح الله إنّ التي أخبرتنا أمس أنّها ميتة لم تمت. فقال : عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام : يفعل الله ما يشاء فاذهبوا بنا إليها ، فذهبوا يتسابقون حتّى قرعوا الباب ، فخرج زوجها فقال له عيسى عليهالسلام : استأذن لي على صاحبتك قال : فدخل عليها
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٤ ، باب البداء والنسخ ، ح ٢.
فأخبرها أنّ روح الله وكلمته بالباب مع عدّة قال : فتخدّرت فدخل عليها فقال لها : ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت لم أصنع شيئاً إلاّوقد كنت أصنعه فيما مضى أنّه كان يعترينا سائل في كلّ ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها وأنّه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغل فهتف فلم يجبه أحد ثمّ هتف فلم يجب حتّى هتف مراراً فلمّا سمعت مقالته قمت متنكّرة حتّى نلته كما كنّا ننيله فقال لها : تنحّي عن مجلسك فإذا تحت ثيابها افعى مثل جذعة عاضّ على ذنبه فقال عليهالسلام : بما صنعت صرف عنك هذا » (١).
تنبيهان
الأوّل : إنّ فلسفة البداء وحكمته عدم القعود عن السعي والجهاد وأن لا نيأس من رحمة الله وإرائته للطريق وهدايته السبل ، ومن جانب آخر أن لا نأمّن أنفسنا من سخطه وعذابه ، ولا نقول : قد جفّ القلم وأنّه لا يحدث الله غير ما قدّره في التقدير الأوّل بل نقول أنّه يمحو ما يشاء ويثبت ، فلا يخفى أنّ هذه العقيدة وهذه الحالة تورثنا وتكّمل لنا حالة الخوف والرجاء بحيث لو صدر عنّا ذنب رجونا العفو والمغفرة ، كما أنّه لو صدرت عنّا خيرات بالغة وحسنات كثيرة خفنا من سوء العاقبة ، وبالجملة أنّ حكمة البداء وفلسفته هي إيقاع العبد بين حالة الخوف والرجاء ، ونتيجته دوام السعي والحركة والعمل مع احتمال الخطأ والمخالفة والوقوع في المهلكة.
الثاني : أنّ إنكار البداء يستلزم إنكار عدّة من المسائل المسلّمة والاعتقادات الضروريّة في الإسلام أو ما أشبه ذلك كمسألة التوبة ، ومسألة الحبط في الأعمال وأنّ الحسنات يذهبن السيّئات ، ومسألة الشفاعة ، وتأثير الدعاء ، وتأثير صلة الرحم وقطعها في إزدياد العمر ونقصانه ، ودفع البلاء بالصدقة ( وقد ورد في الحديث أنّ الصدقة ترفع البلاء المبرم وهو البلاء الذي كتب بالقلم في امّ الكتاب ).
إلى هنا تمّ الكلام عن المقصد الرابع من مباحث الاصول.
__________________
(١) بحارالانوار : ج ٤ ، باب البداء والنسخ ، ح ١.
المقصد الخامس
المطلق والمقيّد
٥ ـ المطلق والمقيّد
وقبل الورود في أصل البحث لابدّ من بيان مقدّمات :
المقدمة الاولى : في تعريف المطلق والمقيّد
نسب إلى المشهور « أنّ المطلق ما دلّ على شائع في جنسه » وحيث إن كلمة « ما » الموصولة في هذا التعريف كناية عن اللفظ يكون المطلق والمقيّد حينئذٍ من صفات اللفظ.
وإستشكل عليه جماعة تارةً بأنّ الإطلاق والتقييد من صفات المعنى لا اللفظ ، واخرى بعدم شموله للألفاظ الدالّة على نفس الماهيّة من دون شيوع كأسماء الأجناس مع أنّهم عدّوا أسامي الأجناس من المطلق ، وثالثة بعدم منعه ، لشموله كلمة « من وما وأيّ » الاستفهاميّة من باب دلالتها أيضاً على العموم البدلي وضعاً مع أنّها ليست من أفراد المطلق.
والمحقّق الخراساني رحمهالله ذهب في المقام أيضاً ( من دون أن يتعرّض لبيان هذه الإشكالات ) إلى ما نبّه عليه في مقامات عديدة وهو أنّ مثل هذا التعريف من تعاريف شرح الاسم لا التعريف الحقيقي حتّى يكون في مجال النقض والإبرام.
ونحن أيضاً ننبّه هنا على ما بيّناه غير مرّة من الجواب وأنّ المراد من التعريف الحقيقي في أمثال المقام ليس التعريف بالجنس والفصل بل المراد منه ما يكون جامعاً ومانعاً ، ولا يخفى إمكان هذا النحو من التعريف وضرورته للمبتدي في العلم لأن يتّضح له الطريق الذي يسلكه ويحيط بأفراد ذلك الموضوع وأغياره ، وقلنا أنّ نفس الإشكالات في جانبي الطرد والعكس في كلمات القوم أقوى شاهد بأنّهم في صدد بيان التعريف الحقيقي بالمعنى الذي ذكرنا.
وبالجملة يجاب عن الإيراد على تعريف المشهور بالنسبة إلى :
الإشكال الثاني : بأنّ الشيوع له معنيان : أحدهما : الشيوع بمعنى العموم ، وحينئذٍ يرد عليه
هذا الإشكال ، وهو عدم شمول التعريف لأنّ الجنس لأنّه ليس للجنس شيوع بل وكذا النكرة ، ثانيهما : السريان والعموم بعد ضمّ مقدّمات الحكمة ولا إشكال في وجود هذا المعنى في اسم الجنس والنكرة.
وأمّا الإشكال الثالث : فيردّ بأنّ كلمة « من وما وأي » الاستفهاميّة ليست من الأغيار بل نحن نلتزم بأنّها أيضاً من أفراد المطلق.
وأمّا الإشكال الأوّل : فيندفع بأنّه كما أنّ المعنى يتّصف بصفة الإطلاق والتقييد ، كذلك اللفظ أيضاً يتّصف بهما بلحاظ كونه مرآة للمعنى وكاشفاً عنه.
لكن مع ذلك كلّه يمكن لنا إرائة تعريف أوضح وأسهل من تعريف المشهور ، بأن ننظر إلى المعنى اللغوي للمطلق ونقول : المطلق ما لا قيد فيه من المعاني أو الألفاظ ، والمقيّد ما فيه قيد ، وبعبارة اخرى : أنّ المطلق في مصطلح الاصوليين نفس ما ذكر في اللغة وهو ما يكون مرسلاً وسارياً بلا قيد.
ومن هنا يظهر أنّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيان ، لأنّه ربّما يكون معنى مقيّداً بالنسبة إلى معنى آخر وفي نفس الوقت يعدّ مطلقاً بالنسبة إلى معنى ثالث ، كالرقبة المؤمنة ، فإنّها مقيّدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة بينما هي مطلقة بالنسبة إلى الرقبة المؤمنة العادلة.
المقدمة الثانية : في شموليّة الإطلاق
إنّ المطلق ـ كما سيأتي ـ يفيد العموم والشمول ببركة مقدّمات الحكمة وهذا الشمول على ثلاثة أقسام ، لأنّه قد يكون بدليّاً وقد يكون استغراقياً وقد يكون مجموعياً ، فلا يصحّ ما ربّما يتوهّم من أنّ المطلق إنّما يدلّ على الشمول البدلي دائماً ، لأنّ كلمة البيع أو الماء مثلاً في قوله تعالى : « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وقوله عليهالسلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء » مطلق مع أنّه يفيد العموم الاستغراقي ، وكلمة العالم في قضيّة « أكرم العالم » أيضاً مطلق مع أنّه قد يكون الشمول فيه مجموعياً ، نعم أنّه يتوقّف على قيام قرينة على أنّ المقصود فيه مجموع العلماء من حيث المجموع.
المقدمة الثالثة : الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة
أنّ الإطلاق والتقييد كما اشير إليه آنفاً ليسا أمرين وجوديّين في الخارج بل هما من الامور
الذهنيّة ، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة فالمطلق ما من شأنه أن يكون مقيّداً وبالعكس.
المقدّمة الرابعة : في مصبّ الإطلاق
ما أفاده في تهذيب الاصول من أنّ مصبّ الإطلاق أعمّ من الطبائع والأعلام الشخصية وتجد الثاني في أبواب الحجّ كثيراً ، في الطواف على البيت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر (١).
أقول : كأنّه وقع الخلط بين نفس الكعبة ومنى والمشعر الحرام وبين الأفعال القائمة بها فهذه المواقف العظيمة وإن كانت اموراً جزئيّة شخصية ولكنّ الأفعال القائمة بها كالطواف والوقوف امور كلّية تصدق على كثيرين ويأتي فيها الإطلاق والتقييد ، فليس الإطلاق والتقييد وصفين لها بل هما وصفان لتلك الأفعال الكلّية.
إذا عرفت هذا فلنشرع في أصل مباحث المطلق والمقيّد فهيهنا مقامات :
المقام الأوّل : في الألفاظ التي يرد عليها الإطلاق
أحدها : « اسم الجنس »
وليس المراد منه معناه المنطقي بل المراد منه في المقام ما يقابل العلم الشخصي ، فيشمل الجواهر والأعراض والامور الاعتباريّة كلّها.
والمشهور أنّ الموضوع له فيه هو الماهيّة ، والماهيّة على أربعة أقسام : الماهيّة بشرط لا ، والماهيّة بشرط شيء ، ( وليس اسم الجنس واحداً منهما قطعاً ) ، والماهيّة اللابشرط القسمي ، والماهيّة اللاّبشرط المقسمي ، والفرق بينهما واضح لأنّ الأوّل ما كان اللحاظ فيه جزء الموضوع له ، والثاني عبارة عن ما ليس مشروطاً بشيء حتّى لحاظ أنّها لا بشرط.
ولا ينبغي الشكّ في أنّ المراد من المطلق هو اللاّبشرط المقسمي لأنّ اللاّبشرط القسمي
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٦٣ ، طبع مهر.
موطنه دائماً هو الذهن هوعاء الاشتراط باللاّبشرطيّة إنّما هو الذهن ، وهو يستلزم عدم صحّة حمل المطلق مثل الإنسان على الخارج حقيقة ، فيكون مثل « زيد إنسان » حينئذٍ مجازاً ، ويستلزم أيضاً عدم صحّة الأخبار عن الخارج نحو جاءني إنسان ، وكذلك عدم صحّة الأمر نحو « جئني بإنسان » فيتعيّن أن يكون الموضوع له اللاّبشرط المقسمي أي القدر الجامع بين الأقسام الثلاثة ، الذي يكون مرآة للخارج.
بقي هنا شيء :
وهو أنّ ما اشتهر في كلماتهم ( بل لعلّه كالمتسالم عليه ) من أنّ الموضوع له في أسماء الأجناس هو الماهيّة من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ، فإنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه عند الدقّة بل الموضوع له هو الموجود الخارجي ، لأنّه المتبادر من إطلاق مثل الإنسان والشجر وغيرهما ، فيتبادر عند إطلاق الإنسان والشجر إنسان خارجي وشجر خارجي ، غاية الأمر إنسان لا بعينه وشجر لا بعينه ، ومن أنكر هذا أنكره بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ، بل يدلّ عليه حكمة الوضع كما مرّ بيانه غير مرّة فإن قد مرّ من أنّ الناس في حياتهم الاعتياديّة لا حاجة لهم إلى الماهيات المطلقة حتّى يضعون الألفاظ بإزائها بل حاجاتهم تمسّ الوجودات الخارجيّة ، فبموازات حاجاتهم إلى المعاني الخارجيّة يضعون الألفاظ.
هذا ، مضافاً إلى وجود صحّة السلب في المقام ، فيصحّ أن يقال : « الإنسان الذهني ليس بإنسان » أو « أنّ النار الذهنية ليست ناراً حقيقة بل النار ذلك الوجود الخارجي الذي يحرق الأشياء » والماء هو « الموجود الخارجي الذي يروي العطشان ».
إن قلت : فما تقول في قضية « الإنسان موجود » أو « الإنسان معدوم » أو « لم يكن الحجر موجوداً ثمّ صار موجوداً »؟ حيث إنّه لو كان المراد من الحجر مثلاً الحجر الموجود يصير معنى الجملة هكذا : كان الحجر الموجود معدوماً ثمّ صار موجوداً فيلزم التناقض أو يلزم حمل الشيء على نفسه في مثل الإنسان موجود لأنّ المعنى فيه يصير هكذا : الإنسان الموجود موجود.
قلنا : يعمل في مثل هذه الموارد عمل التجريد بلا ريب وإلاّ فما تقول في الأعلام الشخصية التي لا إشكال في أنّها وضعت للموجودات الخارجيّة ، فإنّ كلمة زيد مثلاً وضع لزيد الموجود
المتولّد في تاريخ كذا وكذا بلا خلاف ، فما تقول فيها إذا اطلقت واريد منها الماهيّة كما إذا قيل « زيد كان معدوماً ثمّ تولّد ».
إن قلت : الوجود مساوق للتشخّص والجزئيّة وهو ينافي كلّية اسم الجنس.
قلنا : المراد من الوجود هنا هو الوجود السعي وهو لا ينافي الكلّية لأنّه قدر جامع بين الوجودات الجزئيّة الخارجيّة ويكون وعائه الذهن لكن بما أنّه مرآة ومشير إلى تلك الوجودات ، وإن أبيت عن ذلك فاختبر نفسك عند طلب الماء مثلاً أو انظر إلى ظمآن بقيعة يطلب الماء ، فلا ريب في أنّه يطلب الماء الخارجي لا ماهيّته مع أنّه ليس في طلب ماء مشخّص معيّن بل يطلب مطلق الماء الخارجي أو جنس الماء الخارجي بوجوده السعي ، وليس المراد من الوجود السعي إلاّهذا.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الموضوع له في أسماء الأجناس هو الماهيات الموجودة في الخارج بوجودها السعي واتّضح أيضاً أنّ اسم الجنس قابل لأنّ يكون مصبّ الإطلاق والتقييد.
ثانيها : « علم الجنس »
وفيه مذهبان :
المذهب الأوّل : ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ حال علم الجنس كحال اسم الجنس عيناً فإنّ علم الجنس أيضاً موضوع عنده لنفس المعنى بما هو هو من دون لحاظ تعيّنه وتميّزه في الذهن من بين سائر المعاني حتّى يكون معرفة بسببه ، بل تعريفه لفظي ، أي يعامل معه معاملة المعرفة وهو نظير التأنيث اللفظي.
وأورد عليه كثير من الأعلام بأنّ الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ماهوي فإن اسم الجنس وضع لنفس الطبيعة بما هي هي ، وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متعيّنة متميّزة في الذهن من بين سائر الأجناس.
ولكن يرد على إيرادهم أنّه إن كان المراد من التميّز في الذهن فهذا يستلزم كون جميع أسامي الأجناس من أعلام الجنس لأنّ التميّز الذهني حاصل في جميعها ، مضافاً إلى أنّه ممّا لا محصّل له
لأنّ التميّز حاصل على كلّ حال ، وإن كان المراد من التميّز اللحاظ الذهني ، أي أنّ الاسامة مثلاً وضعت لذلك الحيوان المفترس بلحاظ أنّه ليس الشجر أو الحجر وغيرهما ، أي أنّه مقيّد بهذا اللحاظ.
ففيه :
أوّلاً أنّه يستلزم عدم انطباق علم الجنس على الخارج إلاّبالتجريد أو قبول المجازية وكلاهما منفيّان بحكم الوجدان.
وثانياً : ما حكمة الواضع حينئذٍ في وضعه وأي مشكلة أراد حلّها به؟ خصوصاً إذا كان الواضع عامّة الناس فما هو داعي الأفراد العاديين من الناس في وضعهم مثل لفظ الاسامة على هذا النحو.
المذهب الثاني : ما ذهب إليه في تهذيب الاصول فإنّه قال : « اسم الجنس موضوع لنفس الماهيّة وعلم الجنس للطبيعة بما هي متميّزة من عند نفسها بين المفاهيم وليس هذا التميّز والتعيّن متقوّماً باللحاظ بل بعض المعاني بحسب الواقع معروف معيّن وبعضها منكور غير معيّن » (١).
أقول : إن كان مراده من التعبير بالواقع هو الذهن وعام اللحاظ فيرد عليه نفس ما مرّ آنفاً من الإشكالات ، مع أنّه بنفسه أيضاً صرّح بعدمه ، وإن كان المراد منه هو الخارج فلا نعرف لما ذكره من الفرق مفهوماً محصّلاً ولعلّ القصور منّا.
وقال المحقّق الإصفهاني رحمهالله في التعليقة : أنّ في الفصول تبعاً للسيّد الشريف إرادة التعيّن الجنسي ، بيانه : « إنّ كلّ معنى طبيعي فهو بنفسه متعيّن وممتاز عن غيره وهذا وصف ذاتي له ، فاللفظ ربّما يوضع لذات المتعيّن والممتاز كالأسد واخرى للمتعيّن الممتاز بما هو كذلك كالاسامة » (٢).
أقول : إنّ ما أفاده قدسسره لا يبعد صحّته ولا أقلّ من الاحتمال ، وحينئذٍ الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس نظير الفرق بين زيد والرجل من بعض الجهات ، فكما أنّه لا نظر في وضع الرجل لافراد الإنسان إلى التشخّصات الفرديّة والتعيّنات الخارجيّة وأنّ الفرد الفلان تولّد في أيّ
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٦٩ ، طبع مهر.
(٢) نهاية الدراية : ج ١ ، ص ٣٥٤ ، الطبع القديم.