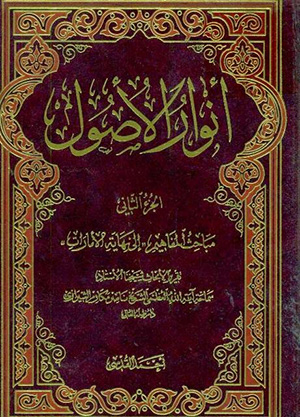الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-8139-14-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
للطلب الحقيقي أو لإنشاء مطلق الطلب ولو لم يكن بداعي الطلب الحقيقي كما إذا صدر بداعي التعجيز أو التهديد؟
واستدلّ لوضعها لإنشاء مطلق التخاطب بوجهين :
أحدهما : أنّه كذلك في أشباهها ونظائرها كأداة النداء وضمائر التخاطب فإنّها موضوعة لإنشاء مطلق التخاطب ولايقاع مجرّد المخاطبة سواء كان مع المخاطب الحقيقي أو التنزيلي.
الثاني : أنّ الوجدان حاكم على أنّ في مثل « ياكوكباً ما كان أقصر عمره » الذي ليس المخاطب فيه حقيقيّاً لعدم كونه حاضراً ملتفتاً ـ ليس هناك تجوّز في أداة الخطاب أصلاً بل هي مستعملة في معناها الحقيقي من إنشاء النداء والخطاب ، فليس فيها عناية ولا مجاز بالنسبة إلى أداة الخطاب ، ثمّ قال ما حاصله : أنّ هذا كلّه فيما إذا لم تكن قرينة في البين توجب الانصراف إلى الخطاب الحقيقي كما هو الحال في حروف الإستفهام والترجّي والتمنّي وغيرها ، وفي نهاية الأمر قال ما حاصله : أنّ هذا الظهور الانصرافي ناشٍ عن عدم قرينة تمنع عن الانصراف المزبور ، وإلاّ إذا كان هناك ما يمنع عن الانصراف إلى المعاني الحقيقيّة كما يمكن دعوى وجوده غالباً في كلام الشارع فلا تختصّ هذه الأداة بالخطاب الحقيقي.
أقول : يرد عليه :
أوّلاً : أنّه قال : إن كان الموضوع له هو الخطاب الحقيقي فلا يشمل المعدومين ، بينما لا إشكال في الشمول على فرض الوجود كما مرّ.
ثانياً : أنّه قال : إن كان الموضوع له هو الخطاب الإنشائي فيشمل المعدومين ، بينما لا إشكال أيضاً في عدم الشمول على فرض العدم.
ثالثاً : لو فرضنا عدم شمول الخطاب للمعدومين فلا ضير فيه ، لأنّه لا ريب في شمول التكليف لهم لوجود أدلّة الاشتراك في التكليف ، ولا حاجة في ثبوت التكليف إلى توجيه الخطاب إليهم ولا ملازمة بين الأمرين.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمهالله قال : إنّ القضايا الخارجيّة مختصّة بالمشافهين ولا تشمل الغائبين والمعدومين ، وأمّا القضايا الحقيقيّة فالظاهر أنّ الخطابات فيها عامّة.
واستدلّ له بأنّ توجيه الخطاب إلى الغائب لا يحتاج إلى أكثر من تنزيله منزلة الحاضر ، وكذلك بالنسبة إلى المعدوم فينزّل منزلة الموجود ، ثمّ قال : هذا المعنى هو مقتضى طبيعة القضيّة الحقيقيّة.
وأورد عليه في حاشية الأجود بأنّ مجرّد الوجود لا يكفي في الخطابات المشافهة بل تحتاج إلى فرض الحضور أيضاً والقضايا الحقيقيّة تفرض لنا الوجود فقط.
ثمّ حاول لحلّ الإشكال ، فذهب إلى ما بنى عليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ الأدوات وضعت للخطاب الإنشائي ، ثمّ قال في آخر كلامه ما حاصله : هذا إذا قلنا أنّ الخطابات القرآنية خطابات من الله بلسان النبي صلىاللهعليهوآله ، أمّا إذا قلنا أنّها نزلت عليه قبل قرائته يكون هذا النزاع باطلاً من أصله لعدم وجود مخاطب غير النبي صلىاللهعليهوآله في ذلك الزمان (١).
أقول : الظاهر أنّ إشكاله على المحقّق المذكور غير وارد لما سيأتي ، مضافاً إلى أنّ الكلام هو في المنهج الذي سلكه لحلّ الإشكال ، لأنّ قوله : إنّ الأدوات وضعت للخطاب الإنشائي تبعاً للمحقّق الخراساني رحمهالله يستلزم عدم كون الخطابات القرآنيّة بداعي الخطاب الحقيقي ، وهو خلاف الوجدان وخلاف بعض الرّوايات الواردة لبيان آداب التلاوة نظير ما ورد لاستحباب ذكر « لبّيك » بعد تلاوة خطاب « يا أيّها الذين آمنوا » ، هذا أوّلاً.
ثانياً : بالنسبة إلى قوله : « إن قلنا أنّ الخطابات القرآنية نزلت على النبي قبل قرائته » ( إلى آخره ) : أنّه لا ريب في أنّها نزلت عليه قبل قرائته ، فلا ينبغي التعليق والترديد فيه بقوله « إن قلنا » ، لكن هذا لا يلازم بطلان النزاع من رأسه ، لأنّها وإن نزلت قبل قرائته صلىاللهعليهوآله لكنّه صلىاللهعليهوآله خليفة الله في مخاطبة الناس فيخاطبهم بلسان الباري تعالى.
والإشكال الأساسي في كلمات هؤلاء الأعلام أنّهم تسالموا على وجود الملازمة بين خطاب المشافهة والحضور وأنّ الحضور لازم فيها ، بينما قلنا أنّ حقيقة الخطاب هي توجيه الكلام نحو الغير مع الإيصال إليه بأيّ وسيلة.
ثمّ إنّه قد حاول في تهذيب الاصول تحليل القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة ، وقال : « إنّ هذا التقسيم للقضايا الكلّية ، وأمّا الشخصيّة مثل « زيد قائم » ممّا لا تعتبر في العلوم فخارجة عن المقسم ، فقد يكون الحكم في القضايا الكلّية على الأفراد الموجودة للعنوان بحيث لا ينطبق إلاّ عليها مثل « كلّ عالم موجود في حال كذا » أو « كلّ من في هذا العسكر كذا » وأمّا القضيّة الحقيقيّة فهي ما يكون الحكم فيها على أفراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود في الحال
__________________
(١) راجع أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤٩١.
وغيره مثل « كلّ نار حارّة » فلفظ « نار » تدلّ على نفس الطبيعة وهي قابلة للصدق على كلّ فرد لا بمعنى وضعها للأفراد ولا بمعنى كونها حاكيّة عنها أو كون الطبيعة حاكيّة عنها بل بمعنى دلالتها على الطبيعة القابلة للصدق على الافراد الموجودة وما سيوجد في ظرف الوجود ، ( إلى أن قال ) : فكلّ نار حارّة إخبار عن مصاديق النار دلالة تصديقية ، والمعدوم ليس مصداقاً للنار ولا لشيء آخر ، كما أنّ الموجود الذهني ليس ناراً بالحمل الشائع ، فينحصر الصدق على الأفراد الموجودة في ظرف وجودها من غير أن يكون الوجود قيداً ، أو أن يفرض للمعدوم وجود أو ينزل منزلة الوجود ومن غير أن تكون القضيّة متضمّنة للشرط كما تمور بها الألسن موراً » (١).
أقول : ويمكن المناقشة فيه :
أوّلاً : بأنّا لا نفهم معناً محصّلاً لقوله « فينحصر الصدق على الأفراد الموجودة في ظرف وجودها من غير أن يكون الوجود قيداً » لأنّ هذا أيضاً يساوق كون الوجود قيداً ، فإن الحارّة مثلاً في مثال « النار حارّة » إنّما هي النار الموجودة في الخارج لا النار بدون الوجود ولا النار الموجودة في الذهن ، نعم إنّ ما أفاده جارٍ في مثل « الأربعة زوج ».
ثانياً : لو لم يكن الوجود قيداً فنسأل : هل تكون القضيّة شاملة للمعدومين أو لا؟ فإن لم تكن شاملة لهم فالقضيّة خارجيّة لا حقيقيّة ، وإن كانت شاملة فيعلم أنّه فرض للمعدوم وجود ، وقد مرّ أنّ حقيقة القضيّة الشرطيّة هو فرض الوجود ، وعلى كلّ حال : القضيّة الحقيقيّة هي ما يكون الوجود قيداً فيها ، غاية الأمر أنّه أعمّ من الوجود التقديري والوجود الفعلي.
ثمّ إنّه في ما سبق أنكر الانحلال في القضايا الكلّية القانونيّة وقد أوردنا عليه بالنقض بالعموم الافرادي ، لكن في المقام له كلام صرّح فيه بالانحلال وإليك نصّه : « وليعلم أنّ الحكم في الحقيقة على الأفراد بالوجه الإجمالي وهو عنوان كلّ فرد أو جميع الأفراد ، فالحكم في المحصورة على أفراد الطبيعة بنحو الإجمال على نفس الطبيعة ولكن على الأفراد تفصيلاً » (٢).
فقد صرّح في هذا الكلام بأنّ الحكم في المحصورة يتعلّق بالمصاديق والأفراد ، بينما قد مرّ منه سابقاً أنّ الحكم في القضايا القانونيّة يتعلّق بالطبيعة فقط.
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٤٢ ـ ٤٣ ، طبع مهر.
(٢) المصدر السابق : ص ٤٣ ـ ٤٤ ، طبع مهر.
فظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة تفصيل المحقّق النائيني رحمهالله في الخطابات الشفاهيّة بين القضايا الحقيقيّة والخارجيّة بأنّ الاولى تشمل الغائب والمعدوم والثانية لا تشملهما ، لأنّ حقيقة الخطاب وهي توجيه الكلام إلى الغير موجودة في كلتا القضيتين ، وقد ردّ تفصيله في تهذيب الاصول بعد ذكر مقدّمات فكلامه تامّ من هذه الجهة.
هذا كلّه في التفصيل بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة.
وهنا تفصيل آخر وهو بين الخطابات الإلهية وغير الإلهية ، ببيان أنّ الاولى شاملة للغائبين والمعدومين ، لأنّ الله محيط بكلّ شيء وكلّ شيء حاضر عنده بخلاف الثانية.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّه يعتبر في الخطاب ثلاثة أشياء : المخاطب ( بالكسر ) والمخاطب ( بالفتح ) وأداة الخطاب ، وفي الخطابات الإلهية وإن لم يكن نقص بالنسبة إلى الأمر الأوّل ، أي المخاطب ( بالكسر ) ولكنّه موجود بالنسبة إلى الأمر الثاني والثالث.
وللمحقّق الإصفهاني رحمهالله هنا تفصيل في هذا التفصيل ، وهو أنّ الخطابات الإلهيّة تشمل الغائبين دون المعدومين ، وأمّا الخطابات البشريّة فلا تشمل المعدومين والغائبين معاً ، والدليل هو إحاطته تعالى بالغائبين ، وأمّا عدم حضورهم وعدم فهمهم لخطابه فلا ضير فيه بل اللازم هو نوع اجتماع بين المخاطِب والمخاطَب إمّا في مكان واحد أو بحكمه أو الإحاطة الإلهية (١).
أقول : هنا مطلبان :
الأوّل : أنّه لابدّ في صحّة الخطاب وكونه حقيقياً الإفهام والإنفهام ولو في ظرف وصوله ( وإلاّ يكون إنشائيّاً ) من دون الفرق بين الخطابات الإلهية وغيرها ، والحاكم بهذا هو العرف والوجدان.
الثاني : في المقصود من إحاطة الله بالمعدومين : فقد قرّر في محلّه أنّ عدم علمه بالمعدومين يوجب النقص في ذاته تبارك وتعالى عن ذلك ولكن قد يستشكل بأنّ علمه بهم إمّا أن يكون حصولياً وارتسامياً أو يكون حضوريّاً ، والأوّل محال لاستلزامه الارتسام في ذاته ، مضافاً إلى أنّه لا إشكال في أنّ علمه بالأشياء يكون بذاتها لا بصورتها ، وإن كان حضوريّاً فلا يشمل المعدومين لأنّهم ليسوا موجودين حتّى يكونوا حاضرين عنده تعالى.
__________________
(١) راجع نهاية الدراية : ج ١ ، ص ٣٤٧.
وللجواب عنه كما بيّناه في محلّه طريقان :
الأوّل : ما ذهب إليه بعض الحكماء من أنّ الله تعالى عالم بالعلّة ، والعلم بالعلّة علم إجمالي بالنسبة إلى المعلول وهو كشف تفصيلي في نفس الوقت.
توضيح ذلك : أنّ الحوادث التي تتحقّق في المستقبل ليست منفكّة عن حوادث الحال والماضي فإنّها سلسلة متّصلة بعضها ببعض ، فلو علمنا بحوادث الحال كما هو حقّها وبجميع جزئياتها فقد علمنا حوادث الماضي والمستقبل أيضاً في نفس الوقت ، وبما أن علمه تعالى بالأشياء يكون هكذا فهو عالم بالموجودين في الحال والمعدومين في الماضي والمستقبل جميعاً.
الثاني : ( وقد يصعب تصوّره على بعض ) أن نقول : أنّ تقسيم الزمان إلى الحال والماضي والمستقبل إنّما هو بالنسبة إلى الممكنات ، وأمّا بالنسبة إلى ذاته تعالى الذي لا حدّ ولا نهاية له فجميع الموجودات في الماضي والمستقبل والحال سواء عنده ، حاضرة لديه بأعيانها لكن كلّ في ظرفه الخاصّ ، فموسى عليهالسلام مثلاً حاضر عنده في ظرفه وزمانه الخاصّ كما أنّ عيسى عليهالسلام أيضاً حاضر عنده في ظرفه الخاصّ ، وأهل الجنّة والجحيم حاضرون عنده في ظرفهما ، فلا شيء من هذه معدوم عنده تعالى بل المعدوم معدوم بالنسبة إلى زمان الحال.
وبعبارة اخرى : أنّ الزمان بمنزلة شريط يتحرّك الإنسان عليه فعلى أي جزء منه كان فهو حال بالنسبة إليه والجزء السابق عليه ماضٍ والجزء اللاحق مستقبل ، وأمّا الذي يكون محيطاً بجميع الشريط من أوّله إلى آخره فالحال والماضي والمستقبل عنده سواء.
وقد يذكر لهذا مثال آخر وهو أنّ من يتصوّر للزمان حالاً وماضياً ومستقبلاً مثله مثل من ينظر من منفذ بيت إلى قطار من الإبل خارج البيت ، فحيث إنّه يرى في كلّ لحظة من الزمان بعض هذه الجمال يتصوّر له القبل والبعد ، وأمّا من يكون فوق البيت مثلاً ويرى جميع القطار في لحظة واحدة فلا معنى لهذا التقسيم بالنسبة إليه.
فبأحد هذين الطريقين يثبت حضور المعدومين عند الله تعالى ، ولكن مع ذلك لا يثبت بهذه المحاولات إمكان تفيهم المعدومين من طرق الخطابات المشافهة المتعارفة ، وبهذا يظهر أنّه لا وجه للتفصيل بين الخطابات الإلهية وغيرها.
تنبيه في ثمرة المسألة :
وقد ذكر لها ثمرتان ، وينبغي قبل بيانهما الإشارة إلى أنّ الثمرة في هذه المسألة لا تظهر بالإضافة إلى التكاليف التي صدرت من الشارع بغير أداة الخطاب لكفاية أدلّة اشتراك التكليف فيها بعد عدم اختصاصها بالموجودين في عصر النبي صلىاللهعليهوآله.
الثمرة الاولى : حجّية ظهور الخطابات المشافهة للغائبين والمعدومين كالمشافهين على القول بالتعميم ، وإلاّ فلا يكون ذلك حجّة بالنسبة إليهم ، وهي مبنيّة على صغرى وكبرى ، أمّا الكبرى فهي اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه ، وأمّا الصغرى فهي أنّ غير المشافهين ليسوا مقصودين بالإفهام.
والأكثر استشكلوا على الكبرى فقط ، ولكن يمكن الإشكال أيضاً على الصغرى.
أمّا الإشكال على الكبرى فهو أنّه مبني على اختصاص حجّية الظواهر بالمقصودين بالإفهام وقد حقّق في محلّه عدم الاختصاص بهم ، وسيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله تعالى.
وأمّا الإشكال على الصغرى فهو أنّ الملازمة بين التخاطب والمقصوديّة بالإفهام ممنوع بل الظاهر أنّ الناس كلّهم إلى يوم القيامة مقصودون بالإفهام وإن لم يعمّهم الخطاب.
أقول : وهذا أشبه شيء بالنداءات التي تطبع في الصحف التي يكون المخاطب فيها شخص أو أشخاص معيّنين مع أنّ المقصود بالإفهام فيها جميع الناس ، بل قد يتّفق عدم كون المخاطب مقصوداً ويكون المقصود غير المخاطب من باب « إيّاك أعني واسمعي ياجارة ». فتلخّص من جميع ذلك عدم تماميّة هذه الثمرة.
لكن يمكن توجيه هذه الثمرة من حيث الصغرى والكبرى ، أمّا الكبرى فلأنّ وظيفة المتكلّم إنّما هي إقامة القرائن للمقصودين بالإفهام فقط وليس من وظيفته إقامتها لمن لم يقصد إفهامه ، وحينئذٍ لو احتملنا ( احتمالاً عقلائياً ) وجود قرينة في البين قد ذكرها المتكلّم للمقصودين بالإفهام ولم تصل إلى غيرهم كما إذا قال المتكلّم مثلاً : « اشتر لي جنساً من الأجناس الموجودة في السوق الفلاني » واحتملنا وجود قرينة في البين قد فقدت وكانت دالّة على أنّ مراد المتكلّم جنس خاصّ من تلك الأجناس ، فحينئذٍ يشكل القول بحجّية كلامه وجواز التمسّك بإطلاقه لغير المقصودين بالإفهام مشكل جدّاً.
نعم ، لو لم يكن هناك قرينة في البين أخذ بظهوره كلّ من وصل إليه كما يحكى ذلك في قضية
كتاب كتبه عثمان لعامله في مصر وأشار إلى قتل الذين أتوا بالكتاب ، فإنّ المخاطب وإن كان هو العامل فقط ولكنّهم لمّا فتحوا الكتاب وشاهدوا ما كتبه رجعوا إليه ووقع ما وقع ، ولم يقل أحد منهم أنّ ظهور الكتاب ليس حجّة بالنسبة إليهم للعلم بعدم وجود قرينة هناك.
أمّا الصغرى فلأنّا وإن وافقنا على وجود خطابات كثيرة ( بل أكثر الخطابات الشرعيّة ) يكون غير المخاطبين فيها أيضاً مقصودين بالإفهام لكن إثباته في جميع موارد الأدلّة الشرعيّة مشكل ( وإن كان جميع الخطابات القرآنيّة هكذا بلا إشكال ) فإنّ في الرّوايات الواردة من ناحية النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام توجد موارد كثيرة التي يحتمل فيها كون المقصود بالإفهام خصوص المخاطبين كالروايات وردت بصيغة « يا أصحابي » مثلاً.
فظهر ممّا ذكرنا ثبوت الملازمة بين الخطاب قصد الإفهام بنحو الموجبة الجزئيّة ، فلو قلنا بعدم شمول الخطابات الشرعيّة لغير المشافهين يشكل إثبات كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام في جميع الموارد ، ويستلزم عدم حجّية بعض الخطابات بالنسبة إليهم.
الثمرة الثانية : صحّة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة وشبهها بناءً على التعميم ، وعدمها بناءً على عدمه.
توضيح ذلك : إن قلنا بشمول الخطابات للمعدومين جاز لهم التمسّك بإطلاقات الكتاب نحو إطلاق قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) مثلاً مطلقاً وإن كان غير المشافهين مخالفين في الصنف مع المشافهين ، كما أنّ التمسّك بها كذلك جائز للموجودين ، وإن قلنا بعدم شمولها لهم فلا يجوز لهم التمسّك بها أصلاً ، فإنّ التمسّك بالإطلاق فرع توجّه الخطاب ، فإذا لم يتمسّك بالإطلاق فلا يبقى في البين سوى دليل الاشتراك ، ولا دليل على الاشتراك إلاّ الإجماع وهو دليل لبّي لا إطلاق له ، فلا يثبت به الحكم إلاّ القدر المتيقّن منه ، وهو موارد اتّحاد الصنف ، وحيث لا اتّحاد في الصنف للمعدومين في فرض الكلام فلا دليل على الحكم أصلاً ، كما إذا احتملنا دخالة حضور الإمام المبسوط اليد في وجوب صلاة الجمعة ، فلا يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ) لإثبات وجوبها في زمن الغيبة لعدم اتّحادهم مع المشافهين في الصنف.
وأجاب عن هذه الثمرة المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية بما حاصله : أنّ مع عدم عموم الخطاب للمعدومين وإن لم يصحّ لهم التمسّك بإطلاقه لرفع دخالة ما شكّ في دخله ممّا كان
المعدومون فاقدين له وكان المشافهون واجدين له ، ولكن صحّ التمسّك بإطلاقه لرفع دخالته في حقّ المشافهين قطعاً بأن يقال : إنّ صلاة الجمعة مثلاً واجبة عليهم مطلقاً سواء كانوا حاضرين في زمان الإمام المبسوط اليد وواجدين لشرط الحضور والاتّحاد في الصنف أم صاروا فاقدين له بالخروج عن حوزة الحكومة الإسلاميّة كالذين هاجروا إلى الحبشة مثلاً أو بفوت الإمام المبسوط اليد والانتقال إلى الفترة الفاقدة لحكومة العدل بعد النبي صلىاللهعليهوآله ، وحينئذٍ إذا ثبت عدم دخل القيد في حقّهم بالإطلاق ثبت في حقّ المعدومين بدليل الاشتراك ، فالفرق بين عموم الخطاب للمعدومين وعدمه إنّما هو في الحاجة إلى ضمّ دليل الاشتراك وعدمها ، فإن كان الخطاب يعمّ المعدومين فلا حاجة إلى ضمّ دليل الاشتراك بل يتمسّكون بالإطلاق ابتداءً ، وإن لم يكن الخطاب عاماً لهم لابدّ من ضمّ دليل الاشتراك حيث إن التمسّك بالإطلاق يكون حينئذٍ في حقّ المشافهين فقط ، فيسري إلى غيرهم بدليل الاشتراك وهو الإجماع.
ويمكن الإيراد على كلامه بأنّ هذا يتمّ في الأوصاف المفارقة ، وأمّا الأوصاف الملازمة ( كصفة العربيّة إذا احتملت دخالتها ) فلا يتصوّر التمسّك بالإطلاق بالنسبة إليها للمشافهين لكي يثبت اتّحاد المعدومين معهم ، وحينئذٍ يرتفع الإشكال عن الثمرة بحذافيرها.
ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ وجود صفة ملازمة تحتمل دخالتها في الحكم ممنوع.
أقول : نعم يرد عليه مع ذلك :
أوّلاً : أنّ التمسّك بالإطلاق للمشافهين يكون فرع حجّية الظواهر لمن لم يقصد إفهامه كما هو مبنى المحقّق الخراساني رحمهالله ، أمّا بناءً على ما اخترناه من اختصاصها بمن قصد إفهامه فلا يجوز التمسّك بالإطلاق للمشافهين أيضاً لأنّه يمكن إثبات التكليف لهم من طريق قرائن موجودة في البين ، فالخطاب من البداية ليس مطلقاً لكي يجوز التمسّك بإطلاقه ، وليس من وظيفة المتكلّم إقامة القرينة لمن لم يقصد إفهامه لكي تنتقل إلينا فنثبت من ناحيتها ثبوت الحكم لنا ، وعليه فلا يكون الإطلاق كاشفاً عن عدم دخل القيد المشكوك دخله في الحكم ، لمكان احتمال الدخل فيه وأنّ الإطلاق يكون من جهة الإتّكال على حصوله للمقصودين.
وثانياً : أنّه يمكن وجود احتمال دخل صفة ملازمة في الحكم كالعربيّة ، بأن يقال مثلاً : كون المشافهين من العرب لعلّه كان سبباً لعدم جواز القنوت بغير العربيّة لهم ، وحينئذٍ لا يمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات الحكم بالنسبة لنا أيضاً بدليل الاشتراك ، للزوم هذا الوصف وعدم انفكاكه عنهم.
بقي هنا شيء :
وهو ما أفاده في التهذيب وإليك نصّ كلامه : « يمكن أن يقال بظهور الثمرة في التمسّك بالآية لإثبات وجوب صلاة الجمعة علينا ، فلو احتملنا أنّ وجود الإمام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها يدفعه أصالة الإطلاق في الآية على القول بالتعميم ، ولو كان شرطاً كان عليه البيان ، وأمّا لو قلنا باختصاصه بالمشافهين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما كان يضرّ الإطلاق بالمقصود وعدم ذكر شرطيّة الإمام أصلاً ، لتحقّق الشرط وهو حضوره عليهالسلام إلى آخر أعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة ولي العصر ( عج ) فتذكّر (١).
أقول : لكن قد ظهر ممّا ذكرنا :
أوّلاً : أنّ المراد من قيد الحضور في صلاة الجمعة إنّما هو حضور الإمام المبسوط اليد فلم يتحقّق الشرط في الخارج إلاّلعشر سنوات من عصر النبي صلىاللهعليهوآله وخمس سنوات من عصر الوصي عليهالسلام.
ثانياً : بالنسبة إلى زمان الرسول أيضاً يتصوّر مفارقة هذه الصفة بالنسبة إلى بعض المشافهين ، وهم الذين خرجوا من حوزة الحكومة الإسلاميّة وعاشوا في غير بلاد الإسلام كالذين هاجروا إلى الحبشة مثلاً.
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٥٠ ، طبع مهر.
الفصل السابع
الكلام فيما إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى البعض
إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى بعضه ، فهل يوجب ذلك تخصيصه أو لا؟
وقد اشتهر التمثيل لذلك بقوله تعالى في سورة البقرة (٢٢٨) ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) ( الآية ) فالضمير في بعولتهنّ راجع إلى خصوص الرجعيات من المطلّقات لا إلى المطلّقات مطلقاً ، فهل عود الضمير إلى بعض أفراد المطلّقات ممّا يوجب تخصيصها به ويكون المراد منها هو خصوص الرجعيّات فيختصّ التربّص بهنّ فقط ، أو لا يوجب ذلك بل المراد منها مطلق المطلّقات ، وبعبارة اخرى : هل نأخذ بأصالة العموم فلا يوجب إرجاع الضمير إلى البعض تخصيص المطلّقات ، أو نأخذ بأصالة عدم الاستخدام فيكون إرجاعه إلى البعض موجباً للتخصيص؟ ففيه : أقوال وذكر المحقّق النائيني رحمهالله في المقام ثلاثة أقوال ، وللمحقّق الخراساني رحمهالله هنا قول بالتفصيل لو أخذناه قولاً آخر تكون الأقوال في المسألة أربعة.
أوّلها : تقديم أصالة العموم والالتزام بالاستخدام.
ثانيها : تقديم أصالة عدم الاستخدام والالتزام بالتخصيص.
ثالثها : عدم جريان كليهما ، أمّا أصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما إذا كان الشكّ في المراد ، فلا تجري فيما إذا شكّ في كيفية الإرادة مع القطع بنفس المراد كما هو الحال في جميع الاصول اللفظيّة ، وأمّا عدم جريان أصالة العموم فلاكتناف الكلام بما يصلح للقرينة ، فيسقط كلا الأصلين عن درجة الاعتبار.
ورابعها : ما يظهر عن المحقّق الخراساني رحمهالله حيث قال : وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقع العام والضمير العائد إلى بعض أفراده في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بحكم يختصّ به
كما في الآية الشريفة ، وأمّا إذا كانا في كلام واحد وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل : « والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردهنّ » فلا ينبغي الريب في تخصيص العام به.
أقول : الظاهر أنّ هذا من قبيل توضيح الواضح وإخراج ما لا يتصوّر النزاع فيه عن محلّ النزاع ، لأنّ محلّ الخلاف ما إذا كان في البين حكمان : أحدهما عام والآخر خاصّ ، وأمّا إذا كان الحكم واحداً كما في المثال الذي ذكره ( والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردهنّ ) فلا يعقل النزاع حينئذٍ كما لا يخفى ، هذا أوّلاً.
وثانياً : لا يتصوّر النزاع أيضاً فيما إذا وقع العام والضمير في كلامين بل لابدّ من كونهما في كلام واحد ، لأنّه إذا جيء بالعام في كلام واريد أن يؤتى بالخاص بعد ساعة مثلاً في كلام مستقلّ فلا وجه بل لا معنى لإتيانه بالضمير ، بل يؤتى على القاعدة بالاسم الظاهر كما لا يخفى ، ولو استعمل الضمير حينئذٍ كان المرجع فيه ما ثبت في الذهن لا الكلام المنفصل عنه.
ثمّ إنّ مختار المحقّق الخراساني رحمهالله تقديم أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام ، وبعبارة اخرى : ترجيح أصالة الظهور في طرف العام على أصالة الظهور في طرف الضمير ، والسرّ فيه ما اشير إليه من أنّ المتيقّن من بناء العقلاء الذي هو مدرك أصالة الظهور هو اتّباعها في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الإرادة والاستعمال بعد ظهور المراد ، والمراد في طرف العام غير معلوم ، إذ لم يعلم أنّه اريد منه العموم أو اريد منه الخصوص فتكون أصالة الظهور حجّة فيه ، بخلاف المراد في جانب الضمير فإنّه معلوم على كلّ حال ، لأنّ أحقّية الزوج بردهنّ هي للرجعيّات لا محالة ، ولكن كيفية الاستعمال مشكوكة ، إذ لم يعلم أنّ العام قد اريد منه الخصوص ليكون استعمال الضمير على نحو الحقيقة أو اريد منه العموم وأنّ الضمير قد رجع إلى بعض ما اريد من المرجع بنحو الاستخدام؟ مختار للمحقّق الخراساني رحمهالله في المقام هو تقديم أصالة العموم ، وقد فصّل بين ما إذا عقد للكلام ظهور في العموم كما إذا كان العام والضمير في كلامين مستقلّين ، وبين ما إذا كان الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينيّة فلا ينعقد للعام ظهور في العموم أصلاً كما إذا كان العام والضمير في كلام واحد ، فإنّ أصالة العموم تجري في القسم الأوّل ولا تجري في القسم الثاني بل يصير الكلام فيه مجملاً يرجع في مورد الشكّ إلى الاصول العمليّة ، فظهر أنّ المحقّق الخراساني رحمهالله يفصّل بين ما إذا كان العام والضمير في كلامين وما إذا كانا في كلام واحد.
أقول : بناءً على ما مرّ من أنّ محلّ النزاع هو ما إذا كان العام والضمير في كلام واحد يرجع
قول المحقّق في الحقيقة إلى القول الثالث في المسألة ، وهو سقوط كلا الأصلين عن الاعتبار ، هذا أوّلاً.
وثانياً : أنّ الآية المباركة وأمثالها خارجة عن محلّ النزاع كما أفاد في تعليقات الأجود (١) لأنّ ما هو المعلوم من الخارج إنّما هو اختصاص الحكم المذكور في الآية المباركة بقسم خاصّ من المطلّقات ، وأمّا استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص ذلك القسم فهو غير معلوم ، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة العموم أو عن أصالة عدم الاستخدام أصلاً.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمهالله ذهب أيضاً كالمحقّق الخراساني رحمهالله إلى تقديم أصالة العموم ، واستدلّ له بثلاثة وجوه :
الوجه الأوّل : أنّ لزوم الاستخدام في ناحية الضمير إنّما يبتني على أن يكون العام المخصّص مجازاً ، لأنّه على ذلك يكون للعام معنيان : أحدهما معنى حقيقي ، وهو جميع ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول أداة العموم ، وثانيهما معنى مجازي وهو الباقي من أفراده بعد تخصيصه ، فإذا اريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام ، وأمّا إذا قلنا بأنّ تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازاً كما هو الصحيح فلا يكون للعام إلاّمعنى واحد حقيقي ، وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازي ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما اريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام.
الوجه الثاني : أنّ الاصول العقلائيّة إنّما تجري عند الشكّ في المراد ، وفي المقام لا شكّ في المراد من الضمير وأنّ المراد منه المطلّقات الرجعيّات ، وبعد العلم بما اريد من الضمير لا تجري أصالة عدم الإستخدام حتّى يلزم التخصيص في ناحية العام.
إن قلت : أنّ أصالة عدم الإستخدام وإن لم تجر بالإضافة إلى نفي الإستخدام في نفسه لعدم ترتّب الأثر عليها بعد معلوميّة المراد كما ذكر إلاّ أنّها تجري بالإضافة إلى إثبات لازم عدم الاستخدام ، أعني به إرادة الخاصّ من العموم ، ونظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوباً مثلاً مع الرطوبة ثمّ خرج الثوب عن محلّ الابتلاء وعلم بنجاسة ذلك الثوب قبل تحقّق الملاقاة مع الشكّ في عروض المطهّر له إلى حال الملاقاة فإنّه لا ريب في أنّه يحكم بالفعل بنجاسة البدن
__________________
(١) راجع أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤٩٥.
الملاقي لذلك الثوب وإن كان نفس الثوب خارجاً عن محلّ الابتلاء أو معدوماً في الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب وإن كان لا يجري لأجل التعبّد بنجاسة نفس الثوب لأنّ ما هو خارج عن محلّ الابتلاء أو معدوم في الخارج غير قابل لأن يتعبّد بنجاسته في نفسه ، إلاّ أنّه يجري باعتبار الأثر اللازم لمجراه أعني به نجاسة البدن في المثال ، فكما أنّ الأصل العملي يجري لإثبات ما هو لازم مجراه وإن لم يكن المجري في نفسه قابلاً للتعبّد ، كذلك الأصل اللفظي يجري لإثبات لوازم مجراه وإن لم يكن المجري في نفسه مورداً للتعبّد ، وعليه فلا مانع من جريان أصالة عدم الاستخدام لإثبات لازم مجريها ، أعني به إرادة الخاصّ ممّا يرجع إلى الضمير في محلّ الكلام.
قلت : قياس الأصل اللفظي بالأصل العملي في ما ذكر قياس مع الفارق لأنّ الأصل العملي إنّما يجري لإثبات الآثار الشرعيّة ولو بألف واسطة ، بخلاف المقام فإنّ إرادة الخاصّ من العام ليست من آثار عدم الاستخدام شرعاً بل هي من لوازمه عقلاً ، والأصل المثبت وإن كان حجّة في باب الاصول اللفظيّة ، إلاّ أنّه من الواضح أنّ إثبات لازم عقلي بأصل فرع إثبات ملزومه ، فالأصل اللفظي إذا لم يمكن إثبات الملزوم به لم يمكن إثبات لازمه به أيضاً لأنّه فرعه وبتبعه.
الوجه الثالث : أنّ استفادة الرجعيّات في قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) ليس من نفس الضمير ، بل يستفاد ذلك من عقد الحمل وهو قوله تعالى : « أحقّ بردهنّ » حيث إنّه معلوم من الخارج أنّ ما هو الأحقّ بالردّ هو خصوص الرجعيّات ، فالضمير لم يرجع إلى الرجعيّات بل رجع إلى نفس المطلّقات وكأنّ استفادة الرجعيّات من عقد الحمل ، فيكون من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، فأين الاستخدام المتوهّم (١)؟ ( انتهى ).
أقول : وفي كلامه مواقع للنظر :
الأوّل : ( في جوابه عن قياس الاصول اللفظيّة بالاصول العمليّة في ذيل الوجه الثاني ) أنّه لا دخل لكون الأصل في المقام مثبتاً أو غير مثبت ولا حاجة إليه في الجواب ، بل العمدة أنّ الاصول اللفظيّة ( لكون مجريها هو الشكّ في المراد ) لا تجري في أمثال المقام سواء كان لها لازم أو لم يكن ، وسواء قلنا بحجّية مثبتات الأمارات أو لم نقل.
__________________
(١) راجع الأجود : ج ١ ، ص ٤٩٢ ـ ٤٩٥ ؛ وفوائد الاصول : ج ١ ، ص ٥٥٢ ـ ٥٥٣.
الثاني : ( بالنسبة إلى قوله في الوجه الأوّل ) أنّه ليس الكلام في كون العام المخصّص مجازاً أو ليس بمجاز ، إنّما الكلام في أنّ مقتضى أصالة عدم الاستخدام كون العام مستعملاً في الباقي بحسب الإرادة الاستعماليّة ، وبالجملة أصالة الحقيقة في العام وأصالة الحقيقة في الضمير تتعارضان فأيّتهما تقدّم على الاخرى؟
الثالث : ( في قوله في الوجه الثالث ) أنّه يتمّ ويحلّ الإشكال بالنسبة إلى الضمير الأوّل ، وهو الضمير في بعولتهن ، وأمّا بالنسبة إلى الضمير الثاني ـ وهو الضمير في « بردهنّ » فيبقى الإشكال على حاله حيث إن مرجعه أيضاً هو المطلّقات ، وإذا كانت الأحقّية مختصّة بالرجعيّات يرجع الضمير بعدها لا محالة إلى خصوص الرجعيّات كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لقد أجاد في التهذيب حيث قال : « كلّ من الضمير في قوله تعالى : وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ وكذلك المرجع قد استعملا في معانيهما ، بمعنى أنّه أطلق المطلّقات واريد منها جميعها وأطلق لفظة « بردهنّ » واريد منها تمام أفراد المرجع ، ثمّ دلّ الدليل على أنّ الإرادة الاستعماليّة في ناحية الضمير لا توافق الإرادة الجدّية ، فخصّص بالبائنات وبقيت الرجعيّات بحسب الجدّ ، وحينئذٍ لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصّص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه ، فرفع اليد عنه رفع عن الحجّة بلا حجّة » (١).
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٥١ ، طبع مهر.
الفصل الثامن
الكلام في تخصيص العام بالمفهوم
ينبغي قبل الورود في أصل البحث ذكر تقسيمات وردت في المفهوم ، فنقول : إنّه على قسمين : مفهوم الموافقة ، وهو ما كان بينه وبين المنطوق توافق في السلب والإيجاب ، ومفهوم المخالفة ، وهو ما كان بينه وبين المنطوق تخالف في السلب والإيجاب ، وأضاف بعض تقسيمين آخرين.
أحدهما : أنّ الموافق تارةً يكون بالأولويّة ، ومثاله معروف وهو قوله تعالى : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ) الذي مفهومه النهي عن الضرب بطريق أولى ، واخرى يكون بالمساواة نحو « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » الذي يشمل بالمفهوم سائر أفراد المسكر بالمساواة.
ثانيهما : أنّ كلاً من المساواة والأولويّة أيضاً على قسمين ، فالمساواة تارةً تكون من قبيل منصوص العلّة ، واخرى تكون من قبيل مستنبط العلّة ، والأولويّة تارةً عقليّة فتدخل في المفهوم ، واخرى تكون عرفيّة فتدخل في المنطوق ، فالمثال المعروف ( فلا تقل لهما افّ ) حيث إن الأولويّة فيه عرفيّة داخلة في المنطوق لا المفهوم.
لكن يمكن النقاش هنا بوجوه :
الوجه الأوّل : تقسيم مفهوم الموافقة إلى الأولويّة والمساواة لا يكون تامّاً لأنّ منصوص العلّة في المساواة لا ينطبق عليه تعريف المفهوم ، لأنّ المفهوم هو حكم غير مذكور ، مع أنّ ذكر العلّة في منصوص العلّة نحو « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » يكون بمنزلة الحكم بأنّ كلّ مسكر حرام ، ولكنّه حذف وقدّر لوضوحه ، فلا يعدّ حكماً غير مذكور. وبعبارة اخرى : الحكم هنا مركّب من صغرى وكبرى ، والصغرى وهو قوله : « لأنّه مسكر » مذكور في الكلام ، وأمّا الكبرى وهو قوله : « كلّ مسكر حرام » فحذفت لوضوحها ، فهي مقدّره في الكلام ، والمقدّر كالمذكور ، ولذلك سمّي هذا القسم بمنصوص العلّة ، يعني الحكم الذي نصّ بعلّته ، وأمّا في مثال
« فلا تقل لهما افّ » أو « إنّ جاءك زيد فأكرمه » فلم يقل أحد بحذف قضيّة « لا تضرب » أو قضية « إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه » أو تقديرهما ، بل يقال بأنّ القضيتين المنطوقتين تدلاّن عليهما بالمفهوم.
الوجه الثاني : أنّ تقسيم المساواة إلى منصوص العلّة ومستنبط العلّة أيضاً تامّ فيما إذا قلنا بحجّية مستنبط العلّة ، مع أنّه ليس بحجّة عند الإماميّة ، لعدم إمكان استنباط ملاكات الأحكام وعللها ، وما أبعد عقول الرجال عن دين الله كما ورد في الحديث.
إن قلت : فما معنى تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّة في المسائل الفقهيّة كما إذا قيل مثلاً : إن سافرت بين مكّة والمدينة ثمانية فراسخ فقصّر ، ونحن نعلم بأنّه لا خصوصيّة لمكّة والمدينة ، ونلغي خصوصيتهما ونحكم بوجوب القصر في سائر الأمكنة إذا تحقّق مقدار ثمانية فراسخ ، فما الفرق بين هذا وقياس مستنبط العلّة؟
قلت : يكون النظر في القياس المستنبط العلّة إلى علّة الحكم ، بينما هو في تنقيح المناط يكون إلى موضوع الحكم ، والفرق بين الموضوع والعلّة واضح حيث إنّ الموضوع هو عنوان مشتمل على جميع ما له دخل في تنجّز التكليف وفعليّته كعنوان المستطيع في وجوب الحجّ ، وأمّا العلّة فإنّها داخلة في سلسلة المبادىء والأغراض ، مضافاً إلى أنّ إلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط طريق إلى تعيين دائرة المنطوق وتوسعتها ولا ربط له بالمفهوم ، فإذا تعدّينا من مورد دليل إلى مورد آخر بالالغاء أو التنقيح وأثبتنا الحكم الثابت في مورد ذلك الدليل لمورد آخر ـ تعدّ دلالة الدليل حينئذٍ من قبيل المنطوق لا المفهوم كما لا يخفى.
الوجه الثالث : إنّ ما ذكره من الفرق بين الأولويّة القطعيّة والعرفيّة أيضاً غير تامّ ، لأنّ الأولويّة سواء كانت عقليّة أو عرفيّة داخلة في المفهوم ، وفهم العرف لا ينافي ذلك ، لوجود ملاك المفهوم في كلتيهما ، حيث إن الملاك هو كون الحكم غير مذكور وهو موجود في مثل قوله تعالى : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ) بالنسبة إلى قضية « لا تضرب » مثلاً كما لا يخفى ، نعم إلاّ إذا كان المنطوق مجرّد طريق وإشارة إلى المفهوم ، فلا يكون القول بالافّ في الآية مثلاً حراماً بنفسه بل يكون نحو كناية عن مثل الضرب ، ففي مثل هذه الموارد تدخل الأولويّة العرفيّة في المنطوق بلا إشكال.
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل البحث فنقول : هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا؟ لا إشكال ولا خلاف في جواز تخصيص العام بالمفهوم إذا كان موافقاً كما إذا قال : « لا تكرم الفسّاق » ثمّ قال : « أكرم الضيف ولو كان كافراً » فمفهومه وجوب إكرام الضيف إذا كان مسلماً فاسقاً بطريق أولى ، وهذا المفهوم موافق للمنطوق في الإيجاب ويكون خاصّاً بالنسبة إلى عموم « لا تكرم الفسّاق ».
وأمّا إذا كان المفهوم مخالفاً ففيه خمسة أقوال :
الأوّل : عدم جواز التخصيص مطلقاً.
الثاني : جوازه مطلقاً.
الثالث : التفصيل بين موارد المفهوم فيختلف باختلاف الموارد والمقامات ، فإن كان الدالّ على المفهوم مثل كلمة « إنّما » فيقدّم على العام ويخصّص العام به وإلاّ فالعام يقدّم.
الرابع : تفصيل المحقّق الخراساني رحمهالله وهو التفصيل بين الكلام الواحد وبين الكلامين المنفصلين ، والتفصيل بين ما إذا فهمنا العموم من الوضع وما إذا فهمناه من مقدّمات الحكمة ، فتارةً يكون العام والمفهوم في كلام واحد واستفدنا العموم والمفهوم كليهما من مقدّمات الحكمة أو استفدنا كليهما من الوضع ، فلا عموم حينئذٍ ولا مفهوم لعدم تماميّة المقدّمات بالنسبة إلى شيء منهما في الأوّل ، ولمزاحمة ظهور كلّ منهما مع الآخر في الثاني ، فلا بدّ حينئذٍ من الرجوع إلى الاصول العمليّة في مورد الشكّ ، واخرى يكونان في كلامين بينهما فصل طويل وكان كلّ منهما بمقدّمات الحكمة أو بالوضع ، فالظهور لا محالة وإن كان ينعقد لكلّ منهما ولكن لابدّ حينئذٍ من أن يعامل معهما معاملة المجمل لتكافؤهما في الظهور إن لم يكن أحدهما أظهر ، وإلاّ فيكون هو القرينة على التصرّف في الآخر.
الخامس : تفصيل المحقّق النائيني رحمهالله ، فإنّه فصّل في المفهوم المخالف بين ما إذا كانت النسبة بين العام والمفهوم ـ العموم والخصوص مطلقاً ، وبين ما إذا كانت من العام يقدّم على العام سواء كان بين المنطوق والعام العموم المطلق أو العموم من وجه ، ومهما كان بين المفهوم والعام ـ العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه فربّما يقدّم العام وربّما يقدّم المفهوم في مورد التعارض من غير فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون بين المنطوق والعام ـ العموم المطلق أو العموم من وجه » (١) ( انتهى ).
__________________
(١) فوائد الاصول ، ج ١ ، و ٢ ص ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ، طبع جماعة المدرسين.
أقول : الإنصاف أنّ البحث إنحرف عن مسيره الأصلي في كلمات المتأخّرين كالمحقّق الخراساني والنائيني رحمهما الله وبعض آخر ( قدّس الله أسرارهم ) فقد تكلّموا عن امور أربع لا ربط لها بمحلّ النزاع.
أحدها : أنّه هل يستفاد العموم أو المفهوم من مقدّمات الحكمة أو من الوضع؟
ثانيها : هل الكلام يكون من قبيل المحفوف بالقرينة أو لا؟
ثالثها : هل العام لسانه آبٍ عن التخصيص أو لا؟
رابعها : هل النسبة بين العام والخاصّ العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه؟
مع أنّ الحقّ في المقام أن يتكلّم عن التفاوت بين المفهوم والمنطوق فقط وأنّه إذا كان العام قابلاً للتخصيص بالمنطوق فهل يخصّص بالمفهوم أيضاً أو لا؟
وبعبارة اخرى : هل يكون للمفهوم من حيث هو مفهوم نقص في التخصيص بالقياس إلى المنطوق؟ وذلك لأنّه لا فرق في هذه النكات الأربع بين المنطوق والمفهوم ، فإنّ المنطوق أيضاً لا يقدّر لتخصيص العام الآبي عن التخصيص ، ولا يخصّصه أيضاً إذا كان هو بمقدّمات الحكمة وكان العام دالاً على العموم بالوضع ، وكذلك إذا كانت النسبة بينه وبين العام العموم من وجه أو كان العام لإقوائيته وأظهريته قرينة على التصرّف في الخاصّ.
إذن فلا بدّ من ارجاع البحث إلى محوره الأصلي ، وهو أن نفرض الكلام أوّلاً في مورد كان العام فيه يخصّص بالخاصّ على تقدير كونه منطوقاً ، ثمّ نبحث في أنّه هل يخصّص بالمفهوم أيضاً في هذا الفرض أو لا؟ وأنّ المفهوميّة هل توجب ضعفاً للخاصّ أو لا؟ وحينئذٍ نقول : ربّما يتوهّم أنّ الدلالة المفهوميّة أضعف من الدلالة المنطوقيّة فلا يكون الخاصّ إذا كان مفهوماً مخصّصاً للعام ، لكن الإنصاف أنّ مجرّد كون الخاصّ مفهوماً لا يوجب ضعفاً ، بل ربّما يكون المفهوم أقوى من المنطوق ، بل ربّما يكون المقصود الأصلي للمتكلّم هو المفهوم فقط.
وبالجملة لا المنطوق بما هو منطوق يوجب قوّة للخاص ولا المفهوم بما هو مفهوم يوجب ضعفاً له ، فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّه يجوز تخصيص العام بالمفهوم كما يجوز تخصيصه بالمنطوق ، نعم كما أشرنا آنفاً قد يكون العام أقوى من الخاص فلا يخصّص العام به كما إذا كا العام آبياً عن التخصيص ، لكنّه لا يختصّ بالمفهوم بل المنطوق أيضاً لا يخصّص العام إذا كان العام كذلك ، نحو قوله عليهالسلام : « ما خالف كتاب الله فهو زخرف » فإنّ هذا عام لا يمكن تخصيصه