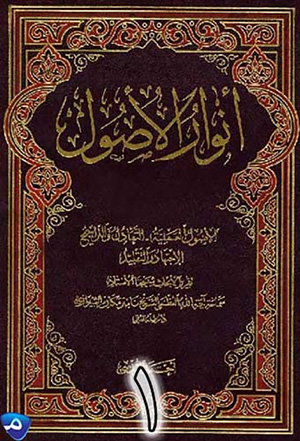الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-8139-12-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٠٨
تفترق مسألة القضاء والقدر عن مسألة الجبر والاختيار في أمرين :
أحدهما : أنّ الاولى أعمّ من الثانيّة من ناحية سعة شمولها لأعمال العباد وغيرهم فإنّ القضاء والقدر جاريان في جميع الكائنات بخلاف مسألة الجبر والاختيار فإنّها مطروحة في مجال أعمال الإنسان فقط.
ثانيهما : أنّ المسألة الاولى بلحاظ انتساب الأفعال إلى الله تعالى والمسألة الثانيّة بلحاظ انتساب الأفعال إلى العباد أنفسهم كما لا يخفى. ولكن مع ذلك فإنّ بينهما قرابة شديدة وربط وثيق وإنّ أدلّة المسألتين متقاربة جدّاً.
الأمر الثاني : أنّ القضاء والقدر في لسان الفلاسفة يأتي على معنيين :
أحدهما : القضاء والقدر العلميين ، بمعنى أنّ القضاء عبارة عن العلم الإجمالي للباري تعالى بجميع الموجودات وهو عين ذاته تعالى ، وأمّا القدر فهو علمه التفصيلي بجميع الموجودات وهو عين ذات الموجودات نفسها.
ثانيهما : القضاء والقدر العمليين التكوينيين ، بمعنى أنّ القضاء هو خلق الصادر الأوّل الذي يتضمّن جميع الموجودات واندرج فيه العالم بتمامه ، والقدر عبارة عن إيجاد الموجودات المتكثّرة ، ولا يخفى ما فيه من الإشكال في المباني.
الأمر الثالث : في معنى القضاء والقدر في اللّغة وفي لسان الآيات.
ففي مفردات الراغب : « القضاء فصل الأمر ، قولاً كان ذلك ( مثل قول القاضي ) أو فعلاً ( نحو قوله تعالى فقضاهنّ سبع سموات ) وكلّ واحد منهما على وجهين : إلهي وبشري ... إلى أن قال في مقام بيان الفرق بين القضاء والقدر : والقضاء من الله أخصّ من القدر لأنّه الفصل بعد التقدير ، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل بعد التقدير ».
وأمّا المستفاد من موارد استعمالها في القرآن فهو أنّ القضاء هو الحكم القطعي الإلزامي تكوينياً كان أو تشريعيّاً ، فالتكويني منه نظير ما جاء في قوله تعالى : ( إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (١) والتشريعي ما جاء في قوله تعالى : ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً )(٢) ، وأمّا القدر فهو بمعنى تعيين المقدار إمّا تكويناً نحو قوله تعالى : ( وَإِنْ
__________________
(١) سورة آل عمران : الآية ٤٧.
(٢) سورة الإسراء : الآية ٢٣.
مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ )(١) ونحو قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ )(٢) ، أو تشريعاً نحو قوله تعالى : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )(٣) الذي ورد في تعيين وتحديد تكليف المعسر والموسع في متعة المطلّقات اللاتي لم يفرض لهنّ المهر.
والمختار في المقام الذي يلائم المعنى اللغوي وظواهر الآيات والرّوايات هو أنّ القضاء والقدر على نحوين : تشريعي وتكويني ، والمراد من القضاء التشريعي هو مطلق الواجبات والمحرّمات التي أمر المكلّف بإتيانها أو نهى عن ارتكابها ، ومن القدر التشريعي هو مقدار هذه الواجبات والمحرّمات وحدودها ومشخّصاتها ، فمثلاً أصل وجوب الصّلاة قضاء الله ، ووجوب إتيانها سبع عشرة ركعات في الأوقات الخمسة قدره ، وهكذا بالنسبة إلى الزّكاة والصّيام والحجّ وسائر التكاليف ، ومن أوضح الشواهد على هذا المعنى وأتقنها ما مرّ من بيان المولى أمير المؤمنين عليهالسلام حينما كان جالساً بالكوفة منصرفاً من صفّين وهو حديث طويل يشتمل على فوائد جمّة ، وقد ورد في ذيله : « ثمّ تلا عليه : ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ) ولا إشكال في أنّ المراد من القضاء في هذه الآية إنّما هو القضاء التشريعي.
وأمّا المراد من القضاء والقدر التكوينيين فهو نفس قانون العلّية وإنّ كلّ شيء يوجد في عالم الوجود وكلّ حادث يتحقّق في الخارج يحتاج إلى علّة في أصل وجوده ( وهو القضاء ) ، وفي تقديره وتعيين خصوصّياته ( وهو القدر ) فمثلاً إذا انكسر زجاج بحجر فأصل الانكسار هو القضاء ، أي عدم تحقّقه بدون العلّة ، وأمّا مقدار الانكسار المناسب لقدر الحجر وشدّة الاصابة فهو القدر.
لا يقال : « لو كان الأمر كذلك أي كانت جميع الكائنات محكومة لقانون العلّية والقضاء والقدر التكوينيين لزم أن تكون أفعال العباد أيضاً محكومة لهذا القانون ويلزم منه الجبر » لأنّه قد مرّ سابقاً أنّ من قضاء الله التكويني وقدره صدور أفعال العباد من محض اختيارهم وإرادتهم وأنّ الجزء الأخير للعلّة التامّة فيها إنّما هو اختيار الإنسان الذي قضى الله عليه وقدره في وجوده ، ولذلك قلنا : أنّ إسناد الفعل إلى الإنسان حقيقي كما أنّ إسناده إلى الله تعالى في نفس الوقت حقيقي أيضاً.
__________________
(١) سورة الحجر : الآية ٢١.
(٢) سورة المؤمنون : الآية ١٨.
(٣) سورة البقرة : الآية ٢٣٦.
والشاهد على ذلك ما هو المعروف من رواية ابن نباتة قال : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له : يا أمير المؤمنين ، تفرّ من قضاء الله؟ قال : « أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله عزّوجلّ » (١).
فإنّه على كلا تفسيريه شاهد لما قلناه ، فإن كان المراد منه القضاء والقدر التكوينيين فمعناه أنّي أفرّ من قضاء الله التكويني ( وهو أصل سقوط الحائط المائل على الإنسان الموجب للجرح أو القتل ) إلى قدره التكويني وهو أنّ الحائط المائل يوجب قتل الإنسان أو جرحه فيما إذا لم يعمل الإنسان اختياره ولم يفرّ منه بإرادته ، فإنّ أصل إيجاب الحائط المائل بعد سقوطه قتل الإنسان من قضاء الله ، ولكن هذا القضاء مقدّر ومشروط بعدم إعمال الإنسان اختياره وإرادته وبعدم عدوله وفراره منه إلى مكان آخر.
وإن كان المراد منه القضاء التكويني والقدر التشريعي فمعناه أنّ موت الإنسان بالحائط المائل وإن كان بقضاء الله وإرادته ولكنّه تعالى أمر الإنسان تشريعاً بالعدول والفرار ، فكما أنّ موت الإنسان بالحائط من قضاء الله التكويني يكون فرار الإنسان منه أيضاً من قدره التشريعي.
ولا يخفى أنّ الحديث على كلا المعنيين أصدق شاهد على أنّ شمول قانون العلّية لجميع الأشياء التي منها أفعال الإنسان الاختياريّة لا ينافي اختياره وإرادته.
إلى هنا تمّ الكلام في المقام الأوّل من « الجهة الاولى » من البحث في معنى الأمر.
المقام الثاني : في صيغة الأمر :
ويبحث فيها في أمرين :
الأمر الأوّل : في مفادها في الجملة
لا إشكال في أنّها وضعت للطلب الإنشائي وبتعبير المحقّق الخراساني رحمهالله لانشاء الطلب ،
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٥ ، ص ١١٤ ، الطبع الحديث لبيروت.
وعلى تعبير بعض الأعاظم لنفس البعث والاغراء ( فإنّها تعابير مختلفة والمقصود واحد ) فإنّه تارةً يطلب الإنسان شيئاً بنفسه مباشرة فيتحرّك نحو الماء مثلاً لرفع العطش بنفسه ، واخرى يطلبه بالتسبيب ، والثاني على قسمين : تارةً يحرّك الإنسان الشخص المأمور نحو المأمور به بحركة تكوينيّة فيبعثه نحو العمل بعثاً خارجياً ويدفعه بقوّة يده مثلاً ، واخرى يحرّكه ويبعثه نحو العمل بإبراز إرادته وطلبه النفساني بلفظ خاصّ ، ومن الألفاظ التي يستعملها الإنسان في القسم الثاني صيغة الأمر فإنّها لفظ ينشأ بها الطلب ، ويتوسّل به إلى مطلوبه.
ثمّ إنّ دواعي هذا البعث والإنشاء مختلفة : فتارةً يكون الداعي فيه الإيجاد في الخارج جدّاً ، فيكون الطلب طلباً جدّياً ، واخرى لا يكون بداعي الجدّ بل بداعي الهزل أو التحقير أو التعجيز أو التهديد أو التمنّي أو الترجّي ، ولكنّه لا يوجب الاختلاف في المستعمل فيه بل إنّه في جميع هذه الموارد واحد ، وهو البعث والطلب ، والتفاوت إنّما هو في الداعي فحسب.
فقولك : أقم الصّلاة ، لا يختلف عن قولك « اعمل ما شئت »! في أنّ المستعمل في كليهما هو الطلب الإنشائي ، والفرق بينهما إنّما هو في أنّ الداعي لقولك الأوّل إنّما هو الجدّ وإيجاد العمل في الخارج حقيقة ، وفي الثاني التهديد وإيجاد الخوف الرادع العمل ، وهذا ممّا يشهد عليه الوجدان ويعضده التبادر ، وحينئذ يكون الاستعمال في جميعها حقيقيّاً ولا مجاز في البين أصلاً.
الأمر الثاني : في دلالتها على الوجوب
لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا اجاءت صيغة الأمر مطلقة وبدون القرينة فانّه يفهم منها الوجوب كما عليه سيرة الفقهاء في الفقه في مقام العمل والاستنباط فإنّهم يعدّون صيغة الأمر حجّة على الوجوب إذا استعملت في الكلام مجرّدة عن القرينة ، وعليه بناء العقلاء عموماً في أوامر الموالي إلى من تحت حكمهم ، إنّما الكلام والإشكال في منشأ هذا الظهور وهذه الدلالة ، وفيه أربع احتمالات :
الاحتمال الأوّل : ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية ، فإنّه أسندها إلى التبادر وقال : لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة.
ولكن اشكاله واضح فإنّه يستلزم المجاز عند استعمال الصيغة في الندب ، مع أنّ الوجدان يحكم بخلافه ، فإنّا لا نرى في استعمالها في الندب عناية ولا رعاية علاقة من علاقات المجاز
( بناءً على القول بها ) ففي قول المولى تعالى « أحسن كما أحسن الله إليك » أو قوله تعالى : ( وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) ( بناءً على استحباب الكتابة في الدَين كما هو المشهور والمعروف ) لا يصحّ سلب معنى الأمر منهما وجداناً ، فلا يصحّ أن يقال أنّه ليس بأمر مع أنّ المجازيّة تستلزم صحّة السلب كما لا يخفى.
الاحتمال الثاني : ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمهالله وهو « أنّ الوجوب إنّما يكون حكماً عقليّاً ومعناه أنّ العبد لا بدّ أن ينبعث عن بعث المولى إلاّ أن يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته وأظهر وبعث وقال مولويّاً « افعل » وليس وظيفة المولى أكثر من ذلك ، وبعد إعمال المولى وظيفته تصل النوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى ، ولا نعني بالوجوب سوى ذلك » (١).
والإنصاف عدم تماميته أيضاً ، لأنّ حكم العقل بوجوب الانبعاث في مقابل مطلق بعث المولى أوّل الكلام ، بل أنّ وجوبه أو استحبابه متفرّع على كيفية إرادته واستعماله لصيغة الأمر ، فإن استعملها في الوجوب يحكم العقل بوجوب الانبعاث وإن استعملها في الندب يحكم العقل باستحباب الانبعاث ، فوجوب الإطاعة والعمل على وفق مراد المولى مسلّم ، إنّما الكلام في مراد المولى من أمره.
الاحتمال الثالث : ما ذكر في تهذيب الاصول ، وهو « أنّها كاشفة عن الإرادة الحتمية الوجوبيّة كشفاً عقلائيّاً ككاشفية الأمارات العقلائيّة ، ويمكن أن يقال أنّها وإن لم تكن كاشفة عن الإرادة الحتمية إلاّ أنّها حجّة بحكم العقل والعقلاء على الوجوب حتّى يظهر خلافه » (٢).
أقول : كلا الوجهين قابلان للمناقشة جدّاً ، لأنّه لا حجّة للعقلاء في باب الألفاظ إلاّمن طريق الدلالة حيث إنّه لا معنى لأماريّة الألفاظ إلاّمن ناحية دلالتها على معنى ، والبناءات العقلائيّة والحجج المعتبرة عندهم في باب الألفاظ لها مجارٍ خاصّة ، فهي إمّا أن تكون من باب الوضع أو من باب مقدّمات الحكمة أو القرينة ، وإذاً لا بدّ من تعيين أحد هذه الطرق حتّى نعيّن كيفية الدلالة ومنشأها.
والحاصل : أنّ بناء العقلاء على الوجوب فرع دلالة هذا اللفظ عليه بأحد أنحاء الدلالة ،
__________________
(١) فوائد الاصول : ج ١ ، ص ١٣٦ ، طبع جماعة المدرّسين.
(٢) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ١٠٥ ، طبع مهر.
وبدونها لا معنى لبنائهم على الوجوب.
الاحتمال الرابع : ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله وهو نفس ما ذهب إليه في المقام الأوّل ، أي في مبحث مادّة الأمر من أنّ دلالتها على الوجوب إنّما تنشأ من قضيّة الإطلاق ومقدّمات الحكمة ببيانين :
أحدهما : أنّ الطلب الوجوبي لمّا كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي فلا جرم أن كان مقتضى الإطلاق عند الدوران هو الحمل على الطلب الوجوبي إذ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد.
ثانيهما : أنّ الأمر بعد أن كان فيه اقتضاء لوجود متعلّقه في الخارج ( ولو باعتبار منشئيته للحكم بلزوم الإطاعة والامتثال ) يكون اقتضاؤه تارةً بنحو يوجب مجرّد خروج العمل عن اللا اقتضائيّة بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتّب عليه من الأجر والثواب فحسب ، واخرى يكون اقتضاؤه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ بحيث يوجب سدّ باب عدمه حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عمّا يترتّب على إيجاده من المثوبة الموعودة ، وفي مثل ذلك. نقول : إنّ قضيّة إطلاق الأمر يقتضي كونه على النحو الثاني لأنّ النحو الأوّل فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مؤونة بيان (١). ( انتهى مع تلخيص في عبارته ).
أقول : أمّا بيانه الأوّل ففيه : أنّ غاية ما يقتضيه هو كون الطلب ذا مراتب : خفيفة وهي الاستحباب ، وشديدة وهي الوجوب ، كما أنّ الوجوب أو الاستحباب أيضاً ذا مراتب كثيرة ، ومجرّد ذلك لا يوجب انصراف الطلب إلى أحدها دون الآخر كما أنّ النور ذو مراتب مختلفة ولا يكون إطلاقه منصرفاً إلى بعض أفراده وهو النور الشديد ، بل كلّ واحد يحتاج إلى البيان فإنّ كلّ واحد له حدّ.
وأمّا بيانه الثاني : فإن كان المراد منه الانصراف إلى الفرد الأكمل فهو أيضاً قابل للمناقشة ، لأنّ الانصراف إلى الفرد الأكمل ممّا لا دليل عليه ، فلذا لا ينصرف « العالم » إلى أعلم العلماء ، وإن كان المراد ما ذكرناه في مادّة الأمر فهو حقّ لا ريب فيه.
توضيح ذلك : أنّ صيغة الأمر تدعو إلى إيجاد الفعل في الخارج من دون أن يتطرّق إليه
__________________
(١) نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ١٦١ ـ ١٦٣ ، طبع جماعة المدرّسين.
الترك ، أي إن طبيعة الطلب لا يتطرّق إليها الاذن بالترك فهي بظاهرها تقتضي الانبعاث ، ولا سبيل لعدم الانبعاث إليها ما لم يصرّح الآمر المولى بالترخيص فتنصرف حينئذٍ إلى الوجوب واللزوم ، ويشهد على ذلك عدم قبول اعتذار العبد بأنّي كنت أحتمل الندب ، بل يقال له « إذا قيل لك افعل فافعل ».
فظهر أنّ منشأ انصراف صيغة الأمر إلى الوجوب ودلالتها عليه إنّما هو طبيعة الطلب الظاهرة في سدّ جميع أبواب العدم ( عدم الطلب ) فيها ، وإن هو إلاّنظير الدفع باليد نحو الخروج فإذا دفعت إنساناً بيدك نحو الخروج لا مجال فيه لاحتمال استحبابه ، وكذا البعث بصيغة الأمر ( اخرج ) فإنّه شبيه البعث التكويني ، أي الدفع باليد ، ولا فرق في هذا الظهور بين كون الطلب من العالي أو المساوي أو الداني ، نعم بينها فرق في وجوب الإطاعة وعدمه ، وهذا بحث كلامي لا دخل له بما نحن فيه من البحث اللّفظي.
إن قلت : أيّة ثمرة تترتّب على هذا البحث ، مع العلم بأنّ المستفاد من صيغة الأمر هو الوجوب على جميع هذا الأقوال ومن أيّ منشأ كان.
قلنا : إنّ ثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا علمنا بعدم كون المتكلّم في مقام البيان حيث تدلّ صيغة الأمر حينئذ على الوجوب بناءً على كونها من باب الوضع ولا تدلّ عليه بناءً على كونها من باب الإطلاق ومقدّمات الحكمة فإنّ من المقدّمات كون المتكلّم في مقام البيان ، إلى غير ذلك.
هذا كلّه في الفصل الأوّل من الفصول التي يبحث عنها في مبحث الأوامر.
الفصل الثاني :
الجمل الخبريّة
لا إشكال في أنّه كثيراً ما تستعمل الجملة الخبريّة موضع الإنشاء ويراد منها الطلب نحو قوله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) وقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) وقد ورد مثل هذا الطلب في روايات كثيرة أيضاً بل لعلّ أكثر الأوامر الواردة فيها يكون من هذا النوع نظير قوله عليهالسلام « يعيد صلاته » مكان قوله : « ليعد صلاته » أو قوله عليهالسلام « يغتسل » أو « يسجد سجدتي السهو » إلى غير ذلك ، كما تستعمل في أكثر الموارد بصورة فعل المضارع والجملة الفعليّة ، وقليلاً ما تكون على هيئة الجملة الاسمية ، وكيف كان فالبحث يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّه كيف يمكن استعمال الجملة الخبريّة وإرادة الإنشاء منها ، فهل هو حقيقة أو مجاز أو كناية؟
المقام الثاني : في أنّها هل تدلّ على الوجوب أو لا؟
أمّا المقام الأوّل فالأقوال فيه ثلاثة :
١ ـ أنّه مجاز لاستعمال الجملة الخبريّة التي وضعت للأخبار في غير ما وضعت له.
ولكنّه بعيد جدّاً ، لأنّ المجاز لا بدّ فيه من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، ومن الواضح أنّه لا علاقة بين الإخبار والإنشاء.
٢ ـ ما مرّ من بعض الأعلام في المعاني الحرفيّة بالنسبة إلى الجمل الخبريّة من أنّها تدلّ على النسبة الايقاعيّة الإيجاديّة ، إلاّ أنّ إيجاد النسبة وايقاعها قد يكون بداعي الحكاية والإخبار كما في الجمل الخبريّة التي تصدر من المتكلّم للاخبار ، وقد يكون بداعي البعث والطلب كما في ما نحن فيه ، فالجملة حينئذٍ استعملت في ما وضعت له ، فلا مجاز ولا حاجة إلى قرينة المجاز ، إلّإ
أنّ الدواعي حيث كانت مختلفة فتارةً يوقع المتكلم النسبة بداعي الإخبار والحكاية ، واخرى يوقعها بداعي الطلب والإنشاء ، أي أنّ لها فردين من النسبة فلابدّ من قيام قرينة لتعيين أحد الفردين.
وربّما يستشهد لكونها ايقاعيّة أنّها توجب السرور أو الكراهة في نفس المخاطب فإنّه يسرّ إذا قيل له « أنت بحر عميق » ويتأذّى وينزعج إذا قيل له « أنت فاسق جاهل » مثلاً.
ولكن قد مرّ أيضاً جوابه تفصيلاً فإنّا قلنا سابقاً أنّ الجملة الخبريّة بمبتدئها وخبرها ونسبتها أي بشراشرها تدلّ على الحكاية والإخبار عن الخارج ، وأنّ النسبة أيضاً أمر تكويني خارجي تحكي عنها النسبة الخبريّة ، وليست من الامور الاعتباريّة حتّى توجد في عالم الاعتبار فراجع.
٣ ـ أنّها كناية عن الطلب والإنشاء ببيان اللازم وإرادة الملزوم فإنّ المولى إذا رأى عبده مطيعاً لأوامره ( إمّا من طريق أنّ العبد قدم إلى المولى للسؤال عن وظيفته وتكليفه أو من أي طريق آخر ) يفترض أوّلاً امتثاله واطاعته في الخارج وأنّه يتصدّى للعمل في الخارج بمجرّد أنّ علم بطلب المولى وإرادته ، ثمّ يخبر عن امتثاله وتصدّيه كناية عن طلبه ، أي يذكر اللازم وهو انبعاث العبد وحركته نحو العمل ويريد منه ملزومه وهو طلب المولى وإرادته لذلك العمل ، وحينئذ لا فرق بين قوله « يغتسل » مثلاً في مقام الإخبار وقوله « يغتسل » في مقام الإنشاء في أنّ كلاً منهما استعمل في الإخبار والحكاية عن الخارج ، إلاّ أن الأوّل يكون بداعي الإخبار حقيقة ، وأمّا الثاني فهو كناية عن الطلب النفساني للعمل.
إن قلت : يلزم من هذا الدور المحال لأنّ لازمه أن يتوقّف الانبعاث على الإخبار ، ويتوقّف صحّة الإخبار على الانبعاث.
قلنا : أنّه كذلك فيما إذا كان الإخبار إخباراً حقيقة بينما هو في المقام كناية عن البعث والطلب ، والمتوقّف على الانبعاث إنّما هو صحّة الإخبار الحقيقي لا ما يكون كناية عن الإنشاء.
إن قلت : إنّ لازمه الكذب كثيراً لكثرة عدم وقوع المطلوب في الخارج من العصاة ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك.
قلنا : الكذب في باب الكنايات متوقّف على عدم وجود المكنّى عنه في الخارج لا على عدم وجود المحكي للجملة الخبريّة التي استخدمت للكناية ، ففي قولك « زيد كثير الرماد » ( للكناية
عن جود زيد ) يلزم الكذب إذا لم يكن زيد جواداً لا ما إذا لم يكن كثير الرماد ، بل قد لا يكون له رماد أصلاً.
هذا كلّه في المقام الأوّل.
وأمّا المقام الثاني : وهو دلالتها على الوجوب فالكلام فيه هو الكلام في صيغة الأمر من جهة الظهور عند العقلاء وأهل العرف ، فلا إشكال هنا أيضاً في أصل الدلالة على الوجوب كما أنّ منشأها هنا أيضاً ما يرجع إلى طبيعة الطلب وما تقتضيه ماهية البعث ، وأنّ جواز الترك قيد إضافي وتحتاج إلى البيان وذكر القرينة.
بقي هنا أمران :
الأمر الأوّل : المعروف والمشهور أنّ دلالة الجمل الخبريّة على الوجوب آكد من دلالة صيغة الأمر ، ببيان أنّها في الحقيقة إخبار عن تحقّق الفعل بإدّعاء أنّ وقوع الامتثال من المكلّف مفروغ عنه.
ولكن الإنصاف أنّه من المشهورات التي لا أصل لها ، فإنّ الجملة الخبريّة حيث إنّها في مقام الكناية عن الطلب تكون أبلغ في الدلالة على الإنشاء كما في سائر الكنايات فإنّها أبلغ في بيان المقصود والدلالة على المطلوب من غيرها ، لا أنّها آكد وأنّ الطلب المنشأ بها يكون أقوى وأشدّ ، كما يشهد عليه الوجدان ، فلا فرق بالوجدان بين قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) وقولك « يغسلون وجوههم » من حيث شدّة الطلب وضعفه والأهمّية وعدمها إلاّ أنّ الثاني أبلغ في الدلالة على وجوب الغسل من باب أنّ الكناية أبلغ من التصريح كما قرّر في محلّه.
الأمر الثاني : ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ ملاك الصدق والكذب في باب الكنايات إنّما هو صدق المعنى المكنّى عنه وكذبه ، لا المدلول المطابقي والمعنى الموضوع له اللفظ ، وحينئذ لا بأس بكثرة عدم وقوع المطلوب في الخارج ، وهي لا تلازم الكذب في قول الله وأولياؤه ( تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علواً كبيراً ).
إلى هنا تمّ الكلام في الفصل الثاني من مبحث الأوامر.
الفصل الثالث
التعبّدي والتوصّلي
ولا بدّ من تقديم امور قبل الورود في أصل البحث :
الأمر الأوّل : في تعريف التعبّدي والتوصّلي وبيان الميزان فيهما
فقد ذكر لهما تعاريف كثيرة التي لا حاجة إلى ذكر جميعها بل نذكر هنا أشهرها وما يرد عليه من الإيراد ثمّ نذكر التعريف المختار.
فالمشهور أنّ الواجب التوصّلي ما لا يتوقّف حصول الامتثال أو حصول الغرض فيه على قصد القربة نظير تطهير المسجد (١) فإنّ الغرض فيه يحصل وبتبعه يسقط الأمر بمجرّد التطهير من دون قصد القربة أو قصد الأمر وبأيّ طريق حصل التطهير ، وأمّا الواجب التعبّدي فهو ما يتوقّف حصول الغرض والامتثال فيه على قصد القربة.
ولكن الإنصاف أنّه تعريف ببعض اللوازم وليس بياناً لماهية الواجب التعبّدي والتوصّلي ، فإنّ اعتبار قصد القربة أو عدمه ينشأ من خصوصيّة في ماهية الواجب التعبّدي أو التوصّلي وإنّهما مع قطع النظر عن قصد القربة مفترقان ماهية وذاتاً.
توضيح ذلك : إنّ الأفعال الاختياريّة للإنسان على قسمين : الأفعال التي يأتي بها لرفع حاجاته اليوميّة كالتجارة والبيع والنكاح والطلاق وغيرها ، والأفعال التي يأتي بها لاظهار عبوديته ونهاية خضوعه وتعظيمه في مقابل ربّه ومولاه ، وهي بنفسها على قسمين أيضاً :
__________________
(١) قد ذكر في المحاضرات غسل الميّت بعنوان أحد الأمثلة للواجب التوصّلي مع أنّه لا إشكال في أنّه من الواجبات التعبّديّة ويعتبر فيه قصد القربة بل هو بنفسه أيضاً اعترف به في تعليقته على العروة ولعلّه من قبيل سهو القلم من ناحية المقرّر.
الأوّل : ما يكون بذاته تعظيماً وتجليلاً ويعدّ خضوعاً وعبوديّة كالسجدة فإنّها تعدّ بذاتها عبوديّة ولو مع عدم قصد القربة ووقوعها في مقابل أي شخص أو أيْ شيء ، وهي عبادة ولو وقعت في مقابل صنم من الحجر والشجر.
الثاني : ما يكون عبادة ولكن لا بذاته وماهيته بل باعتبار المولى وجعله كعباديّة الصّيام ( التي ترجع إلى عباديّة الامساك ) والطواف والسعي في الصفا والمروة والهرولة في موضعها وغير ذلك من أشباهها من الواجبات التعبّديّة في الشرع المقدّس ، فإنّها امور وضعت للخضوع والتعظيم في مقابل المولى الحكيم فإنّه جعلها للعبادة والعبوديّة ووسيلة للتقرّب إليه ، ولا إشكال في أنّ هذا القسم أيضاً يتشخّص بتشخّص العبادة ويتلوّن بلونها بالجعل والاعتبار مع قطع النظر عن قصد القربة والتعظيم وقصد العبادة ، فإنّه نظير ما يعتبر للتعظيم ويوضع للاحترام بين الملل والأقوام ، فعند بعضهم جعل رفع القلنسوة والبُرنيطة للاحترام فيعدّ وضعها إهانة وهتكاً مع أنّ عكسه يعدّ تعظيماً عندنا فيعتبر وضع العمامة مثلاً إحتراماً ورفعها هتكاً ، وكذلك الحال في العبادات ، فالعمدة فيها الجعل والاعتبار ، نعم العبادة المطلوبة تتحقّق بقصد القربة لا بذات العبادة.
فتلخّص : أنّ الفرق بين التعبّدي والتوصّلي لا ينحصر في قصد القربة وعدمه فقط بل إنّهما تفترقان في الماهية أيضاً ، فماهية العمل التعبّدي تفترق عن ماهية العمل التوصّلي ، وبعبارة اخرى : أنّ للعبادة التي توجب التقرّب إلى المولى ركنين : حسن فاعلي وهو أن يكون العبد في مقام الإطاعة والتقرّب إلى المولى ، وحسن فعلي وهو أن يكون ذات العمل مطلوباً للمولى.
ثمّ إنّ المقصود من التعظيم في الموالي العرفيّة إنّما هو تكريم المولى واعظامه ليكون أكرم وأعظم عند الناس ، وأمّا بالنسبة إلى الباري تعالى الكامل بالكمال المطلق والغني الحميد بغناء لا نهاية له فالمقصود منه إنّما هو تقرّب العبد ورشده وقتباس شيء من نوره وصفاته ولو كان كضوء الشمع في مقابل الشمس أو أقلّ من ذلك.
وفي تهذيب الاصول ذكر للواجب قسماً ثالثاً ، فبدّل التقسيم الثنائي إلى الثلاثي حيث قسّم ما يعتبر فيه قصد القربة إلى قسمين :
أحدهما : ما ينطبق عليه عنوان العبوديّة لله تعالى ، بحيث يعدّ العمل منه للربّ عبوديّة له كالصّلاة والاعتكاف والحجّ.
وثانيهما : ما لا يعدّ نفس العمل تعبّداً أو عبوديّة وإن كان قربيّاً لا يسقط أمره إلاّبقصد الطاعة كالزّكاة والخمس ، ثمّ قال : وهذان الأخيران وإن كان يعتبر فيهما قصد التقرّب لكن لا يلزم أن يكونا عبادة بالمعنى الكذكور إذ كلّ فعل قربى لا ينطبق عليه عنوان العبوديّة فإطاعة الولد لوالده والرعايا للملك لا تعدّ عبوديّة لهما بل طاعة ، كما أنّ ستر العورة بقصد امتثال الأمر وانقاذ الغريق كذلك ليسا عبوديّة له تعالى بل طاعة لأمره وبعثه ، وحينئذٍ يستبدل التقسيم الثنائي إلى الثلاثي فيقال : الواجب امّا توصّلي أو تقرّبي ، والأخير إمّا تعبّدي أو غير تعبّدي ... إلى أن قال : فالأولى دفعاً للالتباس حذف عنوان التعبّديّة وإقامة التقرّب موضعها (١). ( انتهى ).
أقول : قد قرّر في محلّه أنّ لبعض الأعمال القربيّة كالزّكاة والخمس حيثيتين : حيثيّة تسمّى بحقّ الله وحيثية يعبّر عنها بحقّ الناس ، أمّا الحيثية الثانيّة فهو ما يوجب تعلّق حقّ الفقراء بأموال المكلّفين وهو يؤخذ منهم ولو جبراً سواء قصد القربة بذلك أو لم يقصدها ، وأمّا الحيثية الاولى فهي ما يوجب تلوّن العمل بلون قربى إلهي ويجعله كسائر الواجبات التعبّديّة كتحمّل الجوع في شهر رمضان أو الهدية والوقوف بمنى وعرفات أو السعي بين الصفا والمروة في أيّام الحجّ ، فكما أنّ اشتراط قصد القربة هناك علامة لجعلها ووضعها للخضوع والعبوديّة بحيث لولاها فسد العمل كذلك هنا من دون أي فرق بينهما في هذه الجهة.
هذا بالنسبة إلى ما ذكره من مثال الخمس والزّكاة ، وأمّا بالنسبة إلى سائر ما ذكره من الأمثلة كستر العورة امتثالاً لأمر الله وانقاذ الغريق ، كذلك ، فمن الواضح أنّه لا يفسد أمثال هذه الامور بترك قصد القربة ، فلو أنقذ الغريق من دون هذا القصد فقد أتى بما وجب عليه وإن لم يستحقّ الثواب ، وهذا أي عدم الاشتراط بالقربة دليل على أنّه لم يجعل عبادة في الشرع المقدّس ، وبعبارة اخرى : العبادة كما ذكره القوم على قسمين : العبادة بالمعنى الأخصّ وهي ما يشترط فيه قصد القربة وبدونها تكون فاسدة ، والعبادة بالمعنى الأعمّ وهي ما يؤتى بقصد القربة وإن لم يعتبر في صحّتها ذلك ، فلو ترك القربة فيها لم يستحقّ الثواب وإن كان عمله صحيحاً بسبب كونه توصّلياً ، والمراد من التعبّدي في المقام هو القسم الأوّل ، أي ما يشترط فيه قصد القربة لا ما يؤتى بقصد القربة وإن لم يشترط بها.
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ١١١ ، طبع مهر.
ثمّ إنّه قال في المحاضرات : إنّ الواجب التوصّلي يطلق على معنيين :
الأوّل : ما لا يعتبر فيه قصد القربة.
الثاني : ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلّف بل يسقط عن ذمّته بفعل الغير سواء أكان بالتبرّع أم بالاستنابة ، بل ربّما لا يعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار ، بل ولا إتيانه في ضمن فرد سائغ ، فلو تحقّق من دون إلتفات وبغير اختيار ، أو في ضمن فرد محرم كفى.
وإن شئت قلت : إنّ الواجب التوصّلي مرّة يطلق ويراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلّف ، ومرّة اخرى يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار ، ومرّة ثالثة يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ ( انتهى ) (١).
أقول : إنّ ما أفاده جيّد في محلّه ، ولكنّه لو كان في مقام بيان مصطلح القوم في الواجب التوصّلي فلم نتحقّقه في كلماتهم ، وإن كان في مقام جعل اصطلاح جديد فلا مشاحّة في الاصطلاح ، ولعلّه كان في مقام بيان آثار الواجب التوصّلي ولوازمه ، ولكن وقع السهو في العبارة فجعل ذلك أقساماً للواجب التوصّلي ، والحاصل أنّ الواجب التوصّلي شيء واحد وكلّ ذلك من لوازمه وآثاره.
الأمر الثاني : في أنحاء قصد القربة
قد ذكر في بعض الكلمات أنحاء أربعة لقصد القربة وأشار إليها المحقّق الخراساني ؛ أيضاً في بعض كلماته : أوّلها : التقرّب بقصد الأمر ، ثانيها : التقرّب بقصد المحبوبيّة ، ثالثها : التقرّب بقصد المصلحة ، ورابعها : التقرّب بقصد كونه لله وإنّ الله أهل للعبادة.
أقول : أمّا التقرّب قصد الأمر : فهو يتصوّر في ما تكون عباديته بالجعل والاعتبار حيث إنّ هذا القبيل من الامور العباديّة تحتاج في تحديدها وتعيين نوعها وكيفيتها إلى أمر واعتبار من ناحية الشارع ، وأمّا ما تكون عباديته ذاتيّة كالسجود فلا حاجة فيها إلى قصد الأمر ليكون عبادة لأنّها خضوع ذاتاً ولا تتصوّر فيه أشكال مختلفة فيكون في حالٍ خضوعاً لله تعالى وفي حال آخر غير خضوع ، وقصد الأمر لا بدّ منه في ما إذا تصوّر لعمل واحد دواعٍ مختلفة وحالات متفاوتة.
__________________
(١) المحاضرات : ج ٢ ، ص ١٣٩ ـ ١٤٠.
وأمّا التقرّب بقصد المحبوبيّة : فلا إشكال في جوازه حيث إنّ قصد المحبوبيّة أيضاً يمكن أن يصير احترازاً عن سائر الدواعي وبياناً للقسم الذي يكون عبادة.
وأمّا التقرّب بقصد المصلحة : فإن كان المقصود من المصلحة ما يترتّب على العبادة من الخضوع والتكامل المعنوي ( وهو ما نسمّيه بالمصلحة الأخلاقيّة ) فهو يرجع إلى القسم السابق ، أي قصد المحبوبيّة ، وإن كان المراد منها المصالح الماديّة كالصحّة في الصّيام ( كما ورد في الحديث : « صوموا تصحّوا » ) وكإصلاح أمر المعاش والامور الاقتصاديّة للمسلمين في الحجّ ( فإنّ من أبعاد الحجّ بعده الاقتصادي كما اشير إليه في الحديث أيضاً ) فلا إشكال في عدم إمكان التقرّب بقصدها كما لا يخفى ، فإنّ هذه الامور ليست اموراً قربيّة إلاّ إذا لوحظ كونها مقدّمة للعبادة والإطاعة بمعنى أنّه يريد صحّة جسمه مثلاً ليقوى على طاعة الله.
وأمّا التقرّب بقصد كون العمل لله : لأنّ الله أهل للعبادة فلا يصحّ أيضاً ، لأنّ التقرّب بعمل خاصّ متفرّع على عباديته في الرتبة السابقة إمّا ذاتاً أو بالجعل والاعتبار ، فإن كان عبادة ذاتاً فهو وإلاّ فلابدّ لصيرورته عبادة من أن يقصد محبوبيته عند الله أو كونه مأموراً به حتّى يمتاز عن أشباهه ونظائره ، وأمّا مجرّد إتيانه لأنّ الله تعالى أهل للعبادة لا يوجب عباديته كما لا يخفى.
فظهر أنّ الصحيح من الأنحاء الأربعة في العبادات المجعولة الاعتباريّة من جانب الشارع إنّما هو القسم الأوّل والثاني فقط ، وأمّا في العبادات الذاتيّة فلا حاجة إلى شيء من ذلك ، نعم إذا أتى بالسجدة بقصد كونها لله تكون عبادة لله ، وإن اريد بها الصنم تكون عبادة للصنم ، فهي عبادة على كلّ حال ذاتاً من دون حاجة إلى جعل واعتبار.
الأمر الثالث : في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به
فقد وقع الخلاف في أنّه هل يجوز أخذ قصد الأمر في متعلّقه شرعاً أو لا؟ ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم الإمكان وإنّ قصد الأمر ممّا يعتبر في العبادات عقلاً لا شرعاً ولهم بيانات مختلفة في إثباته :
منها : ما أفاده المحقّق الخراساني ؛ من لزوم الدور ، وبيانه : إنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر ، والأمر متأخّر عن متعلّقه فلو اعتبر قصد الأمر المتأخّر عن الأمر في المتعلّق السابق على الأمر لزم تقدّم الشيء على نفسه برتبتين وهو محال.
ثمّ أورد على نفسه :
أوّلاً : بما حاصله ، إنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر خارجاً فما لم يتحقّق الأمر في الخارج لم يمكن قصده ، وأمّا تأخّر الأمر عن متعلّقه ( كتأخّر الأمر بالصّلاة عن وجود الصّلاة خارجاً ) فهو باطل لأنّه تحصيل للحاصل ، نعم الأمر متأخّر عن وجود متعلّقه ذهناً لأنّه ما لم يتصوّر الصّلاة لا يأمر به.
وأجاب عنه : بأنّ الإتيان بالصّلاة بداعي الأمر غير مقدور للمكلّف حتّى بعد الأمر إذ لا أمر للصّلاة كي يأتي بها بداعيه فإنّ الأمر حسب الفرض قد تعلّق بالمجموع أي بالصّلاة المقيّدة بداعي الأمر لا بنفس الصّلاة وحدها كي يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ، والأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ( وهو المجموع ) لا إلى غيره ( وهو الصّلاة وحدها ).
ثانياً : بقوله ، نعم إنّ الأمر تعلّق بالمجموع ولكن نفس الصّلاة أيضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقيّدة ( أي بالأمر الضمني ).
وأجاب عنه بقوله : كلاً ، لأنّ ذات المقيّد لا يكون مأموراً بها ، فإنّ الجزء التحليلي العقلي ( وهو ذات « المقيّد » و « التقيّد » حيث إنّهما بعد تعلّق الأمر بمجموع الصّلاة المقيّدة بداعي الأمر جزءان تحليليّان نظير الجنس والفصل ) لا يتّصف بالوجوب أصلاً إذ لا وجود له في الخارج غير وجود الكلّ الواجب بالوجوب النفسي الاستقلالي كي يتّصف بالوجوب ضمناً كما هو الشأن في الجزء الخارجي.
ثالثاً : بقوله ، نعم ، لكنّه إذا أخذ قصد الأمر شرطاً وقيداً وأمّا إذا أخذ شطراً وجزءً فينبسط الأمر حينئذ على الأجزاء ويتّصف كلّ من الصّلاة وقصد الأمر بالوجوب النفسي الضمني أي يكون تعلّق الوجوب بكلّ جزءٍ بعين تعلّقه بالكلّ ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحّة الإتيان بكلّ جزء من أجزاء الواجب بداعي وجوبه.
وأجاب عنه :
أوّلاً : بأنّ تعلّق الأمر بإرادة الأمر وقصده ممتنع لأنّ اختياريّة الأفعال تكون بالإرادة وهي القصد ، فلو كانت اختياريّة الإرادة بإرادة اخرى لتسلسلت.
وثانياً : بأنّ الإتيان بالجزء إنّما يمكن في ضمن الإتيان بالمجموع بداعي الأمر المتعلّق بالمجموع ، وإتيان المجموع بداعي أمره لا يكاد يمكن في ما نحن فيه ، لأنّه يلزم الإتيان بالمركّب
من قصد الأمر وغيره بقصد الأمر وهو محال. ( انتهى كلامه بتوضيح منّا ).
أقول : وفي كلامه مواقع للنظر :
الأوّل : أنّ جوابه عن الإشكال الأوّل بمنزلة تغيير لموضع البحث وقبول حلّ مسألة الدور والدخول في مسألة اخرى فكأنّه اعترف برفع إشكال الدور بمسألة اللحاظ فإنّ اعتباره في المتعلّق يحتاج إلى تصوّره ذهناً فقط لا إلى وجود الأمر خارجاً.
الثاني : أنّه اعترف أيضاً ضمن الإشكالين الأخيرين بإمكان أن يكون قصد الأمر جزءً للمأمور به مع أنّ الجزء داخل في ذات المأمور به وفي قوامه كأحد الأجزاء في المعاجين وكالركوع والسجود في الصّلاة ، بينما قصد الأمر ليس في عداد الأجزاء وإنّما هو يعرض الأجزاء ويكون من قبيل الحالات التي تعرض الشيء فهو من سنخ الشرط لا الجزء ، نظير الاستقبال أو الطهارة في الصّلاة.
الثالث : أنّه أنكر وجود الأمر الضمني النفسي بالنسبة إلى الشرائط وحصر وجوده في الأجزاء مع أنّه يمكن تصوّر الأمر الضمني في الشرائط أيضاً ، غاية الأمر أنّ متعلّقه هو الأجزاء وتقيّدها بالقيد ، حيث إنّ التقيّد أيضاً جزء كسائر الأجزاء المطلوبة وإن كان القيد خارجاً ، فإنّ تقيّد الصّلاة بالطهارة أيضاً متعلّق للأمر النفسي الضمني وإن كانت نفس الطهارة خارجة عنها.
الرابع : أنّه أشار في مقام الجواب عن الإشكال الثالث إلى ما مرّ منه سابقاً من أنّ اختياريّة سائر الأفعال بالإرادة ، وإراديّة الإرادة ليست بها للزوم التسلسل ، وقد مرّ الجواب عنه في البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة فراجع.
الخامس : الوجدان أصدق شاهد على إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به كأن يقول المولى : « كبّر واسجد واركع ... مع قصد هذا الأمر » وكلّ ما ذكر من الأشكال شبهة في مقابل الوجدان لا يعتنى به ، فمثلاً اشكاله بأنّه « يلزم منه وجوب إتيان المأمور به المركّب من قصد الأمر بقصد الأمر ، أي يلزم أن يتعلّق قصد الأمر بقصد الأمر وهو محال » يمكن الجواب عنه بأن لا إشكال في أنّ المحتاج إلى قصد القربة إنّما هو الأجزاء ، وأمّا الشرائط فالذي يحتاج من بينها إلى قصد القربة إنّما هو الطهارة عن الحدث فقط حين تحصيلها لا حين تقيّدها وأمّا سائر الشرائط كالاستقبال والستر والطهارة عن الخبث وقصد القربة نفسه فلا حاجة فيها إلى قصد
القربة بل يكفي تحقّق ذواتها بأي نحو حصلت ولو بدون قصد القربة.
وحينئذ نقول : لو فرضنا كون الأجزاء في الصّلاة تسعة وتعلّق الأمر بها فيصير عشرة مع تقيّدها بقصد الأمر ، فينبسط الأمر على الجميع فيأتي بها بقصد الأمر الضمني ، وهو يرى أنّ الجزء العاشر يحصل بمجرّد ذلك ، فيكون الأمر الضمني في ضمن الكلّ ، والمحتاج إلى قصد الأمر هو الأجزاء لا الشرائط لعدم قيام دليل عليه.
السادس : سلّمنا إستحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر ولكن الطريق في جعل عباديّة العبادات وأخذ قصد التقرّب بها في المتعلّق ليس منحصراً في أخذ قصد الأمر فيه بل يمكن لذلك أخذ قصد المحبوبيّة أو قصد المصلحة المعنويّة في المتعلّق فيقال مثلاً « صلّ بقصد المحبوبيّة أو قصد المصلحة المعنويّة » فإذا لم يأخذه المولى في المتعلّق وأطلقه نتمسّك بإطلاقه لعدم اعتبار قصد القربة وعدم كون الواجب تعبّديّاً.
ثمّ إنّه قد ذُكر هيهنا طريق آخر لأخذ قصد الأمر في المأمور به ، وهو ما أفاده الشّيخ الأعظم رحمهالله على ما في تقريراته ، ثمّ ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله فيما أورده على نفسه رابعاً ، وهو عبارة عن تصحيح اعتبار قصد الأمر في المأمور به من طريق أمرين : أحدهما : يتعلّق بذات العمل ، والآخر : بإتيانه بداعي أمره ، فلو لم يعتبر المولى قصد القربة بواسطة أمر ثانٍ وكان هو في مقام البيان نستكشف عدم اعتباره.
ثمّ أجاب المحقّق الخراساني رحمهالله عنه :
أوّلاً : بأنّا نقطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كسائر الواجبات التوصّلية.
وثانياً ( وهو العمدة ) بأنّ الأمر الأوّل المتعلّق بأصل الفعل إن كان توصّلياً يسقط بمجرّد الإتيان بالفعل ولو بداعي أمره فلا يكاد يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني ، لسقوط الأمر الأوّل بمجرّد الإتيان بالفعل لا بداعي أمره ، وإن كان تعبّديّاً لا يسقط بمجرّد الإتيان بالفعل بغير داعي أمره ، فلا وجه لعدم السقوط إلاّكون الواجب عباديّاً لا يحصل الغرض منه إلاّمع الإتيان به بداعي أمره ، ومع كون الواجب كذلك يستقلّ العقل لا محالة بوجوب إتيانه على نحو يحصل به الغرض أي بداعي أمره وعلى وجه التقرّب به من دون حاجة إلى أمر آخر بإتيانه كذلك.
أقول : يرد على جوابه الأوّل : بأنّه يوجد في باب العبادات أمران : أحدهما : متعلّق بذات