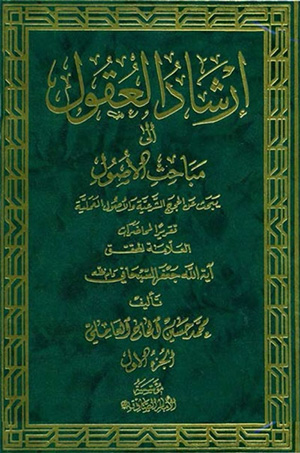الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-077-0
الصفحات: ٦٢٨
فالقول بالنسبة الخارجية فيها كالنسبة الكلامية ـ على ما مرّ ـ موافق للتحقيق ، فانّ زيداً شيء والسطح شيء آخر واستقراره عليه أمر ثالث الذي هو معنى حرفي.
إذا عرفت ما ذكرنا تقف على أنّ منهجنا في دراسة هذه المقدّمة أقرب إلى التحقيق لما عرفت من تفكيك النسبة الكلامية عن النسبة الخارجية ، وبرهنا على الأوّل بالتبادر ، وعلى الثانية بالبرهان ، خلافاً للسيّد الأُستاذ فانّه جعل برهان الأمرين شيئاً واحداً واستدلّ من عدم النسبة الخارجية على انتفاء النسبة الكلامية مع أنّه لا ملازمة بين الانتفاءين. إذ لم يكن الواضع فيلسوفاً حتى يضع الهيئة وفق مقتضى البرهان.
الأمر الثالث
في الحقيقة والمجاز
عرّف المجاز بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، فإن كانت المناسبة هي المشابهة فالمجاز استعارة ، وإلاّ فالمجاز مرسل ، كاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ وبالعكس ، كاستعمال العين في الإنسان مثل ما ورد في قول الإمام أمير المؤمنين علي عليهالسلام : « عيني بالمغرب كتب إليّ يُعلمني ». (١)
وعكسه كاستعمال الإنسان في عضو منه ، كما في قولك : ضربت إنساناً ، إذا ضربت عضواً منه.
وعلى قول هؤلاء يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالوضع وحسب تحديد الواضع حيث إنّ الواضع رخص فيما إذا كان هناك علقة مشابهة أو سائر العلائق البالغة إلى ٢٥ علاقة.
هذا هو المعروف ولكن هناك نظرية جديدة أبدعهاالعلاّمة أبو المجد الشيخ محمد رضا الاصفهاني ( ١٢٨٥ ـ ١٣٦٢ هـ ) في كتابه « وقاية الأذهان » وتبعه السيد المحقّق البروجردي ( ١٢٩٢ ـ ١٣٨٠ هـ ) والسيّد الأُستاذ ( قدس اللّه أسرارهم ) وهذه النظرية من بدائع الأفكار في عالم الأدب ، وقد أحدثت هذه
__________________
١ ـ نهج البلاغة ، قسم الكتب ، برقم ٣٣.
النظرية انقلاباً في عالم المجاز حيث استطاعت أن تغيّر العديد من المفاهيم السائدة آنذاك ، وحاصلها انّ اللفظ في مجال المجاز يستعمل في نفس المعنى الحقيقي بالإرادة الاستعمالية لكن بادّعاء انّ المورد من مصاديق المعنى الحقيقي ، يقول العلاّمة أبو المجد : إنّ تلك الألفاظ مستعملة في معانيها الأصلية ، ومستعملها لم يحدث معنى جديداً ولم يرجع عن تعهده الأوّل ، بل أراد بها معانيها الأوّلية بالإرادة الاستعمالية على نحو سائر استعمالاته من غير فرق بينهما في مرحلتي الوضع والاستعمال. (١)
والدليل على ذلك انّ الغاية المتوخاة من المجاز كالمبالغة في النضارة والصباحة أو الشجاعة أو إثارة التعجب لا يحصل إلاّ باستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لا في المعنى المجازي ، ويعلم ذلك بالإمعان في الأمثلة التالية :
١. يحكي سبحانه عن امرأة العزير انّه لما سمعت بمكر نسوة في حاضرة مصر بقوله : ( ... أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَة مِنْهُنَّ سِكّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ للّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَريمٌ ). (٢)
والغاية من وصفه بـ « ملك » هو المبالغة في النضارة والصباحة ، وهو لا يتم إلاّ أن يستعمل اللفظ في نفس المعنى الحقيقي « فرشته » لا في الإنسان الجميل ، لأنّه لا يؤمّن الغرض المنشود إلاّ به ، بشهادة انّك لو قلت هكذا : « ما هذا بشراً إنْ هذا إلاّ إنسان جميل » لسقطت العبارة عن قمة البلاغة.
|
٢. لدى أسد شاكي السلاح مقـذف |
|
له لبد اظفاره لم تقلم |
فالشاكي مقلوب « الشائك » وهو حدة السلاح ، وقوله : مقذف ، أي من له
__________________
١ ـ وقاية الأذهان : ١٠٣.
٢ ـ يوسف : ٣١.
صولات في ساحات الوغى ، فالغرض هو المبالغة في الشجاعة وانّه أسد حقيقة بشهادة انّه أثبت له لبداً وأظفاراً غير مقلّمة ، والغاية المتوخّاة لا تحصل إلاّ باستعمال الأسد في نفس الحيوان المفترس لكن بادّعاء انّ المورد من مصاديقه. وأمّا إذا استعمل في الرجل الشجاع يكون الكلام بعيداً عن البلاغة بشهادة انّك لو قلت : « لدى رجل شجاع ذي سلاح حاد » ترى بوناً شاسعاً بين المعنيين.
|
٣. قامت تظلّلني ومن عجب |
|
شمس تظلّلني مـن الشمس |
والغرض هو إثارة العجب من أنّ المحبوبة بما انّها شمس ساطعة صارت تظلّله من الشمس ، والتعجب إنّما يحصل إذا استعمل الشمس الأُولى في نفس معناها ، وعندئذ يتعجب الإنسان كيف تكون الشمس مظلّلة من الشمس؟! بخلاف ما إذا قلنا بأنّها استعملت في المرأة الجميلة ، إذ لا موجب عندئذ للتعجب ، لأنّ الأجسام على وجه الإطلاق جميلة وغير جميلة تكون حائلة عن الشمس.
وبذلك تقف على حقيقة أدبية ، وهي انّ المجاز ليس من قبيل التلاعب باللفظ بل من قبيل التلاعب بالمعنى على حد تعبير السيّد الأُستاذ ، فالإنسان البليغ لا يستعير لفظ الأسد للرجل الشجاع وإنّما يستعير معناه له ، وهو لا يتحقّق إلاّ باستعماله في نفس الموضوع له ، غاية الأمر بادعاء ، فيكون المجاز هو استعمال اللفظ في المعنى ليكون قنطرة للفرد الادّعائي.
فإن قلت : إنّ تلك النظرية إنّما تصحّ في اسم الجنس الذي له فرد حقيقي وفرد ادّعائي لا في الاعلام كحاتم ويوسف اللذين ليس لهما إلاّ فرد واحد.
قلت : إنّ قوام المجازية هو ادّعاء العينية ، وهو يدّعي انّه نفس حاتم ونفس يوسف وليس مغايراً.
ويمكن أن يقال : انّ حاتم ويوسف قد خرجا عن العلمية وصارا عند المتكلم اسماً للسخي غاية السخاء ، والجميل غاية الجمال ، فعندئذ يستعمله في الجامع المنطبق على ذينك الفردين.
والذي يؤيد كون المجاز من مقولة الاستعمال فيما وضع له هو انّ الكناية عند القوم من قبيل استعمال اللفظ في الملزوم لغاية الانتقال إلى لازمه ، فهو أشبه بالمجاز حيث إنّه من قبيل الاستعمال في المعنى الحقيقي لغاية الانتقال إلى الفرد الادّعائي. والفرق بينهما وجود الادعاء في المجاز دون الكناية.
فإن قلت : ما الفرق بين هذه النظرية وما نسب إلى السكاكي في كتابه « مفتاح العلوم » حيث إنّه هو أيضاً يدّعي انّ المعنى المجازي فرد ادّعائي للمعنى الحقيقي؟
قلت : الفرق بينهما واضح ، ذلك انّ السكاكي يعتقد كالمشهور بأنّ المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له من أوّل الأمر لكن المجوز لاستعارته لما لم يوضع له هو ادّعاء كونه من مصاديق ما وضع له ادّعاءً على خلاف تلك النظرية التي تقول باستعمال اللفظ فيما وضع له مدّعياً بأنّه من مصاديق ما وضع له من أوّل الأمر ، وإليك نصّ عبارة السكاكي في « مفتاح العلوم » ، قال في علم البيان :
وأمّا المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق ، استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها ، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع ، ثمّ أخذ في تفسير قيود التعريف. (١)
__________________
١ ـ مفتاح العلوم : ١٥٣ ، ط مصر عام١٣١٨ هـ.
وعلى هذا البيان يمكن إرجاع كثير من المجاز في الاسناد إلى المجاز في الكلمة ، فقوله سبحانه حاكياً عن إخوة يوسف : ( وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الّتي كُنّا فِيها وَالعِيرَ الّتي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُون ) (١) فالمشهور انّه من قبيل المجاز في الاسناد بتقدير أهل القرية ، نظير قول الفرزدق في مدح زين العابدين عليهالسلام :
|
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته |
|
والبيت يعرفه والحل والحرم |
فالمعروف انّه من قبيل المجاز في الاسناد أي يعرف أهل البطحاء وطأته ، ولكن الحقّ انّ الجميع من قبيل المجاز في الكلمة ، لأنّه بصدد المبالغة أنّ الأمر من الوضوح وصل إلى حدّ حتى أنّ جدران القرية مطّلعة على هذا الأمر ، وانّ البطحاء تعرف وطأة الإمام فضلاً عن أهلها.
وبذلك يظهر انّ صحّة الاستعمالات المجازية تستند إلى الوضع ، لأنّه من قبيل استعمال اللفظ فيما وضع له ، ولكن حسنه يستند إلى الطبع والذوق.
وبعبارة أُخرى : المصحح هو الوضع منضماً إلى حسن الطبع.
__________________
١ ـ يوسف : ٨٢.
الأمر الرابع
في استعمال اللفظ في اللفظ
إنّ استعمال اللفظ في اللفظ يتصوّر على أقسام أربعة :
١. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، مثل زيد ـ في كلامي هذا ـ لفظ.
٢. إطلاق اللفظ وإرادة مثله ، مثل زيد ـ في كلام القائل زيد قائم ـ لفظ.
٣. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ، كقول القائل : زيد في ضرب زيد فاعل.
٤. إطلاق اللفظ وإرادة نوعه ، كقولنا : زيد على وجه الإطلاق لفظ.
فيقع الكلام في مقامين :
الأوّل : صحّة الإطلاق.
الثاني : كون ذلك الإطلاق استعمالاً أم لا؟ وعلى فرض كونه استعمالاً ، فهل هو حقيقي أو مجازي؟
لا كلام في صحّة الإطلاق ، وأدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، فالأمثلة تعرب عن استحسان الذوق هذا النوع من الإطلاق ، ولم يخالف في ذلك أحد من الأُصوليين إلاّ صاحب الفصول في القسم الأوّل ، فلنرجع إلى المقام الثاني وانّ هذا الإطلاق هل يوصف بالاستعمال أو لا؟ فلنأخذ كلّ قسم بالبحث.
١. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
إنّ حقيقة الاستعمال تقوم على أركان ثلاثة :
الأوّل : إطلاق اللفظ.
الثاني : انتقال المخاطب عند سماع اللفظ إلى الصورة الذهنية.
الثالث : انتقاله منها إلى الوجود الخارجي.
مثلاً إذا قلنا : « قام زيد » يتحقّق هناك الركن الأوّل وهو إطلاق اللفظ ثمّ يعقبه انتقال المخاطب إلى الصورة الذهنية من قيام زيد ، وبما انّ القضيّة ليست ذهنية ينتقل المخاطب من الصورة الذهنية إلى الوجود الخارجي ، ولذلك قلنا بأنّ الاستعمال ثُلاثي الأركان.
وأمّا المقام ، أعني : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، فليس هناك إلاّ ركنان :
أ : إطلاق اللفظ.
ب : انتقال المخاطب إلى الصورة الذهنية ثمّ انتقاله إلى نفس اللفظ الصادر ( الركن الأوّل ) مكان الانتقال إلى الركن الثالث ، أعني : الوجود الخارجي المغاير للّفظ.
وبعبارة أُخرى : انّ الاستعمال أمر ثلاثي ، وهو الانتقال من اللفظ إلى الصورة الذهنية له ، ومنها إلى الخارج ، ولكن الأمر هنا ثنائي ينتقل من اللفظ إلى الصورة الذهنية ومنها إلى اللفظ.
وبعبارة ثالثة : انّ هنا وجوداً خارجياً للّفظ وهو أمر تكويني قائم بالمتكلّم ، وصورة ذهنية له حاصلة في ذهن المخاطب ثمّ انتقال إلى اللفظ الصادر من المتكلّم من دون أن ينتقل إلى شيء ثالث ، فالمنتقل إليه وإن كان لفظاً خارجياً لكنّه ليس شيئاً ثالثاً.
فالمقام من قبيل إلقاء صورة الموضوع في ذهن المخاطب لينتقل منه إلى نفس الموضوع ثمّ يحكم عليه بأنّه كذا.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية وتبعه سيد مشايخنا البروجردي ذهب إلى أنّ هذا القسم من قبيل إلقاء نفس الموضوع في ذهن المخاطب ، ولعلّه من سهو القلم ، بل من قبيل إلقاء صورة الموضوع في ذهن المخاطب ، لأنّ الهوية الخارجية لا تنالها النفس ولا تقع في لوحها.
ومن ذلك يعلم أنّ المقام ليس من قبيل الاستعمال لما عرفت من أنّ الاستعمال ثلاثي الأركان والمقام من قبيل ثنائي الأركان.
وأمّا وصف القضية بالدال والمدلول فلا مانع منه ، فاللفظ بما انّه موجد للصورة في ذهن المخاطب دال ، وبما انّه يُنتقل من الصورة الذهنية إلى نفس ذلك اللفظ فهو مدلول ، كما أنّ الدلالة ليست من قبيل الدلالة الوضعية ، لأنّ الدلالة عبارة عن دلالة اللفظ على معناه الخارجيّ الذي هو غير الصورة الذهنية للّفظ وغير شخص اللفظ ولكن ليس في المقام وراء الأمرين شيء.
ثمّ إنّه لم يخالف في هذا القسم إلاّ صاحب الفصول وقد ذكر دليلاً لمنع صحّة الإطلاق نقله صاحب الكفاية وأجاب عنه ، ولكن أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه حيث إنّ الطبع السليم يستحسن هذا النوع من الإطلاق فمن أراد التفصيل فليرجع إلى محاضرات شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة.
٢. إطلاق اللفظ وإرادة مثله
كما إذا قال : زيد في قولك : زيد قائم ، لفظ وأراد اللفظ الصادر من المخاطب. لا شكّ في إمكانه إنّما الكلام في كون الإطلاق استعمالاً ، أو لا ، والحقّ
انّه استعمال حيث يكون زيد وسيلة وآلة للحاظ مماثله وتصوّره ، فيكون دالاً والمماثل مدلولاً ، فالمماثل هنا بمنزلة المعنى.
وإن شئت قلت : إنّ التلفّظ بلفظ « زيد » يكون سبباً لإيجاد الصورة الذهنية للفظ في ذهن المخاطب ، ثمّ هو ينتقل من تلك الصورة إلى الصورة المماثلة وهو أمر ثالث لا إلى نفس ذلك اللفظ حتى يكون من قبيل القسم الأوّل.
نعم هذا النوع من الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز ، لأنّ زيداً وضع للشخص الخارجي وإطلاقه وإرادة المماثل ليس استعمالاً فيما وضع له ولا في غير ما وضع له بنوع من العلاقة.
٣ و ٤. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ونوعه
المراد من الصنف هو النوع المحدود بقيود ، فإذا قال : زيد في ضرب زيد فاعل فقد حدّ طبيعة زيد بكونه بعد الفعل ، فأطلق لفظ زيد وأُريد منه صنف ذلك اللفظ وهو الواقع بعد فعل ضرب.
نعم الحكم لا يختص بزيد الوارد في الجملة ، بل يعمّه وكل ما ورد بعد فعل ضرب في كلام أيّ متكلّم كان.
وأمّا الرابع ، أعني : إطلاقه وإرادة النوع كما إذا قال : « زيد لفظ » وأراد منه نوع اللفظ لا خصوص ما تكلم ولا مثله ولا صنفه ، فزيد من أي متكلم صدر لفظ ولا شكّ في إمكان هذين الإطلاقين ، إنّما الكلام كونه استعمالاً أو لا؟ والظاهر حسب المعيار الذي عرفت أنّه من قبيل الاستعمال ، لأنّ المخاطب ينتقل من سماع زيد إلى الصورة الذهنية ومنه إلى أمر ثالث وهو زيد الواقع بعد الفعل أو طبيعة اللّفظ.
والحاصل : انّ ركن الاستعمال الذي يقوم على أركان ثلاثة موجود ، فانّ المخاطب ينتقل من الصورة الذهنية إلى مراد المتكلّم ، أعني : الصنف أو النوع وهو أمر ثالث.
وبما انّ هذه المقدّمة لا تمتّ إلى الأُصول بصلة وإنّما هي بحث أدبي ، اكتفينا بهذا المقدار.
فتحصّل ممّا ذكرنا : انّ القسم الأوّل ليس استعمالاً كما أنّه ليس من قبيل إلقاء نفس الموضوع ، بل إلقاء صورة الموضوع في ذهن المخاطب ، وأمّا الأقسام الثلاثة فهي من قبيل الاستعمال ، لأنّ المخاطب ينتقل بعد سماع اللفظ إلى الصورة الذهنية ومنها إلى الفرد المماثل أو الصنف أو النوع.
الأمر الخامس
في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
وقبل الخوض في المقصود ، نذكر أمرين :
الأوّل : ما هو السبب لطرح المسألة؟
عرّف المحقّق الطوسي في « منطق التجريد » ، الدلالةَ المطابقية : أنّها دلالة اللفظ على تمام المسمّى. والتضمنية : انّها دلالة اللفظ على جزئه.
وذكر العلاّمة في شرحه على « منطق التجريد » انّه أورد على المحقّق الطوسي الإشكال التالي وهو : انّ هذا التعريف غير مانع فيما إذا كان اللفظ مشتركاً بين الكلّ والجزء ، كما إذا كان لفظ الإنسان موضوعاً للحيوان الناطق تارة ولخصوص الناطق أُخرى فأطلق الإنسان وأراد الناطق ، فيصدق عليه انّه مطابقي ، لأنّه تمام الموضوع بالنسبة إلى الوضع الثاني ، وتضمني ، لأنّه جزء الموضوع بالنسبة إلى الوضع الأوّل.
ثمّ نقل العلاّمة عن المحقّق الطوسي أنّه أجاب عن الإشكال وقال : إنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه ، بل باعتبار الإرادة والقصد واللفظ ، فحينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني فهو يدلّ على معنى واحد لا غير. ثمّ قال العلاّمة : وفيه نظر. (١)
__________________
١ ـ الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد : ٤.
توضيح جواب المحقّق الطوسي هو : انّ المتكلّم إذا أطلق الإنسان وأراد الناطق فإن أراده بما انّه تمام المعنى فلا يصدق انّه معنى تضمني ، وإن أراد أنّه جزء المعنى فلا يصدق عليه انّه معنى مطابقي.
وقد أجاب المحقّق الطوسي بنفس هذا الجواب عن إشكال أُورد على تعريف المفرد حيث عُرّف المفرد بأنّه الذي ليس لجزئه دلالة أصلاً ، واعترض عليه بعض المتأخرين بلفظ « عبد اللّه » إذا جعل علماً لشخص فانّه مفرد مع أنّ لجزئه دلالة ما.
فأجاب عنه المحقّق الطوسي بأنّ دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجارية على قانون الوضع ، فما يتلفّظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى ، يقال له انّه دال على ذلك المعنى ؛ وما سوى ذلك المعنى ممّا لا تتعلّق به إرادة المتلفّظ ، لا يقال إنّه دالّ عليه ، وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه ، بحسب تلك اللغة أو لغة أُخرى أو بإرادة أُخرى ، يصلح لأن يدل به عليه.
وإذا ثبت هذا فنقول ، اللفظ الذي لا يراد بجزئه الدلالة على جزء معناه ، لا يخلو من أن يراد بجزئه ، الدلالة على شيء آخر أو لا يراد ، وعلى التقدير الأوّل لا تكون دلالة ذلك الجزء متعلّقة بكونه جزءاً من اللفظ الأوّل ، بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظاً برأسه دالاً على معنى آخر بإرادة أُخرى ، وليس كلامنا فيه ، فإذن لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزء دلالة أصلاً وذلك هو التقدير الثاني بعينه ، فحصل من ذلك انّ اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه لا يدل جزؤه على شيء أصلاً. (١)
والحاصل : انّه إذا تلفّظ بلفظ عبد اللّه ، فإمّا يتلفّظ به بما انّ جزء لفظه يدل
__________________
١ ـ شرح الإشارات : ١ / ٣١ ـ ٣٢.
على جزء معناه أو لا يدل ؛ فعلى الأوّل مركب خارج عن التعريف ، وعلى الثاني مفرد لا ينتقض به التعريف.
وعلى كلّ تقدير فالمحقّق الطوسي ممّن ذهب إلى أنّ دلالة اللفظ على المعنى موقوفة على إرادة المتلفّظ ذلك المعنى إرادة جارية على قانون الوضع ، إذ الغرض من الوضع تعدية ما في الضمير وذلك يتوقّف على إرادة اللافظ فما لم يرد المعنى من اللفظ لم تجد له دلالة عليه. (١)
الثاني : أشكال أخذ الإرادة جزءاً للمعنى
إنّ وضع اللفظ للمعنى المراد يتصوّر على وجوه :
١. أخذ الإرادة بالحمل الأوّلي ( مفهوم الإرادة ) جزءاً للمعنى.
٢. أخذ الإرادة بالحمل الشائع الصناعي ( مصداق الإرادة ) جزءاً للمعلوم بالذات.
٣. أخذ الإرادة بالحمل الشائع جزءاً للمعلوم بالعرض.
٤. أخذ الارادة بالحمل الشائع الصناعي بنحو القضية الحينية فـي الموضـوع له.
٥. أخذ الإرادة بالحمل الشائع الصناعي قيداً للوضع. هذه هي الوجوه المتصوّرة.
إذا عرفت هذين الأمرين ، فلنذكر حكم كلّ واحد من هذه الوجوه :
أمّا الوجه الأوّل ، فهو بديهي البطلان ، ولم يذهب إليه أحد.
وأمّا الثاني أي كون اللفظ موضوعاً للمعلوم بالذات ( الصورة الذهنية ) التي
__________________
١ ـ المحاكمات لقطب الدين الرازي في ذيل الإشارات : ١ / ٣٢.
تعلّقت بها الإرادة بالحمل الشائع ، فيلزم أن تكون القضايا إخباراً عن الأُمور الذهنية لا إخباراً عن الخارج ، لأنّ المعلوم بالذات الذي هو متعلّق الإرادة قائم بالذهن ، فالقيد والمقيد كلّها أُمور ذهنية وبالتالي لا ينطبق على الخارج.
وأمّا الثالث ، أي كون اللفظ موضوعاً للمعلوم بالعرض الذي تعلّقت به الإرادة عن طريق الصورة الذهنية (١) ، فهذا أيضاً يستلزم عدم إمكان حمل قائم على زيد الخارجي ، لأنّ الموضوع في « قائم » مركب من أمر خارجي ( المعلوم بالعرض ) وأمر ذهني ( تعلّق الإرادة به ) فلا يصحّ أن يقال : « زيد قائم » إلاّ بالتجريد ، فانّ القيام وإن كان موجوداً في الخارج إلاّ أنّ الإرادة التي وصف بها القيام عن طريق الصورة الذهنية أمر ذهني.
وأمّا الرابع ، أي كون الموضوع له المعلوم بالعرض حين تعلّقت به الإرادة على نحو لا يصدق اللفظ إلاّ على المعنى المراد وفي الوقت نفسه ليس كونه مراداً جزءاً للمعنى ، وهذا هو مفاد القضية الحينية.
توضيحه : انّ القضايا على أقسام ثلاثة :
أ : المشروطة ، مثل قولك : كلّ كاتب متحرك الأصابع مادام كاتباً ، فحركة اليد ثابتة للكاتب بشرط كونه كاتباً.
ب : المطلقة ، مثل قولك : كلّ كاتب متحرك الأصابع بالفعل ، أي في أحد الأزمنة الثلاثة ، فحركة اليد للكاتب على وجه الإطلاق.
ج : والحينية ، وهي نحو قولك : كلّ كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب ، فحركة اليد ثابتة للكاتب لا على وجه الإطلاق حتى يعم المحمول ( الحركة ) حالة
__________________
١ ـ وإنّما يوصف الخارج بكونه معلوماً بالعرض ، لأنّ الإنسان يصل إليه عن طريق الصورة الذهنية ، فتكون الأخيرة معلومة بالذات وما قبلها معلوماً بالعرض.
عدم الكتابة ولا على وجه التقييد حتى يؤخذ في الموضوع مادام كونه كاتباً ، ولكنه في الوقت نفسه لا ينطبق إلاّ على حال الكتابة ، فالمحمول في الحينية وإن كان مطلقاً غير مشروط لكنّه على نحو لا ينطبق إلاّ على المشروطة ؛ وهذا كما إذا رأيت زيداً معمّماً ، فالتعمّم ليس قيداً للمرئيّ ولا للرؤية ، ولكنّه لا ينطبق إلاّ على المعمّم وأنت ما رأيت إلاّ زيداً المعمّم ، وفي المقام ، اللفظ وضع لذات المعنى لكن حين كونها مراداً للمتكلّم واللافظ. وعلى ضوء ذلك لا يرد عليه ما أوردنا من انقلاب القضية الخارجية إلى الذهنية كما في الثاني ، ولا عدم انطباق القضية على الخارج كما في الثالث ، والحينية مع كونها نزيهة عما أورد على القسمين ولكنّها لا تنطبق إلاّ على المضيق وهو المعنى المراد.
يلاحظ عليه : بأنّ القضية الحينية وإن كانت رائجة بين المنطقيّين ولكن لم نتصور لها معنى محصلاً ، فانّ الكتابة في قوله : « حين هو كاتب » إمّا قيد للمحمول ( متحرك الأصابع ) فيكون من قبيل المشروط ، أو ليس قيداً له وللمحمول إطلاق ، فيكون من قبيل المطلقة العامة ، فما معنى هذا التذبذب بين المشروطة والمطلقة ، وإن نطق به المنطقيون؟
وبعبارة أُخرى : انّ القول بأنّ المحمول هو المتحرك المقترن بالكتابة لا بقيدها لا يخلو من إبهام ، لأنّ المحمول إمّا مقيد بالاقتران بالكتابة أو لا ، وعلى الأوّل تعود الحينية إلى المشروطة ، وعلى الثاني يكون المحمول مطلقاً صادقاً في كلتا الحالتين : حالة وجود الكتابة وعدمها.
وبذلك يظهر انّ قوله إنّ الموضوع له هي المعاني حالة كونها مرادة لا مقيداً بها لا يخلو إمّا أن تكون القضية مطلقة فتعم المرادة وغير المرادة ، أو مقيدة فيرجع إلى المشروطة.
وبعبارة أُخرى : انّ تمييز الحصة التوأمة بالإرادة عن الحصة غير التوأمة يحتاج إلى قيد حتى يوضع لاحدى الحصتين دون الأُخرى. ومعه يرجع إلى المشروطة.
وأمّا الخامس : فهو خيرة المحقّق الإصفهاني فقال : العلقة الوضعية متقيدة بصورة الإرادة الاستعمالية وفي غيرها لا وضع ، وما يرى من الانتقال إلى المعنى بمجرّد سماع اللفظ من لافظ غير شاعر فمن جهة أُنس الذهن بالانتقال من سماعه إلى إرادة معناه. (١)
توضيح ما ذكره : هو أنّ الوضع فعل اختياري للواضع ، وكلّ فعل اختياري لابدّ له من غاية ، فالعلّة الغائية تضيق جانب الفعل وتحدده وتخصه بصورة وجوده الغاية وهو الإفادة والاستفادة أو إبراز ما في الضمير.
يلاحظ عليه : أنّ الغرض من الوضع وإيجاد العلقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى ، هي بيان الحقائق الواقعية بما هي هي لا ما وقعت في أُفق الإرادة ، فإذا قال القائل : « الماء جسم رطب سيال » ، فانّه يريد بيان الحقيقة الخارجية وانّ ذلك العنصر بما هو هو لا بما انّه واقع في ذهن القائل ، فإذا كانت الغاية محددة للفعل فالغاية هي بيان الحقائق وهو يوجب إطلاق العلقة الوضعية وعدم تقيّدها بإرادة المتكلّم.
بقي هنا أُمور :
الأوّل : انّ الدلالة تنقسم إلى : تصورية ، وتفهيمية ، وتصديقية.
أمّا الأُولى : فهي عبارة عن دلالة اللفظ على معناه عند سماعه ، وربّما يعبّر عنها بالدلالة الوضعية ، وهي لا تتوقف على شيء ما عدا العلم بالوضع ، ولأجل
__________________
١ ـ نهاية الدراية : ١ / ٢٣.
ذلك ينتقل الذهن إلى المعنى بمجرّد السماع ولو من لافظ غير شاعر.
وأمّا الثانية : أعني الدلالة التفهيمية ، فهي عبارة عن دلالة اللفظ على أنّ المتكلّم أراد تفهيم المعنى للغير ، وهذه الدلالة تتوقّف وراء العلم بالوضع على أنّ المتكلّم في مقام التفهيم ، لا في مقام تمرين الخطابة وأمثالها أو تعلم اللغة.
وأمّا الثالثة : أي الدلالة التصديقية ، فهي عبارة عن دلالة اللفظ على أنّ الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجديّة ، وهي تتوقف وراء الأمرين على أمر ثالث وهو أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية. وهذا الأصل وما قبله أي كونه بصدد التفهيم من الأُصول العقلائية إذا لم يقم دليل على خلافه.
الثاني : انّ المحقّق الخراساني لما قال بوضع الألفاظ للمعاني الواقعية حاول تأويل الكلام المنقول عن العلمين الطوسي والحلي ، بأنّ مرادهما من تبعية الدلالة للإرادة ، هو الدلالة التصديقية ولذلك لا يصحّ لنا أن نُسند مضمون الكلام إلى شخص ما لم يُحرز أنّه أراد ذلك المعنى ، وعليه لو تكلّم مورّياً أو تقيّة أو لغير ذلك لا يصحّ أن يسند مضمونه إليه.
أقول : ما ذكر من تبعية الدلالة التصديقية لإرادة المتكلّم وإن كان صحيحاً لكنّه ليس نظرية خاصّة للعلمين ، بل هي ممّا لم يختلف فيه اثنان ، فاشتمال كلامهما على التبعية ناظر إلى معنى آخر وهو تبعية الدلالة التصورية أو الوضعية للإرادة. وعذر المحقّق الخراساني في هذه النسبة ، عدم مراجعته لكلامهما في محلّه.
الثالث : انّ كلّ من فسّر الوضع بالتعهد والالتزام وقال إنّه عبارة عن التعهد بأنّ كلّما أطلق اللفظ أراد منه المعنى الخاص لا مناص له عن القول باختصاص الدلالة الوضعية بصورة قصد التفهيم وإرادة المعنى من اللفظ.
لأنّ الالتزام أو التعهد الذي هو مقوّم الوضع إنّما يتعلّق بالأمر الاختياري ،
وما هو تحت اختيار الواضع هو ذاك ( كلّما أطلق اللفظ أراد منه المعنى ) ، وأمّا الالتزام بكون اللفظ دالاً على معناه ولو صدر منه عن غير شعور أو اختيار ، فلا يعقل أن يكون طرفاً للالتزام والاختيار.
وبالجملة : إنّما يتعلّق الالتزام بفعل الإنسان لا بفعل غيره. وفي أفعال النفس يتعلّق بالاختياري منها لا بالخارج عنه ، كالنطق نائماً أو ساهياً.
الأمر السادس
في وضع المركّبات
ربّما نسب إلى بعض الأُدباء القول بوضع خاص للمركّبات وراء المفردات.
توضيحه : انّ قولنا « زيد إنسان » حاو لأوضاع ثلاثة ، فللموضوع وضع ، وللمحمول وضع آخر ، وللهيئة وضع ثالث ، فنسب إلى بعض الأُدباء انّه يقول : إنّ هنا وضعاً رابعاً وهو وضع مجموع المادة والهيئة ، وربّما يتجاوز عدد الأوضاع عن الأربعة إلى الخمسة ومن خمسة إلى ستة ، مثلاً : قولنا : « زيد قائم » للمحمول وضعان : وضع للمادة ، ووضع للهيئة مضافاً إلى وضع المبتدأ والهيئة ، فيكون وضع المجموع وضعاً خامساً.
ولو كان لكلّ من الموضوع والمحمول وضع ، كقولنا : « الضارب متعجب » ينتهي عدد الوضع إلى ستة وهكذا يزداد عدد الأوضاع.
فسواء أصحت النسبة إلى بعض الأُدباء ( كما يظهر من شرح المفصّل لابن مالك انّ لهذا القول قائلاً ) أم لم تصح فالقول بوضع المجموع ساقط ، وذلك للوجوه التالية :
١. انّوضع المجموع أمر لغو ، لأنّ وضع المفردات والهيئة الاسمية كافيتان في إفادة المراد من دون حاجة إلى وضع المجموع من حيث المجموع.
٢. ما ذكره ابن مالك في شرحه على المفصل ، وقال : إنّه لو كان للمجموع