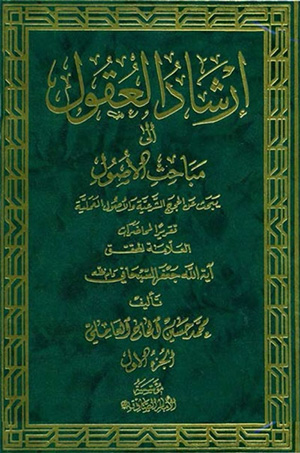الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-077-0
الصفحات: ٦٢٨
السادس : انّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوصَ الصحيحة لزم إشكالان :
الإشكال الأوّل : عدم إمكان حنث الحلف ، لأنّ الحنث يتحقّق بالصلاة الصحيحة ، وهي غير مقدورة بعد نهي الشارع.
الإشكال الثاني : يلزم المحال ، لأنّ المنذور حسب الفرض تعلّق بالصحيحة ، ومع النذر لا تقع صحيحة ، فيلزم من فرض تعلّق النذر بالصحيحة عدم صحّتها.
أقول : إنّ الإشكال مشترك بين الصحيحي والأعمّي ، لأنّ متعلّق النذر على كلا القولين هو الصحيح لا الأعم ، لأنّ المنذور ليس ترك الأجزاء الرئيسية ، ولا الصورة المعهودة المشتركة بين الصحيح والفاسد ، فما هو الجواب عند الأعمّي هو الجواب عند الصحيحي. إذا عرفت ذلك فنقول :
الأوّل : ما أجاب به المحقّق الخراساني ، وقال : لو صحّ ذلك لاقتضى عدم صحّة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعاً.
مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. (١)
أقول : أمّا الجواب الأوّل فواضح لا سترة عليه.
وأمّا الجواب الثاني : فحاصله أنّ النذر منعقد ، والصلاة باطلة ، والحنث متحقق ، وما ذلك إلاّ لأنّ النذر تعلّق بما هو الصحيح في نفسه لا الصحيح من الجهات الطارئة عليه ، والصلاة في الحمام بعد تعلّق النذر بتركها ، صحيحة في حدّ نفسها على وجه لو أتى بها في البيت أو المسجد لكانت صحيحة بالفعل ، وإن
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٤٨.
كانت بعد تعلّق النذر باطلة بالفعل.
بعبارة أُخرى : أنّ للصلاة في الحمام بعد تعلّق النذر بتركها نحوين من الصحة.
أ : كونها صحيحة في حدّ نفسها ، أي تامّة الأجزاء والشرائط ، وهذه هي المنذور تركها.
ب : ما هو الصحيح بالفعل وبالحمل الشائع ، وهو لم يتعلّق به النذر.
وعلى ضوء ذلك فالنذر منعقد لرجحان ترك تلك الصلاة ، والحنث محقّق لأنّه أتى بالمنذور تركها أعني الصلاة الصحيحة في حدّ ذاتها ، وفي الوقت نفسه هي باطلة بالحمل الشائع لتعلّق النهي بها وليست بمبرئة للذمة.
نعم لو تعلّق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل نمنع انعقاد النذر كما نمنع حصول الحنث بفعلها ، لأنّ ما أتى به ليس بصحيح بالفعل.
الثاني : ما أفاده المحقق البروجردي ، وحاصله : منع انعقاد النذر من رأس ، بدليل أنّ صرف المرجوحية الإضافية لا يكاد يكون مصححاً لتعلّق النذر بتركه ، وإلاّ فمن الجائز شرعاً تعلّق النذر بترك الصلاة في البيت لمرجوحيتها بالإضافة إلى الصلاة في المسجد ، ولا أظـن أن يلتزم به أحـد في الفقه ، فالصلاة في الحمام أيضاً كذلك فانّها ليست مرجوحة في حدّ نفسها بل هي مرجوحة بالقياس إلى غيرها مـن أطراف التخيير ، واللازم في صحّة النذر بالتـرك هو المرجـوحية الذاتية ، وأظـن أنّ الجمود على لفظ الكراهة في الصلاة في الحمام ممّا أوجب القول بصحّة النذر بتركها.
وبعبارة أُخرى : المراد من كراهة الصلاة في الحمام هو كونها أقلّ ثواباً لا أنّ فيها حزازة ذاتية حتى يصحّ تعلق النذر بتركها ، وأمّا الأقلية فلا تكون مسوغة لتعلّق النذر ، وإلاّ لزم صحّة تعلق النذر بترك الصلاة في البيت أو في مسجد
المحلة لكونهما أقلّ ثواباً بالنسبة إلى المسجد الجامع. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الكراهة في المقام هي من قبيل القسم الثاني ، أي كونها ذات حزازة ، فانّ الحمام محل الأوساخ والقذارات فإقامة الصلاة فيها أشبه بسقي المولى بماء عذب في وعاء قذر ، فقياس الصلاة في الحمام بالصلاة في البيت قياس مع الفارق ، ولذلك يتعلّق النذر بتركها في الحمام دون الثاني.
الثالث : ما أفاده المحقّق الحائري وتبعه سيدنا الأُستاذ وحاصل كلامهما بإيضاح منّا : أنّ النذر صحيح والصلاة صحيحة بالفعل والحنث واقع.
أمّا الأوّل : فلما عرفت من وجود الحزازة في الصلاة المأتي بها في الحمام فيصحّ تعلّق النذر بتركها كما يصحّ تعلّق النذر بترك سائر المكروهات.
وأمّا الثاني : أي كون الصلاة صحيحة بالفعل فلتعدد متعلّق الأمر في الصلاة والنهي عن الحنث ، فالأمر تعلق بطبيعة الصلاة بما هي هي من دون أن يتعدّى الأمر عن متعلقه إلى شيء آخر ، كما أنّ النهي تعلّق بعنوان الحنث ، فالصلاة المأتي بها في الحمام مصداق ذاتي للصلاة ومصداق عرضي للحنث ، وقد ثبت في محله جواز اجتماع الأمر والنهي بين عنوانين بينهما من النسبة عموم وخصوص من وجه ، فالصلاة المأتي بها مصداق للواجب بالذات كما هي مصداق بالعرض للمنهي عنه.
وأما الثالث : أي تحقّق الحنث لأنّ المفروض هو جواز اجتماع الأمر والنهي على شيء وعدم مزاحمة الأمر للنهي ، فهو صحيح بالفعل وقد حنث به نذره.
إلى هنا تمّت أدلة القائلين بالأعم ، وقد عرفت سقم الجميع وعدم نهوضها على المدّعى ، بقي الكلام في ثمرات المسألة وهذه هي التي سنوضحها في الجهة الآتية.
__________________
١ ـ نهاية الأُصول : ٥٤ ، الطبعة الثانية.
الجهة السابعة
في ثمرات المسألة في مورد العبادات
قد ذكر للمسألة ثمرات أربع نذكر واحدة منها :
جواز التمسّك بالإطلاق
وحاصل الثمرة : صحّة التمسك بالإطلاق على القول بالأعمّ وعدمها على القول بالصحيح.
وذلك لأنّ الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته ، عند الأعمّي يرجع إلى الشك في كونه داخلاً في المأمور به أو لا ، بعد إحراز الموضوع ، أعني : الجامع بين الصحيح والفاسد.
بخلاف الشكّ عند الصحيحي فانّ الشكّ فيهما يرجع إلى الشكّ في صدق الموضوع وعدمه ، ومع الشكّ فيه لا يجوز التمسّك بالإطلاق.
وجهه : أنّ الأركان الأربعة ـ مثلاً ـ تشكِّل عند الأعمي تمام المسمّى ، فيكون محرزاً باحرازه ، فيرجع الشك في جزئية الاستعاذة إلى الشك في كونه جزءاً للمأمور به أو لا بعد إحراز الموضوع فتنفى جزئيته بالإطلاق.
وأمّا عند الصحيحي ، فما وجب من جليل ودقيق فهو عنده داخل في المسمّى ، وليس عنده من التقسيم المزبور عين ولا أثر. مثلاً الشك في جزئية
الاستعاذة ، يرجع إلى الشكّ في دخوله في المسمّى وعدمه ، ومع هذا الشك يكون الموضوع مشكوك الإحراز ، ومعه لا يصحّ التمسّك بالإطلاق ، فانّ التمسّك فرع إحرازه وتعلّق الشك بالطوارئ والعوارض كشرطية الإيمان في الرقبة.
وردّت الثمرة بوجوه ثلاثة :
الوجه الأوّل : أنّ الصحيحي وإن كان لا يتمكن من التمسّك بالإطلاقات اللفظية لكن بإمكانه التمسّك بالإطلاقات البيانية نظير الإطلاق الوارد في صحيحة حمّاد حيث قام الإمام وصلّى ركعتين وبيّن ـ عملاً ـ أجزاء الصلاة وشرائطها (١) ، فإذا شكّ في وجوب الاستفادة فيتمسّك بهذا الإطلاق المسمّى بالإطلاق البياني.
يلاحظ عليه : أنّ ذلك خروج عن محط البحث ، فانّ الثمرة في المسألة هي جواز التمسّك بالإطلاقات اللفظية وعدمها ، وأمّا الإطلاقات البيانية فالصحيحي والأعمي أمامها سواسية.
الوجه الثاني : أنّ الثمرة عديمة الفائدة ، لأنّ المطلقات الواردة في الكتاب لا يجوز التمسّك بها لعدم ورودها في مقام البيان ، فقوله : « أقيموا الصلاة » نظير قول القائل « الغنم حلال » فكما لا يجوز التمسّك بإطلاق قوله : « الغنم حلال » على حلية المغصوب والجلاّل والموطوء لعدم كونه في مقام البيان ، فهكذا الحال في إطلاقات الكتاب ، فانّها في مقام بيان أصل الحكم والتشريع لا في مقام بيان الخصوصيات ، وعندئذ فالصحيحي والأعمّي أمامها سيّان فلا يجوز التمسّك على كلا القولين ، غاية الأمر أنّ الصحيحي ليس له التمسّك لوجهين : إجمال الموضوع ، وكون الخطاب في غير مقام البيان ، والأعمي لوجه واحد.
__________________
١ ـ الوسائل : الجزء ٤ ، الباب ١من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره وإن كان صحيحاً في قسم من إطلاقات الكتاب العزيز غير أنّ بعضها في مقام البيان مثلاً قوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الَّذين آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُُمُ الصِّيام ) (١) في مقام البيان بشهادة انّه سبحانه يأخذ ببيان الجزئيات والتفاصيل ويقول : ( أَيّاماً مَعْدُودات فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخر ) (٢) كما أنّه يأخذ ببيان مبدأ الإمساك ونهايته ويقول : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبيضُ مِنَ الخَيطِ الأَسود ) (٣) فعلى هذا فلو شكّ في مدخلية ترك الارتماس في حقيقة الصيام فعلى القول بالصحيحي يكون مرجع الشكّ إلى صدق المسمّى ، وأمّا على القول بالأعمّي يكون مرجع الشكّ إلى جزئية أو شرطية أمر زائد وراء المسمّى فيتمسّك بإطلاق الآية ويثبت عدم مدخليته.
الوجه الثالث : أنّ الأعمّي أيضاً لا يصحّ له التمسّك بالمطلقات ، لأنّ المسمّى وإن كان الأعم لكن المأمور به هو القسم الصحيح فكلما شكّ في جزئية شيء أو شرطيته فهو شكّ في تحقّق الصلاة الصحيحة.
يلاحظ عليه : أنّ المستشكل خلط بين كون المأمور به ذات الصحيح أو المقيّد بعنوان الصحيح ، فعلى الأوّل إذا كان المسمّى محرزاً ـ كما هو المفروض عند القول بالأعم ـ وشكّ في جزئية شيء أو شرطيته يتمسّك بالإطلاق لإحراز ذات الصحيح لأجل كون الشكّ في شرطية شيء وراء صدق المسمّى.
وأمّا على الثاني فبما أنّ المأمور به مقيد بعنوان الصحّة فيجب على المكلف إحراز ذلك العنوان ويعود الشكّ إلى الشكّ في وجود جزء الموضوع فلا يحرز إلاّ بالإتيان بالمشكوك ، نظير المقام.
وبعبارة أُخرى : فرق بين أمر المولى بتهيئة معجون وعلمنا أنّ مراده هو
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٣.
٢ ـ البقرة : ١٨٤.
٣ ـ البقره : ١٨٧.
المعجون الصحيح ، وبين أمره بتهيئة معجون مقيّد بالصحّة ، فلو شكّ في مدخلية السكر فيه يصحّ التمسّك بالإطلاق على القول الأوّل لإحراز كونه معجوناً ، وإنّما الشكّ في جزئية شيء زائد على المعجون ، وأمّا على الثاني فالشكّ في صدق الموضوع ، لأنّ المأمور به هو المعجون المقيّد بعنوان الصحّة ، فكما يجب على العبد إحراز كونه معجوناً كذلك يجب إحراز كونه صحيحاً ، فالجزء الأوّل وإن كان محرزاً لكن الجزء الثاني بعد ليس محرزاً.
إلى هنا تبيّن أنّ الإشكالات الثلاثة الموجّهة إلى الثمرة الأُولى غير واردة.
نعم يرد على تلك الثمرة إشكالان آخران :
أ : قد عرفنا فيما ذكرنا أنّ ألفاظ العبادات كلّها مستعملة في لسان الشارع فيما هو الموضوع له من أوّل الأمر في العصور السابقة على الإسلام ، إذ ليست هذه الماهيات العبادية من مخترعات الشريعة الإسلامية ، بل كانت موجودة بين العرب قبل الإسلام ، وإنّما تصرّف فيها الشرع المقدس بإضافة بعض الخصوصيات. وعلى ذلك فالموضوع له الذي وضعت بازائه هذه الألفاظ محرز عند الشكّ في وجوب الاستعاذة على كلا القولين ، فيرجع الشكّ على كلا المبنيين إلى الشكّ في جزئية شـيء زائـد أو شرطيتـه ، فيجوز التمسّك بالإطلاقات على القول بالصحيـح والأعمّ.
ب : انّ ما ذكر ليس ثمرة أُصولية ، لأنّ الثمرة الأُصولية ما تقع كبرى في عملية الاستنباط ، وأمّا المقام فانّ غايته كشف وجود الإطلاق على القول بالأعم دونه على الصحيح ، وهذا أشبه بمبادئ المسائل الفقهية ، فالقول بوجود الإطلاق على الأعمّي دون الصحيحي كالقول بوجود الخبر في موضوع دون موضوع فلا يعد ثمرة لمسألة أُصولية.
وأمّا الثمرات الثلاث الباقية فقد طوى عنها الكلام شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ في هذه الدورة وقد أشبع الكلام فيها في الدورات المتقدّمة. (١)
الجهة الثامنة
في أسماء المعاملات
وتحقيق المقام رهن أُمور :
الأوّل : لمّا كانت العبادات من مخترعات الشارع ومعتبراته يصحّ فيها البحث في أنّ ألفاظها هل هي موضوعة للصحيح أو الأعمّ منها؟ لأنّ الموضوع له من مخترعاته ، وهو الذي وضع لفظ العبادة في مقابلها ، وهذا بخلاف المعاملات ، فانّها ليست من مخترعاته بل من مخترعات العقلاء وهم الذين وضعوا ألفاظ المعاملات في مقابل ما اعتبروه بيعاً أو نكاحاً أو إجارة وليس للشارع دور فيها ، سوى تحديدها بحدود وقيود ، وعلى ذلك فلا معنى للقول بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة في الشرع للصحيح أو الأعم ، بل لو صحّ طرحه فلابدّ أن يقال هل المعاملات موضوعة ـ عند العرف والعقلاء ـ لخصوص الصحيح أو الأعم؟
الثاني : ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النزاع في أنّ أسماء المعاملات وضعت للصحيح أو للأعم إنّما يتأتى على القول بوضعها للأسباب دون القول بوضعها للمسببات ، وذلك لأنّ المسبب أمر بسيط دائر أمره بين الوجود والعدم ،
__________________
١ ـ وقد سها قلم زميلنا السيد الجلالي ( حفظه اللّه ) في تقرير الثمرة الثالثة ، والتقرير الصحيح ما يلي : إذا نذر أن يعطى درهماً للمصلّـي فعلى القول بوضعها للصحيح لا يفي بنذره ولا تبرأ ذمّته إلاّ إذا دفع إلى من صلّى صلاة صحيحة ، بخلافه على القول الآخر فتبرأ ذمّته بالدفع إلى كلّ من صلّى ، صحيحة كانت صلاته أم فاسدة. ( المؤلف ).
فالعلقة الحاصلة في البيع والنكاح إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة ، ولا معنى لأن تكون متحقّقة فاسدة ، وهذا شأن الأُمور الاعتبارية البسيطة وهي بين الوجود والعدم ولا واسطة بينهما ، فعلى هذا لو عقد بالفارسية أو كان العاقد غير بالغ ، فعلقة الزوجية إمّا موجودة فتكون صحيحة ، أو غير موجودة.
نعم لو قلنا بوضعها للأسباب فللنزاع فيه مجال ، وذلك لأنّ الأسباب مركبة من أجزاء وشرائط كالإيجاب المتعقّب للقبول مع صدورهما من عاقل بالغ إلى غير ذلك من الشروط ، فيمكن أن يقال بأنّه هل وضعت للمركّب التام من الأسباب عند العرف للأعم. (١)
الثالث : أنّ اختلاف الشرع والعرف في اعتبار سبب وعدمه ـ في عالم الثبوت ـ كبيع المنابذة هل يرجع إلى الوحدة في المفهوم والاختلاف في المصداق كما عليه المحقّق الخراساني أو يرجع إلى الاختلاف في نفس المعتبر؟ (٢) ، فالمعتبر عند الشرع في عالم الثبوت غير المعتبر عند العرف.
استدلّ المحقّق الخراساني على مختاره بقوله :
لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً وانّ الموضوع له هو العقد
__________________
١ ـ ولكن يمكن أن يقال : انّ النزاع لا يجري حتى على القول بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب مثل عدم جريانه على القول بوضعها للمسببات ، وذلك لأنّ أمر الاعتبار يدور أمره بين الوجود والعدم ، فلو كانت العربية معتبرة في العقد ـ عند المعتبر ـ يختصّ اعتبار السببية بها ، ولا يكون غيرها سبباً أصلاً ، لا انّه يكون سبباً فاسداً لأنّ معناه انّه اعتبره لكن بوصف الفساد ، وهو بعيد عن عالم الاعتبار ، فانّه لو ترتب الأثر عليه ، يكون معتبراً ، وإلاّ فلا يعتبره ويحذفه عن قاموس حياته.
٢ ـ قلنا في المعتبر لا الموضوع له لما سيوافيك من أنّ ألفاظ المعاملات في الأدلّة الامضائية موضوعة ومستعملة في الصحيح عند العرف ، وبذلك يتبين انّ هذا البحث راجع إلى مقام الثبوت. وانّ الأولى التعبير بوحدة المعتَبر وعدمها ، لا وحدة الموضوع له ، لما عرفت من أنّه ليس للشارع دور في وضع ألفاظ المعاملات. ( المؤلّف )
المؤثر لأثر كذا شرعاً وعرفاً ، والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محقِّقاً لما هو المؤثر كما لا يخفى. (١)
يلاحظ عليه : بأنّه لو كان المعتبر عند العرف والشرع هو العقد المؤثر « لأثر كذا » كان لما ذكره وجه ويلزم وحدة المعتبر ويرجع الاختلاف إلى المصاديق ويصحّ للشرع أن يخطِّئ العرف تخطئة مصداقية.
وأمّا إذا كان المعتبر أمراً تفصيلياً مثل : الإيجاب والقبول اللفظيين المتعاقبين الصادرين من بالغ عاقل ، فعندئذ يكون عدم اعتبار جزء من أجزاء هذا المعتبر اختلافاً في نفس المعتبر ، لا وحدة في المعتبر واختلافاً في المصداق.
أضف إلى ذلك أنّ التخطئة في المصداق إنّما تصحّ في الأُمور التكوينية التي يكون لها واقع محفوظ فبالقياس إليه يشار إلى أنّ هذا مصداق له وذاك ليس بمصداق كقوله « الفقاع خمر ، هي خمرة استصغرها الناس ». (٢)
وأمّا الأُمور الاعتبارية التي لا واقع محفوظ لها ، وانّ محورها نفس الاعتبار ، فلا يصحّ لمعتبِـر أن يخطِّئ اعتبار معتبر آخر. لأنّ لكلّ معتبر سلطاناً في عالم الاعتبار حسب معاييره.
الرابع : قد عرفت أنّ النزاع في وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو الأعم إنّما يأتي على القول بوضعها للأسباب دون المسببات إذ الأُولى توصف بالصحّة عند اجتماع جميع أجزائها وبالصحّة عند فقدان بعضها ، فعلى ذلك فهي قابلة
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٤٩.
٢ ـ الكافي : ٦ / ٤٢٣ ، باب الفقاع ، الحديث ٩١.
للوضع لأحد المعنيين ثبوتاً ، وإمّا إثباتاً فهي موضوعة للسبب الصحيح لما عرفت من أنّ الغرض يحدد فعل الإنسان فلا يصدر عنه فعل أوسع من غرضه ، وبما أنّ الداعي لاعتبار المعاملات ووضع اللفظ لها ، هو المصالح التي تترتب عليها وتدور عليها رحى الحياة ، فلابد أن يدور اعتباره ثبوتاً ووضع اللفظ إثباتاً ، مدار وجود الاغراض الداعية ، وهي منحصرة بالصحيح من الأسباب دون الفاسد منها ، فيكون الاعتبار والوضع منحصرين به ، فخرجنا بالنتائج التالية :
أوّلاً : اختصاص النزاع في أسماء المعاملات بالعرف دون الشرع.
ثانياً : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح العرفي.
ثالثاً : أنّ اختلاف الشارع والعرف في اعتبار سبب وعدمه يرجع إلى الاختلاف في نفس المعتَبر ، حيث إنّ الشارع اعتبر في عالم الثبوت وجود اللفظ في الأسباب والقبول ولم يعتبره العرف ، وهذا يرجع إلى الاختلاف في المعتبر لا الوحدة في نفس المعتبر والاختلاف في المصداق.
الخامس : في وجه التمسّك بالإطلاقات والأدلّة الإمضائية بعد القول بأنّ أسماء المعاملات وضعت عند العرف للصحيح دون الأعم ، وهذا هو بيت القصيد في هذا المبحث فعلى الفقيه الذي يتمسّك بالأدلة الإمضائية في مقام الشك في التخصيص أو اعتبار قيد أو شرط أن يثبت أنّ القول بوضع الألفاظ للصحيح عند العرف لا يمنع من التمسّك بها ، فيقع البحث في مقامين :
المقام الأوّل : لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات وضعت للأسباب الصحيحة عرفاً فهل يجوز التمسّك بالإطلاق أو لا؟
وبعبارة أُخرى : إذا قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسام للأسباب الصحيحة ، فهل يكون ذلك مانعاً من التمسك بإطلاقات الأدلة الإمضائية عند الشكّ في
صحّة سبب وفساده ، كتقدم القبول على الإيجاب ، أو إجراء الصيغة بلفظ المضارع أو لا؟
التحقيق أنّه لا يكون مانعاً ويترتب عليه صحّة التمسّك بها.
أمّا على مذهب المحقّق الخراساني من اتفاق العرف والشرع فيما هو السبب للملكية أو علقة الزوجية ، وإنّماالاختلاف يرجع إلى التخطئة في المصداق ، فظاهر ، لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان يُنزَّل على أنّ المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً ، ولذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. (١)
وأمّا على المختار من أنّ اختلاف الشارع والعرف في بعض الأسباب إنّما هو من حيث المعتَبر لا من باب الاختلاف في المصداق ، فربما يشكل التمسّك ، لأنّ مرجع الشكّ إلى التمسّك بالعام عند الشبهة المصداقية له ، وإلى هذا الإشكال يشير الشيخ الأعظم في آخر تعريف البيع حيث قال : ويشكل بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق نحو « أحل اللّه البيع » وإطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء منها مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات. (٢)
أقول : الحقّ جواز التمسّك على هذا القول أيضاً ، ويعلم ذلك بأمرين :
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٥٠.
٢ ـ المتاجر : ٨٠ ، آخر تعريف البيع.
١. انّ المعتبر عند الشارع وإن كان يختلف مع المعتبر عند العرف ، لكن الاختلاف ليس بالتباين بل بالأقل والأكثر ، والمفهوم الشرعي لأجل زيادة القيود أضيق من المفهوم العرفي.
٢. انّك قد عرفت أنّه ليس للشارع في باب المعاملات دور فالأسباب والمسببات ووضع اللفظ في مقابل الأسباب كلّها من العرف والعقلاء ، وعندئذ فإذا قال الشارع : « أوفوا بالعقود » فمعنى ذلك أوفوا بالأسباب الصحيحة العرفية ، غاية الأمر أنّ الأمر بالوفاء بعامة العقود إنّما هو بالإرادة الاستعمالية ، فلو افترضنا مورداً ما لم تتعلق به الإرادة الجدية كبيع المنابذة الذي هو بمعنى تعين المبيع برمي الحجارة على قطيع غنم بإصابة شاة معينة ، يشير إليه الشارع بقوله : « لا منابذة في البيع » فإذا سكت فيعلم أنّ السبب الصحيح عند العرف هو السبب الصحيح عند الشرع.
وبعبارة أُخرى : يتخذ السبب الصحيح عرفاً مرآة وطريقاً إلى السبب الصحيح شرعاً ، وإلاّ تلزم لغوية الخطابات الإمضائية ، وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ الأعظم في آخر تعريف البيع ويقول : وأمّا وجه تمسّك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه فلأنّ الخطابات لما وردت على طبق العرف ، حُمِل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، أو على المصدر الذي يراد من لفظ ( بعت ) فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثراً في نظر الشارع أيضاً. (١)
والحاصل : انّ المهم في المقام هو أنّ القول بوضع الألفاظ للصحيح لا يوجب إجمال الأدلة الإمضائية ، ولو قلنا بالإجمال في العبادات ـ على وجه الفرض ـ
__________________
١ ـ المتاجر : ٨٠ ، آخر تعريف البيع.
فلا نقول به في المقام لما عرفت من أنّه ليس للشارع دور في اختراع المعاملات ولا أسبابها ولا في وضع ألفاظها لها ، بل كلّها بيد العرف غير أنّ الشارع إذا تكلم إنّما يتكلم بلسان العرف ، فإذا أمضى العنوان الذي هو اسم للسبب الصحيح عرفاً يكون معناه أنّه كذلك عند الشرع ، فإذا شكّ في سببية شيء كعقد غير البالغ ، فلو كان سبباً عرفاً نستكشف انّه أيضاً سبب شرعاً ، أخذاً بحديث المرآتيّة ، وإلاّ كان عليه التصريح بعدم السببية كما صرح في باب الطلاق وعيّن السبب المعيّن وهو أن يقول المطلّق : « أنت طالق ».
المقام الثاني : إذا قلنا بوضعها للمسببات ، أعني : الملكية الحاصلة من العقد ، وعلقة الزوجية الحاصلة من الإيجاب والقبول ، فشككنا في صحّة واحد من المعاملات ، فالشك في الصحّة يتجلّى على قسمين ، فتارة يكون الشكّ نابعاً من احتمال خروج عنوان عن الإطلاقات ، وأُخرى يكون الشكّ نابعاً من جزئية شيء أو شرطيّته في أسبابها.
أمّا الأوّل : فيجوز التمسّك بالإطلاقات والأدلّة الإمضائية ، لأنّ الشرع إذا أمضى المسبب العرفي وكان الفرد المشكوك واجداً للمسبب حسب نظر العرف ، فبحكم الإطلاق يحكم ببقاء الفرد المشكوك تحته. كما إذا شكّ في خروج البيع الربوي في غير المكيل والموزون كالمعدود والمذروع والمشاهد عن تحت إطلاق قوله تعالى : ( أحل اللّه البيع ) فيحكم ببركة إطلاق الأدلة الإمضائية بعدم خروجها عن المسبب الممضى على وجه الإطلاق.
وأمّا الثاني : إذا كان الشكّ في صحّة المسبب نابعاً من احتمال مدخلية شيء في السبب كمدخلية البلوغ في العاقد ، وتقدّم الإيجاب على القبول في العقد ، فالشكّ في صحة النكاح والبيع بالمعنى المسببي ، نابع عن شرطية البلوغ أو تقدّم
الإيجاب على القبول في السبب ، فهل يمكن رفع الشكّ عن ناحية السبب بالتمسّك بالإطلاق المنصبّ على إمضاء المسبب العرفي أو لا؟
ذهب المحقّق النائيني إلى القول الثاني ، وحاصل كلامه : أنّ إمضاء المسبب كما هو المفروض ( لافتراض أنّ أسماء المعاملات اسم للمسبب دون السبب ) لا يكون دليلاً على إمضاء السبب ، قال قدسسره : انّه إذا كان إمضاؤه للمسببات أي للمعاملات التي هي رائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة ، مع قطع النظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها ، كما في قوله تعالى : ( وأحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ) فانّه في مقام بيان أنّ المعاملات الربوية ـ من دون نظر إلى الأسباب ـ غير ممضاة في الشريعة ، بخلاف المعاملة البيعية ، فالإطلاق لو كان وارداً في هذا المقام فلا يدل على إمضاء الأسباب العرفية ، وذلك لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب وإمضاء السبب ، إلاّ فيما إذا كان له سبب واحد فانّ إمضاءه لمسببه يستلزم إمضاءه لا محالة وإلاّ كان إمضاؤه لغواً ، وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقّن فإنّ نسبة المسبّب حينئذ إلى الجميع على حدّ سواء فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض ، وفي غير هاتين الصورتين لابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وفي الزائد يرجع إلى أصالة العدم. (١)
ثمّ إنّه قدسسره أجاب عن الإشكال بجواب فلاحظه. (٢)
والأولى أن يجاب بوجهين :
أ : وجود الملازمة العرفية بين إمضاء المسببات والأسباب ، فهي وإن لم تكن
__________________
١ ـ أجود التقريرات : ١ / ٤٩ ـ ٥٠ ؛ المحاضرات : ١ / ١٩٧.
٢ ـ حاصله : إبداء الفرق بين إمضاء الأسباب وإمضاء الأدوات ، فنفى الملازمة في الأُولى وأثبتها في الثانية ، قائلاً بأنّ نسبة الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المنشأ من قبيل الإيجاد بالآلة لا من باب السبب والمسبب.
عقلية ولكنّها ملازمة عرفية فإمضاء المسبب العرفي والذي له سبب مثله ، يلازم إمضاء الثاني.
ب : التمسّك بالإطلاق المقامي ، وحاصله : أنّ كلّ شيء لا يلتفت إليه إلاّ الأوحدي من الناس ، فلو كان معتبراً كان على الشارع التنبيه عليه ، وإلاّ لزم نقض الغرض ، فمثلاً : أنّ العرف يرى تحقّق المنشأ في باب الطلاق بأي صيغة اتفقت ، مثل قوله : « أنت خلية » ، و « أنت برية » ، ولكن الشارع لا يرى السبب إلاّ قوله : « أنت طالق » فإذا أمضى الشارع المسبب العرفي ( الطلاق العرفي ) ولكن كان هناك اختلاف بين الشرع والعرف في السبب نبّه عليه كما قال : إنّما الطلاق أن تقول : « أنت طالق ». (١)
وحيث لم يرد في باب المعاملات بيان خاص بالنسبة إلى السبب يستكشف من سكوت الشارع عدم اعتبار سبب خاص ، وانّ السبب الفعلي كالسبب القولي ، وهذا نظير قصد الوجه والتمييز اللّذين يدّعيهما ابن إدريس في امتثال الواجبات ، والمشهور لم يقل بوجوبهما وذلك تمسكاً بإطلاقات أدلّة الصلاة ، لأنّ قصد الوجه والتمييز من الأُمور العقلية التي لا يلتفت إليهما إلاّ الأوحدي من الناس فلو كان واجباً كان على الشارع التنبيه عليها ، ومثله المقام.
فإن قلت : فهل يمكن دفع الشكّ عن طريق المرآتية حسب ما قرر في المقام الأوّل؟
قلت : ثمة فرق جوهري بين المقامين فانّ الإمضاء تعلّق في المقام الأوّل بالأسباب ، وتعلق الشكّ بسببية شيء كالمعاطاة ، فيمكن أن يقال انّ إمضاء السبب العرفي طريق إلى السبب الشرعي ، وهذا بخلاف المقام فانّ المفروض
__________________
١ ـ الوسائل : ١٥ ، الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث ٣ و ٤.
أنّ الإمضاء تعلّق بالمسبب ، ولكن الشكّ تعلّق بشرطية شيء في السبب كتقدّم الإيجاب على القبول فلا يمكن إمضاء المسبب الصحيح عرفاً طريقاً إلى إمضاء السبب.
وعلى كلّ تقدير فهذا البحث هو بيت القصيد في هذا المقام ، فعلى الفقيه الجهد وبذل الجد حتى يرفع المحاذير الواقعة أمام التمسّك بالإطلاقات ، سواء أقلنا بوضعها للأسباب أو المسببات.
السادس : في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات
هل أسماء المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسببات؟ وهذه مسألة صغروية.
والجواب انّ الأدلّة على قسمين :
١. ما يكون العنوان اسماً للسبب كما هو الحال في قوله ( يا أيُّها الَّذِينَ آمنُوا أُوفوا بالعُقُود ) (١) فالإمضاء يتعلّق بالأسباب.
فانّ العقد عبارة عن شدّ الحبلين ، واستعير في الآية للإيجاب والقبول ، فتكون الآية ظاهرة في إمضاء الأسباب فيؤخذ بإطلاقها في كلّ ما يراه العرف سبباً إلاّ إذا قام الدليل على إلغاء سببيته.
وما ربما يقال من أنّ العقد هو العهد المشدد فلا يصدق إلاّ في الأيمان والأقسام ، في غير محله ، لقوله سبحانه : ( إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح ) (٢) فالعقدة في الآية بمعنى الإيجاب والقبول المعبّر عنهما بالعُقْدة.
وربما يقال بأنّ الآية ناظرة إلى إمضاء المسببات ، لأنّها تأمر بالوفاء بالعقود والوفاء إنّما يتصوّر في أمر باق وما هو الباقي هو المسبب دون السبب فانّه أمر آني.
____________
١ ـ المائدة : ١.
٢ ـ البقرة : ٢٣٧.
يلاحظ عليه : أنّ الأسباب لها بقاء في عالم الاعتبار بشهادة أنّه ربّما يتعلّق بها الفسخ.
٢. ما يكون العنوان ظاهراً في المسبب مثل قوله : ( أحَلَّ اللّهُ البَيْع ) (١) وقوله : « الصلح جائز بين المسلمين » (٢) و « النكاح سنّتي » (٣) و « الطلاق بيد من أخذ بالساق ». (٤)
السابع : في أقسام الجزئية والشرطية و ...
إنّ دخالة شيء في شيء تارة تكون بنحو الجزئية وأُخرى بنحو الشرطية.
ثمّ إنّ الجزئية والشرطية تنقسمان إلى الجزئية والشرطية للماهية ، وأُخرى للفرد ، وبذلك تصير الأقسام أربعة.
كما أنّ تأثير الشيء تارة يكون وجوده مؤثراً في المطلوب أو في كماله ، وأُخرى يكون وجوده مخلاً ، ثمّ المخل ينقسم إلى قسمين ، فتارة يكون وجوده مخلاً للواجب ومبطلاً للغرض ، وأُخرى يكون وجوده مخلاً للهيئة الاتصالية وقاطعاً لها كالضحك والبكاء والفعل الكثير الماحي لصورة الواجب. فيسمى الأوّل بالمانع كالحدث والخبث ، والثاني بالقاطع كالبكاء الممتد.
وإليك التفاصيل :
أمّا إذا كان للشيء مدخل في قوام الماهية سواء أكان بنحو الجزئية كالركوع والسجود ، أو بنحو الشرطية كالطهارة ، فيسميان بجزء الماهية وشرطها ، والفرق بين الجزء والشرط واضح ، لأنّ الجزء بوجوده حاضر في حدّ الشيء فيكون القيد والتقيد داخلاً فيها ، وأمّا الشرط فهو بوجوده وإن لم يكن حاضراً في قوام الشيء
__________________
١ ـ البقرة : ٢٧٥.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١ ، الحديث ٢.
٣ ـ لآلي الأخبار : ٣ / ٢٢١.
٤ ـ الجامع الصغير : ٢ / ٥٧.
ولكنّ لوجوده قبل المأمور به أو معه أو بعده تأثيراً في حصول المطلوب ، فيكون القيد خارجاً والتقيّد داخلاً ، فالطهارة قبل الصلاة واستقبال الكعبة حين الصلاة والأغسال الليلية للمرأة المستحاضة بعد الصوم من قبيل الشروط للماهية.
وبعبارة أُخرى ما يكون دخيلاً في أصل المطلوب بنحو الجزئية أو الشرطية يسمّى جزء الماهية وشرطها.
وأمّا إذا كان الشيء غير دخيل في قوام الشيء على نحو لو لم يكن محققاً لما يضرّبه ولكن له مدخلية في كمال المطلوب وجماله ، فإن كان دخيلاً على نحو الجزئية يسمى جزء الفرد ، وإن كان دخيلاً بنحو الشرطية يسمى شرط الفرد ، وهذا كالقنوت في الصلاة أو الصلاة في المسجد ، فالصلاة بلا قنوت أو في غير المسجد صلاة صحيحة وافية بالغرض المطلوب غير أنّ القنوت في الصلاة ، وإقامتها في المسجد يوجب كمال المطلوب وجماله ، وهذا ما يعبّر عنه بجزء الفرد وشرطه فالأمران يعدان من محققات الفرد ومشخصاته وإن لم يكونا من قوام الشيء والغرض المطلوب.
وبذلك يعلم أنّ القنوت في الصلاة جزء للصلاة الموجودة فهي بعامة أجزائها مصداق للواجب مثل الصلاة في المسجد لا أنّ أصل الصلاة واجبة والقنوت أمر مستحب في واجب.
وما هذا إلاّ لأنّ الصلاة مع القنوت فرد وحداني له حكم واحد وليس له حكمان ، ولا يعد القنوت أمراً زائداً على الصلاة الموجودة كردّ السلام إلى من سلّم على المصلي فانّ التسليم بعنوان الجواب شيء وراء الصلاة ، أو الصلاة على النبي إذا سمع اسمه ، فهي تعدّ أمراً زائداً على الصلاة ، مستحباً فيها بخلاف المشخصات الفردية فانّهما من أجزاء الفرد والفرد بوحدته مصداق للواجب.
وربّما يورد على هذا التصوير ـ أي تقسيم الجزء والشرط إلى كونهما جزءاً أو
شرطاً للفرد ـ بأنّ المراد من الجزء أو الشرط في المقام ، هو العوارض الفردية الخارجية عن ماهية الشيء ، وهذا إنّما يتصور في المركبات الخارجية ، مثلاً الإنسان له علل القوام ـ أعني الجنس والفصل ـ كما له العوارض الفردية من الأعراض التسعة من الطول والقصر واللون وغيرها ، وعندئذيحلّله العقل إلى أُمور مربوطة بجوهره وماهيته ، وأُمور مربوطة بعوارضه وخصوصياته الفردية.
وأمّا المركب الاعتباري فبما أنّه فاقد للوحدة الحقيقية فكلّ فرد منه له ماهية خاصّة فللفاقد ماهية ، وللواجد ماهية أُخرى ، مثلاً الصلاة مع القنوت موجودة ، والصلاة لا معه موجودة أُخرى ، فلا يعد القنوت من العوارض الفردية والبواقي من علل القوام.
يلاحظ عليه : بأنّ الأُمور الاعتبارية سهلة المؤونة ، فيمكن أن تسمّي ماله مدخلية في أصل الغرض بجزء الماهية وشرطها ، وماله مدخلية في كمال الغرض فهو جزء الفرد أو شرطه ، ويمكن أن يقال بصورة التقريب أنّ ذلك التقسيم بكلا شقيه نظير ما نشاهده في التكوين كالدار فهناك ما هو دخيل في أصل المطلوب على وجه لولاه لما يتحقق الغرض كالغرف ، وهناك ما يعد كمالاً للدار كالإيوان والسرداب ، فلو وجدا كانا جزءاً من الدار وإلاّ لم يضر.
هذا كلّه حول الجزئية والشرطية ، وأمّا المانعية والقاطعية ، فمدخلية الأُولى لأجل كون وجود المانع مخلاً للواجب ولملاكه ، وهذا ما يعبّر عنه مسامحة بجزئية عدمه أو شرطيته ، وإلاّ فحقيقة الأمر هو كون المانع بوجوده مخلاً ، وأمّا القاطع فهو أيضاً بوجوده يخل بالهيئة الاتصالية ويقطعها.
إلى هنا تمّت الأقسام الستة ، وأمّا القسم السابع فهو أن يكون الواجب ظرفاً للمستحب بدون مدخلية أحدهما في الآخر وذلك ، كالأدعية الواردة في أيّام شهر رمضان لخصوص الصائم.