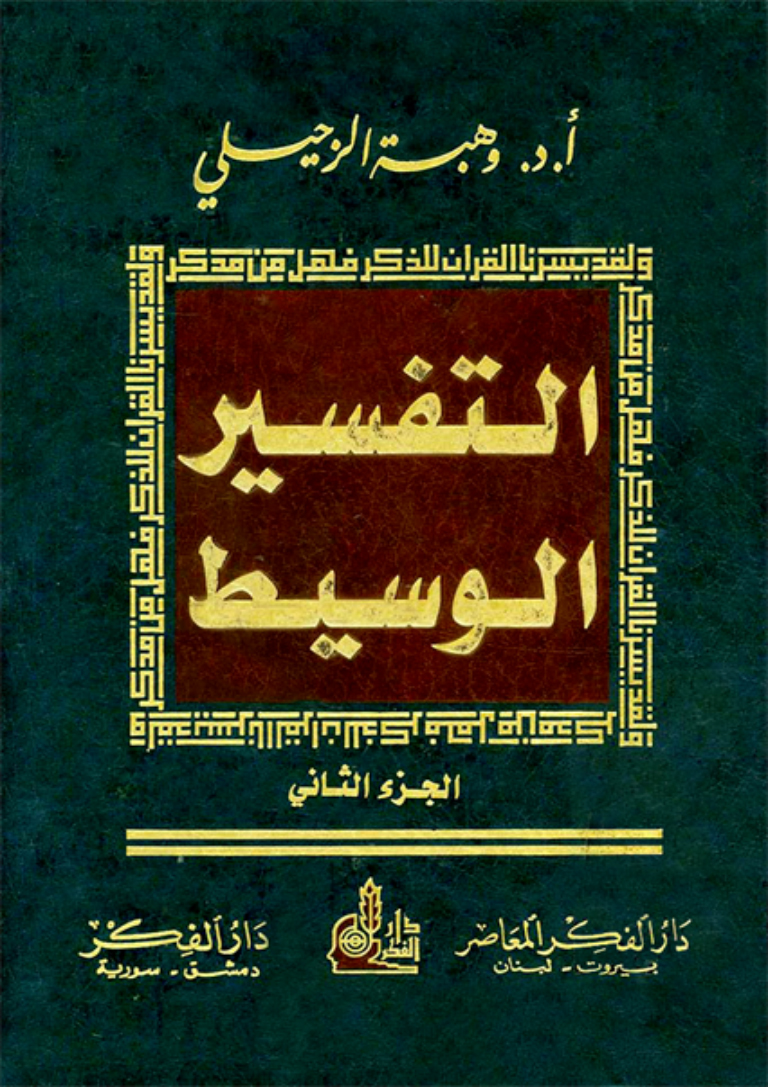الدكتور محمد سيد طنطاوي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
ISBN: 977-14-0522-5
الصفحات: ٣٩٢
ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (٧١) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٧٢) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (٧٣)) (١) (٢) (٣) [يونس : ١٠ / ٧١ ـ ٧٣].
ذكر الله تعالى في قرآنه مجموعة من قصص الأنبياء ، مواساة للنّبي صلىاللهعليهوسلم ليتأسى بهم ، ويأنس بسيرتهم ، فتهون عليه الشدائد والمكائد ، ويتّعظ مشركو مكة بعاقبة المكذّبين رسلهم قبلهم.
وتتعدد أساليب بيان القصة بحسب المناسبات وما يقتضيه المقام ، وهذه الآيات وصف سريع لقصة نوح عليهالسلام مع قومه ، معناها : أخبر أيها الرسول كفار مكة الذين يكذّبونك بخبر قوم نوح الذي كذّبوه ، كيف أهلكهم الله بالغرق ، فيعاملون بمثل ما عومل به من تقدّمهم.
اذكر لهم حين قال نوح لقومه : يا قوم إن كان قد شقّ أو عظم عليكم قيامي بوعظكم من كلام ونحوه ، وتذكيري إياكم بالوعظ والزجر بالأدلة والبراهين الدّالة على وحدانية الله وعبادته ، فإني توكلت على الله وفوّضت أمري إليه ووثقت به ، فلا أبالي بعدئذ بما أوذيت ، ولا أكفّ عن دعوتي ورسالتي ، فاعزموا على ما تريدون من أمر تفعلونه بي ، أنتم وشركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله من الأصنام والأوثان. ولا تجعلوا أمركم الذي تعتزمونه خفيّا مشكلا بل أظهروه لي ، وتبصروا فيه ، ثم نفّذوا ذلك الأمر بالفعل ، ولا تؤخّروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا الحكم المقضي ، فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم ؛ لأنكم لستم على شيء ، والله عاصمي وحامي ومسلّمي من أذاكم.
__________________
(١) اقضوا : أدّوا إلي.
(٢) لا تمهلوني.
(٣) يخلفون الذين أغرقوا.
وهذا غاية الثقة بالله والاعتماد عليه ، والاستهانة والاستخفاف بمن دونه ، فعلى المؤمن أن يعتصم بالله ويثق بوعده ، ويعتمد على ربّه ، فإن العاقبة في النهاية له.
فإن أعرضتم عن تذكيري ، وكذبتم ، ولم تؤمنوا برسالتي ، ولم تطيعوني فيما أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته ، فإني لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا من أجر أو جزاء ، إن ثواب عملي وجزائي على الله ربّي الذي أرسلني إليكم ، وأمرني أن أكون من المسلمين ، أي المنقادين الطائعين الممتثلين لما أمرت به من الإسلام والخضوع لله عزوجل. والإسلام بالمعنى العام وهو الانقياد لله وطاعته والالتزام بالدين الحنيف وهو توحيد الله وإطاعته والإعداد للقائه ، هو مضمون رسالات الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم.
ثم أخبر الله عن مصير قوم نوح المكذبين ، وفي ضمن ذلك الإخبار توعّد للكفار بمحمد صلىاللهعليهوسلم ، وضرب المثال لهم ، فحالكم من التكذيب تشبه حال الأقدمين بالنقمة والتعذيب. لقد أصرّوا على تكذيب نوح عليهالسلام ، فنجّاه الله هو والمؤمنين به ، بحملهم في السفينة التي صنعها بأمر الله ، وجعل الله النّاجين مع نوح خلائف أولئك الهالكين في عمارة الأرض وسكناها من بعدهم ، وأغرق الله بالطّوفان الذين كذّبوا نوحا ، فانظر أيها الرّسول محمد كيف أنجينا المؤمنين ، وأهلكنا المكذّبين المنذرين الذين أنذرهم رسولهم بالعذاب قبل وقوعه ، فلم يرتدعوا ، وأصرّوا على تكذيبه. وهذه هي العاقبة الوخيمة لكل المصرّين على تكذيب الأنبياء ، وهذه هي العاقبة الحميدة للمؤمنين المصدّقين بالله ربّا وبالإسلام دينا وشرعة ومنهاجا.
قصة موسى عليهالسلام مع قومه
ـ ١ ـ
الحوار بين موسى وفرعون
استمرّ تكذيب الأنبياء بين الأمم من بعد نوح عليهالسلام ، فمنع الله عنهم الخير والإيمان ، ومن أمثلة ذلك قصة موسى مع فرعون وقومه ، وفيها يشتدّ الحوار بين رسول الحق موسى ، وبين زعيم الباطل فرعون ، فموسى عليهالسلام يعلو صوته بالدعوة إلى توحيد الله وإبطال الوهية من دونه ، وفرعون يدافع عن عرشه وسلطانه وادّعاء ألوهيته ، لتظلّ له الهيمنة ، ويكون الهدف من إيراد القصة في هذه الآيات ضرب المثل لحاضري محمد صلىاللهعليهوسلم ، ومضمونه : كما حلّ بهؤلاء يحلّ بكم معشر قريش. وهذه آيات تصوّر صولة الحق مع موسى وهزيمة الباطل مع فرعون ، قال الله تعالى :
(ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (٧٤) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (٧٥) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (٧٦) قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (٧٧) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (٧٨)) (١) (٢) (٣) (٤) [يونس : ١٠ / ٧٤ ـ ٧٨].
هذا موكب النور الإلهي ، بعث الله من بعد نوح عليهالسلام رسلا إلى أقوامهم ، مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهمالسلام بالمعجزات الدّالة على صدقهم ، والبراهين الواضحة على صدق نبوّتهم ورسالتهم ، فلم تؤمن تلك الأقوام
__________________
(١) أي بعد نوح عليهالسلام.
(٢) البيّنات : المعجزات والبراهين الواضحة.
(٣) نختم.
(٤) لتصرفنا.
بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم بالوحي والرسالة الإلهية ، كما كذّب المتقدمون من قبلهم ، ممن كانوا على شاكلتهم في الكفر (كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) أي هذا فعلنا بهؤلاء الذين تجاوزوا طورهم ، واجترحوا ما لا يجوز لهم ، كما فعلنا بأمثالهم ، ختمنا على قلوب المعاندين ، فلم يعد الخير نافذا إليها ، ولا يتنظر إيمانهم حتى يروا العذاب الأليم. وهذا إنذار شديد لمشركي العرب بأنهم يستحقون عذابا مثل عذاب الأمم السابقة إذا استمروا في تكذيبهم الرّسل ومعارضة دعوة النّبي صلىاللهعليهوسلم.
ثم بعث الله تعالى من بعد أولئك الرّسل موسى وأخاه هارون عليهماالسلام إلى فرعون ملك مصر وأشراف قومه وأتباعهم ، بعثهما الله بالآيات البيّنات الدّالة على صدقهما كالعصا واليد ، فاستكبر فرعون وأتباعه عن قبول الحق والانقياد له ، وعن الإيمان بموسى وهارون ، وكانوا قوما مجرمين ، أي معتادي الاجرام كفارا ذوي آثام عظام ، والغين في الجريمة ، ممعنين في الكفر والضلال.
فلما جاءهم موسى عليهالسلام بدليل الحق على الرّبوبية والألوهية لله تعالى ، قالوا عنادا وعتوّا : إن هذا لسحر واضح ، أي إن عصا موسى التي تنقلب حية ، ويده التي تضيء كالشمس هما في زعم فرعون وملئه سحر بيّن.
فأجابهم موسى منكرا عليهم وموبّخا لهم : أتقولون للحق الواضح البعيد عن السحر الباطل : إنه سحر ، والحال أنكم تعرفون أن السحر تخييل وتمويه ، ولو كان هذا سحرا لانكشف واضمحلّ وزال ، ولم يبطل سحر السحرة ، فهو إذن معجزة إلهية ، لا سحر وشعوذة ولا تمويه.
فقال قوم فرعون لموسى قول صاحب الحجة الضعيفة بالتمسك بالتقليد للآباء والأجداد : أجئتنا يا موسى لتصرفنا وتردّنا عن دين آبائنا وأجدادنا؟ ولتكون لكما ، أي لك ولهارون أخيك الكبرياء في الأرض ، أي الرياسة الدينية والسلطة الدنيوية
وهي الملك والسلطان ، وما نحن لكما بمصدّقين فيما تدّعيانه من دين جديد ، يبطل دين الأسلاف والآباء.
وهذا إعلان صريح من فرعون وقومه بأنهم مكذبون برسالة موسى وأخيه هارون ، إلا أنهم خاطبوا موسى أولا بقولهم : (أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) ؛ لأنه كان هو الدّاعي لهم للإيمان بما جاء به ، والإقرار بتوحيد الإله ، ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. ثم أشركوا معه أخاه في قولهم : (وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ) لأنه كان رسولا شريكا في الدعوة ، وفي الإفادة من ثمراتها ، وهي في زعمهم تحقيق النفوذ والسلطة والعظمة.
وهذه ذريعة للتكذيب برسالة موسى وأخيه هارون ، وإغراء للمستفيدين من حكم فرعون بمقاومة هذه الرسالة ، ومطاردة موسى وأخيه ، حفاظا على كرسي الحكم الملكي والسلطة في أراضي مصر.
ـ ٢ ـ
الاحتكام للسحرة في عهد فرعون
زعم فرعون أو ظنّ أن ما جاء به موسى من معجزة العصا واليد مجرد سحر ظاهر ، فدعا إلى الاحتكام للسّحرة ليبطل دعوة موسى عليهالسلام ، ولينقذ موقفه أمام الناس ، وليحافظ على هيلمانه وسلطانه ، ولكن الله غالب ، والمعجزة الإلهية هي التي ستبطل إفك السحرة ، ويظهر الحق ، وتعلو كلمة الله والإيمان به ، حتى ولو كره المجرمون ذلك. وهذا ما صوّرته الآيات القرآنية التالية :
(وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (٧٩) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠) فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (٨١) وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨٢)) [يونس : ١٠ / ٧٩ ـ ٨٢].
أراد فرعون بكل إصرار وعناد التمويه على الناس وصدّهم عن اتّباع موسى ، ومعارضة ما جاء به عليهالسلام من دعوة الحق المبين إلى توحيد الله ، فاعتمد على زخارف السّحرة والمشعوذين ، فانعكس الأمر عليه ، وظهرت البراهين الإلهية على الملأ العام ، وآمن السحرة بالله تعالى ، وخسر فرعون.
ومعنى الآيات : قال فرعون لخدمته وحاشيته لما رأى معجزة العصا واليد البيضاء : ائتوني بكل ساحر حاذق عالم ، ظنّا منه ألا فرق بين المعجزة الإلهية والسحر ، فأتوا به ، فلما جاء السحرة وتجمعوا ، قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون من أفانين السحر ، ليظهر الحق ، ويبطل الباطل.
فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ، وخيّلوا بها ، وظنّوا أنهم قد ظهروا وانتصروا ، قال لهم موسى واثقا غير مبال بهم : ما أتيتم به هو السّحر بعينه ، لا ما سماه فرعون سحرا مما جئت به من المعجزة من عند الله. وهذا السحر الذي أظهر تموه إن الله سيبطله ويمحقه ويظهر زيفه قطعا أمام الناس ، بما يفوقه من المعجزة التي هي آية خارقة للعادة ، تفوق السحر وأشكاله المختلفة. وقوله سبحانه : (إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ) عدة بالإبطال من الله تبارك وتعالى.
وعلة ذلك : (إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) أي لا يثبته ولا يقويه ، ولا يجعله صالحا للبقاء ؛ لأنه محض افتراء والسّحر تخييل وتمويه ، يتبدد ويفنى أمام المعجزة الرّبانية المجراة على يد موسى عليهالسلام.
وتابع موسى عليهالسلام قوله : (وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨٢)) أي ويريد الله أن يؤيّد الحق ويظهره ، ويثبّته ويقويه ، وينصره على الباطل بأوامره ووعده موسى ، وذلك ولو كره المجرمون ، أي الظالمون كفرعون وملئه. والمجرم : المجترم الراكب للخطر. وتحقق بالفعل انتصار الحق على الباطل ، كما جاء في
آية أخرى : (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨)) [الأعراف : ٧ / ١١٨] ، وقوله سبحانه : (إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى) [طه : ٢٠ / ٦٩].
هذا اختيار صعب قاس لكل من المعجزة والسحر ، فالمعجزة آية إلهية خارقة للعادة ، يؤيد الله تعالى بها صدق الأنبياء ، لإقناع الناس وتصديق دعوتهم. وأما السحر فهو إفساد وتمويه وتزييف ، لا حقيقة له ثابتة ، لذا لم يصمد أمام الشيء الحقيقي الثابت ، الذي لا تمويه فيه.
وهذا المعنى هو ما تضمنته آية : (إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) أي لا يضرّ أحدا كيد ساحر ، لذا قال العلماء : لا تكتب هذه الآية على مسحور إلا دفع الله عنه السّحر.
وكان في برمجة أو خطة موسى عليهالسلام بأن يبدأ السّحرة أولا بالإلقاء براعة وثقة بما لديه من المعجزة ، وعدم الاكتراث بالسّحرة ، فإن كل ما فعلوه من لفت أنظار الناس وإخافتهم ، حينما ألقوا حبالهم وعصيهم ، محق وأبطل بإلقاء العصا التي انقلبت ثعبانا عظيما ، التهم جميع الحبال والعصي ، وصدق موسى فيما أعلنه قبل المبارزة : (ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ).
وحينئذ ، حين التهمت العصا جميع الحبال والعصي ، أدرك السّحرة خسارتهم ، وعرفوا أن فعل موسى ليس من قبيل السّحر ، فهم أعرف الناس بأساليبه وفنونه ، فلم يعاندوا ، وشرح الله صدورهم للإيمان ، فآمنوا دون خشية من فرعون وبأسه وتهديده ، وأسقط في يد فرعون وملئه ، وخابوا وخسروا ، وانتصر الحق وزهق الباطل.
ـ ٣ ـ
إيمان طائفة بموسى عليهالسلام
بالرغم من الجهود المباركة المضنية من موسى عليهالسلام في دعوة الناس في مصر إلى الإيمان برسالته وبوحدانية الله ، لم يؤمن به إلا طائفة قليلة من قومه بني إسرائيل ، وهم فتيان وشباب أكثرهم أولو آباء كانوا تحت خوف من فرعون وأعوانه. وفي ذلك تسرية عن هموم نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام بسبب اغتمامه من إعراض قومه عنه وإصرارهم على الكفر ، فله أسوة بسائر الأنبياء. وهذا ما أبانته الآيات القرآنية التالية :
(فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (٨٣) وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (٨٤) فَقالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (٨٦) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧)) (١) (٢) [يونس : ١٠ / ٨٣ ـ ٨٧].
هذه هي حصيلة دعوة موسى عليهالسلام في أول أمره ، فلم يصدق بدعوته بادئ الأمر إلا قليل من قومه بني إسرائيل ، مع ما جاء به من البيّنات الواضحة الدّالة على صدقه ، وهم طائفة من الشباب الخاضعين للحكم الفرعوني ، على خوف من فرعون وجنوده أن يردوهم إلى الكفر ؛ لأن فرعون كان جبّارا عنيدا ، شديد البطش بخصومه ، مستعليا في أرض مصر ، ومتجاوزا الحدّ بادّعاء الرّبوبية واسترقاق أسباط الأنبياء.
__________________
(١) الفتنة : الاختبار والابتلاء بالشدائد ، والمراد هنا : موضع عذاب.
(٢) اتّخذوا بيوتكم مساجد ومصلى.
وتابع موسى رعاية المؤمنين ، فقال لهم حينما لمس خوفهم من الاضطهاد : إن كنتم آمنتم ، أي صدقتم بالله وآياته حقّا ، فعليه توكّلوا وفوّضوا أموركم إليه ، وثقوا بنصره وحمايته لكم إن كنتم مسلمين ، أي خاضعين لله وطاعته ، منقادين لأحكامه وأوامره ، لأن التوكّل على الله لا يختلط بغيره. فالمراد من قوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) أهل طاعة مع إيمان ، فيكون ذكر الإسلام فيه زيادة معنى. فقالوا فورا : على الله توكّلنا واعتمدنا ، وبه وثقنا واستعنّا على أعدائنا ، ربّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، أي لا تنزل بنا بلاء بأيدينا أو بغير ذلك ، مدة مجاورتنا لأتباع فرعون ، فيعتقدون أن إهلاكنا إنما هو لسوء ديننا ، وصلاح دينهم ، وأنهم أهل الحق. فهذا الدعاء يتضمن دفع أمرين : أحدهما ـ القتل والبلاء الذي توقعه المؤمنون. والآخر ـ ظهور الشّرك باعتقاد أهله أنهم أهل الحق ، وفي ذلك فساد الأرض.
وتابعت طائفة الإيمان دعاءها بقولهم : (وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (٨٦)) أي خلّصنا برحمتك وإحسانك وعفوك من تسلّط الكافرين بك ، الظّالمين الطّغاة ، الذين كفروا الحق وستروه ، ونحن قد أعلناه وآمنّا بك وتوكّلنا عليك.
ثم أوضح الحقّ تعالى سبب إنجاء بني إسرائيل من فرعون وقومه ، فقال : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً ...) أي أمرنا موسى وأخاه هارون عليهماالسلام أن يتخذا لقومهما بمصر بيوتا ، تكون مساكن للاعتصام فيها ، وأمر القوم أن يتخذوا البيوت مساجد متّجهة نحو القبلة في بيت المقدس ، وأن يقيموا جميعا الصلاة في تلك البيوت ، أي أتموها وافية بشروطها ، لئلا يطّلع عليهم الكفرة ، فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. وبشر يا موسى المؤمنين برسالتك بالصون والنصر على أعدائهم في الدنيا ، وبالجنة في الآخرة.
ولا شك بأن الإيمان الطوعي الاختياري هو الإيمان الحق ، وهو المطلوب والذي
يفيد صاحبه في الدّارين. وخطاب بني إسرائيل بالصلاة بعد الإيمان كان قبل نزول التوراة ، لأنها لم تنزل إلا بعد إجازة البحر وإهلاك فرعون وجنوده في اليم.
ومن ثمار الإيمان الحق : التّفاني في مرضاة الله وتقديم الدين على الدنيا ، لذا قدمت الطائفة المؤمنة بموسى عليهالسلام الحماية من الفتنة الإيمانية وعدم المحنة في الدين ، على نجاة أنفسهم من ظلم القوم الظالمين ، فقالوا أولا : (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) ثم قالوا : (وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (٨٦)).
ـ ٤ ـ
دعاء موسى على فرعون وملئه
حينما ييأس الرّسول النّبي من إجابة دعوته عند قومه ، قد يدعو عليهم بإذن من ربّه ، وهذا ما فعله موسى عليهالسلام الذي دعا قومه في مصر لتوحيد الإله ، زمنا طويلا ، فدعا الله عليهم بالهلاك والإبادة حتى تتهيأ الأرض لجيل آخر يستجيب لدعوة الإيمان. وكان دعاء موسى عليهالسلام متميزا ببيان سبب الدعاء ، وهذا ما وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى :
(وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (٨٩)) (١) (٢) [يونس : ١٠ / ٨٨ ـ ٨٩].
غضب موسى عليهالسلام من أقباط مصر ، فدعا عليهم ، وقدم للدعاء تقرير نعم
__________________
(١) أتلفها وأزلها.
(٢) اطبع عليها.
الله عليهم وكفرهم بها ، قائلا : ربّنا آتيت فرعون وأشراف قومه من الدنيا والنعمة ما أبطرهم ، وهو الزينة الشاملة من حلي ولباس وأثاث ورياش وأموال كثيرة ومتاع الدنيا ونحوها من الزروع والأنعام ، وأدى التّرف والنعيم بهم أن تكون عاقبة أمرهم إضلال عبادك عن الدين ، والطغيان في الأرض ، والإسراف في الأمور كلها.
واللام في قوله تعالى : (رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ) تسمى لام العاقبة والصيرورة ، أي إن النعمة آلت بهم وصارت إلى الضّلال والانحراف ، مثل اللام في قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ) (١) (آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) والمعنى : آتيتهم تلك النّعم ، فصار أمرهم إلى كذا ، وكان عاقبة قوم فرعون من النّعم هو الضّلال والكفر وتأليه فرعون.
(رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ) أي ربّنا أمحق وأزل آثار أموالهم وأهلكها ، واختم على قلوبهم واجعلها قاسية ، حتى لا تنشرح للإيمان ، فيستحقّوا شديد العقاب ، ولا يؤمنوا حتى يشاهدوا العذاب المؤلم الشديد الإيلام. وجعل موسى في دعائه رؤية العذاب نهاية وغاية ، وذلك لعلمه من قبل الله تعالى أن المؤمن عند رؤية العذاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه من كفره ، وكان دعاء موسى مشتملا على عقابين : مادي ومعنوي. أما المادي فهو تدمير أموالهم وإهلاكها. وأما المعنوي : فهو الطبع والختم على قلوب قوم فرعون بالكفر ومنع نفاذ الخير إليها.
ثم أجاب الله هذه الدعوة في فرعون نفسه وقومه معه ، بالغرق ، وروي عن ابن جريج ومحمد بن علي والضّحاك : أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة ، وحينئذ كان أمر الغرق. وروي أيضا أن هارون كان يؤمّن على دعاء موسى عليهالسلام ؛ فلذلك نسب الدعاء إليهما.
لقد أجيبت دعوتكما يا موسى وهارون ، وقبلنا دعاءكما كما سألتما من تدمير آل
__________________
(١) أي الطفل موسى في التّابوت.
فرعون ، فاستقيما ، أي فاثبتنا على ما أنتما عليه من الدعوة لدين الحق ، وإلزام الحجة ، ولا تستعجلا الأمر قبل ميقاته ، فإن ما طلبتما كائن ، ولكن في وقته ، ولا تتبعانّ سبيل الذين لا يعلمون ، أي طريق الجهلة في الاستعجال ، أو عدم الثقة والاطمئنان بوعد الله تعالى ، فإن وعدي لا خلف فيه.
ولا يدلّ هذا النّهي عن الجهل أن مقتضاه صدر من موسى وهارون عليهماالسلام ، كما في خطاب نبيّنا صلىاللهعليهوسلم : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزّمر : ٣٩ / ٦٥] لا يدلّ على صدور الشّرك منه.
ومن المقرر أن إجابة الدعاء يصادف مقدورا ، ودعاء موسى وهارون على هذا النحو ، وهذا معنى إجابة الدعاء.
وإجابة الدعاء لها وقت مخصوص في علم الله وتقديره ، وليس ذلك بحسب مراد العبد الداعي ، وإنما بحسب مراد الله تعالى. فتعجل الإجابة جهل لا يليق مع الأدب مع الله تعالى. وهو أيضا شك في الثقة بوعد الله تعالى بإجابة الداعي إذا دعاه. لهذا أمر الله موسى وهارون عليهماالسلام بالاستقامة وترك سلوك طريق من لا يعلم حقيقة الوعد والوعيد.
لقد طويت صفحة الطاغية فرعون وقومه من التاريخ بتدبير من الله وعدل ؛ لأن ادّعاء الألوهية وممارسة ألوان البغي والجور ، غير مقبول بحال في منهج الحكم الإلهي.
ـ ٥ ـ
إغراق فرعون وإنجاء الإسرائيليين
اشتطّ فرعون وقومه في الظلم ، وبالغوا في إيذاء بني إسرائيل واستعبادهم وتسخيرهم في الأعمال الشاقة ، ولكن البغي والجور لا يدوم في شرع الله وقدره.
وحينما آن وقت العذاب بحسب حكمة الله ، صمم فرعون وجنوده على استئصال بني إسرائيل فتابعوهم حينما خرجوا من مصر ، وصمموا على إبادتهم ، وإنهاء دعوة موسى عليهالسلام ، حتى لا يكون هناك مضايق أو معارض. وتحققت المعجزة الكبرى بتدبير الله ، قال الله تعالى واصفا مصير فرعون وأتباعه وعاقبة بني إسرائيل :
(وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ (٩٢) وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٩٣)) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) [يونس : ١٠ / ٩٠ ـ ٩٣].
هذه نهاية الطاغية فرعون وقومه ، روي أن فرعون كان في ثمان مائة ألف أدهم (٦) ، حاشا ما بقي من ألوان الخيل ، وروي أقل من هذه الأعداد. كما روي أن بني إسرائيل الذين جاوزوا البحر كانوا ست مائة ألف.
والمعنى : تجاوزونا ببني إسرائيل البحر بقدرتنا وحفظنا ، فلحقهم فرعون وجنوده ظلما وعدوا ، أي باغين وعادين عليهم ، فلما أشرف فرعون على الغرق قال : آمنت بأنه لا إله بحق إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل ، وأنا من المسلمين ، أي المنقادين المذعنين لأمره.
كرر فرعون هذه العبارة ثلاث مرات ، فلم يقبل منه الإيمان ، لأنه إيمان عند الإكراه والاضطرار ، وليس فيه اختيار. لذا ردّ الله تعالى عليه عن طريق جبريل أو
__________________
(١) ظلما واعتداء.
(٢) أفي هذه اللحظة تؤمن حين أيقنت الهلاك؟
(٣) عبرة.
(٤) أنزلنا وأسكنا.
(٥) منزلا صالحا مرضيّا.
(٦) أي أسود.
بإلهام من الله بقوله : أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق ، وأيست من نفسك ، وقد عصيت الله من قبل هذا الوقت ، وكنت من الضّالّين المضلّين عن الإيمان ، وذلك في قوله سبحانه : (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ).
(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ...) أي فاليوم ننقذ جسدك من الغرق والارتماء في قاع البحر ، لتكون لبني إسرائيل دليلا أو علامة على موتك وهلاكك ؛ لأنه كان في أنفس المصريين الأقباط : أن فرعون أعظم شأنا من أن يغرق ، ولتكون عبرة لمن بعدك من الناس يعتبرون بك ، فينزجرون عن الكفر والفساد في الأرض وادّعاء الرّبوبية. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته.
وليس الأمر مقصورا على فرعون وجنوده في إهمال النظر في الكون وآياته ، للدلالة على وجود الله وتوحيده ، وإنما أكثر الناس غافلون عن حجج الله وأدلّته على أن العبادة لله وحده ، فلا يتّعظون بها ولا يعتبرون ، لعدم تفكّرهم في أسبابها ونتائجها. وفي هذا دلالة على ذمّ الغفلة وترك أو إهمال الفكر والنظر في أسباب الحوادث وعواقبها.
وقد كان هلاكهم يوم عاشوراء من شهر المحرم ، كما صحّ في حديث البخاري عن ابن عباس.
وفي مقابل إغراق فرعون وأتباعه ، أنعم الله على بني إسرائيل نعما أخرى ، فأنزلهم منزلا صالحا للعيش فيه ، ورزقهم من الطيبات ، أي اللذائذ المستطابة المباحة فيها ، وأنعم الله عليهم فيها بكثير من الخيرات ، من الثمار والغلال والأنعام وصيد البر والبحر. ولكنهم جحدوا هذه النعم ، فلم يستحقوا التكريم ، ووقعوا في المنازعات والخلافات في التوراة وفي شأن رسالة محمد صلىاللهعليهوسلم ، بعد ما علموا أحكام التوراة وأوصاف نبي آخر الزمان فيما هو مسطر في كتابهم ، فكفر به بعضهم ، وآمن آخرون. إن ربّك يفصل ويحكم بينهم يوم القيامة في شأن ما اختلفوا فيه ، فيميز المحق
من المبطل ، بإنجاء أهل الحق من النار ، وإدخالهم الجنة ، وإهلاك المبطلين وتعذيبهم في نار جهنم.
الدّعوة إلى تصديق القرآن
إن مهام الداعية لتصديق القرآن دقيقة وشاقة ، وتتطلب صبرا وحكمة ، وعزيمة وإرادة ، وهي بالتالي يسيرة غير عسيرة ؛ لأن تصديق القرآن فرع من الإيمان بالله تعالى ، فمن آمن بوجود الله وتوحيده ، سهل عليه الإيمان بالقرآن الذي أنزله ربّ العزّة بواسطة الوحي على قلب النّبي صلىاللهعليهوسلم ، ومن هنا كان مطلع أول السورة الثانية في سورة البقرة من القرآن الكريم : (الم (١) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (٢)) [البقرة : ٢ / ١ ـ ٢]. وكانت مهمة النّبي صلىاللهعليهوسلم في بدء دعوته المشركين للتصديق بالقرآن الكريم صعبة للغاية ، لأنها في وسط وثني ، لا يعرف غالبا غير عقيدة الوثنية ، وتأليه الأصنام والأوثان. قال الله تعالى مبيّنا صدق النّبي صلّى الله عليه وسلّم في دعوته للإيمان بالقرآن مبتدئا به عليهالسلام على سبيل المبالغة : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (٩٤) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (٩٥) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (٩٧)) (١) [يونس : ١٠ / ٩٤ ـ ٩٧].
جمهور العلماء والصواب في معنى الآية : أنها مخاطبة للنّبي صلىاللهعليهوسلم ، والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك أو يعارض. ومطلعها : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ ..) له مثال في قوله تعالى لعيسى عليهالسلام : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي ...).
__________________
(١) الشّاكّين.
ومعنى الآيات : إن وقع منك شك أيها النّبي في صدق النّبوة والقرآن وإنزاله إليك. والمراد بذلك قومه ، على سبيل الافتراض والمبالغة ، فاسأل علماء أهل الكتاب الذين يقرءون الكتاب ، أي التوراة من قبلك ، فهم على علم تامّ بصحة ما أنزل إليك ، فلا تكونن من الشّاكين. فالخطاب للسامع ويراد به غيره ، وهو تعبير مألوف بين العرب ، على طريقة المثل العربي : «إياك أعني واسمعي يا جارة».
فالنّبي صلىاللهعليهوسلم لا يوصف بالشّك ، قال ابن عباس : لا والله ما شكّ طرفة عين ، ولا سأل أحدا منهم ، وقال : «لا شك ولا أسأل ، بل أشهد أنه الحق» كما ذكره قتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري.
وتتمة الآية : (لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ) أي والله لقد جاءك الحق واضحا ، لا مرية فيه ولا ريب ، بما أخبرناك في القرآن ، وبأنك رسول الله ، وأن اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ، لما يجدون في كتبهم من نعتك وأوصافك ، فلا تكونن من الشّاكين في صدق ما نقول ، وفي بيان الوعد والوعيد. وفي هذا تثبيت للأمة ، وإعلام لكل فرد أن صفة نبيّهم صلىاللهعليهوسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب ، كما جاء في آية أخرى : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ) [الأعراف : ٧ / ١٥٧]. والنّهي في قوله تعالى : (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ) تعريض بالشّاكّين والمكذّبين للنّبي صلىاللهعليهوسلم من قومه.
قال البيضاوي في تفسيره : وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدّين ينبغي أن يسارع إلى حلّها بالرجوع إلى أهل العلم.
ثم أورد القرآن في مجال تأكيد تصديقه ما هو أشد مما سبق ، فقال الله تعالى : (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (٩٥)) أي ولا تكونن
أيها النّبي وكل سامع ممن كذب بآيات الله الدّالة على وحدانيته وقدرته على إرسال الرّسل لهداية البشر ، فتكون ممن خسروا الدنيا والآخرة.
وهذا أيضا من باب التّهييج والتّثبيت وقطع الأطماع عنه عليهالسلام في مساومته على حلول وسط ، مثل قوله تعالى : (فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ) [القصص : ٢٨ / ٨٦]. وفي الآية هنا تعريض بالكفار الخاسرين الضّالّين.
وأنهى القرآن المشكلة في عناد الكفار ، فقال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (٩٦)) أي إن الّذين ثبتت عليهم كلمة الله ، أي قضاؤه وحكمه بالعذاب ، لا يؤمنون أبدا ، لفقدهم الاستعداد للإيمان ، وتصميمهم على الكفر ، وليس المراد منعهم من الإيمان ، وإنما بيان لحقيقة اختيارهم بحسب علم الله عزوجل المحيط بكل شيء. وهؤلاء الذين علم الله أنهم لا يؤمنون سيبقون على كفرهم وجحودهم ، ولو جاءتهم كل آية كونية حسّية أو علمية أو قرآنية ، كآيات موسى التّسع ، وتفجير الأنهار والصعود في السماء ، وآيات إعجاز القرآن ، لو جاءهم أي شيء من ذلك وغيره لا يؤمنون حتى يروا العذاب المؤلم الموجع الذي يطبق عليهم ، وحينئذ لا ينفعهم الإيمان ، لأنه إيمان اليأس كإيمان فرعون.
متى يصحّ الإيمان
؟ الإيمان جوهر وكنز يملأ النفس والقلب ، ويلازم العقل والفكر ، ويظل رأس مال المؤمن في جميع أدوار الحياة حتى يفارق الدنيا ، ولا ينجي الإنسان سواه بعد الموت والرحيل إلى عالم الآخرة. لذلك كان قائما على الإرادة والاختيار ، ولا فائدة منه ، ولا بقاء له إذا فرض بالإكراه أو نشأ حال الاضطرار أو اليأس من الحياة. والإيمان
الجماعي مثل الإيمان الفردي لا بدّ فيه من الطواعية والرّضا والاختيار ، وقد وصف الله تعالى حالة الإيمان المقبول في الآيات التالية :
(فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (٩٨) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (١٠٠)) (١) [يونس : ١٠ / ٩٨ ـ ١٠٠].
تتضمن هذه الآيات أمورا أربعة : ارتباط الإيمان بالاختيار والرّضا ، والإشارة لقصة يونس مع قومه ، ومنع الإكراه على الدّين ، وكون الإيمان حاصلا بمشيئة الله وإرادته وإذنه.
أما ارتباط الإيمان بالاختيار والرّضا فقد حثّ القرآن عليه في مطلع هذه الآيات ، ومضمون ذلك : فهلا آمن أهل قرية من قرى الرّسل المرسلين إليهم ، بإرادتهم ، وبعد دعوتهم للإيمان وإقامة الحجة عليهم ، وقبل نزول العذاب واستحالة الإيمان ، فنفعهم إيمانهم.
والأمر الثاني ـ قصة يونس عليهالسلام ، فإن قومه في أرض نينوى بمقاطعة الموصل شمال العراق ، كانوا قد كفروا ، ثم لما رأوا أمارات العذاب ، تضرّعوا إلى الله تعالى ، وأخلصوا التوبة ، وأظهروا الإيمان ، فرحمهمالله وتقبّل منهم إيمانهم على سبيل الاستثناء ، وكشف عنهم العذاب ، ومتّعهم إلى أجل ، تعليما وتوجيها ليونس عليهالسلام. والفرق بين إيمانهم وإيمان فرعون : أنهم آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل ، وإن كان بعد ظهور أماراته. وأما إيمان فرعون فكان عند اقتراب الموت ومعاينة الغرق وحين اليأس من النجاة. وفي هذا تعريض بأهل مكة ، وحضّ شديد لهم على
__________________
(١) العذاب.
أن يكونوا على الأقل ، مثل قوم يونس ، آمنوا قبل أن يصلوا إلى درجة اليأس ، مع احتمال حدوث العذاب كما وقع في قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وجنوده. وهذا كله بقضاء الله ومشيئته فيهم.
والأمر الثالث في الآيات : منع الإكراه على الإيمان. فلو شاء ربّك يا محمد أن يأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان برسالتك ، والاستجابة لدعوتك ، لفعل ، ولو شاء الله تعالى لكان الجميع مؤمنين ، كما جاء في آية أخرى : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً) [الرّعد : ١٣ / ٣١]. وكلمة (كُلُّهُمْ) تفيد الإحاطة والشمول. وكلمة (جَمِيعاً) تفيد حدوث الإيمان في وقت واحد ، دون تباطؤ ولا تعاقب.
وإذا كان هذا بمقدور الله تعالى ، أفأنت يا محمد تكره الناس بالقتال وتلزمهم أو تلجئهم إلى الإيمان ، حتى يكونوا مؤمنين موحّدين. فالإيمان لا يتم ولا يطلب إلا بالاختيار والطواعية ، ولا يحدث بالإكراه والقسر والإرهاب الملجئ ، وما أكثر الآيات المانعة من الإكراه على الدين والإيمان ، في قوله تعالى : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) [البقرة : ٢ / ٢٥٦].
والأمر الرابع والأخير في الآيات ردّ الأمر في الإيمان لإرادة الله ومشيئته. فليس لنفس أن تؤمن إلا بمراد الله وتوفيقه ، أو بقضائه وقدره ، والنفس مختارة في الدخول في الإيمان اختيارا غير مطلق ، حتى لا يتنافى ذلك مع سلطان الله في كونه ، فلا يتم شيء قهرا عنه ، ويكون الإيمان مقيدا بسنّة الله في الخلق. ويجعل الله الرّجس أي العذاب على الذين لا يتدبرون حجج الله وبيّناته وبراهينه ، ويسيئون في تفكيرهم ، ولا يستعملون عقولهم في النظر بما يرشدهم إلى الحق من آيات الله في الكون والحياة ، ويتأمّلون في آيات القرآن. فإذا عطّلوا منافذ المعرفة والحواس الهادية إلى
الصواب ، واتّبعوا الهوى ، وانقادوا لمؤثرات البيئة وتقليد الآباء والأجداد ، كانوا هم المسيئين لأنفسهم ، المؤثرين الكفر على الإيمان ، والضّلالة على الهدى والرّشاد ، وكانوا بهذا الاختيار وإهمال العقل غير معذورين في كفرهم.
النّظر والتّفكّر
الطريق إلى تصحيح العقيدة بالله وجودا وتوحيدا أمر مبسط يسير ، وهو لا يعدو أن يكون تأمّلا حرّا من غير تأثر ببيئة ووراثة وتقاليد ، وتقديرا من النهج القرآني للعقل الإنساني والإرادة البشرية وجّه الإسلام نحو إعمال العقل والفكر في مكنونات الكون وأسراره ، وأوجب الدين النظر والتفكر وجعله فريضة إسلامية شاملة ، من أجل التوصل إلى الحق ، والتخلّص من العقائد الفاسدة والموروثات الضّالّة. وهذا هو صريح الآيات القرآنية :
(قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (١٠١) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (١٠٢) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٣)) [يونس : ١٠ / ١٠١ ـ ١٠٣].
قوله تعالى : (قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أمر صريح للناس ، والأمر للوجوب ، بإيجاب الاعتبار والنظر في المصنوعات الدّالة على الصانع ، وغير ذلك من آيات السماوات وأفلاكها وكواكبها وسحابها ، وعجائب المخلوقات فيها وفي الأرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك. والمعنى : انظروا في ذلك نظرا صحيحا ينبّهكم إلى المعرفة بالله والإيمان بوحدانيته.
إن النظر في الأكوان وما فيها من أسرار يرشد الإنسان الضّال أو الكافر إلى وجود