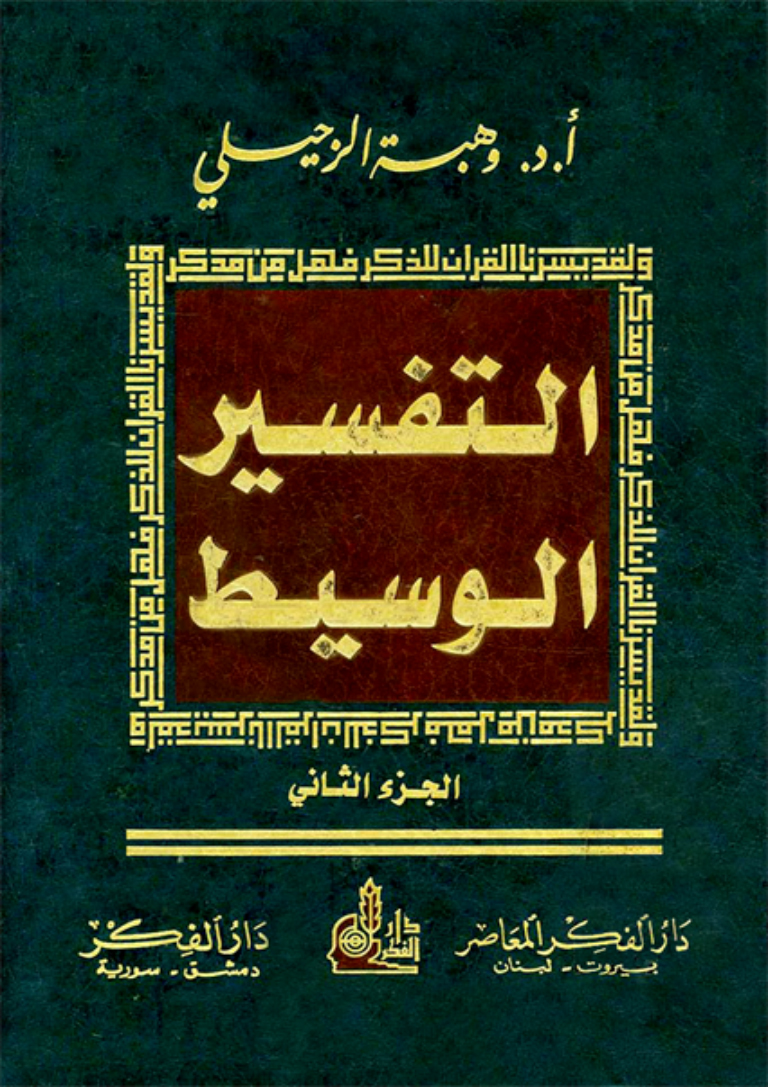الدكتور محمد سيد طنطاوي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
ISBN: 977-14-0522-5
الصفحات: ٣٩٢
هذه الآيات تأمر المؤمنين بالتزام شرع التحليل والتحريم الإلهي ، فيباح لكم أيها المؤمنون الأكل مما رزقكم الله حلالا طيبا أي مستلذا ، وعليكم أن تشكروا الله على تباين حالكم من حال الكفرة ، وإن كنتم تعبدونه حقا ، وتطيعونه فيما أمر ، وتنتهون عما نهى. وسبب نزول هذه الآية أن الكفار المشركين كانوا قد سنّوا في الأنعام سننا معينة ، فأحلّوا بعضا وحرموا بعضا ، فأمر الله المؤمنين بأكل جميع الأنعام التي رزقها عباده. وآخر الآية (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) تحريض للنفوس على التزام شرع الله ، كما تقول لرجل : إن كنت من الرجال فافعل كذا ، على معنى تحريض نفسه.
وحصر الله تعالى بكلمة (إِنَّما) المفيدة للحصر المحرمات وقت نزول الآية بالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والمذبوح على غير اسم الله ، ثم نزلت المحرمات بعد ذلك ، لكن من اضطر أو أكره أي دعته الضرورة وألجأته ، من غير بغي ولا عدوان أي غير مستعمل لهذه المحرمات مع وجود غيرها ، ولا متجاوز حدود الله فيها ، فلا مانع من تناول هذه المحرمات ، ويرخص له أكلها ، ويرفع عنه الإثم حال الضرورة ، فيغفر الله فعله ، ويرحمه فلا يعاقبه على مثل ذلك.
ثم رد الله على المشركين الذين حرموا البحائر والسوائب ونحوها من كل ما حرّموا ، وأحلوا ما في بطون بعض الأنعام وإن كان ميتة ، فنهى الله المؤمنين عن سلوك سبيل المشركين بالتحليل والتحريم بآرائهم ، فلا يجوز لكم أيها المشركون أن تحللوا وتحرموا بالرأي والهوى والجهالة ، من دون اتباع شرع الله ، ولمجرد وصف ألسنتكم الكذب من غير دليل ولا حجة ، وذلك لتصير عاقبة أمركم إسناد التحليل والتحريم إلى الله كذبا ، من غير إنزال شيء فيه ، فإن من حلل أو حرم شيئا برأيه المحض ، دون دليل أو وحي من الله ، كان من الكاذبين على الله سبحانه. وهناك
وعيد على الكذب والكاذبين ، فإن الذين يختلقون الكذب على الله ، لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة ، أما في الدنيا فيتمتعون متاعا قليلا زائلا ، وأما في الآخرة فلهم عذاب مؤلم جدا.
ثم أخبر الله تعالى بما حرم على اليهود ، فلقد حرمنا على اليهود ما قصصناه عليك في سورة الأنعام ، وهو ذوات الأظفار كالأوز والبط ، وشحوم الدواب ما عدا السّنام ، والمجاور للأمعاء (الحوايا) والمختلط بالعظام ، وما كان التحريم بظلم من الله ، ولكن كان بسبب ظلم ارتكبوه ، وذلك الظلم : هو عصيان أوامر الله ، ومعاداة الرسل ومعاندتهم ، وتجاوز حدودهم ، فعوقبوا بما حرمه الله عليهم ، كما جاء في آية أخرى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) [النساء : ٤ / ١٦٠]. أي إن التحريم كان صراحة بسبب الظلم والبغي ، عقوبة وتشديدا ، ووضعا للعقوبة في موضعها.
وعلى الرغم من كون التحريم على اليهود ، بسبب ظلم ارتكبوه ، فإن الافتراء على الله ومخالفة أمره ، لا يمنع من التوبة وحصول المغفرة والرحمة ، فإن ربك غفار ستار ، رحيم بالذين افتروا عليه التحريم والتحليل ، وعملوا السوء ؛ وهو كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي بسبب الجهالة ، أي تعدي الطور ، وركوب الرأس ، ويخرج من الجهالة المتعمد ، ثم تابوا وأنابوا إلى الله ، وأصلحوا الأعمال على وفق مراد الله ورسوله ، فإن الله يغفر الذنب للتائب ، ويرحمه في الآخرة والدنيا ، أي إن المغفرة والرحمة مرتبطان بالتوبة والإنابة والندم على الأفعال ، وإصلاح الأعمال.
اتباع ملة إبراهيم عليهالسلام
إن مضمون الرسالات الإلهية الاعتقادية والأخلاقية هو واحد غير مختلف ، فإن جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى عبادة الله وحده دون إشراك ، وإلى نبذ الوثنية وعبادة الأصنام. وإلى الأخلاق الكريمة كالصدق والإحسان والوفاء بالعهد ، وكان إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليهالسلام شديد الدعوة إلى هذه الأصول المشتركة ، فجاء القرآن يلزم نبينا صلىاللهعليهوسلم باتباع ملته والاقتداء به ، لاتصافه بصفات تسع هي ما يأتي في هذه الآيات :
(إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٢٢) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٣) إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٤)) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) [النحل : ١٦ / ١٢٠ ـ ١٢٤].
لما كشف الله فعل اليهود وتحكّمهم في شرعهم ، بذكر ما حرّم عليهم ، أراد أن يبين بعدهم عن شرع إبراهيم والافتخار به ، وأن يصف حال إبراهيم ، ليبين الفرق بين حاله وحالهم وحال قريش أيضا.
وصف الله تعالى في هذه الآيات إبراهيم إمام الحنفاء وأب الأنبياء بتسع صفات وهي :
١ ـ أنه كان أمة ، أي رجلا جامعا للخير والصفات الحميدة ومعلما الخير ، كالناس الكثير.
__________________
(١) رجلا جامعا ومعلما للخير.
(٢) مطيعا.
(٣) مائلا عن الباطل إلى الدين الحق.
(٤) حذف النون من ((لم يك)) لكثرة الاستعمال ، كحذف الياء من : لا أبال ولا أدر.
(٥) اختاره للنبوة.
(٦) شريعته وهي التوحيد.
(٧) فرض تعظيمه.
٢ ـ وكان قانتا لله ، أي خاشعا مطيعا لله تعالى.
٣ ـ وكان حنيفا ، أي مائلا عن الشرك والباطل ، وداعيا للتوحيد ومؤمنا به.
٤ ـ ولم يكن من المشركين ، بل كان من الموحدين في الصغر والكبر.
٥ ـ وكان شاكرا لأنعم الله عليه ، أي جميع نعم الله عليه ، قليلها وكثيرها.
٦ ـ اجتباه ربه ، أي اختاره واصطفاه للنبوة.
٧ ـ وهداه الله إلى صراط مستقيم ، أي وفقه في الدعوة إلى الله إلى طريق قويم.
٨ ـ وآتاه الله في الدنيا حسنة ، أي حببّه إلى جميع الخلق ، فكل أهل الأديان يقرون به ، ويعظمونه ، سواء المسلمون واليهود والنصارى. فالحسنة : لسان الصدق وإمامته بجميع الخلق.
٩ ـ وإنه في الآخرة في زمرة الصالحين ، تحقيقا لدعائه : (رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣)).
وبعد تعداد هذه الصفات التسع لإبراهيم الخليل ، عليهالسلام ، أمر الله نبيه محمدا صلىاللهعليهوسلم باتباعه ، لكماله وصحة توحيده وطريقته ، وبعده عن الشرك ، وكونه لم يكن من المشركين ، واتباع ملة إبراهيم إنما هو في أصول الدعوة ، أي الدعوة إلى توحيد الله ، وفضائل الأخلاق والأعمال ، والوحي إلى محمد صلىاللهعليهوسلم باتباع ملة إبراهيم : من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
ومن حسنات إبراهيم : تعظيمه يوم الجمعة واختياره للعبادة ، كما اختاره نبينا عليه الصلاة والسلام ، لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة ، وتمت فيه النعمة على العباد.
أما تعظيم اليهود السبت واختيارهم إياه ؛ فلأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا
من المخلوقات ، وفرغ فيه من خلق مخلوقاته ، وإنما شرع تعظيمه عند اليهود الذين اتفقوا على ذلك أخيرا ، وألزموا به إلزاما قويا ، فذلك عقوبة من الله لهم ، حيث إنهم لم يثبتوا على تعظيمه ، بل عصوا فيه وتعدوا ، فشدد الله عليهم ، وأعنتهم في هذا التكليف ، ولم يكن تعظيمه من ملة إبراهيم.
وكان باقي الآية وعيدا لهم ، فالله يفصل بين الفريقين من اليهود فيما اختلفوا فيه في شأن اتباع موسى وعيسى ، ويجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب. وظل اليهود متمسكين بتعظيم السبت ، حتى بعث الله عيسى عليهالسلام ، فحولهم إلى يوم الأحد ، كما تحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة. ثم عدلوا عن تحويل عيسى ، وعادوا إلى ما كانوا عليه.
وهناك اختلاف آخر بيّن اليهود ، غير الاختلاف المذكور في الآية ، ذكره نبينا صلىاللهعليهوسلم في الحديث ، حيث قال فيما رواه الشافعي والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، اليهود غدا ، والنصارى بعد غد».
يظهر من إبراز هذه الاختلافات مراد واضح لله عزوجل وهو أن تتحد الأمم والشعوب ، والجماعات والأفراد على عقيدة واحدة وعبادة واحدة ، وأخلاق ومعاملات واحدة ، وعادات ومناهج واحدة ، وحينئذ يعم الخير ، ويسود السلام ، وتنتهي المنازعات إلى يوم القيامة.
أسلوب الدعوة إلى الله
النجاح المحقّق والدائم في الأعمال يتوقف على الأسلوب الناجح والمنهج المعقول ، والخطة السليمة ، وبما أن غرس العقيدة في القلب ليس أمرا سهلا ، فيحتاج ذلك إلى حكمة في الخطاب ، وإثارة العاطفة ، وإقناع العقل ، وتنبيه الفكر ، وإذا استخدمت هذه الوسائل ، ولم تحقق الهدف المطلوب ، كان الموقف من المخاطبين متسما بالعناد وركوب الرأس ، والتأثر بالأهواء والمصالح أو لعوامل أخرى كالتبعة إلى سيد أو قائد ، والمهم التزام الأسلوب الحسن ، كما قال الله تعالى في الدّعوة إلى دين الله تعالى :
(ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨)) (١) [النحل : ١٦ / ١٢٥ ـ ١٢٨].
اشتملت الآيات على بيان أسلوب الدعوة إلى الله تعالى ، وعلى العدالة والمماثلة في العقاب ، وعلى الصبر في المحن والمصائب.
وسبب نزول الآية : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ...) فيما روى الحاكم والبيهقي والبزار عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقف على حمزة حين استشهد ، وقد مثّل به ، فقال ، لأمثلنّ بسبعين منهم مكانك ، فنزل جبريل ، والنبي صلىاللهعليهوسلم واقف ، بخواتيم سورة النحل : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ...)
__________________
(١) مضايقة وحرج.
إلى آخر السورة ، فكفّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وأمسك عما أراد. أي من الانتقام والأخذ بالثأر لحمزة.
فهذه الآية نزلت في شأن التمثيل بالحمزة رضي الله عنه في يوم أحد. وقيل لهرم ابن حبان حين احتضر : أوص ، فقال : إنما الوصية في المال ، ولا مال لي ، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) الآيات.
والمعنى : ادع أيها النبي الناس إلى دين الله وشريعة ربك ، وهي الإسلام ، بالحكمة : أي بالقول المحكم ، والموعظة الحسنة ، أي بالعبرة والتوجيه والكلمة المؤثرة في القلوب ، والتلطف بالإنسان ، بإحلاله وتنشيطه ، ليحذر الناس بأس الله تعالى ، ويحققوا لأنفسهم النجاح ، وجادلهم بالتي هي أحسن ، أي وحاججهم محاجة تتصف بالحسن ، والإقناع ، وبالرفق واللين ، ولطف الخطاب ، والصفح عن المسيء ، وقابل الإساءة بالإحسان ، واقصد من الجدال الوصول إلى الحق ، دون رفع الصوت أو السبّ أو التعيير أو التهكّم والاستهزاء ، كما قال الله تعالى : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) [العنكبوت : ٢٩ / ٤٦].
ثم ذكر الله تعالى علة الأمر بالمجاملة في القول : وهي أنه سبحانه علم الشقي والسعيد من الناس ، ومن حاد أو انحرف عن سبيل الله والحق ، وهو مجازيهم على ضلالهم واهتدائهم حين لقاء ربهم ، فله وحده الجزاء والحساب ، لا لأحد من البشر ولو كان نبيا.
والعقاب ينبغي أن يكون بالمثل ، فإن عاقبتم أحدا من الناس على إساءته أو جرمه ، فعاقبوه بمثل فعله ، فذلك هو موجب العدل ، ولئن صبرتم على الأذى وصفحتم عن المسيء ، فالصبر والعفو خير للصابرين أو العافين من الانتقام ، لأن انتقام الله أشد ، وعقابه أعظم. فهذه الآية كما تقدم بإجماع المفسرين مدنية نزلت في
شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه يوم أحد. ولتأكيد مضمونها أمر الله نبيه بقوله : اصبر أيها النبي على ما أصابك من أذى في سبيل الدعوة ، وما صبرك إلا بعون الله وتوفيقه ومشيئته ، ولا تجزع أو لا تحزن على إعراض المشركين والمخالفين المعادين ، فإن الله قدّر ذلك ، ولا تحزن على قتلى أحد ، فترك الحزن مما يستعان به على الصبر ، ولا تكن في غم وضيق صدر من مكرهم وتدبيرهم الكيد لك ، ومحاولتهم إلحاق السوء والأذى بك ، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك.
إن الله مع المتقين الذين تركوا المحارم ، واجتنبوا المعاصي ، إنه تعالى معهم بالنصر والعون والتأييد ، والله مع المحسنين أعمالهم برعاية الفرائض والمندوبات في فعل الخير ، والقيام بالطاعة ، وأداء الحقوق ، وفعل الواجبات. والصبر : من التقوى والإحسان. إن هذه المعية لله مع المتقين والمحسنين معية خاصة ، يراد بها الإعانة والتأييد والهداية.
تفسير سورة الإسراء
معجزة الإسراء
تقترن نبوة النبي أو إرسال الرسول عادة بمعجزة : وهي الأمر الخارق للعادة ، لإثبات النبي أو الرسول صدقه أمام قومه ، وأنه نزل عليه الوحي من ربه ، ومن المعروف أن الله تعالى أيّد نبينا محمدا صلىاللهعليهوسلم بمعجزات مثل معجزات الأنبياء قبله ، وقد ينفرد بمعجزة لا يماثله فيها نبي سابق ، مثل انشقاق القمر ، والإسراء والمعراج. وكان حادث الإسراء قبل الهجرة بعام أو بعام ونصف ، وكان ذلك في رجب ، والنبي صلىاللهعليهوسلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوما ، والمتحقق أن ذلك كان بعد شقّ الصحيفة : وثيقة مقاطعة قبائل قريش لبني هاشم وبني المطلب. وافتتح الله تعالى سورة الإسراء بخبره الموجز في الآية التالية من سورة الإسراء المكية :
(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١)) (١) (٢) (٣) [الإسراء : ١٧ / ١].
لفظ الآية يقتضي أن الله عزوجل أسرى بعبده : وهو محمد صلىاللهعليهوسلم. والمعنى : تنزه الله تعالى من كل سوء أو عجز أو نقص أو شريك أو ولد ، فهو كامل الصفات تام القدرة ، فهو الذي أسرى بعبده محمد بواسطة الملائكة ، في جزء من الليل ، وبشخصه
__________________
(١) تنزيها لله وتعجيبا من قدرته.
(٢) سار به ليلا بالبراق.
(٣) وهو مسجد بيت المقدس ، سمي ((الأقصى)) في ذلك الوقت ؛ لأنه كان أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة.
جسدا وروحا ، في تمام اليقظة ، لا في المنام ، من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ، في بيت المقدس ، وعاد إلى بلده في ليلته ؛ لأن الله تعالى قادر قدرة تامة على فعل العجائب والمعجزات.
وأكثر المفسرين اتفقوا على أن الإسراء حدث بالجسد والروح ، المعبر عنه بكلمة «عبده» وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة ، لا في الرؤيا والمنام ، ولو كان مناما لقال الله تعالى : بروح عبده ، ولم يقل : «بعبده» ولو كان مناما ، لما كانت فيه آية ولا معجزة. ثم عرج بالنبي صلىاللهعليهوسلم إلى السموات وإلى ما فوق العرش ، حيث فرضت في المعراج الصلاة على المؤمنين ، وكانت بحق معراج المؤمن ، وصلة بين العبد وربه ، ولا خلاف أن في الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس على هذه الأمة.
ووصف الله تعالى ما حول الأقصى بالبركة من ناحيتين :
إحداهما ـ النبوة والشرائع وإرسال الرسل الذين كانوا في ذلك القطر ، وفي نواحيه ونواديه.
الناحية الثانية ـ النّعم من الأشجار والمياه والأرض الخصبة ذات الأنهار والأشجار والثمار ، التي خص الله الشام بها. روى ابن عساكر عن زهير بن محمد عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات ، وخص فلسطين بالتقديس» وهو ضعيف.
وكان القصد من الإسراء : هو ما قاله الله تعالى : (لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا) أي لنري محمدا بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات ، والملائكة ، والجنة ، وسدرة المنتهى وغير ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. وقوله تعالى في نهاية الآية : (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) وعيد من الله تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمدا صلىاللهعليهوسلم في أمر الإسراء ، فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك ، معناها : إن الله هو السميع لما تقولون ، البصير
بأفعالكم ، يسمع الله أقوال المشركين وتعليقاتهم على حادث الإسراء واستهجانهم لوقوعه ، واستهزاءهم بالنبي صلىاللهعليهوسلم في إسرائه من مكة إلى القدس ، والله يبصر ما فعل أولئك المشركون ، وبما يكيدون لنبي الله ورسالته.
وقد تواترت بذلك الأخبار والأحاديث النبوية في مصنفات الحديث الثابتة ، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام ، حيث روي عن عشرين صحابيا. وجلّ العلماء على أن الإسراء كان بشخصه صلىاللهعليهوسلم ، وأنه ركب البراق من مكة ، ووصل إلى بيت المقدس وصلّى فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما جاء في كتاب الطبري : هو دابة إبراهيم عليهالسلام الذي كان يزور عليه البيت الحرام.
والإسراء بكامل شخص النبي صلىاللهعليهوسلم هو الصحيح ، ولو كانت الحادثة منامية ، ما أمكن قريشا أن تشنّع ، ولا فضّل أبو بكر رضي الله عنه بالتصديق ، لأنه كان أول المصدّقين ، ولا قالت له أم هانئ : لا تحدث الناس بهذا ، فيكذبوك. وأما المراد بقوله تعالى : (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) [الإسراء : ١٧ / ٦٠]. فهي رؤيا بصرية لا منامية ، لأنه يقال لرؤية العين : رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها بأن الإسراء رؤيا منامية ، فهو لم يصح ، لأن عائشة كانت صغيرة ، لم تشاهد الحادث ، ولا حدّثت بذلك عن النبي صلىاللهعليهوسلم.
إنزال التوراة على موسى عليهالسلام
إن من أصول الإيمان في ديننا : هو الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ، وهي مائة وأربعة كتب : صحف شيث ستون ، وصحف إبراهيم ثلاثون ، وصحف موسى قبل التوراة عشر ، والتوراة والزبور
والإنجيل والفرقان ، وقد أخبر الله تعالى في أوائل سورة الإسراء بإنزال التوراة على موسى عليهالسلام أحد الأنبياء والرسل الخمسة أولي العزم ، فقال سبحانه :
(وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (٢) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (٣)) (١) (٢) [الإسراء : ١٧ / ٢ ـ ٣].
عطف الله تعالى بقوله : (وَآتَيْنا) على حادث الإسراء في قوله : (أَسْرى بِعَبْدِهِ) لعقد الصلة بين الخبرين ، كأنه سبحانه قال : أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا ، وآتينا موسى كتاب التوراة ، فلقد أكرم الله تعالى موسى عليهالسلام ، قبل محمد صلىاللهعليهوسلم ، بالكتاب المنزل الذي آتاه أو أعطاه إياه ، وهو التوراة الذي جعله الله هداية لبني إسرائيل ، يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب ، من ظلمات الجهل والضلال والكفر ، إلى نور العلم والمعرفة والدين الحق. وقد جعلنا ذلك الإنزال لئلا تتخذوا يا ذرية نوح من دون الله وكيلا تفوضون إليه أموركم ، فقوله سبحانه : (وَكِيلاً) أي ربّا تكلون إليه أموركم.
والمقصود : لا تتخذوا ربا تفوضون إليه أموركم ، فأنتم من ذرية أو بني نوح لصلبه ، لأن نوحا عليهالسلام ، آدم الأصغر ، وأبو البشر الثاني ، وكل من على الأرض من نسله ، وتلك الذرية : هم الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح ، وهداهم إلى طريق التوحيد والحق والخير ، وتعداد هذه النعم على الناس في الإنجاء المؤدي إلى وجودهم ، يقتضي قبح الكفر والعصيان منهم ، كما أن أصلهم وهو نوح كان عبدا شاكرا لأنعم الله وكثير الشكر في أحواله ، يحمد الله في كل حال ، وعلى كل نعمة ، على المطعم والمشرب والملبس وقضاء الحاجة ونحو ذلك. فما على الذرية إلا أن يقتفوا أثر نوح ، ويتبعوا منهجه وسنته في توحيد الله وعبادته ، والاقتداء به.
__________________
(١) ربا تكلون إليه أموركم.
(٢) منصوب بفعل : تتخذوا ، فهو مفعول به ثان ، أي ألّا تتخذوا بشرا إلها من دون الله ، أو منصوب على الاختصاص أو على النداء ، أي أخص ذرية أو يا ذرية.
ووصف نوح بكونه (عبدا) ، ووصف نبينا محمد أيضا بأنه (عبد الله) دليل واضح على مرتبة الأنبياء ، وهي مرتبة العبودية الخالصة لله تعالى ، فإن معجزة الإسراء والمعراج الخارقة لنبينا ، لا يصح وصفها بغير حقيقتها ، ولا إنزال النبي في منزلة تتجاوز موضعه الحقيقي ، وهو كونه عبدا لله ، أي خاضعا لعزة الله وسلطانه.
وإن إنزال التوراة على موسى عليهالسلام إنما هو من أجل الالتزام بأحكامها والاهتداء بهديها ، والتقاء أتباعها مع دعوة الحق ، ودعوات الأنبياء جميعا ، ومنهم نوح عليهالسلام وخاتم النبيين محمد صلىاللهعليهوسلم. وهذا المنهاج الموحد للأنبياء : هو الذي ينبغي أن يقتدي به الناس ، فإن الدعوة إلى توحيد الله وعبادته واحدة في كل الشرائع ، ولا يصح أن يكون بين أتباع الأنبياء اختلاف وأحقاد ، وكراهية وعداوة ، فذلك شأن من لا يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر.
وتوحيد هذا المنهاج يفهم مما ربط الله تعالى به النهي عن الإشراك واتباع ذرية نوح الموحدة لله ، والمراد الحمل على التوحيد لله ، بذكر إنعامه تعالى عليهم المتضمن إنجاء آباء البشرية من الغرق في سفينة نوح عليهالسلام ، حين لم يكن لهم وكيل يتوكلون عليه ، سوى الله تعالى.
وينبني على منهج التوحيد لله رب العالمين ألا يتخذ البشر أحدا منهم إلها من دون الله ، أو أربابا من دون الله ، فإن المنعم الحقيقي هو الله تعالى ، والناس بسبب ضعفهم وحاجتهم إلى الله سبحانه أجدر بهم أن يتجهوا نحو ربهم الذي خلقهم وهداهم وأنعم عليهم ، وهو وحده الذي يحاسبهم في الدار الآخرة على كل ما قدموه من خير أو شر.
إفساد الإسرائيليين وتشريدهم مرتين
إن جزاء الأمم في ميزان العدل الإلهي يكون بحسب الطاعة أو العصيان ، ولا يكون عقاب من الله تعالى لأحد إلا بسبب جرمه وجحوده ، أو تحديه وعناده ومعارضته دعوة الرسل ، وخروجه عن هدي الله تعالى. وهكذا كان الحال مع بني إسرائيل في التاريخ ، أفسدوا في الأرض ، فشردوا فيها مرتين بسبب فسادهم ، ويتكرر العقاب أو الثواب عادة بتكرر سببه. قال الله تعالى واصفا هذه الأحوال :
(وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (٤) فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (٥) ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (٦) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً (٧) عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً (٨)) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) [الإسراء : ١٧ / ٤ ـ ٨].
هذه الآيات : إخبار عن أحوال بني إسرائيل وتاريخهم القديم ، ومضمون الخبر : أن الله أعلمهم في التوراة على لسان موسى ، وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم سيفسدون في الأرض التي يحلّون فيها مرتين ، ويخالفون مخالفتين : مخالفة ما جاء في التوراة وتغييرها ، وقتل بعض الأنبياء مثل أشعيا وزكريا ويحيى ، ويتكبرون عن طاعة
__________________
(١) علمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين.
(٢) تتجاوزنّ في الظلم والعدوان.
(٣) يجوز أن يقع الوعد في الشر بمعنى العقاب الحالّ.
(٤) ذوي قوة.
(٥) الديار : هي المنازل والمساكن.
(٦) الغلبة.
(٧) أكثر عددا من عدوكم.
(٨) أي بعثناهم ليسوءوا ، فهي لام ((كي)).
(٩) ليدمروا ما استولوا عليه.
(١٠) مهادا.
الرسل ، ويطلبون في الأرض العلو والفساد ، ويظلمون من قدروا على ظلمه ، وهذا مطابق لما هم عليه الآن.
فإذا حان موعد المرة الأولى من الإفساد والشر ، وحل وقت العقاب ، سلط الله عليهم جندا أولي بأس شديد ، أي قوة وشدة ، فتوغلوا في بلادهم وتملكوها ، وقاموا بتخريب مدنهم ، وإحراق التوراة ، وسبي كثير منهم ، وكان هذا وعدا حتمي الوقوع ، نافذ المفعول ، بسبب تمردهم عن طاعة الله ، وقتلهم الأنبياء.
ثم رد الله تعالى لهم القوة ، وأهلك أعداءهم ، وجعلهم أكثر نفيرا أي عددا من الرجال ، وأمدهم الله بالأموال والأولاد ، في حال الطاعة والاستقامة على أمر الله. وتبدّل هذه الحال للعبرة والعظة.
وبما أن شرع الله وقانونه عادل ، فإن الله سبحانه أوضح لهم أنه إن أحسنوا العمل ، وأطاعوا الله ، واتبعوا الأوامر ، واجتنبوا النواهي ، فإنهم يحسنون لأنفسهم ؛ لأن الطاعة تنفعهم ، وإن أساؤوا بفعل المحرّمات ، أساؤوا لأنفسهم ، لأن وباء المعصية يضرهم ، ويمنع عنهم الخير ، ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنيا ، وإيقاع العذاب في الآخرة.
وإذا حان موعد الإفساد الثاني ، وحل أجل العقاب عليه ، بعث الله عليهم الأشداء ، وتعرضوا لإظهار الإساءة في وجوههم بالقهر والإهانة من أولي البأس الشديد ، ودخول مسجد بيت المقدس قاهرين مفسدين ، كما حدث في المرة الأولى ، ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريبا وهلاكا شديدا ، بإزالة آثار الحضارة والعمران ، وإبادة السكان ، وإتلاف الحرث والزرع والثمر.
ثم يفتح الله تعالى باب الأمل أمام المفسدين من بني إسرائيل ، ومضمونه : لعل الله أن يرحمهم ، ويعفو عنهم بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداء ، إن
تابوا وأقلعوا عن المعاصي ، فإن عادوا إلى الإفساد والعصيان في مرة ثالثة ، أعاد الله عليهم تسليط الأعداء ، وإنزال العقاب بهم ، بأشد مما مضى سابقا ، مع ادخار العذاب لهم أيضا في الآخرة.
والله تعالى جعل جهنم للكافرين مستقرا وسجنا لا محيد عنه ، كما جعلها مهادا ومستقرا لهم ، ومحطة تشوى فيها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، وهذا تصوير لشمول العذاب لهم ، كما جاء في آية أخرى : (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) [الأعراف : ٧ / ٤١] أي أغطية.
وتكون العبرة في سرد وقائع التاريخ الإسرائيلي في القرآن واضحة ، وهي أن التنكيل والعذاب شأنهم في الدنيا إذا أدمنوا الفساد والإفساد ، والإنقاذ والرحمة كغيرهم يشملهم إذا استقاموا على طاعة الله والتزموا أوامره.
الغاية من إنزال القرآن
لكل شيء حكمة وغاية ، وأفعال الله تعالى تهدف إلى تحقيق غاية ، وترشد إلى مصلحة ، وتدعو إلى ما فيه خير ، وتمنع كل ما هو شر ، وإنزال القرآن الكريم والدعوات الإلهية والرسالية أو النبوية من أجل تحقيق غايات كبري وأهداف سامية ، لمصلحة البشرية جمعاء ، وللمسلمين والمسلمات بصفة خاصة ، وأهداف القرآن : عامة وخاصة ، وعمومها : الهداية للطريق التي هي أقوم ، وخاصة : تبشير الطائعين بالجنة ، وإنذار العصاة بالنار ، قال الله تعالى مبينا هذه الأهداف :
(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْراً كَبِيراً (٩) وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (١٠) وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً (١١)) (١) [الإسراء : ١٧ / ٩ ـ ١١].
هذه الآيات دعوة صريحة قاطعة مقنعة للناس جميعا ، للإيمان بالقرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله ، لإنقاذهم من الظلمات إلى النور ، وإسعادهم في الدنيا والآخرة ، وأسباب هذه الدعوة ثلاثة :
أولا ـ إن القرآن الكريم يرشد ويدعو للحال والطريقة التي هي أقوم وأصلح ، وأسدّ وأحكم ، وهي الدين القويم ، وملة التوحيد الخالص لله : (لا إله إلا الله) والأقوال والأفعال السديدة الرشيدة.
ثانيا ـ إن القرآن العظيم ذو هدف إصلاحي جذري في الحياة الإنسانية ، فهو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من فرائض ومندوبات وأعمال خيّرة ، يبشرهم بالثواب العظيم أو الأجر الكبير وهو الجنة يوم القيامة ، جزاء عملهم. وعمل الصالحات إنما هو لكمال الإيمان ، وترجمة المصداقية والانسجام مع العقيدة.
ثالثا ـ إن القرآن المجيد ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله وتوحيده ، ولا بوجود البعث والآخرة ، والثواب والعقاب ، ينذرهم بالعذاب الشديد الموجع أو المؤلم ، جزاء ما قدموا من سوء الاعتقاد وفساد الأعمال.
فيكون للقرآن هدف إيجابي وسلبي معا في آن واحد ، فهو يبشر المؤمنين العاملين عملا صالحا بالجنة ، وينذر الكافرين بالعذاب الأليم ، وفي هذا التوجه المزدوج مسرّة لأهل الإيمان ، ووعيد للكفار والعصاة.
ولكن الإنسان ظالم لنفسه عادة ، ويتعجل النتائج ، مما استدعى أن تكون هذه
__________________
(١) أعتدنا : معناه أحضرنا وأعددنا.
الآية : (وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ) ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على أموالهم وأولادهم في وقت الغضب والتضجر ، فهم يدعون بالشّر في ذلك الوقت ، كما يدعون بالخير في وقت التثبت ، فلو أجاب الله دعاءهم في وقت الشر لأهلكهم ، ولكن الله تعالى يصفح ولا يجيب دعاء الضّجر المستعجل.
إن الله لطيف بعباده ، لا يجيب دعاء المتعجل بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ، كما يدعو ربّه بالخير ، أي بالعافية والسلامة والرزق ، ولو استجيب دعاؤه لهلك ، ولكن الله بفضله ورحمته لا يستجيب دعاءه ، كما قال الله سبحانه في آية أخرى : (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) [يونس : ١٠ / ١١].
وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تدعو على أنفسكم ، ولا على أموالكم ، أن توافقوا من الله ساعة إجابة ، يستجيب فيها».
والذي يحمل الإنسان على ذلك مع الأسف : هو قلقه وعجلته ، وطمعه وحرصه ، كما صوّر القرآن هذا الطبع في قوله تعالى : (وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً) أي يتعجل تحصيل المطلوب ، دون تفكير في عواقبه.
وكلمة : (الإنسان) في الآية يراد بها الجنس (وهو أيّ إنسان) بحسب ما في الخلق من ذلك. وما على الإنسان إلا أن يتعقل ويصبر ولا يتعجل ، ويفوض الأمر للخالق البارئ المقدر ، ويهتدي بهداية القرآن في الإرشاد لما فيه حسن الختام والعاقبة ، ولما يتفق مع الواقع ، فليست الحياة جنة طافحة بالنعم والخير ، وإنما فيها الشر والشدة أحيانا ، كما أن فيها الخير واليسر والسعة أحيانا أخرى.
المسؤولية الشخصية
الحياة ابتلاء واختبار ، والإنسان يتقلب في المعاش والكسب مستفيدا من ظرف الليل والنهار ، وما فيهما من فوائد تدل على قيمة الوقت وحساب الزمان ، ومقتضى العدل والحق أن يستقل كل إنسان في عمله والمسؤولية عنه ، لأن له ثمرته ، وعليه تبعاته ، ويكون حسابه في الدنيا والآخرة حسابا فرديا شخصيا ، لا يسأل عن عمل غيره ، وهو الذي يسطّر لنفسه النتائج ، فمن اهتدى إلى الحق والخير ، وعمل بموجبها ، كان نفع الهداية لنفسه ، ومن تنكر للحق وسلك طريق الشر ، كان وبال الضلال على نفسه ، فالمسئولية شخصية ، ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد البيان والإنذار ، قال الله تعالى مبينا هذه القواعد :
(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً (١٢) وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً (١٣) اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (١٤) مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (١٥)) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) [الإسراء : ١٧ / ١٢ ـ ١٥].
هذه الآيات تبين بعض نعم الحياة الدنيوية ، وهي أيضا تدل على قدرة الله العظمى وحكمته البالغة ، فالله سبحانه جعل الليل والنهار علامتين دالتين على قدرته وبديع صنعه ، وفي تعاقبهما تحقيق مصلحة الإنسان والحيوان والنبات ، أما الليل وظلامه ، ففيه الراحة والسكون ، وأما النهار وضوؤه بالشمس ، ففيه التقلب في أنحاء
__________________
(١) جعلنا القمر مطموس الضوء.
(٢) جعلنا الشمس مضيئة.
(٣) وكلّ : منصوب بفعل مقدر تقديره أوجدنا.
(٤) أي ألزمناه عمله من خير أو شر.
(٥) حاسبا أو محاسبا.
(٦) لا تحمل نفس آثمة.
الدنيا للعمل والعيش والكسب ، والضوء يناسبه الحركة والانتقال وإتقان الأعمال ، والظلام في الليل يناسبه هدوء الأعصاب ، وراحة الجسد ، ومتعة العقل والفكر. وفي تعاقب الليل والنهار ابتغاء الرزق والتمكن من التخطيط ليلا ، وإنجاز العمل نهارا.
وفي دوران الليل والنهار تعريف بحساب الزمان ومرور الأيام والشهور والأعوام ، والتعرف على المصالح في الدورات الزراعية ، وتحديد الآجال والأعمار ، والديون والمعاملات ، ومعرفة حساب وقت العبادات من صلاة وصيام ، وحجّ وزكاة ، ولو لم يتغاير الليل والنهار لما تحققت الراحة ، ولما عرف مقدار الوقت ، وعاش الإنسان في عماية وجهالة ، أو في تعب وعناء ، لحساب الأشياء وتقدير الأزمان.
ومن كرم الله وفضله : أنه سبحانه أبان للإنسان كل شيء به حاجة في مصالح الدين والدنيا والآخرة ، وعرّفه طريق الحياة ، ودستور المعيشة ، وأسلوب المعاملة ، بتفصيل دقيق ، وبيان واف.
وجعل الله عمل كل إنسان ملازما له ، بخيره وشره ، فيكون المراد بقوله سبحانه : (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ) هو عمله ، فالطائر : هو العمل الصادر عن الإنسان ، وملازمته له كملازمة الطائر لصاحبه.
قال ابن عباس : (طائره) : ما قدّر عليه وله. وخاطب الله العرب في هذه الآية بما تعرف من عادة زجر الطير تيامنا وتشاؤما ؛ وسيخرج الله لكل إنسان يوم القيامة كتابا يراه ، ويستقبله منشورا أمامه ، فيه جميع أعماله خيرها وشرها. ويقال له حين تلقّي الكتاب : اقرأ كتاب عملك في الدنيا ، كفى بنفسك حاسبا تحسب أعمالك وتحصيها. قال الحسن البصري : قد عدل ، والله فيك ، من جعلك حسيب نفسك.
وإذا كان كل واحد مختصا بعمل نفسه ، فمن اهتدى إلى الحق والصواب ، واتبع