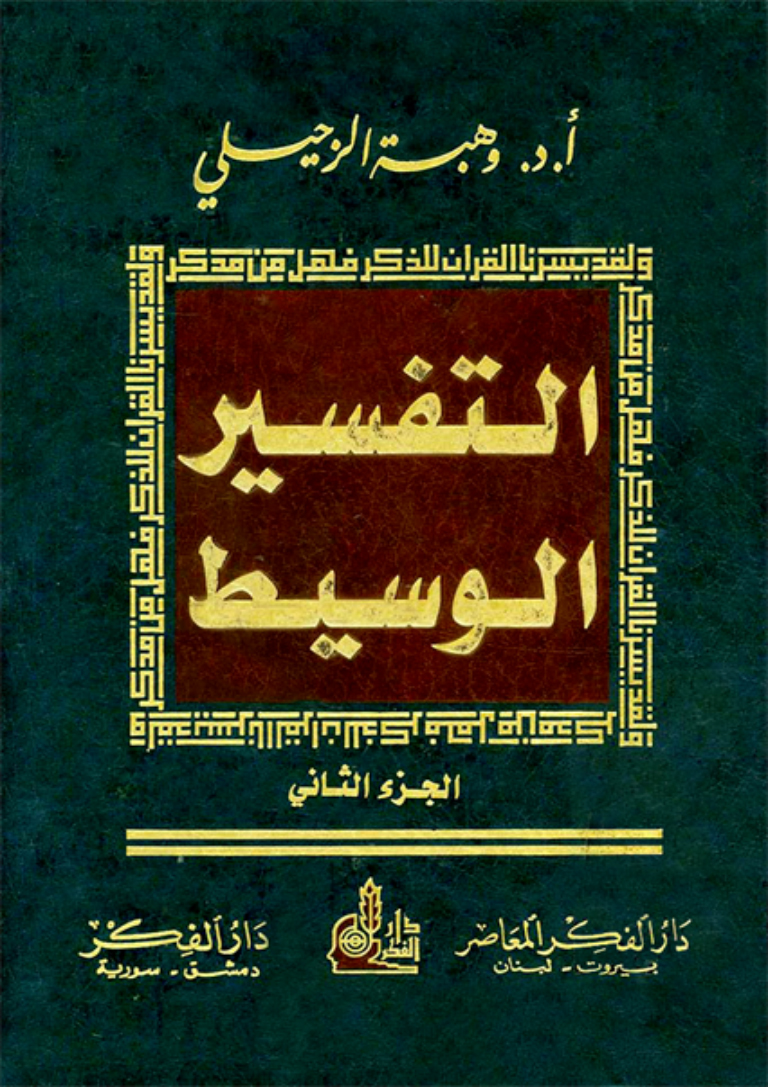الدكتور محمد سيد طنطاوي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
ISBN: 977-14-0522-5
الصفحات: ٣٩٢
ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨)) [يونس : ١٠ / ١٥ ـ ١٨].
هذه الآيات إظهار للحجة القاطعة من الله على المشركين في التكذيب بالقرآن ، والعكوف على عبادة الأصنام ، وبيان واضح أن القرآن ليس من قبل النّبي محمد ولا هو من عنده ، وإنما هو من عند الله ، ولو شاء الله ما بعثه به ، ولا تلاه عليهم ، ولا أعلمهم به. فقولهم : (ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا) أي من نمط آخر ليس فيه عيب آلهة المشركين ، إنهم يريدون تبديل القرآن على حسب مزاجهم ، بجعل آية مكان آية في الوعيد والطعن بهم. ومنشأ هذا المطلب : هو إنكارهم البعث والحساب ، وتكذيبهم بالثواب والعقاب في الآخرة.
فردّ الله عليهم معلّما نبيّه أن يقول : ما يصح لي ولا من شأني أن أبدّل هذا القرآن من قبل نفسي ، فليس هو كلامي ، وإنما هو كلام الله ، وإني لا أتبع فيه إلا ما يوحى إلي ، وهو ما أبلّغكم به ، إني أخشى إن خالفت وحي ربّي وأمره عذاب يوم عظيم الهول ، شديد الوقع ، وهو عذاب النار يوم القيامة.
بل قل لهم أيها الرّسول : لو شاء الله ألا أتلو هذا القرآن عليكم ما تلوته ، ولو شاء الله ألا أعلمكم به أو أخبركم بأحكامه ، وأنتم أعلم الناس بسيرتي ، ولم تجرّبوني في كذب ، بدليل أني مكثت بينكم أربعين سنة من قبل نزول القرآن ، لا أتلو شيئا منه ولا أعلمه ، أفلا تستعملون عقولكم وتتفكرون في أن من عاش أمّيّا أربعين عاما ، لم يقرأ كتابا ولا تعلّم من أحد ، لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته وعلومه وشرائعه ، ولم تستطيعوا معارضته أو الإتيان بمثل أقصر سورة منه ، وهذا دليل على أن القرآن يتميّز بإعجازه التّام ، لأنه كلام الله ، وليس كلام بشر.
فلا أحد في البشر أظلم من رجلين : أحدهما ـ من افترى على الله الكذب بنسبة الشّريك أو الولد لله ، أو بتبديل كلامه على النّحو الذي اقترحتموه ، والثاني ـ من كذب بآيات الله البيّنة ، فكفر بها ، إنه لا يفوز المجرمون (أي الكافرون) في الآخرة. وهذا دليل على عظم جرم المفتري على الله بعد بيانه الساطع بأن القرآن كلام الله ، ودليل أيضا على أنه لا نجاة للكفار من العذاب الأخروي ، ولن يحققوا أي فوز ، بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى.
وأي الموقفين أصحّ عقلا وأسلم عاقبة وأبين حقيقة : موقف الإيمان بربّ واحد خالق رازق ، نافع مانع للضّر ، أو موقف المشركين الذين يعبدون الأصنام ، ويزعمون أن شفاعتها تنفعهم عند الله ، أو أنهم وسطاء لهم بين يدي الله. فردّ الله عليهم بقوله : (قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ ..) أي قل لهم أيها الرّسول : لا دليل لكم على ما تدّعون ، أتخبرون الله بما لا وجود له في السّماوات ولا في الأرض ، وما لا يعلم من وجود هؤلاء الشفعاء المزعومين ، تنزه الله عن أن يكون له شريك أو معين ، وتعاظم وتعالى علوّا كبيرا عما يشركون به من الشّفعاء والوسطاء ، ويستحيل على الله وجود شيء من الشّرك أو الشّركاء الذين يشركونهم به.
وهذا تقريع وتوبيخ للمشركين في زعمهم وافترائهم بوجود أنباء في السماوات والأرض ، لا يعلمها الله ولا وجود لها في الواقع.
وحدة المعبود والسّلطان الإلهي
تدلّ الفطرة الإنسانيّة الأصليّة في جميع البشر على الإقرار بوجود إله واحد ، والإذعان لربّ واحد ، له السّلطان الغيبي المطلق والتّصرف الشّامل في الكون
والإنسان ، والرحمة والشدة ، والنفع والضّر ، فإذا تركت هذه الفطرة على مساقها السليم ، كان الإنسان موحّدا ، عابدا لله وحده ، فهو المعبود بحق ، وكل ما يصدر عن الإنسان من شرك وانحراف ، وتصورات شاذّة عن الإله خالق الكون ، فإنما هو من منشأ طارئ ، يعكّر صفو الاتجاه الصحيح نحو الله تعالى. قال الله سبحانه مصوّرا حقيقة الفطرة السّوية في أقدم العصور :
(وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٩) وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٢٠) وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (٢١)) (١) (٢) (٣) [يونس : ١٠ / ١٩ ـ ٢١].
إن توحيد الله تعالى أمر قديم في البشر ، وهو الأصل العام في كل إنسان ، وما الشّرك في العبادة أو الوثنية وعبادة الأصنام إلا أمر طارئ دخيل ، ومذهب فاسد حادث في الناس ، بسبب اتّباع الأهواء والتصورات المخطئة. فقد كان الناس كلهم على دين واحد وملّة واحدة هو دين التوحيد ، وفطرة الاعتراف بربّ واحد. وذلك كما جاء في آية أخرى : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [البقرة : ٢ / ٢١٣] ويوضح هذا الحديث الصحيح : «كل مولود يولد على الفطرة ، حتى يعرب عنه لسانه ، فأبواه يهوّدانه ، أو ينصّرانه ، أو يمجّسانه».
لقد طرأ الاختلاف في توحيد الله تعالى على عقول البشر وتصوراتهم بعد الخلق السّوي والتكوين القويم ، ولكن حلم الله ورحمته اقتضيا إمهال الإنسان ليراجع
__________________
(١) نائبة أصابتهم.
(٢) دفع وطعن.
(٣) أعجل جزاء.
حسابه ويصحح خطأه ، ولولا ما تقدم من الله تعالى من كلمة حق في جعل الجزاء الفاصل بين الناس يوم القيامة ، لعجّل العذاب للناس في الدنيا بإهلاك المبطلين ، وتعذيب العصاة بسبب اختلافهم ، ولقضي بينهم في منازعاتهم أو خلافاتهم. وفي هذا وعيد للمنحرفين وإمهال للظالمين الكافرين.
ثم أورد الله شبهة يتمسك بها الكفار في كفرهم وزعمهم ، وهي أنهم يقولون : هلا أنزل على النّبي محمد صلىاللهعليهوسلم آية كونية حسّية مشاهدة كالتي نزلت على نوح وشعيب وهود وصالح وموسى وعيسى ، تلك الآية تضطر الناس إلى الإيمان بالله ، فردّ الله عليهم بأن يقول نبيّه لهم : إنما سلطان الغيب وتقديره أو معرفته وتوجيهه لله تعالى ، إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، لا يطّلع على غيبه أحد ، والله وحده هو المختصّ بعلم الغيب ، فلا يعلم به إلا هو ، والأمر كله لله ، يعلم عواقب الأمور ، فإن قدر وشاء ، أنزل آية كونية أو عقلية أو غيرهما ، وإن شاء لم ينزلها ، ويعلم الوقت المناسب لكل شيء. ثم قال تعالى : (فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) وهذا وعيد واضح ، فإن كنتم لا تؤمنون بي حتى تشاهدوا ما سألتهم من نزول الآيات المقترحة ، فانتظروا حكم الله فيّ وفيكم ، وهو ما يستحلّ بكم من العذاب جزاء عنادكم وجحودكم بالآيات. وقد حقق الله تعالى وعيده ، بنصر عبده محمد صلىاللهعليهوسلم في معركة بدر وغيرها.
وهناك جواب آخر على طلب إنزال آية غير القرآن ، وهو أن الله تعالى إذا أذاق الناس وهم الكفار رحمة ، ورزقهم فضلا ، من بعد ضرّاء مسّتهم ، كالرّخاء بعد الشّدة ، والخصب بعد الجدب ، والأمن بعد الخوف ، والصحة بعد المرض ، إذا هم يسرعون بالمفاجأة الغريبة وهي المكر ، أي الاستهزاء والطعن في مقام الحمد والشكر ، والتّنكر للجميل والمعروف بعد زوال المكروه عنهم ، وعدم الارتداع عن المعاصي ، وذلك في الناس كثير. وإزاء هذا الموقف قل لهم يا محمد : الله تعالى أسرع مكرا ، أي
تدبيرا محكما ، وجزاء عدلا على أفعالكم ، قبل أن تدبروا مكيدة أو خطة لإطفاء نور الإسلام ، وكل آت قريب ، إن رسلنا وهم الملائكة الحفظة الكرام يكتبون أو يسجّلون جميع ما تفعلونه وتدبرونه ، أو تخطّطون له ، ويحصونه عليكم ، ثم يعرضونه على الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ، فيجازي كل واحد على فعله بما يستحق.
مقابلة النّعمة بالجحود
يختلف الناس في تقدير نعمة الله الخالق عليهم ، فالمؤمن يشكر الله تعالى على أفضاله ونعمه الكثيرة في الحياة والصحة والرزق والجاه والمال ، والكافر أو المشرك يقابل النعمة بالجحود ، ويتنكر للمعروف ، وينسى ما تفضّل به الله عليه من نجاة بعد خوف ، وأمن بعد قلق ، وعافية بعد مرض ، وغنى بعد فقر ، وعزّ بعد ذلّ. والشأن في الإنسان السّوي المنصف أن يقرّ بهذه الأفضال الإلهية ، ويشكر المنعم في جميع الأحوال. قال الله تعالى واصفا حال الجاحدين المتنكّرين للجميل والخير :
(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٣)) (١) (٢) (٣) [يونس : ١٠ / ٢٢ ـ ٢٣].
هذه الآية تتضمن تعداد النّعم على الناس ، ثم تزجرهم عن الجحود وتذمّ بغيهم وتجاوزهم الحدود ، ومن أعظم النعم تحقيق الأمن بعد الخوف ، والنّجاة من المخاطر
__________________
(١) شديدة الهبوب.
(٢) أحدق بهم الهلاك.
(٣) يفسدون ويظلمون.
بعد التعّرض لها ، فالله تعالى هو الذي يمكّن الناس من السير وتجاوز المسافات في البر والبحر بوسائط النقل المعروفة ، من الدّواب والبواخر والسيارات والطائرات والقطارات ، وتلك نعم جليلة ، حتى إنه إذا كان الناس راكبين في السّفن الشراعية وجرت فوق الماء بريح هادئة لينة ، ثم تعرّضت للاضطرابات ومخاطر الغرق بتغيّر الريح واشتدادها ، فتهبّ عاصفة قوية ، ويعتقد الركاب أنهم غارقون هالكون بسبب الأعاصير والأمواج العاتية التي تحيط بهم من كل جهة ، في تلك الحالة الرهيبة لا يجد الركاب ملجأ إلا الله ، فيتّجهون إلى دعائه مخلصين له الدعاء والعبادة والتّضرع ، ولا يتّجهون لغير الله ربّهم ، ويقولون بصدق وحرارة وإخلاص : لئن أنجانا الله من هذه المخاطر والدّواهي لنكونن من جماعة الشاكرين نعمة الله ، الموحّدين له ، العابدين إياه. ولكن سرعان ما يتبدل الموقف ، وينقض هؤلاء الركاب العهد أو الوعد ، فحينما ينجيهم الله من تلك الورطة ، وينقذهم من خطر الغرق أو الهلاك ، إذا هم يعودون إلى سيرتهم الأولى ، من نكران وجود الله وتوحيده ، والوقوع في الظلم والبغي ، والعصيان والفسوق ، كما جاء في آية أخرى : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً (٦٧)) [الإسراء : ١٧ / ٦٧].
ثم زجر الله أهل البغي والإسراف ، والجحود والإنكار ، والمعصية والضّلال ، فقال سبحانه : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) أي إنما وبال هذا البغي وجزاؤه وإثمه على أنفسكم في الدنيا والآخرة ، ولا تضرّون به أحدا غيركم ، تتمتعون في الدنيا متاعا زائلا لا قرار له ، من توبيخ الضمير والوجدان ، أو التعرض لأنواع البلايا والأمراض والقلاقل أو الخسران في نهاية الأمر ، وفي الآخرة أيضا جزاء محقق على البغي والانحراف ، لأن مصير جميع الخلائق ومآلهم إلى الله يوم القيامة ، فيخبرهم
بجميع أعمالهم ، ويجازيهم عليها الجزاء الأوفى المناسب ، بسبب ما كانوا يعملون. وفي هذا تهديد كاف ، ووعيد قاطع شاف. جاء في حديث أحمد والبخاري : «ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ، مع ما يدّخر له في الآخرة ، من البغي وقطيعة الرّحم».
وقال سفيان بن عيينة : (إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي تعجّل لكم عقوبته في الحياة الدنيا ، وعلى هذا قالوا : البغي يصرع أهله.
والحقّ أن إنذارات القرآن وألوان التهديد والوعيد بالعذاب لها هدف تربوي سام ، فهي من أجل توجيه الإنسان نحو الخير ، والصلاح ، والهدى والنّور ، والاستقامة على أمر الله وشكره باستعمال القوى الإنسانية في مرضاته ، وهي أيضا تحذير من الشّر وتنبيه إلى مغبّته وسوء عاقبته ، فالويل كل الويل لمن بغى على نفسه وظلم غيره ، قال الله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [النّور : ٢٤ / ٦٣].
أروع مثل للحياة الدنيا
تتميز تشبيهات القرآن الكريم لبعض الأوضاع الجسمية أو الخطيرة بالواقعية والإيجاز ، والتصوير السريع البليغ ، ليسهل إدراك الأمور على وجهها الصحيح ، ولتكون الأحوال المشاهدة خير دليل معبّر عن الواقع ، وعبرة للمتأمّل المتّعظ. فإذا تفاعل الإنسان مع منظور المستقبل وتأثّر بما يؤول إليه ، أحسّ بمسؤوليته ، وبادر إلى العمل والبناء ، والعطاء والإنتاج ، قبل أن يفوت الأوان وتضيع الفرصة. وهذا مثل بليغ للحياة الدنيا تصوّره الآية القرآنية التالية كأن رساما ماهرا يرسم مشاهدها : (إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٤)) (١) (٢) (٣) [يونس : ١٠ / ٢٤].
هذه الآية العظيمة تصوير للحياة والفناء العاجل ، وقد تكرر هذا التشبيه أو التمثيل في القرآن الكريم في مناسبات عديدة ، مثل قوله تعالى : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ (٢٠)) [الحديد : ٥٧ / ٢٠].
وتوضيح هذا المثل كما يبدو فيما يأتي :
إنما مثل التّفاخر في الحياة الدنيا وزينتها بالمال والبنين ، ثم أيلولتها إلى الفناء السريع ، كمطر نزل من السماء ، فاختلط بالتراب والنبات ، فأنبت نباتات شتى ، تشابكت واختلط بعضها ببعض ، منها ما يأكله الناس من زروع وحبوب وثمار ، ومنها ما تأكله الأنعام من علف ومراع وغير ذلك.
حتى إذا تكامل نمو النبات وازدهر ، وأخذت الأرض حسنها وزينتها الفانية ، وتزيّنت بأبهى أنواع الزينة ، واكتسست الجبال والوديان والسهول بالأشجار الباسقة ، والأزهار النّضرة ، والحبوب والثمار اليانعة ، مما يأكل الناس من الزروع والأشجار ونحو ذلك من المراعي والأعلاف ، وازّيّنت ، أي ظهرت زينتها ، وأيقن أهلها الذين زرعوها أو غرسوها أنهم قادرون على جذاذها وحصادها والانتفاع بها. وبينما هم كذلك ، مفتونون بحسن النّبات والثّمر والزهر ، جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة ،
__________________
(١) نضارتها بالنباتات.
(٢) كالنبات المحصود.
(٣) لم تمكث زروعها.
فيبست أوراقها وتلفت ثمارها ، ونزل بها القضاء المقدّر لهلاكها ليلا أو نهارا ، فجعلها الله تعالى كالأرض المحصودة ، لا خضرة ولا نضرة فيها ، كأن لم تنبت ، وكأنها لم تكن في حال حياة قبل ذلك ، وهذا معنى قوله تعالى : (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) أي كأن لم تنعم ولم تنضر ولم تغر بغضارتها ، وفي تفسير أبي بن كعب : وما كنا لنهلكها إلا بذنوب أهلها.
ثم ختم الله تعالى هذا المثل الرائع بقوله : (كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) أي كهذا المثل المبيّن الذي يوضح حال الدنيا وسرعة زوالها ، نبيّن الحجج والأدلّة الدّالة على إثبات التوحيد والجزاء وكل ما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم ، لقوم يتفكرون في آيات الله ، أي يستعملون تفكيرهم وعقولهم في الاتّعاظ والاعتبار بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها زوالا سريعا ، مع اغترارهم بها ، وتمكّنهم من خيراتها ، علما بأن من طبع الدنيا الهرب ممن طلبها ، والطلب لمن هرب منها.
والغرض الواضح من هذه الآية التحذير من الاغترار بالدنيا ، إذ هي معرّضة للتّلف والزّوال بموت أو غيره من رزايا الدنيا. وخصّ المتفكّرين بالذّكر تشريفا للمنزلة ، وليقع التّسابق إلى هذه الرتبة. فجدير بكل عاقل ألا يغتر بالدنيا ، فإنها غرّارة زائلة ، وليبادر إلى اغتنام أيام عمره فيها ، فيعمل العمل الصالح ، ويصحح العقيدة ، ويؤمن بالله حقّ الإيمان ، وينفع نفسه وأمّته ووطنه ، ويخلّد سمعة طيبة إما بكلمة طيبة ، أو بخير يفعله ، أو منع من شرّ يدمّر حياته وحياة غيره.
التّرغيب في الجنّة والتّرهيب من النّار
لم يترك القرآن المجيد خيرا إلا دعا إليه جميع البشر في كل زمان ومكان ، ولم ير في شيء شرّا إلا حذّر منه ونفّر ، وأعلن وأنذر ، وجعل القرآن غاية للخير ومقصدا عامّا
ألا وهو الجنّة ، كما جعل مصير الشّر مصيرا شاملا ومحقّقا ألا وهو النار. وهذا دليل واضح على حبّ الله الخير والمصلحة لعباده ، وإرادته تعالى إبعادهم من الشرور والمفاسد والمساوئ ، لما فيها من ضرر مؤكد وتدمير محقق. قال الله تعالى مبيّنا هذا المنهج الإلهي في شرعة القرآن :
(وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٥) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (٢٦) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (٢٧)) (١) (٢) (٣) (٤) [يونس : ١٠ / ٢٥ ـ ٢٧].
إذا كانت دعوة الإسلام إلى الإيمان بالله وحده دعوة عامّة لكل أجناس البشر ، فإن الهداية التي هي الإرشاد مختصّة بمن قدّر إيمانه. ومعنى الآية : والله يدعو إلى الإيمان والعمل الصالح المؤدّيين إلى دار السّلام وهي الجنّة ، وسميت الجنة بدار السلام ، لأن من دخلها ظفر بالسّلامة والكمال ، وأمن الفناء والآفات ، وسلم من الشوائب والنقائص والأكدار.
ودعوة الله إلى دار السّلام وأمره بالإيمان عام لكل البشر ، ولكنه سبحانه يختص أهل الإيمان بالهداية ، أي بالإرشاد والتوفيق إلى الطريق القويم الموصّل إلى الجنّة ، ولا أقوم ولا أهدى من شرعة القرآن والإسلام المتضمنة أصول العقائد والأخلاق والشرائع والأحكام. ومن المعلوم أن الهداية نوعان : هداية دلالة عامّة ، وهي عامة لجميع الناس ، وهي الدعوة إلى الإيمان والإسلام ، وهداية توفيق وعناية ، وهي خاصة بالمؤمنين ، يوفقهم الله إلى طريق الاستقامة ، ويعينهم على القيام بواجباتها وآدابها.
__________________
(١) غبار مع سواد.
(٢) أثر هوان.
(٣) مانع يمنع عذابه.
(٤) كسيت وغطّيت.
ودعوة القرآن إلى الدين الحق كالدعوة إلى مأدبة فاخرة ، أخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : «خرج علينا رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوما فقال : إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي ، وميكائيل عند رجلي ، يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا ، فقال : اسمع سمعت أذنك ، واعقل عقل قلبك ، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتّخذ دارا ، ثم بنى فيها بيتا ، ثم جعل فيها مأدبة ، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه ، فمنهم من أجاب الرسول ، ومنهم من تركه ، فالله الملك ، والدّار الإسلام ، والبيت الجنّة ، وأنت يا محمد الرّسول ، من أجابك دخل الإسلام ، ومن دخل الإسلام دخل الجنّة ، ومن دخل الجنّة أكل منها».
والسبب في دعوة القرآن إلى الإسلام هو مراعاة مصلحة المدعوين ، فإن للذين أحسنوا العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : المثوبة الحسنى في الدار الآخرة ، ولهم أيضا زيادة وهي النظر إلى وجه الله عزوجل. ولا يغشى وجوه أهل الجنّة شيء مما يغشى وجوه الكفرة من الغبرة التي فيها السواد ، والهوان والصغار : (وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ) والقتر : الغبار المسودّ. أولئك هم مستحقّو الجنّة وأصحابها حقّا ووجوبا ، ويقيمون فيها على الدوام من غير زوال ، وهذا على جهة المدح لهم والتشريف.
وفي مقابل هؤلاء صنف آخر وهم الأشقياء الذين اقترفوا السّيئات وارتكبوا المنكرات من الكفر والشّرك والظّلم ، فلهم جزاء عادل سيّئة مثل سيّئتهم ، أي جزاء مناسب لمعاصيهم ، وتعمّ السّيئات هنا الكفر والمعاصي ، فسيّئة الكفر التّخليد في النار ، وسيّئة المعاصي مرجع الجزاء فيها إلى الله تعالى ، وتحيط بالكافرين والعاصين مذلّة وهو ان لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه ، كأنما ألبست وجوههم أغشية من سواد الليل المظلم ، لفرط سوادها وظلمتها ، أولئك المتّصفون بتلك الصفات هم
لا غيرهم أصحاب النّار هم فيها خالدون ، أي دائمون فيها ، لا يزحزحون عنها.
والحاصل : أن مصير المؤمنين إلى نعيم في الجنان وخلود فيها ، ومصير الكافرين إلى عذاب شديد في النّيران وتخليد فيها ، والمرجع في أهل المعاصي إلى مشيئة الله تبارك وتعالى ، إن شاء عذّبهم ، وإن شاء غفر لهم.
مشهد من مشاهد الحشر
جميع مشاهد القيامة عجيبة مذهلة ، رهيبة مخوفة مؤلمة ، لأن المصير مجهول ، والحساب عسير ، والنهاية أبدية ، فإما إلى جنّة عرضها السماوات والأرض ، وإما إلى نار شديدة اللهب والإحراق. ومن أبرز تلك المشاهد الفصل النهائي بين المشركين وآلهتهم المزعومة ، والحوار الحادّ بين الفريقين ، وهذا ما أوضحه القرآن المجيد في قوله تعالى :
(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ (٢٨) فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (٢٩) هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (٣٠)) (١) (٢) [يونس : ١٠ / ٢٨ ـ ٣٠].
هذا مشهد رهيب من مشاهد الحشر يوم القيامة ، حيث يجتمع الناس في صعيد واحد ، وتحسم فيه المواقف ، وتتبدّد مزاعم المبطلين. يقول الله لنبيّه : اذكر أيها الرسول يوم نجمع أهل الأرض كلهم من الجنّ والإنس ، والبرّ والفاجر ، والمحسن والمسيء ، ثم نقول لأهل الشّرك : الزموا مكانكم ، وذلك مقترن بحال الشّدة والخزي ،
__________________
(١) أي فرقنا بينهم في الحجة والمذهب.
(٢) تختبر أو تعلم.
أنتم وشركاؤكم ، لا تبرحوا المكان حتى تنظروا ما ذا يفعل بكم ، ففرقنا بين الشركاء والمشركين ، وقطعنا ما كان بينهم من الصّلات والعلاقات.
يقف المشركون عبدة الأوثان يوم القيامة ، في موقف الخزي ، مع أصنامهم ، ثم ينطق الله الأصنام بالتّبري منهم ، فيقول الشّركاء وهم الذين يزعم الوثنيّون أنهم شركاء لله ، يقولون لعابديهم : ما كنتم تخصوننا بالعبادة ، إنما كنتم تعبدون الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادا ، فوافقتموهم وأطعتموهم. وفي هذا تهديد ووعيد ، وبيان انقطاع الأمل في شفاعة الشركاء.
والشّركاء : إما الملائكة أو عيسى أو الأصنام التي ينطقها الله تعالى ، وكل ما عبد من دون الله تعالى ، من صنم أو وثن أو شمس وقمر ، أو ملك وإنسيّ وجنّي. فكفى بالله شاهدا وحكما عدلا بيننا وبينكم أنّا ما دعوناكم إلى عبادتنا ، ولا أمرناكم بها ، ولا رضينا منكم بذلك. وهذا تبكيت عظيم للمشركين ، وتهديد في حقّ العابدين.
إننا كنّا في غفلة تامّة عن عبادتكم ، لا ندري بها ، ولا ننظر إليها ، ولا نرضى عنها.
هنالك في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتذوق وتعلم ما قدمت من العمل من خير وشرّ ، فتعرف كيف هو ، أقبيح أم حسن؟ كما يختبر الرجل الشيء ويتعرفه ، ليتبين حاله.
وأرجعوا إلى عقاب الله وشديد بأسه ، ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ، الحقّ الثابت الدّائم ، ففصّلها ، وأدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، دون تلك الشركاء والأنداد الأصنام. وهذا يبين أن الله مولى المشركين في الملك والإحاطة لا في الرحمة والنصر ونحوه.
وذهب عن المشركين افتراؤهم وما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه ،
ويتخذون تلك الأنداد آلهة مزعومة ، ولم يبق لهم نصير ولا شفيع ، والأمر كله يومئذ لله تعالى. وهذا تنبيه على زوال ما يدعون أن تلك الشركاء شفعاء لهم عند الله ، وأن عبادتهم تقرّب إلى الله تعالى.
إن ما يلاقيه المشركون من خيبة الأمل بالأصنام ونحوها من المعبودات تبرهن للعقلاء أن السلطان في الحساب والثواب والعقاب لله وحده. وإذا كان الله وحده هو المحاسب للناس ، فهو المعبود بحق ، وما على الناس قاطبة إلا أن يوجهوا أنفسهم نحو ما يفيد ، ويمنع الضّرر ، وأنه لا شفاعة إطلاقا للأصنام ونحوها ، فهي تعلن البراءة من عابديها ومن عبادتهم الباطلة.
ألا فليستيقظ الضمير والعقل البشري ، وليعلم أن من بيده الخلق والرزق ، والإحياء والإماتة ، والحساب والثواب والعقاب ، هو الجدير بالعبادة والتعظيم ، والتّنزيه والتّقديس ، وطلب المدد منه سبحانه وتعالى.
مناقشة المشركين في وحدانيّة الله
ما من إنسان سوي عاقل إلا ويحسّ في أعماق نفسه بوجود الله الخالق ، ولا بدّ من أن يمرّ في خاطره يوما ما ومضة من تفكير أو شعور مرهف بأنه بأشد الحاجة إلى قدرة الله في تفريج كربه ، ونجاته من محنته ، وهذا ما كان مستقّرا في أذهان المشركين الوثنيّين وعقائدهم ، فإنهم كانوا يقرّون بوجود الله تعالى ، ولكنهم كانوا يسيئون التّصوّر ، فلا يوحّدون الله ، وإنما ينسبون إليه الشّركاء من الأوثان والأصنام وغيرها ، وهذا غاية الانحدار والهبوط في الفكر والتّصور والاعتقاد ، لذا ردّ الله عليهم في هذه الآيات لإثبات توحيد الألوهية وتوحيد الرّبوبية معا من غير انفصال : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (٣١) فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٢) كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٣٣)) (١) (٢) (٣) [يونس : ١٠ / ٣١ ـ ٣٣].
هذه الآيات مناقشة حادّة ، وتوبيخ وإلزام في الحجة لأولئك المشركين الذين يقرّون بوجود الله ، ولكنهم خطأ لا يعتقدون بوحدانية الله ، قل أيها النّبي لمشركي مكّة وأمثالهم : من الذي ينزل المطر من السماء ، فينبت به الزرع والشجر ومختلف النباتات والثمار والفاكهة ، فيكون ذلك رزقا لكم أيها البشر ، بسبب خيرات السماء وبركات الأرض ، ومن الذي أوجد لكم السمع والأبصار ، وهذا لفظ يعم جملة الإنسان ومعظمه ، حتى إن ما عداهما تبع ، ومن الّذي يهب الحياة ، ويزيلها بالموت ، فيخرج الحي من الميت كالجنين من النطفة ، والطائر من البيضة ، والنبات من الأرض ، إذ له نمو شبيه بالحياة الحركية. ومن الذي يخرج الميت من الحي مثل البيضة من الطائر ، والحبّ والنّوى من الزرع والشّجر ، وهناك أمثلة علمية أخرى لإخراج الحيّ من الميت كالغذاء المحروق الذي يتناوله الإنسان ، فيتولّد منه الدّم ، وإخراج الميت من الحيّ كالخلايا الميتة في الدم والجلد التي يطرحها مع البخار والعرق. ومن الذي يدبّر أمور العالم ويسيطر على شؤون الكون ، ويتصرّف في المخلوقات حسبما يشاء ، من غير عوائق ولا موانع؟!
هذه الأسئلة الخمسة لا يملك المشركون إلا أن يقولوا : إن الفاعل هو الله ، فهو موجود من غير شكّ ولا مندوحة لهم عن هذا الإقرار ، بسبب إيجاد الرزق ، وإحياء الإنسان ، وهبة الحياة ، وإحداث الموت والفناء ، وتدبير الأمور كلها. وإذا اعترف الإنسان بوجود الله ، فما باله ينكر وحدانية الله؟ وقل لهم أيها الرسول : أفلا تتّقون
__________________
(١) الثابت الوجود بالبرهان.
(٢) تعدلون عنه إلى الكفر.
(٣) ثبتت ووجبت.
أنفسكم عقاب الله بالإشراك وعبادة غير الله ، أفلا تتّقون في افترائكم وجعلكم الأصنام آلهة؟!
فذلكم المتّصف بالقدرة الخلاقة والإرادة المبدعة هو الله الخالق المربّي والمدبّر ، وهو الحق الثابت بذاته الذي لا شك فيه ، وهو الواحد القهار الذي لا يصلح معه مخلوق في الألوهية والرّبوبية ، ومن كانت هذه صفاته هو الرّب الحقّ ، أي المستوجب للعبادة والألوهية ، وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق. وليس فيما وراء الحقّ إلا الضّلال والباطل ، ومن يتجاوز الحق الذي هو عبادة الله وحده ، وقع في الضّلال.
فكيف تصرفون عن الحق إلى الضّلال ، وكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل ، وعن الهدى إلى الضلال؟ ذلك ما لا يقبله عقل ولا منطق.
وكما كانت صفات الله كما وصف ، وعبادته واجبة كما تقرر ، وحقت الرّبوبية لله والألوهية لله ، أي ثبتت واستقرّت في الواقع ، كذلك حقّت وثبتت كلمة الله وحكمه على الذين فسقوا ، أي تمرّدوا في الكفر ، وأصرّوا على الضّلال : أنهم لا يؤمنون ، أي حقّ عليهم واستقرّ انتفاء الإيمان في قلوبهم ، وتحقّق منهم البعد عن الإيمان الحق. وإذا لم يؤمنوا بالرغم من استقرار هذه الصفات الإلهية التي لا مجال لإنكارها ، فإنهم يكونون من أصحاب النار.
والخلاصة : إن المنطق يقضي بالتّسوية بين الإقرار بوجود الله ، وبين الاعتراف بوحدانية الله ، ولا يعقل التفريق بينهما ، ومن آمن بوجود الله ، فعليه أن يؤمن بتوحيد الله ، وهذا أسلوب في إثبات التوحيد من طريق العقل والفكر المجرد ، لأن توحيد الألوهية والرّبوبية متلازمان.
إثبات البعث
إن إثبات التوحيد لله يقتضي إثبات البعث من القبور ، لأن من ابتدأ الخلق ، قادر على إعادة الخلق ، والإعادة أهون من الابتداء ، ووجود البعث أمر ضروري لإقامة العدل المطلق بعد اختبار الناس في عالم الدنيا المملوء بالمظالم والانحرافات ، فيكون إيجاد عالم الآخرة ضروريا للتناصف وإحقاق الحق ، ودحر الباطل ، وإنجاز الوعد الإلهي الحق بتحقيق الآمال ، والظفر بدار الخلود. قال الله تعالى مقيما الدليل على وجود البعث :
(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٣٤) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٥) وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (٣٦)) (١) (٢) [يونس : ١٠ / ٣٤ ـ ٣٦].
هذا وصف آخر لقصور الأصنام وعجزها ، وتنبيه على قدرة الله عزوجل ، وبدء الخلق يراد به إنشاء الإنسان في أول مرة ، وإعادة الخلق : هي البعث من القبور.
قل أيها الرسول للمشركين : من الذي بدأ خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات؟ هل يستطيع أحد غير الله ذلك ، سواء كان صنما أو ملكا أو كوكبا أو رسولا ونحو ذلك؟ ومن الذي يقدر أن يعيد إيجاد الخلق مرة أخرى ، فيكون خلقا جديدا؟
إنه لا مجال أن يكون غير الله هو الذي يبعث من القبور ، قل لهم أيها الرسول : الله هو القادر وحده على بدء الخلق وإعادته ، لأن القادر على البدء قادر على
__________________
(١) تصرفون عن طريق الرّشد.
(٢) لا يهتدي بنفسه ، أصله يهتدي ، فأدغم التاء بالدال ، وفتحت الهاء بحركة التاء.
الإعادة ، فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك ، ويستقل به وحده لا شريك له ، لأنه ليس من الممكن للبشر بحال ، لا عقلا ولا عادة أن يعيد إنسانا أو حيوانا إلى الوجود بعد الموت ، وليس أدلّ على ذلك من الواقع ، فإن الإنسان حريص على بقاء الأحياء ، ولكنه عاجز عن إعادة ميت إلى الحياة مرة أخرى. وإذا كان لا بدّ من الاعتقاد بحصر القدرة على البعث بالله وحده ، فكيف تصرفون أيها المشركون عن طريق الرشد إلى الباطل ، وعن الحق وهو التوحيد إلى الضلال ، وهو الإشراك وعبادة الأصنام؟! قل لهم أيها الرسول أيضا : هل يستطيع أحد من شركائكم هداية الضّال والحيران ، إما بالفطرة والغريزة ، وإما بالحواس من سمع وبصر ونحوهما ، وإما بالعقل والتفكير ، وإما بهداية كتب السماء والرسل ، أو هم عاجزون عن ذلك كله؟!
هذه الهداية إلى طريق الصواب ، والدعوة إلى العدل هي تماما كالقدرة على الخلق والتكوين ، لا يستطيعها أحد سوى الله وحده.
وبما أن المشركين يدركون تمام الإدراك أن شركاءهم لا يستطيعون شيئا من الخلق والهداية التشريعية ، فلم يجدوا جوابا ، فأجابهم الله : (قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِ) أي إن الله وحده هو الذي يهدي إلى الحق والصواب بما أوجد من الأدلة والبراهين ، وبما أرسل من الرسل ، وأنزل من الكتب ، وبما منح الإنسان من التوصل للإيمان بطريق العقل والحواس التي هي مفاتيح المعرفة.
ومن أحق باتّباع قوله وطاعة أمره؟ أهو الذي يقدر على الهداية إلى الحق والرشاد والإيمان ، أم الذي لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره ، وهو الله تعالى؟ إن الأصنام كما وصفها الله لا تستطيع هداية أحد ، فكيف يصح عبادتها ، وما لكم أيها المشركون كيف تحكمون بالتسوية بين الله وبين خلقه؟ وهذا تعجب شديد من حكمهم الجائر بالمساواة بين عبادة الله مباشرة ، وعبادة الشركاء العاجزين عن كل شيء.
وكلمة (أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى) يراد بها الأصنام لا تستطيع أن تهتدي بنفسها إلا أن تهدى من قبل غيرها.
لقد آن الأوان إلى الاعتراف بأن أكثر المشركين لا يتّبعون في اعتقادهم بشفاعة الأصنام وعبادتها إلا مجرد ظنّ خطأ ، ووهم فاسد ، إن الظنّ الفاسد لا يفيد في إثبات الحق شيئا ، إن الله عليم تامّ العلم بأفعالهم ، فيجازيهم عليها ، فمن كذب القرآن والرسول ، واتّبع الآباء والأجداد من دون دليل ولا حجة ، يعاقب عقابا شديدا في نار جهنم. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد.
إثبات كون القرآن كلام الله
إن أعظم هدية دائمة الأثر من الله لعباده هي هدية القرآن وحي الله وكلامه المنزل على رسوله محمد صلىاللهعليهوسلم ، فليس هو بالحديث المفترى ، وآية ذلك إعجازه نظما ومعنى ، وتحدي العرب بأن يأتوا بمثله في بيانه المحكم وتشريعه المبرم. فأجدر بالبشر قاطبة أن يحتفلوا على الدوام بهذه الهدية الرّبانية ، وأن يبادروا لقبول هذا التنزيل ليحققوا لأنفسهم عزّ الدنيا وسعادة الآخرة. وهذا ما وصف الله تعالى به كتابه العزيز لإثبات كونه كلام الله ومعجزة النّبي :
(وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (٣٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (٣٨) بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٩)) (١) [يونس : ١٠ / ٣٧ ـ ٣٩].
__________________
(١) بيان عاقبته.
هذا نفي قول من قال من قريش : «إن محمدا يفتري القرآن ، وينسبه إلى الله تعالى» وهو تشنيع لقولهم وإعظام للأمر ، فإن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة ، الدّالّة على صدق النّبي صلىاللهعليهوسلم. وهو كلام الله قطعا ، وإعجازه وتحدّي العرب به دليل على ذلك.
ومعنى الآية : ما من شأن القرآن أن يختلق ويصاغ من غير الله تعالى ، لأن تميّزه بأرقى درجات البلاغة والفصاحة ، وإحكام تشريعه ، وإخباره عن المغيبات ، وإعجازه العلمي ، واشتماله على المعاني الشاملة الخصبة النافعة في الدنيا والآخرة ، كل ذلك برهان قاطع على أن القرآن من الله سبحانه ، فهو كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين في جملته وتراكيبه ، ولا يقدر أحد أن يجاريه أو يعارضه.
لقد ثبت أن أبا جهل فرعون هذه الأمة قال : إن محمدا لم يكذب على بشر قط ، أفيكذب على الله؟!
إنه ـ أي القرآن ـ مصدّق ومؤكد ما تقدمه من الكتب الإلهية المنزلة على الرسل ، كإبراهيم وموسى وعيسى وداود من الصحف والتوراة والإنجيل والزبور ، وموافق لها في أصول الدعوة إلى توحيد الله ، والإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر ، وتقرير صالح الأعمال ، وبيان فضائل الأخلاق ، وهو أيضا مهيمن عليها ، ومبيّن ما لها وما عليها ، كما قال الله تعالى : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) [المائدة : ٥ / ٤٨].
ومعنى قوله سبحانه : (وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ) أي وفي القرآن بيان الأحكام والشرائع ، والحلال والحرام ، والعبر والمواعظ ، والآداب والأخلاق بيانا شافيا كافيا. ولا شك في ذات القرآن أبدا ، وإن ارتاب مبطل فيه ، فلا يلتفت إليه ، إنه كلام ربّ العالمين المنزل بالوحي على نبيّه الأمين ، بدليل سلامته عن الاضطراب والاختلاف.