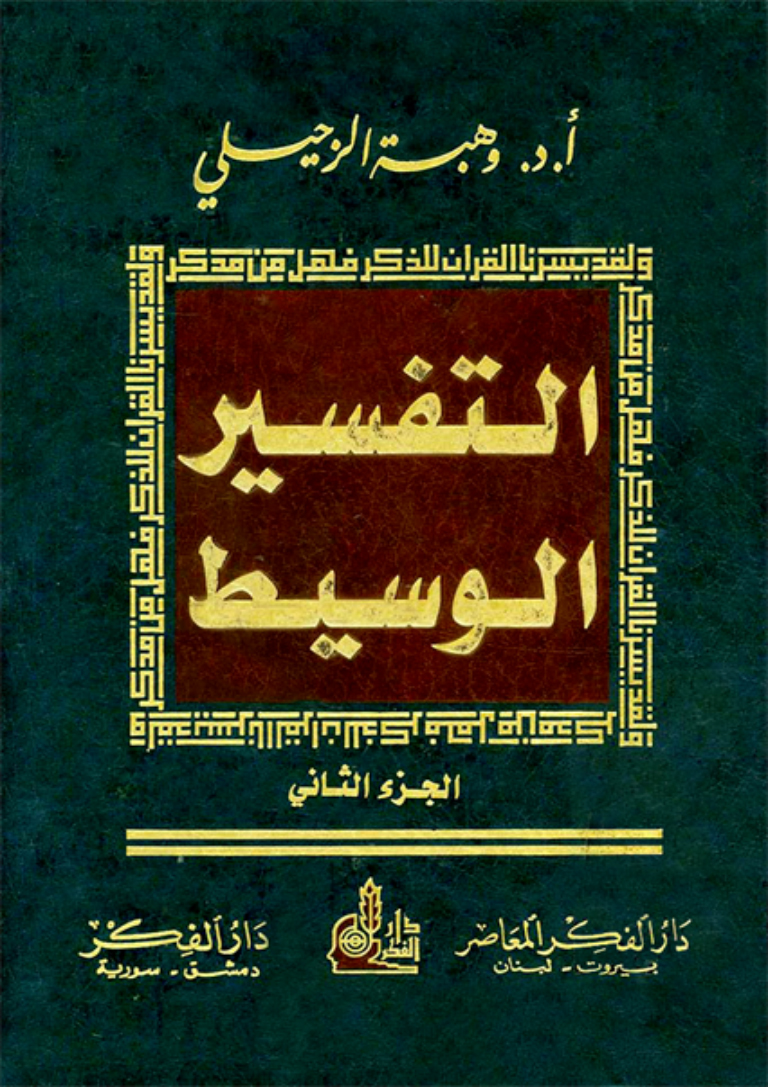الدكتور محمد سيد طنطاوي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
ISBN: 977-14-0522-5
الصفحات: ٣٩٢


تفسير سورة يونس
ظاهرة الوحي
ظاهرة الوحي هي همزة الوصل بين الإله وبعض الناس من أنبيائه ورسله ، فلولاها لم يكن هناك وجود للدين وأحكام الشرع ونظام الإله الذي شرعه لعباده. ولولا الوحي لم نعرف شيئا عن الغيبيات في عالم الآخرة وما بعد الموت من حساب وعذاب وصراط وجنة ونار ، ولولا الوحي الإلهي لكانت حياة البشرية بمثابة حياة الغابة يتحكم فيها القوي بالضعيف ، دون خوف من حساب أو تقدير لمسؤولية ، والتعجب من ظاهرة الوحي منشؤها انعدام الإيمان بالله تعالى وسيطرة الفكر المادي ، وغلبة الأهواء والشهوات ، من غير تقدير ومعرفة لمدى قدرة الله عزوجل ، وخلقه الملائكة وسائط نقل الكلام الإلهي لرسل الله الكرام ، وقد صور القرآن الكريم مدى العجب في نزول الوحي بما لا يصح في قاموس الإيمان ، فقال الله تعالى في مطلع سورة يونس المكية :
(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (١) أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (٢)) (١) [يونس : ١٠ / ١ ـ ٢].
أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : لما بعث الله محمدا رسولا ،
__________________
(١) سابقة فضل.
أنكرت العرب ذلك ، أو من أنكر ذلك منهم ، فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا ، فأنزل الله : (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً) الآية ، وأنزل : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ) [يوسف : ١٢ / ١٠٩] فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا : وإذا كان بشرا فغير محمد كان أحق بالرسالة : (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : ٤٣ / ٣١] يكون أشرف من محمد ، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ، ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. فأنزل الله ردا عليهم : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) [الزخرف : ٤٣ / ٣٢].
ابتدأ الله تعالى هذه السورة (سورة يونس) بقوله (الر) كابتداء البقرة ب (الم (١)) والقصد من هذه الحروف المقطعة التنبيه إلى ما يتلى بعدها ليعتني المرء بفهم ما يسمع أو يقرأ ، وتعديد الحروف على طريق تحدي العرب بأن يأتوا بشيء من مثل هذه السورة أو بغيرها من القرآن ، وحيث إنهم عجزوا ، دل ذلك على أن القرآن كلام الله تعالى. تلك آيات القرآن المحكم ، أو ذات الحكمة لاشتماله عليها ، أو تلك آيات السورة الحكيمة ، التي أحكمها الله وبيّنها لعباده ، وقوله تعالى : (تِلْكَ) بمعنى (هذه). و (الْكِتابِ) المراد به القرآن ، وهو الأظهر.
وقوله تعالى : (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ) يراد به الإنكار على من تعجب من الكفار على إرسال المرسلين من البشر ، أي عجيب أمر بعض الناس الذين ينكرون إيحاءنا إلى رجل من جنسهم من البشر ، قال ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمدا صلىاللهعليهوسلم رسولا ، أنكرت العرب ذلك ، أو من أنكر منهم ، فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد ، فأنزل الله عزوجل : (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً).
هذا التعجب في غير محله ، لأن كل الرسل من البشر ، من جنس المرسل إليهم ليكون ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم والتفاهم معهم.
ومهمة هذا النبي الموحى إليه هي الإنذار من الناس : (أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) أي أوحينا إليه بأن أنذر الناس ، وخوّفهم من عذاب النار يوم البعث ، إذا ظلوا كافرين ضالين عاصين ، والمهمة الثانية : تبشير المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم ، أي سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة عند الله في جنات النعيم ، وأجرا حسنا بما قدموا. والأعمال الصالحة : هي صلاتهم وصومهم وصدقهم في القول والفعل وتسبيحهم.
وقوله سبحانه : (قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ) فيه حذف يدل الظاهر عليه تقديره : فلما أنذر وبشر ، قال الكافرون كذا وكذا. أو : ومع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم ، بشيرا ونذيرا ، قال الكفار : إن هذا القرآن سحر ظاهر بيّن ، وهم الكاذبون في ذلك. ووصفوه بالسحر : لما رأوا من تأثيره القوي في القلوب. ثم تبين لعقلاء العرب وحكمائهم أن القرآن ليس سحرا ، لأنهم جربوا السحر وعرفوه ، فلم يجدوه مطابقا له ، وإنما هو وحي من عند الله على قلب نبيه ، مشتمل على أحكام سامية عالية في التشريع والقضاء ، والسياسة والاجتماع والعلوم والأخلاق والآداب ، معجزة في أسلوبه ونظمه ومعانيه ، يفوق قدرة البشر على محاكاته أو الإتيان بشيء مثله.
أدلة توحيد الله وإثبات البعث
أقام القرآن الكريم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على أصلين أو ركنين من أركان الدين : وهما أولا ـ التوحيد الخالص لله في العبادة والدعاء ، وثانيا ـ إثبات البعث والجزاء. وتوحيد الله يتضمن إثبات وجود إله قادر نافذ الحكم بالأمر والنهي ، وإثبات البعث يقتضي إثبات حياة الآخرة بما فيها من حشر ونشر ومعاد
وقيامة ، ليحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر بهما الأنبياء ، ولإحقاق الحق وإظهار العدل المطلق. وهذه آيات كريمة تبين هذين الأصلين :
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٣) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (٤)) (١) (٢) [يونس : ١٠ / ٣ ـ ٤].
الآية الأولى ابتداء دعوة إلى الإقرار بوجود الله وتوحيده وعبادته والاعلام بصفاته ، وفي هذا ردّ على إنكار الوحي ووصف النبي صلىاللهعليهوسلم بأنه ساحر. ومضمون الرد : أن الله تعالى رب العالم والكون جميعه ، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، قيل : هي من أيام الآخرة ، وقال الجمهور وهو الصواب : بل من أيام الدنيا ، ثم استوى ربنا تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله ، ولا يعلم كيفيته إلا هو ، والعرش أعظم المخلوقات ، واستوى بقهره وغلبته ، وقد سئل الإمام مالك : كيف استوى؟ فقال : «الكيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة».
والله تعالى في استوائه على العرش يدبر أمر الخلائق والكون بما يتفق مع حكمته وعلمه ، ويقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته ، وسبقت به كلمته. والسلطان المطلق لله تعالى في الدنيا والآخرة ، ففي الآخرة لا يستطيع شفيع أن يشفع لأحد عنده تعالى إلا من بعد إذنه ، أي إرادته ومشيئته ، كقوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة : ٢ / ٢٥٥] فلا تشفع الأصنام والملائكة أو البشر الذين يزعمون
__________________
(١) بالعدل.
(٢) ماء شديد الحرارة.
أن آلهتهم تشفع لهم عند الله ، وإنما الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية من الخلق والتقدير والحكمة والتدبير والتصرف في الشفاعة : وغيرها وهو ربكم المتولي شؤونكم ، لا غيره ، إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك.
(فَاعْبُدُوهُ) أي فأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له : (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي أفلا تتفكرون أدنى تفكر في أمركم أيها المشركون ، فتتوصلون إلى أن الله وحده هو المستحق للربوبية والعبادة ، لا ما تعبدونه من الآلهة ، وأنتم تقرون بوجود الله وتفرده بالخلق ، كما في قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ) [الزخرف : ٤٣ / ٨٧]. ومع إيمان العرب بوحدة الربوبية ، كما تدل هذه الآية وغيرها ، إلا أنهم كانوا يشركون معه غيره في الألوهية ، وهذا ضلال يستدعي التصحيح والرجوع عنه.
ثم أثبت الله تعالى أصلا آخر من أصول الإيمان بعد إثبات التوحيد في العبادة والدعاء ، وهو البعث والجزاء ، فيخبر الله تعالى أن إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة ، بعد الموت ، لا يترك أحدا منكم أبدا ، ووعد الله بإيجاد المعاد في الآخرة وعدا حقا ثابتا لا خلف فيه ولا نقص.
والدليل على البعث أنه تعالى كما بدأ الخلق وأنشأه حين التكوين ، كذلك يعيده في النشأة الأخرى ، والإعادة في ميزان الإنسان أهون من البدء ، وهما سواء بالنسبة لله سبحانه ، قال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم : ٣٠ / ٢٧].
وفائدة المعاد واضحة هي أن يجزي الله الذين آمنوا بالله ورسله وما أنزل إليهم ، وعملوا الأعمال الطيبة الصالحة ، بالعدل في رحمتهم وحسن جزائهم ، فهو الجزاء الأوفى ، حيث يعطي كل عامل ما يستحقه من الثواب. والجزاء بالعدل لا يمنع
التفضل بمضاعفة أجر المحسنين. وأما الذين كفروا بالله ورسله وأنكروا البعث ، وتعجبوا من الإيحاء لبشر ينذرهم ويبشرهم ، فلهم من الجزاء شراب ساخن شديد الحرارة ، يقطّع الأمعاء ، ويشوي البطون ، فبئس الشراب شرابهم ، ولهم أيضا يوم القيامة عذاب موجع مؤلم أشد الألم بسبب كفرهم ، من سموم وحميم وظل من يحموم ، بسبب ما كانوا يكفرون أو يجحدون من توحيد الله وإنكار البعث والجزاء.
إثبات القدرة الإلهية
ما من شيء معقول أو محسوس أو ملموس أو مشاهد إلا ويدل دلالة قاطعة على قدرة الله تعالى الخارقة والزائدة على أية قدرة ، لأن قدرة الله تعالى تتميز في إيجاد الموجودات وما يكون بينها من نسب ومقادير يقتضيها إبداع التسوية والتركيب وإتقان الأشياء. أما قدرة البشر مثلا فهي مقصورة على معرفة ظواهر القدرة الإلهية والاستفادة منها في التصنيع والتعديل والتطوير وتغيير الشكل ، مع العجز التام عن إيجاد المعدوم وخلق الأشياء ، قال الله تعالى واصفا بعض الظواهر الكونية الدالة على قدرته الفائقة :
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (٦)) (١) [يونس : ١٠ / ٥ ـ ٦].
هذه الآية تصف آيات الله ، وتنبه على صنعته الدالة على الصانع المتقن ، من خلال بيان أحوال الشمس والقمر الدالة على التوحيد من جهة الخلق والإيجاد ، وعلى إثبات
__________________
(١) جعله ذا منازل يسير فيها.
المعاد من جهة كونهما أداة لمعرفة السنين والحساب ، ثم ذكر المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار ، وما أبدع الله في السماوات والأرض.
الله سبحانه جعل الشمس في النهار ضياء للكون ، ومصدرا للحياة وإشعاع الحرارة الضرورية للحياة ، في النبات والحيوان ، وجعل القمر نورا في الليل يبدد الظلمات ، وقدر مسيره في فلكه منازل ، ينزل كل ليلة في واحدة منها ، وهي ثمانية وعشرون منزلا معروفة لدى العرب ، يرى القمر فيها بالأبصار : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) [يس : ٣٦ / ٣٩] وهي البروج.
وهذه الآية تقتضي أن الضياء أعظم من النور وأبهى ، بحسب الشمس والقمر ، والضياء أشد تأثيرا على الأبصار ، وأما نور القمر فهو أهدأ وأقرب للتفاعل والتجاوب معه. لذا شبه الله تعالى هداه ولطفه بخلقه بالنور ، فهداه في الكفر كالنور في الظلام ، فيهتدي قوم ويضل آخرون. ولو شبه الله هداه بالضياء لوجب ألا يضل أحد ، فيصبح الهدى مثل الشمس التي لا تبقى معها ظلمة.
ومن فوائد الشمس والقمر : معرفة حساب الأوقات والأزمان ، فبالشمس تعرف الأيام ، وبالقمر تعرف الشهور والأعوام ، وفي كل من الحساب الشمسي والقمري فوائد ، فالحساب الشمسي ثابت ، والحساب القمري أسهل على البدوي والحضري ، لذا أنيطت به الأحكام الشرعية ، وبكلا الحسابين رفق بالناس ، وتسهيل لمعرفة شؤون المعاش والتجارة والإجارة وغير ذلك مما يحتاج لمعرفة التواريخ.
ما خلق الله ذلك المذكور من الشمس والقمر إلا خلقا ملتبسا بالحق الذي هو الحكمة البالغة ، ولم يخلقه عبثا بل لحكمة وفائدة ، فمعنى قوله تعالى : (ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ) أي للفائدة لا للعب والإهمال ، فيحق أن تكون كما هي.
يبين الله الآيات الكونية الدالة على عظمته وقدرته ، والآيات القرآنية المرشدة
للإيمان ونظام الحياة ، لقوم يعلمون طرق الدلالة على الخالق ومنافع الحياة ، ويميزون بين الحق والباطل. وإنما خص تفصيل ذلك بالعلماء ، لأن نفع التفصيل وإدراكه فيهم ظهر ، وعليهم أضاء.
ودليل آخر على قدرة الله تعالى وهو تعاقب الليل والنهار ، إذا جاء هذا ذهب هذا ، وإذا ذهب هذا جاء هذا ، لا يتأخر عنه شيئا ، وفي تفاوتهما أيضا عبرة ، فيظهر طولهما وقصرهما بحسب مواقع الأرض من الشمس ، وما لهما من نظام دقيق ، وما فيهما من برودة وحرارة ، يعود نفع كل ذلك للإنسان الذي جعل الله له الليل لباسا وسكنا ، والنهار معاشا وحركة وتقلبا ، ويعود نفعه أيضا للحيوان والنبات.
ومن أدلة القدرة الإلهية أيضا : ما خلق الله في السماوات والأرض من أحوال الجماد والنبات والحيوان ، وأحوال الرعود والبروق والسحب والأمطار ، وأحوال البحار من مد وجزر ، وأحوال المعادن من خواص وتركيب ومنافع في البناء والحياة وتقدم المدينة والحضارة.
إن في ذلك كله لآيات ودلائل دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته ، وحكمته وعظمته ، وكمال علمه ، لقوم يتقون مخالفة سنن الله في التكوين ، وسننه في التشريع ، فسنة الحياة المادية الحفاظ على الصحة ، وسنة الحياة المعنوية الاستقامة ، من أفسدها وخالفها أساء لنفسه ، وكل من لم يتق عقاب الله وسخطه وعذابه ، بارتكابه المعاصي ومخالفة السنن ، عوقب على ذلك في الدنيا والآخرة. وخص الله تعالى هنا القوم المتقين تشريفا لهم ، إذ الاعتبار فيهم يقع ، وتأملهم فيها أدق وأفضل من تأملات من لم يهتد ولا اتقى.
جزاء المؤمن والكافر
العدالة التامة هي ميزان الجزاء الواقع في الآخرة ، وهذا مقتضى المنطق وأمل المحرومين والمعذبين والمظلومين في عالم الدنيا ، فلا ترتاح النفس ولا تهدأ إلا بإنصاف الخلائق ، والشعور بأن هناك ربا عادلا ينصف أهل الحق والعمل الصالح ، ويجازي أهل الباطل والضلال والفساد ، وهذا المنهج الإلهي هو ما فاضت به دلالات آيات القرآن المجيد في كل مناسبة من مناسبات الترغيب لأهل الإيمان ، وترهيب أهل الجحود والعصيان ، قال الله تعالى :
(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ (٧) أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (٨) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩) دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (١٠)) (١) [يونس : ١٠ / ٧ ـ ١٠].
هذه الآيات تقارن بين مصير أهل الجحود والكفر ، وأهل التصديق والإيمان ، لتحذير الكافرين منكري البعث ، وتثبيت المؤمنين ، ومعناها ما يأتي : إن الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآخرة ، ولا يحسنون الظن بذلك ، ولا أمل لهم بالنجاة ، ولا خوف عندهم من الحساب والعقاب والجزاء على الأعمال ، لإنكارهم البعث والمعاد ، ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة ، لغفلتهم عنها ، واطمأنوا بها وسكنوا إلى لذائذها فهي آخر همهم ومنتهى غرضهم ، وكانوا غافلين عن آيات الله الكونية والشرعية ، فلا يتفكرون في الكون ولا يأتمرون بأحكام الشرع ، هؤلاء المذكورون مقامهم ومقرهم في نار جهنم ، وذلك بسبب كسبهم السيئات واجتراحهم الآثام
__________________
(١) لا يتوقعونه.
والخطايا ، مع كفرهم بالله ورسوله واليوم الآخر. وفي هذا رد واضح على الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبر مكره على المعصية ، ونص صريح على تعلق العقاب بما يكسبه الإنسان من السيئات.
هذا جزاء الكافرين الأشقياء الذين أنكروا البعث ولم يريدوا إلا الحياة الدنيا ومتعتها ، وألهتهم الدنيا عن التأمل في الآخرة والإعداد لها. ولما قرر الحق تبارك وتعالى حالة الفرقة الهالكة في الآخرة ، عقّب ذلك ببيان حال الفرقة الناجية ، ليتضح الطريقان ، ويرى الناظر فرق ما بين الهدى والضلال ، وهذا كله من الله لطف بعباده وتعريف سابق للمصير المرتقب في المستقبل الأخروي.
وحال الفريق الثاني هو ما قررته الآية : إن الذين صدقوا بالله ورسله ، وامتثلوا ما أمروا به ، فعملوا الصالحات ، ولم يغفلوا عن آيات الله في الكون والشريعة ، يرشدهم ربهم إلى طرق الجنان في الآخرة ، وهي التي تجري الأنهار من تحت أشجارها ومن تحت غرفها ، فيكون مستقرهم جنات الخلد والنعيم الأبدي ، جعلنا الله منهم ونجانا من عذاب النار. وعطف العمل الصالح على الإيمان دليل على استقلال كل منهما عن الآخر ، فلا يكفي الإيمان القلبي ، بل لا بد للنجاة من العمل الصالح الذي هو كالتابع للإيمان والدليل عليه والتتمة له. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : (يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ) قال : حدثنا الحسن قال : بلغنا أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «المؤمن إذا خرج من قبره ، صوّر له عمله في صورة حسنة وريح طيبة ، فيقول له : ما أنت؟ فو الله إني لأراك عين امرئ صدق ، فيقول له : أنا عملك ، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة ، وأما الكافر فإذا خرج من قبره ، صوّر له عمله في صورة سيئة وريح منتنة ، فيقول له : ما أنت؟ فو الله إني لأراك عين امرئ سوء ، فيقول : أنا عملك ، فينطلق به حتى يدخله النار».
ويكون دعاء المؤمنين في الجنة مبدوءا بقولهم : (سُبْحانَكَ اللهُمَ) أي تنزيها وتقديسا لك يا الله ، أو اللهم إنا نسبحك ، وتكون تحيتهم في الجنة عبارة (السلام) الدالة على السلامة من كل مكروه ، كما جاء في آية أخرى : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (٢٥) إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً (٢٦)) [الواقعة : ٥٦ / ٢٥ ـ ٢٦] وهي تحية المؤمنين في الدنيا ، وتحية الله تعالى حين لقائه لأهل الجنة : (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) [الأحزاب : ٣٣ / ٤٤] وتحية الملائكة لهم عند دخول الجنة : (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ) [الزمر : ٣٩ / ٧٣] وآخر دعائهم الذي هو التسبيح : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي إن خاتمة كلامهم شكر الله تعالى وحمده على سابغ نعمه ، والحمد أعم من الشكر ، وهو أول ثناء على الله حين دخول الجنة ، كما في آية أخرى : (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (٧٤)) [الزمر : ٣٩ / ٧٤].
عجلة الإنسان في تقرير المصير
يتعجّل الإنسان عادة تقرير المصير وتحقيق النتائج ، سواء في حال الخير أو الشرّ ، وهذا دليل القصور في التفكير ، وسوء التقدير ، ولو فكر الإنسان تفكيرا مليّا هادئا ، وتأمّل في أحداث الدنيا ، لتوقف عن العجلة ، وبادر إلى الحلم والأناة ، والصبر والإيمان ، وتفويض الأمر للخالق الدّيان. ولو لم يفعل ذلك في حال المكروه أو الشرّ ، لوقع في أسوأ العواقب ، ودمّر نفسه ووجوده لطيشه وعجلته ، وهذا الطبع يصفه القرآن الكريم للتحذير والتنبيه ، فقال الله تعالى :
(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ (١)
__________________
(١) لأهلكوا.
لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (١٢)) (١) (٢) (٣) [يونس : ١٠ / ١١ ـ ١٢].
قال مجاهد : «نزلت في دعاء الرجل على نفسه أو ماله أو ولده ونحو هذا ، فأخبر الله تعالى أنه لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابتهم إلى الخير لأهلكهم». وقيل : إن هذه الآية نزلت بمناسبة قوله تعالى واصفا طيش المشركين : (اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ) [الأنفال : ٨ / ٣٢]. وقيل : نزلت في قوله تعالى : (ائْتِنا بِما تَعِدُنا) [الأعراف : ٧ / ٧٧] وما جرى مجراه.
والمعنى : إن الإنسان كما يتعجّل الخير ، لأنه يحبّه ، يتعجّل الشرّ حين يغضب ويضجر ، فلو استجاب الله للناس دعاءهم في حال الشرّ ، كاستعجالهم تحقيق الخير ، لأميتوا وهلكوا ، مثل استعجال مشركي مكة إنزال العذاب عليهم ، كما قال تعالى : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ) [الرّعد : ١٣ / ٦].
وسمى الله تعالى العذاب شرّا في هذه الآية ، لأنه أذى في حقّ المعاقب ، ومكروه عنده ، كما سماه سيّئة في آية : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ) ولكنه سبحانه وتعالى بحلمه ولطفه بعباده لا يستجيب للناس دعاءهم في الشرّ ، إمهالا لهم وتركا لفرصة التّأمل والتفكير ، إذ لو أجابهم لانتهى أمر وجودهم وهلكوا ، كما هلك الذين كذبوا الرّسل ، وربما آمن بعضهم بالله. وأما عذاب سائر الكفار فيتركه إلى يوم القيامة ، فيترك الذين لا يتوقعون لقاء الله ولا يؤمنون بالبعث ، في طغيان الكفر والتكذيب ،
__________________
(١) في تجاوزهم الحدّ في الكفر يتحيّرون.
(٢) استغاث بنا لكشفه في حال الاتكاء على جنبه.
(٣) استمر على حالته الأولى.
يترددون فيه متحيرين ، ولا يعجل لهم في الدنيا عذاب الاستئصال تكريما لخاتم النّبيّين محمد صلىاللهعليهوسلم.
وكذلك اقتضت رحمته تعالى بعباده ألا يستجيب لهم دعاءهم على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشرّ ، في حال الضّجر والغضب ، لأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك.
روى أبو داود والبزار عن جابر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تدعوا على أنفسكم ، لا تدعوا على أولادكم ، لا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة ، فيستجيب لكم».
ومن عجلة الإنسان أيضا أنه إذا أصابه ضرّ من مرض أو فقر أو خطر ، بادر إلى دعاء ربّه بإلحاح في كشف ضرّه وإزالته ، حالة كونه مضطجعا على جنبه ، أو قاعدا ، أو قائما ، وفي جميع أحواله ، فإذا فرّج الله شدّته وكشف كربته ، أعرض ونأى بجانبه ، وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء ، ومضى في طريقه من الغفلة عن ربّه وفي إشراكه بالله وقلّة توكّله عليه ، كأنه لم يدع ربّه إلى شيء ، ومثل ذلك العمل القبيح المنكر ، أو التّزيين من الله بخلقه الكفر لهم واختراعه في نفوسهم ، أو من الشيطان بالوسوسة والمخادعة ، مثل ذلك زيّن للمشركين طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون من أعمال الشّرك ، والإعراض عن القرآن والعبادات ، واتّباع الشّهوات.
والضّرّ عند اللّغويين : لفظ عام لجميع الأمراض والرّزايا في النفس والمال والأحبّة ، وقيل : هو مختصّ برزايا البدن : الهزال والمرض.
وقوله : (مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا) وإن نزلت في الكفار ، فهي تتناول كل من دخل تحت معناها من كافر أو عاص. والمراد بالإنسان في قوله سبحانه : (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ) هو الكافر ، لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم. والخلاصة : المراد من الآية النّهي عن العجلة في الدعاء ، والأمر بالتسليم إلى الله تعالى ، والضّراعة إليه في كل حال.
السّنّة الإلهيّة في تعاقب الأجيال
في القرآن الكريم تقرير جلي لسنن الله في الكون والنفس والحياة ، يقصد من بيانها تربية النّفس الإنسانية على أساس من الإصلاح الجذري ، والبعد عن المزالق والمهالك ، أو الوقوع في البلايا والمصائب. فهناك سنّة إلهيّة في الهداية والضّلال ، وسنّة إلهيّة في المؤمنين والظالمين من الكافرين والمنافقين ، وسنّة إلهية في المسؤولية الشخصية والمسؤولية الجماعية ، وسنّة إلهيّة في الدعاء والعبادة والجهاد والمعاملة ، والابتلاء والمصيبة ، والرزق والإنفاق ، والحياة الدنيوية والأخروية.
وهذه السّنن الإلهية تقرر قوانين محددة ، وتتصف بأنها دائمة خالدة ، وثابتة غير متغيرة ، ومستمرة غير متحولة ، تشمل الأولين والآخرين. وهذا منهاج الله تعالى في قرآنه كما حكى في آيات كثيرة ، منها قوله سبحانه : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) [الأحزاب : ٣٣ / ٦٢].
ومن سنن الله تعالى في النفس وتعاقب الأجيال ما جاء في قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (١٣) ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٤)) (١) (٢) [الأحزاب : ١٠ / ١٣ ـ ١٤].
هذه آية وعيد وتهديد بعذاب الاستئصال والإهلاك للكفار مقرونة بضرب الأمثال لهم ، في تعذيب الأمم السابقة ، ليرتدعوا عما هم فيه من تحدّ لموكب الإيمان أو مطلب متسرع في تعجيل العذاب ، مع أن القانون الإلهي واحد ، فكما فعل السابقون أفعالا منكرة فعذّبوا ، كذلك يفعل بالأجيال المتلاحقة بسبب التّشابه في الأسباب واقتراف السّيئات.
__________________
(١) القرون أي الأمم.
(٢) استخلفناكم بعد إهلاك الماضين.
يخبر الله تعالى أهل مكة وغيرهم في هذه الآية بأنه أهلك كثيرا من الأمم بسبب ظلمهم وتكذيبهم الرّسل فيما جاءوهم به من البيّنات والحجج الواضحة كما قال سبحانه : (وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً) [الكهف : ١٨ / ٥٩] والإهلاك إما بعذاب الاستئصال لأقوام الرّسل الذين كذبوا بهم مثل نوح وعاد وثمود ، وإما بإذلالهم واستيلاء الأمم القوية عليهم ، بسبب ظلم بعضهم بالفسق والفجور.
لقد أهلك الله الأمم العاتية لما ظلموا أنفسهم ، وأصروا على الكفر ، وكذبوا بالبيّنات الدّالة على صدق الرّسل ، فلم يؤمنوا بهم وعارضوهم وقاوموهم ، وقوله تعالى : (وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) إخبار عن قسوة قلوبهم ، وشدة كفرهم ، وإفراطهم في العناد والتّحدي ، فلم يعد هناك أمل في إصلاحهم ، ولا فائدة في إمهالهم ، بعد إقامة الحجج عليهم ببعثة الرّسل.
وقوله سبحانه : (كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) معناه : مثل ذلك الجزاء أي الإهلاك ، نجزي كل مجرم. وهذا إعلان واضح ووعيد لأهل مكة المشركين على جريمتهم بتكذيب نبيّهم ورسولهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.
وليس عذاب الاستئصال العام لقوم إفناء للنوع البشري ، وإنما هو مجرد وعيد وإنذار ، فيعّوض الله جيلا بجيل ، لذا خوطب مشركو مكة بأن جعلهم الله خلفاء في الأرض ، بعد تلك القرون أو الجماعات المهلكة ، ليبين في الوجود ما علمه أزلا في القديم الذي لا أول له ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إن الله تعالى إنما جعلنا خلفاء لينظر كيف عملنا ، فأروا الله حسن أعمالكم في السّر والعلانية» وكان عمر يقول أيضا : «قد استخلفت يا بن الخطاب ، فانظر كيف تعمل».
وتقرير وجود المشركين المكّيين عقب إهلاك الظالمين المتقدّمين إشعار بأن دورة
الزمان ستتحول قريبا ، فتكون أمّة القرآن هي صاحبة العزّة والسّيادة ، والخلافة في الأرض ، إذا لازمت الطاعة ، واتّبعت هدي القرآن وسنّة رسول الإسلام ، كما جاء في آية أخرى : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) [النّور : ٢٤ / ٥٥]. وقد تحقق هذا الوعد على مدى التاريخ الماضي ، ويمكن أن يتحقق مرة أخرى إذا أحسن المسلمون أعمالهم ، وساروا في فلك الهداية الرّبانيّة ، واستظلّوا بظلّ راية القرآن المجيد.
مطالب المشركين العجيبة
لقد أبدى المشركون في عهد نزول الوحي الإلهي رغبات غريبة ومطالب عجيبة للتّهرب من الحقيقة ، والعبث بالشريعة ، فطالبوا بتبديل القرآن من أجل إقرار شركهم والرّضا عن كفرهم ووثنيتهم ، ولم يدروا بأن إنزال القرآن من عند الله الذي يفعل ما يشاء ، ويأمر بما يريد ، ويختار ما هو حقّ وصواب ، ويهدم ما كان باطلا وخطأ. وليس أبطل مما أعلنه المشركون من التشكك في القرآن والطعن في نبوة الرسول المنزل عليه كلام الله ، وصف القرآن هذا الموقف العجيب بقوله تعالى :
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٦) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (١٧) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ (١) (٢)
__________________
(١) لا أعلمكم به.
(٢) لا يفوزون بمطلوب.