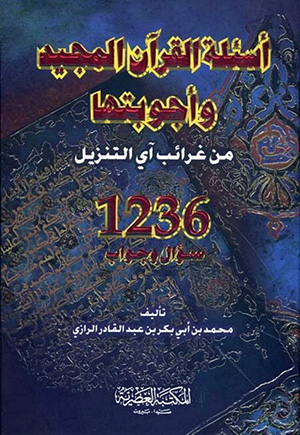محمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: المكتبة العصريّة للطباعة والنشر
الطبعة: ١
ISBN: 9953-34-026-9
الصفحات: ٤٠٨
[١٨٩] فإن قيل : كيف قال : (إِلَّا مَنْ أَمَرَ) [النساء : ١١٤] ، ثم قال : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) [النساء : ١١٤]؟
قلنا : ذكر الآمر بالخير ليدل به على خيرية الفاعل بالطريق الأولى ، ثم ذكر الفاعل ووعده الأجر العظيم إظهارا لفضل الفاعل المؤتمر على الآمر.
الثاني : أنه أراد : ومن يأمر بذلك ، فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر أنواع الفعل ، وإذا كان الآمر موعودا بالأجر العظيم كان الفاعل موعودا به بالطّريق الأولى.
[١٩٠] فإن قيل : كيف قال : (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً) [النساء : ١١٧] ، أي ما يعبدون من دون الله إلّا اللّات والعزّى ومناة ونحوها ، وهي مؤنثة ، ثم قال : (وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً) [النساء : ١١٧] ، أي ما يعبدون إلّا الشّيطان؟
قلنا : معناه أن عبادتهم للأصنام هي في الحقيقة عبادة للشيطان ، إمّا لأنّهم أطاعوا الشيطان فيما سوّل لهم وزيّن من عبادة الأصنام بالإغواء والإضلال ، أو لأنّ الشّيطان موكل بالأصنام يدعو الكفّار إلى عبادتها شفاها ويتزيّى للسدنة فيكلمهم ليضلّهم.
[١٩١] فإن قيل : كيف يقال إن العبد يحكم بكونه من أهل الجنة بمجرد الإيمان ، والله تعالى شرط لذلك العمل الصالح بظاهر قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) [النساء : ٥٧] وقوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ) [النساء : ١٢٤] وإلا لما كان للتقييد فائدة؟
قلنا : قيل إن المراد بالعمل الصالح الإخلاص في الإيمان ، وقيل : الثبات عليه إلى الموت ، وكلاهما شرط في كون الإيمان سببا لدخول الجنة.
[١٩٢] فإن قيل : كيف قال : و (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) [النساء : ١٢٣] والتائب المقبول التّوبة غير مجزيّ بعمله ، وكذلك من عمل سيئة ثم أتبعها حسنة ، لأنها مذهبة لها وماحية بنص القرآن؟
قلنا : المراد من يعمل سوءا ويمت مصرا عليه ، فإن تاب منه لم يجز به.
الثاني : أن المؤمن يجازى في الدّنيا بما يصيبه فيها من المرض وأنواع المصائب والمحن ، كما جاء في الحديث ؛ والكافر يجازى في الآخرة.
[١٩٣] فإن قيل : كيف خصّ المؤمنين الصالحين بأنّهم لا يظلمون بقوله :
__________________
[١٩٠] السدنة : مفردها سادن وهو من يقوم على خدمة المعبد.
(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) [النساء : ١٢٤] الآية ؛ مع أن غيرهم لا يظلم ، أيضا؟
قلنا : قوله : (وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) [النساء : ١٢٤] راجع إلى الفريقين عمال السوء وعمال الصالحات لسبق ذكر الفريقين.
الثاني : أن يكون من باب الإيجاز والاختصار فاكتفى بذكره عقب الجملة الأخيرة عند ذكر أحد الفريقين لدلالته على إضماره عقب ذكر الفريق الآخر ، ولا يظلم المؤمنون بنقصان أعمالهم ، ولا الكافرون بزيادة عقاب ذنوبهم.
الثالث : أن المراد بالظلم نفي نقصان ثواب الطاعات ، وهذا مخصوص بالمؤمنين ، لأن الكافرين ليس لهم على أعمالهم ثواب ينقص منه.
[١٩٤] فإن قيل : طلب الإيمان من المؤمنين تحصيل حاصل ، فكيف قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) [النساء : ١٣٦] الآية؟
قلنا : معناه : يا أيها الذين آمنوا بعيسى آمنوا بالله ورسوله محمد. وقيل : معناه : يا أيها الذين آمنوا يوم الميثاق آمنوا الآن. وقيل معناه : يا أيها الذين آمنوا علانية آمنوا سرّا.
[١٩٥] فإن قيل : قوله تعالى : (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ) [النساء : ١٤١] لم سمّى ظفر المؤمنين فتحا ، وظفر الكافرين نصيبا؟
قلنا : تعظيما لشأن المؤمنين وتحقيرا لحظ الكافرين ؛ لأنّ ظفر المسلمين أمر عظيم ؛ لأنه متضمن نصرة دين الله وعزة أهله ؛ تفتح له أبواب السماء حتى ينزل على أولياء الله ، وظفر الكافرين ليس إلا حظا دنيئا وعرضا من متاع الدنيا يصيبونه ، وليس بمتضمن شيئا مما ذكرنا.
[١٩٦] فإن قيل : كيف قال : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء : ١٤١] ، وقد نصر الكافرين على المؤمنين يوم أحد ، وفي غيره أيضا ، إلى يومنا هذا؟
قلنا : المراد به السبيل بالحجة والبرهان ، والمؤمنون غالبون بالحجة دائما.
[١٩٧] فإن قيل : كيف كان المنافق أشد عذابا من الكافر ؛ حتّى قال الله تعالى ، في حقهم : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) [النساء : ١٤٥] ؛ مع أنّ المنافق أحسن حالا من الكافر ، بدليل أنه معصوم الدم وغيره محكوم عليه بالكفر ، ولهذا قال الله تعالى في حقهم (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ) [النساء : ١٤٣] فلم يجعلهم مؤمنين ولا كافرين؟
قلنا : المنافق وإن كان في الظّاهر أحسن حالا من الكافر ، إلّا أنه عند الله ، في
الآخرة ، أسوأ حالا منه ، لأنه شاركه في الكفر ، وزاد عليه الاستهزاء بالإسلام وأهله ، والمخادعة لله وللمؤمنين.
[١٩٨] فإن قيل : الجهر بالسوء غير محبوب لله تعالى أصلا ؛ بل المحبوب عنده العفو والصفح والتجاوز فكيف قال : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) [النساء : ١٤٨] أي إلا جهر من ظلم.
قلنا : معناه ولا جهر من ظلم ، فإلّا بمعنى ولا ، وقد سبق نظيره وشاهده في قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) [النساء : ٩٢].
[١٩٩] فإن قيل : كيف يجوز دخول «بين» على أحد في قوله تعالى : (وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) [النساء : ١٥٢] وبين تقتضي اثنين فصاعدا ، يقال فرقت بين زيد وعمرو ، وبين القوم ، ولا يقال فرقت بين زيد؟
قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه في قوله تعالى : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) [البقرة : ٦٨] في آخر سورة البقرة ، أيضا.
[٢٠٠] فإن قيل : ما فائدة إعادة الكفر في الآية الثانية بقوله تعالى : (وَبِكُفْرِهِمْ) [النساء : ١٥٦] بعد قوله : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ) [النساء : ١٥٥] الآية.
قلنا : لأنه قد تكرر الكفر منهم فإنهم كفروا بموسى وعيسى عليهماالسلام ، ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام ، فعطف بعض كفرهم على بعض.
[٢٠١] فإن قيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى ابن مريم ، عليه الصلاة والسلام ، يسمونه الساحر ابن الساحرة ، والفاعل ابن الفاعلة ؛ فكيف أقرّوا أنّه رسول الله بقولهم : (إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ) [النساء : ١٥٧]؟
قلنا : قالوه على طريق الاستهزاء ، كما قال فرعون : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
[٢٠٢] فإن قيل : كيف وصفهم بالشك بقوله : (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ) [النساء : ١٥٧] ، ثم وصفهم بالظّن بقوله : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) [النساء : ١٥٧]
__________________
[١٩٨] ـ الوجه الذي اختاره المصنف ، في الجواب ، ضعيف وللمفسرين في الآية أقوال أرجح مما ذكر هنا. ولعل الأمر أشكل على الرّازي هنا من جهة كلمة السوء ، في حين أن المراد بها في الآية ذكر معايب الناس وإفشاءها ، واستثنى من ذلك ما كان ظلما في حق الغير ؛ فإن للمظلوم ذكر ما اقترفه الظالم في حقه ، في مقام التظلّم. وفسرها الفراء بحسب الجري والمصداق : بأن المراد بها أن يذكر الضيف بخل من امتنع عن استضافته إذا نزل عنده فلم يكرمه ، وهو من باب التظلّم كما تقدم.
والشك تساوي الطرفين ، والظن رجحان أحدهما ؛ فكيف يكونون شاكين ظانين ؛ وكيف استثنى الظن من العلم ، وليس الظن فردا من أفراد العلم ؛ بل هو قسيمه؟
قلنا : استعمل الظن بمعنى الشك مجازا لما بينهما من المشابهة في انتفاء الجزم ؛ وأما استثناء الظن من العلم فهو استثناء من غير الجنس ، كما في قوله تعالى : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً) [مريم : ٦٢].
وقيل : لأنّ المراد بالشك هنا ما يشمل الظن ، واستثناء الظن من العلم في الآية منقطع ؛ فإلّا فيها بمعنى لكن ، كما في قوله تعالى : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) [الواقعة : ٢٥ ، ٢٦] ، وما أشبهه.
[٢٠٣] فإن قيل : كيف يكون للنّاس على الله حجّة قبل الرّسل ، وهم محجوجون بما نصبه لهم من الأدلة العقلية الموصلة إلى معرفته ، حتى قال : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) [النساء : ١٦٥]؟
قلنا : الرسل والكتب منبهة من الغفلة ، وباعثة على النظر في أدلة العقل ومفصّلة لمجمل الدنيا وأحوال التكليف التي لا يستقل العقل بمعرفتها ، فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميما لإلزام الحجة ، لئلا يقولوا : (لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً) [طه : ١٣٤] فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له.
[٢٠٤] فإن قيل : كيف قال : (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ) [النساء : ١٦٦] ولم يقل أنزله بقدرته أو بعلمه وقدرته ؛ مع أن الله تعالى لا يفعل إلّا عن علم وقدرة؟
قلنا : معناه أنزله متلبسا بعلمه : أي عالما به ، أو وفيه علمه ، أي معلومه أو معلمه من الشرائع والأحكام. وقيل معناه : أنزله عليك بعلم منه أنّك أولى بإنزاله عليك من سائر خلقه.
[٢٠٥] فإن قيل : كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته ، وعيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق وحادث فكيف صح إطلاق الكلمة عليه في قوله تعالى : (رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ) [النساء : ١٧١].
قلنا : معناه أن وجوده في بطن أمه كان بكلمة الله تعالى ، وهو قوله : (كُنْ) من غير واسطة أب ، بخلاف غيره من البشر سوى آدم. وقيل : المراد بالكلمة الحجة.
[٢٠٦] فإن قيل : على الوجه الأول ، لو كان صحة إطلاق الكلمة على عيسى ، صلوات الله على نبينا وعليه ، لهذا المعنى لصح إطلاقها على آدم عليه الصلاة والسلام لأن هذا المعنى فيه أتم وأكمل لأنه وجد بهذه الكلمة من غير واسطة أب ولا أم أيضا.
قلنا : لا نسلم أنه لا يصح إطلاقها عليه لهذا المعنى ، بل يصح.
[٢٠٧] فإن قيل : لو صح إطلاقها عليه لجاء به القرآن كما جاء في حق عيسى عليه الصلاة والسلام؟
قلنا : خص ذلك بعيسى لأن المجيء في حقّ عيسى ، عليه الصلاة والسلام ، إنما كان للرد على من افترى عليه وعلى أمه ونسبه إلى أب ؛ ولم يوجد هذا المعنى في حقّ آدم ، عليه الصلاة والسلام ، لاتفاق الناس كلهم على أنه غير مضاف إلى أب ولا إلى أم.
سورة المائدة
[٢٠٨] فإن قيل : كيف الارتباط والمناسبة بين قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : ١] وقوله : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) [المائدة : ١]؟
قلنا : المراد بالعقود عهود الله عليهم في تحليل حلاله وتحريم حرامه ، فبدأ بالمجمل ثم أتبعه بالمفصل من قوله : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) [المائدة : ١] وقوله بعده : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة : ٣] الآية.
[٢٠٩] فإن قيل : ما أكله السبع وعدم وتعذر أكله ، فكيف يحسن فيه التحريم حتى قال : (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) [آل عمران : ٥]؟
قلنا : معناه وما أكل منه السبع ، يعني الباقي بعد أكله.
[٢١٠] فإن قيل : قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) [المائدة : ٣] ، يدل من حيث المفهوم عرفا على أنه لم يرض لهم الإسلام دينا قبل ذلك اليوم ، وليس كذلك ، فإن الإسلام لم يزل دينا مرضيا للنبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه عند الله منذ أرسله عليه الصلاة والسلام.
قلنا : قوله اليوم ظرف للجملتين الأوليين لا للجملة الثالثة ؛ لأن الواو الأولى للعطف ، والثانية للابتداء ؛ فالجملة الثالثة مطلقة غير موقتة.
[٢١١] فإن قيل : قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) [المائدة : ٤] كيف صلح جوابا لسؤالهم والطيبات غير معلومة ولا متفق عليها لأنها تختلف باختلاف الطباع والبقاع؟
قلنا : المراد بالطيبات هنا الذبائح ، والعرب تسمي الذبيحة طيّبا وتسمي الميتة خبيثا ، فصار المراد معلوما لكنه عام مخصوص كغيره من العمومات.
[٢١٢] فإذا قيل : ما فائدة قوله : (مُكَلِّبِينَ) بعد قوله : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) [المائدة : ٤] والمكلّب هو المعلم من كلاب الصيد؟
__________________
[٢١٢] قول المصنف : «فعلى هذا لا يكون تكرارا» وجهه غير ظاهر بمجرد تفسير (مكلبين) بما ذكر ؛ بل دفع التكرار إنما يتم بأن يكون مكلبين حالا من ضمير علمتم ، كما هو رأي العكبري في إملائه.
قلنا : قد جاء في تفسير المكلّب أيضا أنه المضري للجارح والمغري له فعلى هذا لا يكون تكرارا ، وعلى القول الأول يكون إنما عمم ثم خصص فقال مكلبين بعد قوله : (وَما عَلَّمْتُمْ) [المائدة : ٤] ؛ لأن غالب صيدهم كان بالكلاب ، فأخرجه مخرج الغالب الواقع منهم.
[٢١٣] فإن قيل : ظاهر قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) [المائدة : ٥] يقتضي إباحة الجوارح المعلمة وهي حرام.
قلنا : فيه إضمار وتقديره : مصيد ما علمت من الجوارح ، يؤيده ما في تمام الكلام من قوله : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة : ٤].
[٢١٤] فإن قيل : المؤمن به هو الله لقوله تعالى : (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ) [البقرة : ١٣٦] فالمكفور به يكون هو الله أيضا ، ويؤيده قوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ) [البقرة : ٢٨] وإذا ثبت هذا فكيف قال : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) [المائدة : ٥] مع أنه لا يصح أن يقال آمن بالإيمان فكذلك ضده؟
قلنا : المراد به : ومن يرتد عن الإيمان يقال كفر فلان بالإسلام إذا ارتد عنه ، فكفر بمعنى ارتد ؛ لأن الردة نوع من الكفر ، والباء بمعنى عن ، كما في قوله تعالى : (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ) [المعارج : ١] وقوله تعالى : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) [الفرقان : ٥٩].
وقيل : المراد هنا بالإيمان المؤمن به تسمية للمفعول بالمصدر ، كما في قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) [المائدة : ٩٦] ، أي مصيده ، وقولهم : ضرب الأمير ، ونسج اليمن.
[٢١٥] فإن قيل : كيف قال : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) [المائدة : ٩] ولم يقل : وعملوا السيئات ؛ مع أن الغفران يكون لفاعل السيئات لا لفاعل الحسنات؟
قلنا : كل أحد لا يخلو من سيئة صغيرة أو كبيرة ، وإن كان ممن يعمل الصالحات وهي الطاعات ، والمعنى : أن من آمن وعمل الحسنات غفرت له سيئاته.
قال تعالى : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) [هود : ١١٤].
[٢١٦] فإن قيل : كيف قال في آخر قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) [المائدة : ١٢] الآية ، (فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) [المائدة : ١٢] مع أن الذي كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل؟
قلنا : نعم ولكن الضلال بعد ما ذكر من النعم أقبح ؛ لأن قبح الكفر بقدر عظم النعم المكفورة ، فلذلك خصه بالذكر.
[٢١٧] فإن قيل : كيف قال : (وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى) [المائدة : ١٤] ولم يقل ومن النصارى؟
قلنا : لأن هؤلاء كانوا كاذبين في دعواهم أنهم نصارى ، وذلك أنهم إنما سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله تعالى ، وهم الذين قالوا لعيسى نحن أنصار الله ، ثم اختلفوا بعده نسطورية ويعقوبية وملكانية أنصارا للشيطان ، فقال ذلك توبيخا لهم.
[٢١٨] فإن قيل : كيف قال : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) [المائدة : ٥] مما كتمتموه من الكتاب فلا يظهره ولا يبين كتمانكم إياه ، فكيف يجوز للنبي صلىاللهعليهوسلم أن يمسك عن إظهار حق كتموه مما في كتبهم؟
قلنا : إنما لم يبين البعض لأنه كان يتبع الأمر ولا يفعل شيئا من الأمور الدينية من تلقاء نفسه بل اتباعا للوحي ، فما أمر ببيانه بينه ، وما لم يؤمر ببيانه أمسك عنه إلى وقت أمره ببيانه ، وعلى هذا الجواب يكون لفظ العفو مجازا عن الترك ، فيكون قد أعلمه الله به وأطلعه عليه ولم يأمره ببيانه لهم فترك تبيانه لهم.
الثاني : أن ما كان في بيانه إظهار حكم شرعي كصفته ونعته والبشارة به وآية الرجم ونحوها بينه ، وما لم يكن في بيانه حكم شرعي ولكن فيه افتضاحهم وهتك أستارهم فإنه عفا عنه.
الثالث : أن عقد الذمة اقتضى تقريرهم على ما بدلوا وغيروا من دينهم ، إلا ما كان في إظهاره معجزة له وتصديق لنبوته من نعته وصفته ، أو ما اختلفوا فيه فيما بينهم وتحاكموا إليه فيه كحكم الزنا ونحوه.
[٢١٩] فإن قيل : كيف قال : (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ) [المائدة : ١٥ ، ١٦] ، مع أنّ العبد ما لم يهده الله أولا ، لا يتبع رضوانه ؛ فيلزم الدور؟
قلنا : فيه إضمار تقديره : يهدي به الله من علم أنه يريد أن يتبع رضوانه ، كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) [العنكبوت : ٦٩] ، أي والذين أرادوا سبيل المجاهدة فينا لنهدينهم سبل مجاهدتنا.
[٢٢٠] فإن قيل : لم نر ولم نسمع أن قوما من اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله فكيف أخبر الله تعالى عنهم بذلك؟
قلنا : المراد بقولهم أبناء الله خاصة الله ، كما يقال أبناء الدنيا وأبناء الآخرة.
وقيل : فيه إضمار تقديره : أبناء أنبياء الله.
[٢٢١] فإن قيل : كيف يصح الاحتجاج عليهم بقوله تعالى : (قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ) [المائدة : ١٨] مع أنهم ينكرون تعذيبهم بذنوبهم ، ويدعون أن ما يذنبون بالنهار يغفر بالليل ، وما يذنبون بالليل يغفر بالنهار.
قلنا : هم كانوا مقرين أنه يعذبهم أربعين يوما وهي مدة عبادتهم العجل ، في غيبة موسى عليهالسلام لميقات ربه ؛ ولذلك قالوا : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) [البقرة : ٨٠].
وقيل : أراد به العذاب الذي أوقعه ببعضهم في الدنيا من مسخهم قردة كما فعل بأصحاب السبت ، وخسف الأرض كما فعل بقارون ، وهذا لا ينكرونه ، وعلى هذا الوجه يكون المضارع بمعنى الماضي في قوله : (فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ) [المائدة : ١٨] والإضافة إليهم بمعنى الإضافة إلى آبائهم ، كأنه قال : فلم عذب آباءكم.
[٢٢٢] فإن قيل : قوله تعالى : (بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) [المائدة : ١٨] إن أريد به يغفر لمن يشاء منكم أيها اليهود والنصارى ، ويعذب من يشاء يلزم جواز المغفرة لهم وأنه غير جائز لقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء : ٤٨] وإن أريد به يغفر لمن يشاء من المؤمنين ويعذب من يشاء لا يصلح جوابا لقولهم.
قلنا : المراد به يغفر لمن يشاء منهم إذا تاب من الكفر. وقيل : يغفر لمن يشاء ممن خلق وهم المؤمنون ، ويعذب من يشاء وهم المشركون.
[٢٢٣] فإن قيل : كيف قيل : (يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً) [المائدة : ٢٠] ولم يكن قوم موسى عليهالسلام ملوكا؟
قلنا : المراد جعل فيكم ملوكا ، وهم ملوك بني إسرائيل ، وهم اثنا عشر ملكا ، لاثني عشر سبطا ، لكل سبط ملك.
وقيل : المراد به أنه رزقهم الصحّة ، والكفاية ، والزوجة الموافقة ، والخادم ، والبيت ، فسماهم ملوكا لذلك.
وقيل : المراد به أنه رزقهم المنازل الواسعة التي فيها المياه الجارية.
[٢٢٤] فإن قيل : من أين علم الرجلان أنهم الغالبون ، حتى قالا : (فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ) [المائدة : ٢٣]؟
قلنا : من جهة وثوقهم بإخبار موسى صلىاللهعليهوسلم بذلك بقوله : (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) [المائدة : ٢١].
وقيل : علما ذلك بغلبة الظن ، وما عهداه من صنع الله تعالى بموسى عليه الصلاة والسلام في قهر أعدائه.
[٢٢٤ م] فإن قيل : قوله تعالى : (وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [المائدة : ٢٣] يدل على أن من لم يتوكل على الله لا يكون مؤمنا وإلا لضاع التعليق وليس كذلك.
قلنا : «إن» هنا بمعنى إذ ، فتكون بمعنى التعليل ، كما في قوله تعالى : (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٢٧٨].
[٢٢٥] فإن قيل : كيف التوفيق بين قوله تعالى : (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) [المائدة : ٢١] وبين قوله : (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ) [المائدة : ٢٦].
قلنا : معناه كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها ، فلما أبوا الجهاد قيل : فإنها محرمة عليهم.
الثاني : أن كل واحد منهما عام أريد به الخاص ، فالكتابة للبعض وهم المطيعون ، والتحريم على البعض وهم العاصون.
الثالث : أن التحريم موقت بأربعين سنة والكتابة غير موقتة ، فيكون المعنى أن بعد مضي الأربعين يكون لهم. وهذا الجواب تام على قول من نصب الأربعين بمحرمة وجعلها ظرفا ؛ فأمّا من جعل الأربعين ظرفا لقوله : (يَتِيهُونَ) [المائدة : ٢٦] مقدما عليه فإنه جعل التحريم مؤبدا فلا يتأتى على قوله هذا الجواب ؛ لأن التقدير عنده : فإنها محرمة عليهم أبدا ، يتيهون في الأرض أربعين سنة ؛ وهو موضع قد اختلف فيه المفسرون ، والفرّاء من جملة من جوّز نصب الأربعين بمحرمة ويتيهون ؛ والزّجّاج من جملة من منع جواز نصبه بمحرمة ، ونقل أن التحريم كان مؤبدا ، وأنّهم لم يدخلوها بعد الأربعين ، ونقل غيره أنه دخلها بعد الأربعين من بقي منهم وذرية من مات منهم.
ويعضد الوجه الأوّل كون الغالب في الاستعمال تقدّم الفعل على الظرف الذي هو عدد لا تأخّره عنه ، يقال : سافر زيد أربعين يوما وما أشبه ذلك ، وقلما يقال على العكس.
[٢٢٦] فإن قيل : كيف قال : (إِذْ قَرَّبا قُرْباناً) [المائدة : ٢٧] ولم يقل قربانين ؛ لأنّ كل واحد منهما قرّب قربانا؟
__________________
[٢٢٦] البيت بتمامه :
|
فمن يك أمسى بالمدينة رحله |
|
فإنّي وقيّارا بها لغريب |
وهو من قصيدة لضابئ بن الحارث البرجميّ قالها حين حبسه عثمان بن عفان في المدينة. وقيّار اسم جمل الشاعر ، وقيل : اسم فرسه. وقد جاء عند الرّازي مرفوعا وهي رواية أخرى للبيت. والوجه في الرفع على مذهب الكسائي ضعف إنّ أما الفرّاء فالوجه فيه عنده عطفه على اسم مكنى عنه ، والمكنى لا تظهر فيه علامة الرفع.
والبيت من شواهد الكتاب ١ / ٨. وهو في خزانة الأدب ٤ / ٣٢٣.
قلنا : أراد به الجنس فعبّر عنه بلفظ الفرد ، كقوله تعالى : (وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها) [الحاقة : ١٧].
الثاني : أن العرب تطلق الواحد وتريد الاثنين ، وعليه جاء قوله تعالى : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ) [ق : ١٧]. وقال الشاعر :
فإنّي وقيار بها لغريب
تقديره : فإني بها لغريب وقيار كذلك ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ) [البقرة : ٦٢] الآية. وقيل : إنما أفرده لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والمثنّى والمجموع.
[٢٢٧] فإن قيل : كيف صلح قوله : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) [المائدة : ٢٧] جوابا لقوله : (لَأَقْتُلَنَّكَ) [المائدة : ٢٧]؟
قلنا : لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل قال له ذلك كناية عن حقيقة الجواب وتعريضا ، معناه إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى لا منّي فلم تقتلني؟
[٢٢٨] فإن قيل : كيف قال هابيل لقابيل : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) [المائدة : ٢٩] ، أي تنصرف بهما ؛ مع أن إرادة السوء والوقوع في المعصية للأجنبي حرام ، فكيف للأخ؟
قلنا : فيه إضمار حرف النفي تقديره : إنّي أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك ، كما في قوله تعالى : (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) [النمل : ١٥] ، أي أن لا تميد بكم ، وقوله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) [يوسف : ٨٥] ، وقول امرئ القيس :
فقلت يمين الله أبرح قاعدا
الثاني : أن فيه حذف مضاف تقديره : إني أريد انتفاء أن تبوء بإثمي وإثمك ، كما في قوله تعالى : (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) [البقرة : ٩٣] ، أي حبّ العجل.
الثالث : أن معناه ، إنّي أريد ذلك إن قتلتني لا مطلقا.
الرابع : أنه كان ظالما ، وجزاء الظالم تحسن إرادته من الله تعالى فتحسن من العبد أيضا.
__________________
[٢٢٨] تمام البيت :
|
فقلت يمين الله أبرح قاعدا |
|
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي |
وهو من قصائد ديوانه : ٣٢.
[٢٢٩] فإن قيل : قوله تعالى : (فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) [المائدة : ٣١] ، يدل على أنّ قابيل كان تائبا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «الندم توبة» ؛ فلا يستحق النار.
قلنا : لم يكن ندمه على قتل أخيه ؛ بل على حمله على عنقه سنة ، أو على عدم اهتدائه إلى الدفن الذي تعلّمه من الغراب ، أو على فقد أخيه لا على المعصية ، ولو سلمنا أن ندمه كان على قتل أخيه ، ولكن يجوز أن الندم لم يكن توبة في شريعتهم ، بل في شريعتنا ، أو نقول : التّوبة تؤثر في حقوق الله تعالى لا في حقوق العباد ، والدّم من حقوق العباد ، فلا تؤثر فيه التّوبة.
[٢٣٠] فإن قيل : كيف يكون قتل الواحد كقتل الكل ، وإحياء الواحد كإحياء الكل والدليل يأباه من وجهين :
أحدهما : أن الجناية كلما تعددت وكثرت كانت أقبح فتناسب زيادة الإثم والعقوبة ، هذا هو مقتضى العقل والحكمة.
الثاني : أن المراد بهذا التشبيه إما أن يكون تساوي قتل الواحد والكل في الإثم والعقوبة ، أو تقاربهما ، وإنما كان يلزم منه أنه إذا قتل الثاني أو الثالث وهلم جرا أن لا يكون عليه إثم آخر ، ولا يستحق عقوبة أخرى ؛ لأنه أثم إثم قتل الكل ، واستحق عقوبة قتل الكل بمجرد قتل الأول ، أو الأول والثاني ؛ لأن قتل الواحد إذا كان يساوي قتل الكل أو يقاربه ، فقتل الاثنين يجعل عليه إثم قتل الكل وعقوبة قتل الكل ؛ فكيف يزداد بعد ذلك بقتل الثالث والرابع وهلم جرا ، ولو قتل الكل لما ازداد عن قتل الكل وعقوبة قتل الكل ، ولا يجوز أن يستحق بقتل الواحد أو الاثنين إثم قتل الكل ، وبقتل الكل إثم قتل الكل! قلنا : أقرب ما قيل فيه أن المراد من قتل نفسا واحدة بغير حقّ كان جميع الناس خصومه في الدنيا إن لم يكن له ولي ، وفي الآخرة مطلقا ، لأنهم من أب وأم واحدة.
وقيل : معناه من قتل نفسا نبيا وإماما عادلا فهو كمن قتل الناس جميعا من حيث إبطال المنفعة على الكل ؛ لأن منفعتهما عامة للكل.
وقيل : المراد بمن قتل هو قابيل ، فإن عليه من الإثم بمنزلة إثم قتل الكل ؛ لأنه أول من سن القتل ؛ فكل قتل يوجد بعده يلحقه شيء من وزره بغلبة التسبب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «من سنّ سنّة حسنة» الحديث ؛ وهذا أحسن في المعنى ؛ ولكن اللفظ لا يساعد عليه ، وهو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما) [المائدة : ٣٢] ؛ لأنّ هذا المعنى إذا أريد به قابيل لا تختص كتابته ببني إسرائيل.
__________________
[٢٢٩] الحديث أخرجه أحمد في مسنده : ١ / ٣٧٦.
[٢٣٠] الحديث أخرجه مسلم في باب الزكاة ، حديث ١٠١٧ ، وأحمد في مسنده : ٤ / ٣٦٢.
[٢٣١] فإن قيل : كيف وجه قوله تعالى : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) [المائدة : ٣٣] الآية ، وحقيقة المحاربة بين العبد والرب ممتنعة؟
قلنا : فيه إضمار تقديره : يحاربون أولياء الله. وقيل : أراد بالمحاربة المخالفة.
[٢٣٢] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ) [المائدة : ٣٦] ولم يقل بهما ، والمذكور شيئان؟
قلنا : قد سبق جواب مثله قبيل هذا في قوله : (إِذْ قَرَّبا قُرْباناً) [المائدة : ٢٧] ، وهنا جواب آخر وهو أن يكون وضع الضمير موضع اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك ، وذلك يشار به إلى الواحد والاثنين والجمع.
[٢٣٣] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) [المائدة : ٤٢] وحال النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب لا يخلو عن هذين القسمين ؛ لأنه إما أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم؟
قلنا : فائدته تخيير النبي ، عليه الصلاة والسلام ، بين الحكم بينهم وعدمه ، ليعلم أنه لا يجب عليه أن يحكم بينهم كما يجب عليه ذلك بين المسلمين إذا تحاكموا إليه ؛ وقيل : إن هذا التخيير منسوخ بقوله تعالى : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) [المائدة : ٤٨] وهو القرآن يدل عليه أول الآية (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) [المائدة : ٤٨] في الحكم بالتوراة.
[٢٣٤] فإن قيل : لما أنزل الله القرآن صار الإنجيل منسوخا به ، فكيف قال : (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ) [المائدة : ٤٧]؟
قلنا : هو عام مخصوص ، أي ما أنزل الله فيه من صدق نبوة محمد ، عليه الصلاة والسلام ، بعلاماته المذكورة في الإنجيل ، وذلك غير منسوخ.
[٢٣٥] فإن قيل : كيف قال : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ) [المائدة : ٤٩] ؛ مع أن الكفار معاقبون بكل ذنوبهم؟
قلنا : أراد به عقوبتهم في الدنيا ، وهو ما عجله من إجلاء بني النضير وقيل بني قريظة وذلك جزاء بعض ذنوبهم لأنه جزاء منقطع ، وأما جزاؤهم على شركهم فهو جزاء دائم لا يتصور وجوده في الدنيا.
وقيل : أراد بذلك البعض ذنب التولي عن الرضا بحكم القرآن ، وإنما أبهمه تفخيما له وتعظيما.
[٢٣٦] فإن قيل : حسن حكم الله وصحته أمر ثابت على العموم بالنسبة إلى الموقنين وغير الموقنين ، فكيف قال : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة : ٥٠]؟
قلنا : لما كان الموقنون أكثر انتفاعا به من غيرهم ، بل هم المنتفعون به في الحقيقة لا غير كانوا أخص به ، فأضيف إليهم لذلك ، ونظيره : قوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) [النازعات : ٤٥].
[٢٣٧] فإن قيل : قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة : ٥١] يقتضي أن يكون من وادّ أهل الكتاب وصادقهم كافرا وليس كذلك لقوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة : ٨] الآية.
قلنا : المراد بقوله : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ) [المائدة : ٥١] المنافقون ، لأنها نزلت في شأنهم وهم كانوا من الكفار في الدنيا ضميرا واعتقادا ، ومعناه أنه منهم في الآخرة جزاء وعقابه أشد.
[٢٣٨] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة : ٥١] ، وكم من ظالم هداه الله تعالى فتاب وأقلع عن ظلمه؟
قلنا : معناه لا يهديهم ما داموا مقيمين على ظلمهم.
الثاني : أن معناه : لا يهدي من قضى في سابق علمه أنه يموت ضالا.
الثالث : أن معناه : لا يهدي القوم الظالمين يوم القيامة إلى طريق الجنة ، أي المشركين.
[٢٣٩] فإن قيل : كيف قال : (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [المائدة : ٥٤] ولم يقل أذلة للمؤمنين ، وإنما يقال ذل له لا ذل عليه؟
قلنا : لأنه ضمن الذل معنى الحنوّ والعطف فعدّاه تعدّيته ، كأنه قال : حانين على المؤمنين عاطفين عليهم.
[٢٤٠] فإن قيل : كيف قال : (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) [المائدة : ٥٦] وكم مرة غلب حزب الله تعالى في زمن النبيّ صلىاللهعليهوسلم وبعده إلى يومنا هذا؟
قلنا : المراد به الغلبة بالحجة والبرهان لا بالدولة والصولة ، وحزب الله هم المؤمنون غالبون بالحجة أبدا.
[٢٤١] فإن قيل : المثوبة مختصة بالإحسان ، فكيف قال : (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ) [المائدة : ٦٠] الآية؟
قلنا : لا نسلم أن الثواب والمثوبة مختص بالإحسان ؛ بل هو الجزاء مطلقا بدليل قوله تعالى : (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) [المطففين : ٣٦] ، أي هل جوزوا ، وقوله تعالى : (فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ) [آل عمران : ١٥٣] وهو كلفظ البشارة لا اختصاص له
لغة بالخبر السار ؛ بل هو عام شامل للشر ؛ قال الله تعالى : (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) [آل عمران : ٢١].
[٢٤٢] فإن قيل : ما فائدة إرسال الكتاب والرسول إلى أولئك الكثيرين الذين قال في حقهم : (وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً) [المائدة : ٦٤]؟
قلنا : فائدته إلزام الحجة عليهم.
الثاني : تبجيل الكتاب والرسول فإنّ الخطاب بالكتاب إذا كان عامّا ، والرّسول إذا كان مرسلا إلى الخلق كلهم ، كان ذلك أفخم وأعظم للرسول والمرسل.
[٢٤٣] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) [المائدة : ٦٦] الآية ، يقتضي تعلق الرخاء وسعة الرزق بالإيمان بالكتاب والعمل بما فيه ، وليس كذلك ، فإن كثيرا من المؤمنين بالكتب الأربعة العاملين بما فيها ممّا لم ينسخ ، عيشهم في الدنيا منكد ، ورزقهم مضيّق.
قلنا : هذا التعليق خاص في حقّ أهل الكتاب ؛ لأنهم اشتكوا من ضيق الرزق حتى قالوا : (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) [المائدة : ٦٤] فأخبرهم الله تعالى أن ذلك التضييق عقوبة لهم بشؤم معاصيهم وكفرهم ، والله تعالى يجعل ضيق الرزق وتقديره نعمة في حق بعض عباده ، ونقمة في حقّ بعضهم وكذلك الرخاء والسعة فيعاقب بهما على المعصية ، ويثيب بهما على الطاعة ، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الأشخاص ، فلا يلزم من توسيع الرزق الإكرام. ولا من تضييقه الإهانة ولا يلزم عكسه أيضا ، ولهذا رد الله تعالى ذلك بقوله : (فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ) [الفجر : ١٥] إلى قوله تعالى : (كَلَّا) [الفجر : ١٧] ، أي ليس الأمر كما ظن الإنسان وزعم من أن توسيع الرزق دليل الكرامة وتضييقه دليل الإهانة ، بل دليل الكرامة هو الهداية والتوفيق للطاعات ، ودليل الإهانة هو الإضلال وحرمة التوفيق.
[٢٤٤] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) [المائدة : ٦٧] ومعلوم أنه إذا لم يبلغ المنزل إليه لم يكن قد بلّغ الرسالة؟
__________________
[٢٤٤] ـ قول المصنف في الجواب : «المراد حثه على تبليغ ما أنزل عليه من معايب اليهود ومثالبهم».
كتفسير للآية أو كبيان لسبب نزولها مخالف لما هو معروف مشهور عند جمهور المفسرين ، وهو أنها نزلت حين قفل النبي صلىاللهعليهوسلم من حجة الوداع. وفي حدود هذا التاريخ كان القرآن مملوءا بذكر معايب اليهود ومثالبهم ، فأي معايب لهم بعد ليكون عدم تبليغها وإظهارها ـ وقد نصر الله المسلمين وأعزهم ـ مساوقا لعدم تبليغ الرسالة جملة؟! يراجع في ذلك تفسير الآية عند الفخر الرازي ، وابن كثير والسيوطي في الدّر المنثور ، وغيرهم.
قلنا : المراد حثه على تبليغ ما أنزل عليه من معايب اليهود ومثالبهم. فالمعنى بلغ الجميع ، فإن كتمت منه حرفا كنت في الإثم والمخالفة كمن لم يبلغ شيئا البتة ، فجعل كتمان البعض ككتمان الكل.
وقيل : أمر بتعجيل التبليغ كأنه صلىاللهعليهوسلم كان عازما على تبليغ جميع ما نزل إليه ، إلا أنه أخر تبليغ البعض خوفا على نفسه وحذرا ؛ مع عزمه على تبليغه في ثاني الحال ، فأمر بتعجيل التبليغ ، يؤيد هذا القول قوله تعالى : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة : ٦٧].
[٢٤٥] فإن قيل : كيف ضمن الله تعالى لرسوله العصمة بقوله : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة : ٦٧] ثم إنه شجّ وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته؟
قلنا : المراد به العصمة من القتل لا من جميع الأذى ، فإن جميع العصمة من جميع المكاره لا تناسب أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأنهم جامعون مكارم الأخلاق ومن أشرف مكارم الأخلاق تحمّل الأذى.
الثاني : أن هذه الآية نزلت بعد أحد ؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزلت من القرآن.
[٢٤٦] فإن قيل : كيف قال : (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) [البقرة : ٢٧٠] ؛ مع أن بعض الظالمين وهم العصاة من المؤمنين يشفع فيهم النبيّ صلىاللهعليهوسلم يوم القيامة فيكون ناصرا لهم؟
قلنا : المراد بالظالمين هنا المشركون ، يعلم ذلك من أول الآية ووسطها.
[٢٤٧] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ) [المائدة :
٧٧] ، بعد قوله : (قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ) [المائدة : ٧٧]؟
قلنا : المراد بالضلال الأول ضلالهم عن الإنجيل ، وبالضلال الثاني ضلالهم عن القرآن.
[٢٤٨] فإن قيل : قوله تعالى : (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) [المائدة :
٧٩] والنهي عن المنكر بعد فعله ووقوعه لا معنى له؟
قلنا : فيه إضمار حذف مضاف تقديره : كانوا لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه ، أو عن منكر أرادوا فعله ، كما يرى الإنسان أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوّى وتهيّأ فينكر ، ويجوز أن يريد بقوله : (لا يَتَناهَوْنَ) لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر فعلوه ، بل يصرون عليه ويداومون ، يقال : تناهى عن الأمر وانتهى عنه بمعنى واحد : أي امتنع عنه وتركه.
[٢٤٩] فإن قيل : كيف قال : (وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ) [المائدة : ٨١] والمراد بقوله منهم المنافقون أو اليهود على اختلاف القولين وكلهم فاسقون؟
قلنا : المراد به فسقهم بموالاة المشركين ودسّ الأخبار إليهم لا مطلق الفسق ، وذلك الفسق الخاص مخصوص بكثير منهم ، وهم المذكورون في أوّل الآية في قوله :
(تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ) [المائدة : ٨٠] الآية لا شامل لجميعهم.
[٢٥٠] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) [المائدة : ٩٠] وهذه الأعيان كلها مخلوقات لله تعالى فأين عمل الشيطان في وجودها؟
قلنا : فيه إضمار تقديره : إنما تعاطي الخمر والميسر إلى آخره أو مباشرته إلخ.
[٢٥١] فإن قيل : مع هذا الإضمار كيف قال من عمل الشيطان ، وتعاطي الخمر والقمار ونحوهما من عمل الإنسان حقيقة؟
قلنا : إنما أضيف إلى الشيطان مجازا ؛ لأنه هو السبب في وجود الفعل بواسطته ووسوسته وتزيينه ذلك للفساق فصار كما لو أغرى رجل رجلا بضرب آخر فضربه ، فإنه يجوز أن يقال للمغري هذا من عملك.
[٢٥٢] فإن قيل : كيف جمع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في الآية الأولى ، ثم خص الخمر والميسر في الآية الثانية؟
قلنا : لأن العداوة والبغضاء بين الناس تقع كثيرا بسبب الخمر والميسر وكذلك يشتغلون بهما عن الطاعة ، بخلاف الأنصاب والأزلام فإن هذه المفاسد لا توجد فيها ، وإن كانت فيها مفاسد أخر.
وقيل : إنما كرّر ذكر الخمر والميسر فقط لأن الخطاب للمؤمنين ؛ بدليل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [المائدة : ٩٤] وهم إنما يتعاطون الخمر والميسر فقط ، وإنما جمع الأربعة في الآية الأولى إعلاما للمؤمنين أن هذه الأربعة من أعمال الجاهلية ، وإنه لا فرق بين من عبد صنما أو أشرك بالله تعالى بدعوى علم الغيب ، وبين من شرب الخمر أو قامر مستحلا لهما.
[٢٥٣] فإن قيل : كيف يحسن أن يفعل الله تعالى فعلا يتوسل به إلى تحصيل علم حتى قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ) [المائدة : ٩٤]؟
قلنا : معناه ليميز الله الخائف من غير الخائف عند الناس. وقيل : معناه ليعلم عباد الله من يخافه بالغيب وهو قريب من الأول. وقيل : معناه ليعلم الخوف واقعا كما علمه منتظرا.
[٢٥٤] فإن قيل : كيف قال : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
__________________
[٢٥٤] الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبد الله ، يعرف بابن شهاب الزهري ، من بني زهرة بن كلاب. كلفه عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث ، ولذلك يقال عادة إنه أول من دوّن الحديث.
كان فقيه الأمويين بالشام. ولد سنة ٥٨ ه وتوفي سنة ١٢٤ ه. أخذ عنه كثيرون الفقه والحديث ، من أشهرهم مالك بن أنس.
[المائدة : ٩٥] ووصف العمدية ليس بشرط لوجوب الجزاء ، فإنه لو قتله ناسيا أو مخطئا وجب الجزاء أيضا؟
قلنا : عند ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وصف العمدية شرط لوجوب الجزاء ، فلا يرد عليهم السؤال ، وأما على قول الجمهور فإنما قيده بوصف العمدية ؛ لأن الواقعة التي كانت سبب نزول الآية كانت عمدا على ما يروى عن الصحابة أنه اعترض حمار وحش بالحديبية وهم محرمون ، فطعنه أبو اليسر برمحه فقطعه فنزلت الآية ، فخرج وصف العمدية مخرج الواقع لا مخرج الشرط.
وقال الزهري : نزل الكتاب بالعمد ، ووردت السنة بالوجوب في الخطأ.
[٢٥٥] فإن قيل : كيف قال : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) [المائدة : ٩٥] ؛ مع أن الشرط بلوغه إلى الحرم لا غير؟
قلنا : لما كان المقصود من بلوغ الهدي إلى الحرم تعظيم الكعبة ذكر الكعبة تنبيها على ذلك. وقيل : معناه بالغ حرم الكعبة.
[٢٥٦] فإن قيل : قوله تعالى : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [المائدة : ٩٧] أي دلالة لهذه الأمور المذكورة على علم الله تعالى بما في السموات وما في الأرض وأنه بكل شيء عليم؟
قلنا : ذلك إشارة إلى كل ما سبق ذكره من الغيوب في هذه السورة من أحوال الأنبياء والمنافقين واليهود لا إلى المذكور في هذه الآية :
الثاني : أن العرب كانت تسفك الدماء وتنهب الأموال ، فإذا دخل الشهر الحرام أو دخلوا إلى البلد الحرام كفوا عن ذلك ، فعلم الله تعالى أنه لو لم يجعل لهم زمانا أو مكانا يقتضي كفهم عن القتل ونهب الأموال لهلكوا ، فظهرت المناسبة.
[٢٥٧] فإن قيل : كيف قال : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ) [المائدة : ١٠٣] والجعل هو الخلق بدليل قوله تعالى : (وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) [الأعراف :
__________________
[٢٥٧] بحيرة : من قولهم بحرت البعير ، أي شققت أذنه شقا واسعا. وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة عشرة أبطن شقوا أذنها وسيبوها فلا تركب ، ولا يحمل عليها.
ـ سائبة : يقال للناقة إذا ولدت خمسة أبطن ؛ فتسيّب في المرعى ، فلا تردّ عن حوض ولا علف.
ـ وصيلة : من قول الجاهليين ، حين تلد الشاة ذكرا وأنثى ، وصلت أخاها ، يريدون حمته عن الذبح ، فلا يذبحون الذكر من أجلها.
ـ حام : يقوله عرب الجاهلية للفحل إذا ضرب عشرة أبطن. يريدون : حمى ظهره ، فلا يركب.
١٨٩] وقوله تعالى : (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ) [الأنعام : ١] وخالق هذه الأشياء هو الله تعالى؟
قلنا : المراد بالجعل هنا الإيجاب والأمر : أي ما أوجبها ولا أمر بها. وقيل : المراد بالجعل التحريم.
[٢٥٨] فإن قيل : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) [المائدة : ١٠٥] يدل على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان؟
قلنا : معنى قوله أنفسكم : أي أهل دينكم كما قال تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء : ٢٩] أي أهل دينكم.
وقيل : المراد به آخر الزمان عند فساد الزمان وتعذر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو زماننا هذا.
[٢٥٩] فإن قيل : كيف يقول الرسل (لا عِلْمَ لَنا) [المائدة : ١٠٩] إذا قال الله تعالى لهم : (ما ذا أُجِبْتُمْ) [المائدة : ١٠٩] وهم عالمون بما ذا أجيبوا؟
قلنا : هذا جواب الدهشة والحيرة حين تطيش عقولهم من زفرة جهنم نعوذ بالله تعالى منها ، ومثله لا يفيد نفي العلم ولا إثباته.
الثاني : أنهم قالوا ذلك تعريضا بالتشكي من قومهم وإظهارا للالتجاء إلى الله تعالى في الانتقام منهم ، كأنهم قالوا : أنت أعلم بما أجابونا به من التصديق والتكذيب.
الثالث : معناه : لا علم لنا بحقيقة ما أجابونا به ؛ لأنا نعلم ظاهره وأنت تعلم ظاهره ومضمره ، ويؤيده ما بعده.
[٢٦٠] فإن قيل : أيّ معجزة لعيسى صلىاللهعليهوسلم في تكليم الناس كهلا حتى قال : (تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً) [المائدة : ١١٠]؟
قلنا : قد سبق جوابه في سورة آل عمران مستقصى.
[٢٦١] فإن قيل : كيف قال الحواريون (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ) [المائدة : ١١٢] شكوا في قدرة الله تعالى على بعض الممكنات وذلك كفر ، ووصفوه بالاستطاعة وذلك تشبيه ؛ لأن الاستطاعة إنما تكون بالجوارح ، والحواريون خلص أتباع عيسى عليهالسلام والمؤمنون به بدليل قوله تعالى حكاية عنهم (قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ) [المائدة : ١١١].
قلنا : هذا استفهام عن الفعل لا عن القدرة ، كما يقول الفقير للغني القادر : هل تقدر أن تعطيني شيئا ، وهذا يسمى استطاعة المطاوعة لا استطاعة القدرة ، أو المعنى :
هل يسهل عليك أن تسأل ربك؟ كقولك لآخر : هل تستطيع أن تقوم معي؟ وأنت تعلم استطاعته لذلك.
[٢٦٢] فإن قيل : لو كان المراد هذا المعنى فلم أنكر عليهم عيسى عليهالسلام بقوله : (قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [المائدة : ١١٢]؟
قلنا : إنكاره عليهم إنما كان لأنهم أتوا بلفظ يحتمل المعنى الذي لا يليق بالمؤمن المخلص إرادته وإن كانوا لم يريدوه.
[٢٦٣] فإن قيل : كيف قال عيسى عليهالسلام (وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) [المائدة : ١١٦] وكل ذي نفس فهو ذو جسم ؛ لأن النفس عبارة عن الجوهر القائم بذاته المتعلق بالجسم تعلق التدبير ، والله تعالى منزه عن الجسم؟
قلنا : النفس تطلق على معنيين : أحدهما هذا والثاني حقيقة الشيء وذاته ، كما يقال : نفس الذهب والفضة محبوبة ، أي ذاتهما ، والمراد به في الآية ثانيا هذا المعنى.
[٢٦٤] فإن قيل : كيف قال عيسى عليهالسلام : (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ) [المائدة : ١١٧] الآية ، مع أنه قال لهم كثيرا من الكلام المباح غير الأمر بالتوحيد؟
قلنا : معناه ما قلت لهم فيما يتعلق بالإله.
[٢٦٥] فإن قيل : إذا كان عيسى لم يمت وإنما هو حي في السماء فكيف قال (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) [المائدة : ١١٧]؟
قلنا : أراد بالتوفّي إتمام مدة إقامته في الأرض ، وإتمامه قد سبق في قوله تعالى : (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَ) [آل عمران : ٥٥] والسؤال إنما يتوجه على قول من قال : إن السؤال والجواب وجدا يوم رفعه إلى السماء ، وأما من قال : إن السؤال إنما يكون يوم القيامة ، وعليه الجمهور ، فالجواب مطابق ولا إشكال فيه.
[٢٦٦] فإن قيل : لو قال عيسى عليهالسلام : إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم ، وإن تغفر لهم فإنهم عبادك ، كان أظهر مناسبة؟
قلنا : معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وتصرف المالك المطلق الحقيقي في عبيده مباح : أي تصرف كان ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الذي لا ينقص من عزه شيء بترك العقوبة والانتقام ممن عصاه ، الحكيم في كل ما يفعله من العذاب أو المغفرة.
[٢٦٧] فإن قيل : كيف قال : (يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) [المائدة : ١١٩] يعني يوم القيامة ، والصدق نافع في الدنيا والآخرة ، ولفظ الآية في قوة الحصر؟
قلنا : لما كان نفع الصدق في الآخرة هو الفوز بالجنة والنجاة من النار ونفعه في