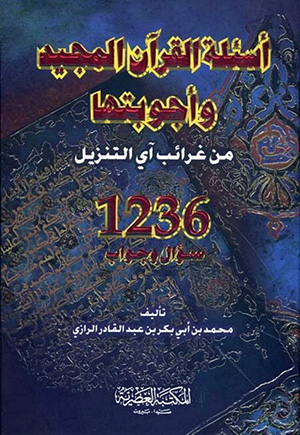محمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: المكتبة العصريّة للطباعة والنشر
الطبعة: ١
ISBN: 9953-34-026-9
الصفحات: ٤٠٨
أن يرجع عن وصيته التي أوصى بها أهله ؛ فمات مسلما ، فلذلك غفر له.
[٤٩٣] فإن قيل : في قوله تعالى : (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً) [يوسف : ١٠٠] كيف جاز لهم أن يسجدوا لغير الله تعالى؟
قلنا : لعله كان السجود عندهم تحية وتكرمة كالقيام والمصافحة عندنا. وقيل : كان انحناء كالركوع ولم يكن بوضع الجبهة على الأرض ، إلا أن قوله تعالى : (وَخَرُّوا) يأبى ذلك ، لأن الخرور عبارة عن السقوط ، ولا يرد عليه قوله تعالى : (وَخَرَّ راكِعاً) [ص : ٢٤] لأنهم قالوا أراد به ساجدا فعبر عن السجود بالركوع كما عبر عن الصلاة في قوله تعالى : (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) [البقرة : ٤٣] أي صلوا مع المصلين.
وقيل له : أي لأجله ، فاللام للسببية لا لتعدية السجود إلى يوسف عليهالسلام ، فالمعنى وخروا لأجل يوسف سجدا لله تعالى شكرا على جمع شملهم به. وقيل : الضمير في له يعود إلى الله تعالى ، وهذا الوجه يدفعه قوله تعالى : (يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا) [يوسف : ١٠٠].
[٤٩٤] فإن قيل : كيف ذكر يوسف عليهالسلام نعمة الله تعالى عليه في إخراجه من السجن فقال : (وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ) [يوسف : ١٠٠] ولم يذكر نعمته عليه في إخراجه من الجب وهو أعظم نعمة ؛ لأن وقوعه في الجب كان أعظم خطرا؟
قلنا : إنما ذكر هذه النعمة دون تلك النعمة لوجوه :
أحدهما : أن محنة السجن ومصيبته كانت أعظم لطول مدتها ، فإنه لبث فيه بضع سنين وما لبث في الجب إلا مدة يسيرة.
الثاني : أنه إنما لم يذكر الجب كيلا يكون في ذكره توبيخ وتقريع لإخوته عند قوله لهم : (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) [يوسف : ٩٢].
الثالث : أن خروجه من السجن كان مقدمة لملكه وعزه فلذلك ذكره ، وخروجه من الجب كان مقدمة الذل والرق والأسر فلذلك لم يذكره.
الرابع : أن مصيبة السجن كانت أعظم عنده لمصاحبة الأوباش والأراذل وأعداء الدين ، بخلاف مصيبة الجب فإنه كان مؤنسه فيه جبريل وغيره من الملائكة عليهمالسلام.
[٤٩٥] فإن قيل : كيف قال يوسف : (تَوَفَّنِي مُسْلِماً) [يوسف : ١٠١] وهو يعلم أنّ كلّ نبي لا يموت إلّا مسلما؟
قلنا : يجوز أن يكون دعا بذلك في حالة غلبة الخوف عليه غلبة أذهلته عن ذلك العلم في تلك الساعة.
الثاني : أنه دعا بذلك مع علمه إظهارا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة وتعليما للأمة وطلبا للثواب.
[٤٩٦] فإن قلنا : كيف يجتمع الإيمان والشرك وهما ضدان ؛ حتّى قال تعالى : (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف : ١٠٦]؟
قلنا : معناه وما يؤمن أكثرهم بأن الله تعالى خالقه ورازقه وخالق السموات والأرض قولا إلا وهو مشرك بعبادة الأصنام فعلا.
الثاني : أن المراد بها المنافقون يؤمنون بألسنتهم قولا ويشركون بقلوبهم اعتقادا.
الثالث : أن المراد بها تلبية العرب ، كانوا يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ؛ فكانوا يؤمنون بأول تلبيتهم بنفي الشريك ، ويشركون بآخرها بإثباته.
[٤٩٧] فإن قيل : هذه التلبية توحيد كلها ولا شرك فيها ؛ لأن معنى قولهم إلّا شريكا هو لك : إلا شريكا هو مملوك لك موصوفا بأنك تملكه وتملك ما ملك ، واللام هنا للملك لا لعلاقة الشركة ، وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون حقيقيا ويحتمل أن يكون مجازيا ، بيان الأول أنا إن قلنا إن اللام حقيقة في المعنى العام في مواردها وهو الاختصاص يكون قولهم : لا شريك لك ، عاما في نفي كل شريك يضاف إلى الله تعالى بجهة اختصاص ما ، فيدخل في النفي من جهة لفظ الشريك المضاف بجهة المملوكية ، وهو شريك زيد وعمرو ونحوهما ثم يقطع عليه الاستثناء فيكون استثناء حقيقيا ، وإن قلنا إنها مشتركة بين المعاني الثلاثة الموجودة في موارد استعمالها وهي الملك والاستحقاق ، ويقال الاختصاص والعلية ، فقولهم : لا شريك لك يكون عاما أيضا عند من يجوز حمل المشترك على مفهومه في حالة واحدة فيكون الاستثناء أيضا حقيقيا كما مر ، وأما على قول من لا يجوّز ذلك يكون النفي واردا على أحد مفهوماته وهو علاقة الشركة ، فيكون الاستثناء بعده مجازيا ، من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وهو نوع من أنواع البلاغة مذكور في علم البيان ، وشاهده قول الشاعر :
|
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم |
|
بهنّ فلول من قراع الكتائب |
معناه : إن كان هذا عيبا ففيهم عيب ، وهذا ليس بعيب فلا يكون فيهم عيب ، فكذا هنا ، معناه : إن كان الشريك المملوك لك يصلح شريكا فلك شريك ، وهو لا يصلح شريكا لك ، فلا يكون لك شريك ؛ لأنّ كل ما يدّعى أنه شريك لك فهو مملوك
__________________
[٤٩٧] البيت للنابغة الذبياني وهو في ديوانه : ٤٤. وانظر البصائر ٢ / ٤٣٢ ، من قصيدة له في مدح الحارث الأصغر.
لك ، وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى : (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ) [الروم : ٢٨] الآية.
قلنا : على الوجه الأول إنه ليس بصحيح ؛ لأنه لو جعلنا اللام حقيقة في المعنى العام وهو الاختصاص يلزم منه الكفر حيث وجد نفي الشريك من غير استثناء ، لأنه يلزم منه نفي ملكه تعالى شريك زيد وعمرو ونحوهما وهو كفر ، واللازم منتف ؛ لأنه إيمان محض بلا خلاف.
[٤٩٨] فإن قيل : إنما لم يكن كفرا مع عمومه ؛ لأنّ الحقيقة العرفية عند عدم الاستثناء نفي كل شريك يضاف إلى الله تعالى بعلاقة الشريك ، لا نفي كل شريك يضاف إليه بجهة ما فصارت الحقيقة اللغوية مهجورة بالحقيقة العرفية عند عدم الاستثناء. والجواب عن أصل السؤال أنه سؤال حسن محقق ، وأن هذه التلبية توحيد محض على التقديرين ، فإن صح النقل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها ، فإنما نهى عنها لأنها توهم إثبات الشريك لمقتضى الاستثناء عند قاصري النظر وهم عوام الناس ، فلهذه المفسدة نهى عنها.
سورة الرعد
[٤٩٩] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ) [الرعد : ١٠] ولم يقل ومن هو سارب بالنهار ، ليتناول معنى الاستواء المستخفي والسارب ، وإلا فقد تناول واحدا هو مستخف وسارب ، أي ظاهر ، وليتناسب لفظ الجملة الأولى والثانية ، فإنه قال في الجملة الأولى : (مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ) [الرعد : ١٠]؟
قلنا : قوله تعالى : (وَسارِبٌ) معطوف على «من» لا على مستخف ، فيتناول معنى الاستواء اثنين.
الثاني : أنه وإن كان معطوفا على مستخف إلا أن من هنا في معنى التثنية كقوله :
نكن مثل من يا ذئب يصطحبان
فكأنه قال سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار.
[٥٠٠] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) [الرعد : ١٤] أي في ضياع وبطلان ، والكفار يدعون الله تعالى في وقت الشدائد والأهوال ومشارفتهم الغرق في البحر فيستجيب لهم؟
قلنا : المراد : وما عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال ، ويعضده قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) [الرعد : ١٤] أي يعبدون.
[٥٠١] فإن قيل : كيف طابق قولهم : (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) [الرعد : ٢٧] قوله : (قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ) [الرعد : ٢٧]؟
قلنا : هو كلام جرى مجرى التعجب من قولهم ؛ لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي أوتيها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يؤتها نبي قبله ، وكفى بالقرآن وحده آية
__________________
[٤٩٩] هذا عجز بيت للفرزدق ، وهو في ديوانه : ٨٧٠. وأمالي ابن الشجري ٢ / ٣١١. والبيت بتمامه :
|
تعشّ فإن واثقتني لا تخونني |
|
نكن مثل من يا ذئب يصطحبان |
هكذا يروى البيت عند النحاة. وله رواية أخرى في كتب الأدب فتوضع كلمة تعال محل تعشّ في بداية البيت.
والشاهد فيه تثنية يصطحبان لأن فاعله من أريد به الشاعر والذئب.
وراء كل آية ، فإذا جحدوا آياته ولم يعتدّوا بها وجعلوه كأنّ آية لم تنزل عليه قط كان موضعا يتعجب منه ، فكأنه قيل لهم : ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كفركم.
[٥٠٢] فإن قيل : كيف المطابقة بين قوله تعالى : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) [الرعد : ٣٣] وقوله : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) [الرعد : ٣٣].
قلنا : فيه محذوف تقديره : أفمن هو رقيب على كل نفس صالحة وطالحة يعلم ما كسبت من خير وشر ، ويعد لكل جزاء كمن ليس كذلك وهو الصنم ، ثم ابتدأ فقال : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) [الرعد : ٣٣] ، أو تقديره : أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء ، أو التقدير : أفمن كان بهذه الصفة يغفل عن أهل مكة وأقوالهم وأفعالهم وجعلوا لله شركاء.
[٥٠٣] فإن قيل : كيف اتصل قوله تعالى : (قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ) [الرعد : ٣٦] بما قبله وهو قوله تعالى : (وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) [الرعد : ٣٦]؟
قلنا : هو جواب للمنكرين معناه : قل إنما أمرت فيما أنزل إليّ بأن أعبد الله ولا أشرك به ، فإنكارهم لبعضه إنكار لعبادة الله تعالى وتوحيده ، كذا أجاب به الزمخشري ، وفيه نظر.
[٥٠٤] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) [الرعد : ٤٢] أثبت لهم مكرا ثم نفاه عنهم بقوله تعالى : (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً) [الرعد : ٤٢]؟
قلنا : معناه أن مكر الماكرين مخلوق له ولا يصير إلا بإرادته ، فبهذه الجهة صحة إضافة مكرهم إليه.
الثاني : أنه جعل مكرهم كلا مكر ، بالإضافة إلى مكره ؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون ، فيعكس مكرهم عليهم. فإثباته لهم باعتبار الكسب ، ونفيه عنهم باعتبار الخلق.
سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام
[٥٠٥] فإن قيل : كيف قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) [إبراهيم : ٤] هذا في حق غير النبيّ عليه الصلاة والسلام من الرسل مناسب ؛ لأن غيره لم يبعث إلى الناس كافة ، بل إلى قومه فقط ، فأرسل بلسانهم ليفقهوا عنه الرسالة ولا تبقى لهم حجة بأنا لم نفهم رسالتك ، فأما النبيّ عليه الصلاة والسلام فإنه بعث إلى الناس كافة ، قال تعالى : (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) [الأعراف : ١٥٨] (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) [سبأ : ٢٨] فإرساله بلسان قومه إن كان لقطع حجة العرب ، فالحجة باقية لغيرهم من أهل الألسن الباقية ، وإن لم يكن لغير العرب حجة أن لو نزل القرآن بلسان غير العرب يكن للعرب الحجة.
قلنا : نزوله على النبيّ عليه الصلاة والسلام بلسان واحد كاف ؛ لأن الترجمة لأهل بقية الألسن تغني عن نزوله لجميع الألسن ، ويكفي مئونة التطويل كما جرى في القرآن العزيز.
الثاني : أن نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل ، وأسلم من التنازع والخلاف.
الثالث : أنه لو نزل بألسنة كل الناس وكان معجزا في كل واحد منها ، وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها ، كما كلم أمته التي هو منها لكان ذلك أمرا قريبا من القسر والإلجاء ، وبعثة الرسل لم تبن على القسر والإلجاء ؛ بل على التمكين من الاختيار ، فلما كان نزوله بلسان واحد كافيا كان أولى الألسنة لسان قوم الرسول ؛ لأنهم أقرب إليه وأفهم عنه.
[٥٠٦] فإن قيل : (يُذَبِّحُونَ) [البقرة : ٤٩] وفي سورة الأعراف : (يُقَتِّلُونَ) [الأعراف : ١٤١] بغير واو فيهما ، وقال هنا (وَيُذَبِّحُونَ) [إبراهيم : ٦] بالواو والقصة واحدة؟
قلنا : حيث حذف الواو وجعل التذبيح والتقتيل تفسيرا للعذاب ، وبيانا له ، وحيث أثبتها جعل التذبيح كأنه جنس آخر غير العذاب ؛ لأنه أوفى على بقية أنواعه وزاد عليها زيادة ظاهرة ، فعلى هذا يكون إثبات الواو أبلغ.
[٥٠٧] فإن قيل : ما معنى التبعيض في قوله تعالى : (لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) [إبراهيم : ١٠]؟
قلنا : ما جاء هذا إلا في خطاب الكافرين كقوله تعالى في سورة نوح عليهالسلام : (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) [نوح : ٤] وقوله تعالى ، في سورة الأحقاف : (يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) [الأحقاف : ٣١] وقال تعالى في خطاب المؤمنين في سورة الصف : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ) [الصف : ١٠] إلى قوله : (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [الصف : ١٢] وقال تعالى ، في آخر سورة الأحزاب : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [الأحزاب : ٧٠ ، ٧١] ، وكذا باقي الآيات في خطاب الفريقين إذا تتبعتها ، وما ذلك إلا للتفرقة بين الخطابين لئلا يسوى بين الفريقين في الوعد مع اختلاف رتبتهما ، لا لأنه يغفر للكفار مع بقائهم على الكفر بعض ذنوبهم ، والذي يؤيد ما ذكرناه من العلة أنه في سورة نوح عليهالسلام وفي سورة الأحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان مطلقا. وقيل : معنى التبعيض أنه يغفر لهم ما بينهم وبينه لا ما بينهم وبين العباد من المظالم ونحوها.
وقيل : «من» زائدة.
[٥٠٨] فإن قيل : كيف كرر تعالى الأمر بالتوكل وكيف قال أوّلا (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [إبراهيم : ١١] وقال ثانيا : (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) [إبراهيم : ١٢]؟
قلنا : الأمر الأول لاستحداث التوكل ، والثاني لتثبيت المتوكلين على ما استحدثوا من توكلهم فلهذا كرره ، وقال أولا المؤمنون وثانيا المتوكلون.
[٥٠٩] فإن قيل : كيف قالوا لرسلهم (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) [إبراهيم : ١٣] والرسل لم يكونوا على ملة الكفار قط ، والعود هو الرجوع إلى ما كان فيه الإنسان؟
قلنا : العود في كلام العرب يستعمل كثيرا بمعنى الصيرورة ، يقولون : عاد فلان يكلمني ، وعاد لفلان مال وأشباه ذلك ، ومنه قوله تعالى : (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) [يس : ٣٩].
الثاني : أنهم خاطبوا الرسل بذلك بناء على زعمهم الفاسد واعتقادهم أن الرسل كانوا أولا على ملل قومهم ثم انتقلوا عنها.
الثالث : أنهم خاطبوا كل رسول ومن آمن به فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحد ، ونظير هذا السؤال ما سبق في سورة الأعراف من قوله تعالى : (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) [إبراهيم : ١٣] وفي سورة يوسف عليهالسلام من قوله تعالى : (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) [يوسف : ٣٧] الآية.
[٥١٠] فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال في قوله تعالى : (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ) [إبراهيم : ٢١].
قلنا : لما كان قول الضعفاء توبيخا وتقريعا وعتابا للذين استكبروا على استتباعهم إياهم واستغوائهم ، أحالوا الذنب على الله تعالى في ضلالهم وإضلالهم ، كما قالوا : (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا) [الأنعام : ١٤٨] و (لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) [النحل : ٣٥] يقولون ذلك في الآخرة كما كانوا يقولون في الدنيا ، كما حكى الله تعالى عن المنافقين : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) [المجادلة : ١٨] الآية.
وقيل : معنى جوابهم : لو هدانا الله في الآخرة طريق النجاة من العذاب لهديناكم ، أي لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا بكم طريق الهلكة في الدنيا.
[٥١١] فإن قيل : كيف اتصل وارتبط قولهم : (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) [إبراهيم : ٢١] بما قبله؟
قلنا : اتصاله به من حيث إن عتاب الضعفاء للذين استكبروا كان جزعا مما هم فيه وقلقا من ألم العذاب ، فقال لهم رؤساؤهم : (لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) [إبراهيم : ٢١] يريدون أنفسهم وإياهم لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين عليها في الدنيا ، كأنهم قالوا للضعفاء : ما هذا الجزع والتوبيخ ، ولا فائدة فيه كما لا فائدة في الصبر ، فإن الأمر أعظم من ذلك وأعم.
[٥١٢] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ) [إبراهيم : ٢٢] عبر عنه بلفظ الماضي ، وذلك القول من الشيطان لم يقع بعد وإنّما هو مترقب منتظر يقوله يوم القيامة؟
قلنا : يجوز وضع المضارع موضع الماضي ، ووضع الماضي موضع المضارع إذا أمن اللبس ، قال الله تعالى : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) [البقرة : ١٠٢] أي ما تلت ، وقال تعالى : (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ) [البقرة : ٩١] وقال الحطيئة الشاعر :
|
شهد الحطيئة يوم يلقى ربه |
|
أنّ الوليد أحقّ بالغدر |
فقوله : (عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) [البقرة : ١٠٢] نفى اللبس ، وكذا قوله تعالى : (مِنْ
__________________
[٥١٢] البيت في ديوان الحطيئة. ويروى : بالعذر بدل بالغدر.
قَبْلُ) [البقرة : ٢٥] وقول الحطيئة يوم يلقى ربه ، وقوله تعالى : (لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ) [إبراهيم : ٢٢] لأن قضاء الأمر إنما يكون يوم القيامة.
[٥١٣] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ) [إبراهيم : ٢٧] وقد رأينا كثيرا من الظالمين هداهم الله بالإسلام وبالتوبة وصاروا من الأتقياء؟
قلنا : معناه أنه لا يهديهم ما داموا مصرين على الكفر والظلم معرضين عن النظر والاستدلال.
الثاني : أن المراد منه الظالم الذي سبق له القضاء في الأزل أنه يموت على الظلم ، فالله تعالى يثبته على الضلالة لخذلانه ، كما يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وهو كلمة التوحيد.
الثالث : أن معناه : أن يضل المشركين عن طريق الجنة يوم القيامة.
[٥١٤] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) [إبراهيم : ٣٠] والضلال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ الأنداد وهي الأصنام ، وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى ، كما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : ٣]؟
قلنا : قد شرحنا ذلك في سورة يونس عليهالسلام إذ قلنا هذه لام العاقبة والصيرورة لا لام الغرض ، والمقصود كما في قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) [القصص : ٨] وقول الشاعر :
لدوا للموت وابنوا للخراب
وقول الآخر :
|
فللموت تغذو الوالدات سخالها |
|
كما لخراب الدّهر تبنى المساكن |
والمعنى فيه أنّهم لمّا أفضى بهم اتخاذ الأنداد إلى الضّلال أو الإضلال صار كأنّهم اتخذوها لذلك ، وكذا الالتقاط والولادة والبناء ، ونظائره كثيرة في القرآن العزيز وفي كلام العرب.
[٥١٥] فإن قيل : كيف طابق الأمر بإقامة الصلاة وإنفاق المال وصف اليوم بأنه لا بيع فيه ولا خلال؟
قلنا : معناه قل لهم يقدمون من الصلوات والصدقة متجرا يجدون ربحه يوم لا
__________________
[٥١٤] الشطر من بيت لأبي العتاهية وقد تقدّم.
ـ البيت الثاني لم نقف على نسبته لقائل.
ـ سخالها : مفردها سخل وهو ولد الشاة قبل أن يفطم.
تنفعهم متاجر الدنيا من المعاوضات والصدقات التي يجلبونها بالهدايا والتحف لتحصيل المنافع الدنيوية ، فجاءت المطابقة.
[٥١٦] فإن قيل : كيف قال تعالى : (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ) [إبراهيم : ٣١] ، أي لا صداقة ، وفي يوم القيامة خلال لقوله تعالى : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف : ٦٧] ولقوله عليه الصلاة والسلام : «المرء مع من أحبّ»؟
قلنا : لا خلال فيه لمن لم يقم الصلاة ولم يؤد الزكاة. فأمّا المقيمون الصلاة والمؤتون الزّكاة فهم الأتقياء ، وبينهم الخلال يوم القيامة ، لما تلونا من الآية.
[٥١٧] فإن قيل : كيف قال : (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) [إبراهيم : ٣٣] والمسخّر للإنسان هو الذي يكون في طاعته يصرّفه كيف شاء في أمره ونهيه كالدّابة والعبد والفلك ، كما قال تعالى : (وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا) [الزخرف : ١٣] ، وقال تعالى : (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) [الزخرف : ٣٢] ، وقال تعالى : (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ) [إبراهيم : ٣٢]. ويقال : فلان مسخّر لفلان إذا كان مطيعا له وممتثلا لأوامره ونواهيه؟
قلنا : لمّا كان طلوعهما وغروبهما وتعاقب اللّيل والنهار لمنافعنا متّصلا مستمرا اتصالا لا تنقطع علينا فيه المنفعة ولا تنخرم ، سواء شاءت هذه المخلوقات أم أبت ، أشبهت المسخّر المقهور في الدنيا ، كالعبد والفلك ونحوهما.
والثّاني : أنّ معناه أنّها مسخّرة لله لأجلنا ومنافعنا. فإضافة التّسخير إلى الله تعالى ، بمعنى أنّه فاعل التسخير ، وإضافة التّسخير إلينا بمعنى عود نفع التّسخير إلينا ، فصحّت الإضافتان.
[٥١٨] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ) [إبراهيم : ٣٤] والله تعالى لم يعطنا كل ما سألناه ولا بعضا من كل فرد مما سألناه؟
قلنا : معناه : وآتاكم بعضا من جميع ما سألتموه لا من كلّ فرد فرد.
[٥١٩] فإن قيل : لا يصح هذا المحمل لوجهين :
أحدهما : أنه لا يحسن الامتنان به.
الثّاني : أنه لا يناسبه قوله تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها) [إبراهيم : ٣٤]؟
قلنا : إذا كان البعض الّذي أعطانا هو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح والأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنّسبة إلى البعض الذي منعه عنّا لمصلحتنا ، أيضا ؛ لا يحسن الامتنان به ، ويكون مناسبا لما بعده.
__________________
[٥١٦] الحديث أخرجه أحمد في مسنده : ١ / ٣٩٢.
وجواب آخر : عن أصل السؤال : أنه يجوز أن يكون قد أعطى جميع السائلين بعضا من كلّ فرد مما سأله جميعهم ، وبهذا المقدار يصح الإخبار في الآية وإن لم يعط كل واحد من السائلين بعضا من كل فرد مما سأله ذاك ، وإيضاح ذلك أن يكون هذا قد أعطي شيئا مما سأله ذاك ، وأعطي ذاك شيئا مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقهما ، كما أعطي النبيّ عليه الصلاة والسلام الرؤية ليلة المعراج وهي مسئول موسى عليهالسلام وما أشبه ذلك.
[٥٢٠] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها) [إبراهيم : ٣٤] والإحصاء والعد بمعنى واحد كذا نقله الجوهري ، فيكون المعنى وإن تعدوا نعمة الله لا تعدوها ، وهو متناقض كقولك : إن تر زيدا لا تبصره ، إذ الرؤية والإبصار واحد؟
قلنا : بعض المفسرين فسّر الإحصاء بالحصر ، فإن صحّ ذلك لغة ، اندفع السؤال. ويؤيّد ذلك قول الزّمخشري لا تحصوها ، أي لا تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها ، وعلى القول الأول فيه إضمار تقديره : وإن تريدوا عد نعمة الله لا تعدوها.
[٥٢١] فإن قيل : كيف قال تعالى : (لا تُحْصُوها) [إبراهيم : ٣٤] وهو يوهم أن نعم الله غير متناهية ، وكل نعمة ممتن بها علينا فهي مخلوقة ، وكل مخلوق متناه؟
قلنا : لا نسلم أنه يوهم أنها لا تتناهى ، وذلك لأن المفهوم منه منحصر في أنا لا نطيق عدّها أو حصر عددها ، ويجوز أن يكون الشيء متناهيا في نفسه ، والإنسان لا يطيق عدّه كرمل القفار وقطر البحار وورق الأشجار وما أشبه ذلك.
[٥٢٢] فإن قيل : كيف قال إبراهيم عليهالسلام : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) [إبراهيم : ٣٥] وعبادة الأصنام كفر ، والأنبياء معصومون عن الكفر بإجماع الأمة ، فكيف حسن منه هذا السؤال؟
قلنا : إنما سأل هذا السؤال في حالة خوف أذهله عن ذلك العلم ؛ لأن الأنبياء عليهمالسلام أعلم الناس بالله فيكونون أخوفهم منه فيكون معذورا بسبب ذلك.
وقيل إن في حكمة الله تعالى وعلمه أن لا يبتلي نبيا من الأنبياء بالكفر بشرط أن يكون متضرعا إلى ربه طالبا منه ذلك ، فأجرى على لسانه هذا السؤال لتحقيق شرط العصمة.
[٥٢٣] فإن قيل : كيف قال : (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) [إبراهيم : ٣٦] جعل الأصنام مضلة. والمضل ضار. وقال في موضع آخر : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ) [يونس : ١٨] ، ونظائره كثيرة فكيف التوفيق بينهما؟
قلنا : إضافة الإضلال إليها مجاز بطريق المشابهة. ووجهه أنهم لما ضلوا بسببها فكأنها أضلتهم ، كما يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم ، أي افتتنوا بسببها واغتروا ، ومثله قولهم : دواء مسهل ، وسيف قاطع ، وطعام مشبع ، وماء مرو وما أشبه ذلك. ومعناه : حصول هذه الآثار بسبب هذه الأشياء ، وفاعل الآثار هو الله تعالى.
[٥٢٤] فإن قيل : كيف قال : (أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ) [إبراهيم : ٣٧] ولم يقل أفئدة الناس ، وقوله قلوب الناس أظهر استعمالا من قوله قلوبا من الناس؟
قلنا : قال ابن عباس ، رضي الله تعالى عنهما ، لو قال إبراهيم عليهالسلام في دعائه أفئدة الناس ، لحجت جميع الملل وازدحم عليه الناس حتى لم يبق لمؤمن فيه موضع ، مع أن حج غير الموحدين لا يفيد ، والأفئدة هنا القلوب في قول الأكثرين ، وقيل : الجماعة من الناس.
[٥٢٥] فإن قيل : إذا كان الله تعالى قد ضمن رزق العباد ، فلم سأل إبراهيم عليهالسلام الرزق لذريته فقال : (وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ) [إبراهيم : ٣٧]؟
قلنا : الله تعالى ضمن الرزق والقوت الذي لا بد للإنسان منه ما دام حيا ولم يضمن كونه ثمرا أو حبا أو نوعا معينا ، فالسؤال كان لطلب الثمر عينا.
[٥٢٦] فإن قيل : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ) [إبراهيم : ٣٩] شكر على نعمة الولد ، فكيف يناسبه بعده (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ) [إبراهيم : ٣٩]؟
قلنا : لما كان قد دعا ربه لطلب الولد بقوله : (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) [الصافات : ١٠٠] فاستجاب له ، ناسب قوله بعد الشكر : (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ) [إبراهيم : ٣٩] أي لمجيبه من قولهم : سمع الملك قول فلان إذا أجابه وقبله ، ومنه قولهم في الصلاة «سمع الله لمن حمده» أي أجابه وأثابه.
[٥٢٧] فإن قيل : كيف قال : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَ) [نوح : ٢٨] استغفر إبراهيم لوالديه وكانا كافرين ، والاستغفار للكافرين لا يجوز ، ولا يقال إن هذا موضع الاستثناء المذكور في قوله تعالى : (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ) [التوبة : ١١٤] الآية ، لأن المراد بذلك استغفاره لأبيه خاصة بقوله : (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) [الشعراء : ٨٦] والموعدة التي وعدها إيّاه إنما كانت له خاصة بقوله : (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) [مريم : ٤٧] ولهذا قال تعالى : (إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) [الممتحنة : ٤]؟
قلنا : هذا الاستغفار لهما كان مشروطا بإيمانهما تقديرا ، كأنه قال ولوالدي إن آمنا.
الثاني : أنه أراد بهما آدم وحواء صلوات الله عليهما ، وقرأ ابن مسعود وأبي
والنخعي والزهري رضي الله عنهم «ولوالدي» يعني إسماعيل وإسحاق ، ويعضد هذه القراءة سبق ذكرهما ، ولا إشكال على هذه القراءة.
وقيل : إن هذا الدّعاء على القراءة المشهورة كان زلة من إبراهيم صلوات الله عليه ، وإليها أشار بقوله : (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) [الشعراء : ٢٨].
[٥٢٨] فإن قيل : الله تعالى منزه ومتعال عن الغفلة ، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بصفات جلاله وكماله ، فكيف يحسبه النبي عليه الصلاة والسلام غافلا وهو أعلم الخلق بالله حتى نهاه عن ذلك بقوله : (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) [إبراهيم : ٤٢]؟
قلنا : يجوز أن يكون هذا نهيا لغير النبيّ عليه الصلاة والسلام ممن يجوز أن يحسبه غافلا لجهله بصفاته ، وقوله تعالى ، بعده : (وَأَنْذِرِ النَّاسَ) [إبراهيم : ٤٤] ، لا يدل قطعا على أن الخطاب الأول للنّبيّ عليه الصلاة والسلام ، لجواز أن يكون ذلك النهي لغيره مع أن هذا الأمر له.
الثاني : أنه مجاز معناه : ولا تحسبن الله مهمل الظالمين وتاركهم سدى ، أي لكون هذا من لوازم الغفلة عنهم.
الثالث : أن النهي وإن كان حقيقة والخطاب للنّبيّ عليه الصلاة والسلام فالمراد به دوامه وثباته على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلا كقوله تعالى : (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [القصص : ٨٧] وقوله تعالى : (وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) [الشعراء : ٢١٣] ونظير هذا النهي من الأمر قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) [النساء : ١٣٦] وقول بعض المفسرين : إن معنى الآية يا أيها الذين آمنوا بموسى أو بعيسى آمنوا بمحمّد عليه الصلاة والسلام لا يخرج الآية عن كونها نظيرا ؛ لأنّ الاستبدال بالإيمان بالله باق ، فتأمّل.
سورة الحجر
[٥٢٩] فإن قيل : كيف قالوا : (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) [الحجر : ٦] اعترفوا بنبوته ، إذ الذّكر هو القرآن الّذي نزل عليه ، ثم وصفوه بالجنون؟
قلنا : إنّما قالوا ذلك استهزاء وسخرية ، لا تصديقا واعترافا ؛ كما قال فرعون لقومه : (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) [الشعراء : ٢٧] وكما قال قوم شعيب ، عليهالسلام : (إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) [هود : ٨٧] ، ونظائره كثيرة.
الثاني : أنّ فيه إضمارا تقديره : يا أيها الّذي تدّعي أنك نزل عليك الذّكر.
[٥٣٠] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) [الحجر : ٢٣] والوارث هو الّذي يتجدّد له الملك بعد فناء المورث ، والله تعالى إذا مات الخلائق لم يتجدّد له ملك ؛ لأنه لم يزل مالكا للعالم بجميع ما فيه ومن فيه؟
قلنا : الوارث في اللغة عبارة عن الباقي بعد فناء غيره ، سواء تجدّد له من بعده ملك أو لا ؛ ولهذا يصح أن يقال لمن أخبر أنّ زيدا مات وترك ورثة ، هل ترك لهم مالا أو لا؟ فيكون معنى الآية : ونحن الباقون بعد فناء الخلائق.
الثاني : أنّ الخلائق لمّا كانوا يعتقدون أنّهم مالكون يسمون بذلك ، أيضا ، إمّا مجازا أو خلافة عن الله تعالى ، كالعبد المأذون والمكاتب. ويدل عليه قوله تعالى : (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) [آل عمران : ٢٦] فإذا مات الخلائق كلهم سلمت الأملاك كلّها لله تعالى عن ذلك القدر من التعلق ، فبهذا الاعتبار كانت الوراثة ، ونظير هذا قوله تعالى : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) [غافر : ١٦] والملك له أزلا وأبدا.
[٥٣١] فإن قيل : قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ) [الحجر : ٣٠] دلّ على
__________________
[٥٣١] سيبويه : هو عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، أبو بشر ، لقبه سيبويه. ولد في إحدى قرى شيراز سنة ١٤٨ ه ، واختلف في مكان وفاته وتاريخها ، والمعروف أنّه توفي سنة ١٨٠ ه (!) أقام بالبصرة وأخذ عن الخليل بن أحمد. ثم ، انتقل إلى بغداد وبها جرت مناظرته للكسائي. ألّف الكتاب وبه يعرف.
ـ الخليل : هو الخليل بن أحمد الفراهيدي اليزدي الأحمدي ، أبو عبد الرحمن. إمام اللغة والأدب ، وواضع علم العروض. كان عارفا بالموسيقى. أشهر تلاميذه سيبويه. ولد في البصرة سنة ١٠٠ ه وتوفي بها سنة ١٧٠ ه. كان زاهدا. من مؤلفاته : العين (وهو أشهر ما صنف) ، معاني ـ
الشمول والإحاطة وأفاد التوكيد ؛ فما فائدة قوله : (أَجْمَعُونَ) [الحجر : ٣٠]؟
قلنا : قال سيبويه والخليل : هو توكيد بعد توكيد ، فيفيد زيادة تمكين المعنى وتقريره في الذّهن ، فلا يكون تحصيل الحاصل ؛ بل تكون نسبة أجمعون كنسبة كلهم إلى أصل الجملة. وقال المبرد : قوله تعالى : (أَجْمَعُونَ) [الحجر : ٣٠] يدل على اجتماعهم في زمان السجود ، وكلهم يدل على وجود السجود من الكل ، فكأنّه قال : فسجد الملائكة كلهم معا في زمان واحد. واختار ابن الأنباري هذا القول ، واختار الزّجّاج وأكثر الأئمة قول سيبويه وقالوا : لو كان الأمر كما زعم المبرد لكان أجمعون حالا لوجود حد الحال فيه ، وليس بحال لأنه مرفوع ولأنه معرفة كسائر ألفاظ التوكيد.
[٥٣٢] فإن قيل : ما وجه ارتباط قوله تعالى : (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) [الحجر : ٥١] بما قبله من قوله تعالى : (نَبِّئْ عِبادِي) [الحجر : ٤٩] الآيتين؟
قلنا : لما أنزل الله عزوجل : (نَبِّئْ عِبادِي) [الحجر : ٤٩] الآيتين ولم يعين أهل المغفرة وأهل العذاب غلب الخوف على الصحابة رضي الله عنهم ، فأنزل الله تعالى بعد ذلك قصة ضيف إبراهيم عليهالسلام ليزول خوف الصحابة وتسكن قلوبهم ، فإن ضيف إبراهيم عليهالسلام جاءوا ببشارة للولي وهو إبراهيم ، وعقوبة للعدو وهم قوم لوط عليهالسلام وكذلك تنزل الآيتين المتقدمتين على الولي والعدو لا على الولي وحده.
الثاني : أن وجه الارتباط أن العبد وإن كان كثير الذنوب والخطايا غير طامع في المغفرة ، لا يبعد أن يغفر الله تعالى له على يأسه ، كما رزق إبراهيم الولد على يأسه بعد ما شاخ وبلغ مائة سنة أو قريبا منها.
[٥٣٣] فإن قيل : كيف قالت الملائكة : (قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ) [الحجر : ٦٠] أي قضينا ، والقضاء لله تعالى لا لهم؟
قلنا : إسناد التقدير للملائكة هو مجاز ، كما يقول خواص الملك ، دبرنا كذا وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، ويكون الفاعل لجميع ذلك هو الملك لا هم ، وإنما يظهرون بذلك مزيد قربهم واختصاصهم بالملك.
[٥٣٤] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ) [الحجر :
__________________
ـ الحروف ، الجمل ، جملة آلات العرب ، كتاب العروض ، النقط والشكل ، تفسير حروف اللغة ، الخ.
ـ المبرّد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ، أبو العباس ، اشتهر بالمبرّد. كان إمام العربية في بغداد في زمنه ، وإماما في الأدب. ولد في البصرة سنة ٢١٠ ه وتوفي سنة ٢٨٦ في بغداد. من مؤلفاته : الكامل ، المقتضب ، التعازي والمراثي ، شرح لامية العرب ، إعراب القرآن ، طبقات النحاة البصريين ، الخ.
٨٠] وأصحاب الحجر قوم صالح ، والحجر اسم واديهم أو مدينتهم على اختلاف القولين ، وقوم صالح لم يرسل إليهم غير صالح فكيف يكذبون المرسلين؟
قلنا : من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الكل ؛ لأن كل الرسل متفقون في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى.
[٥٣٥] فإن قيل : كيف قال تعالى هنا (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) [الحجر : ٩٢ ، ٩٣] ، وقال في سورة الرحمن : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ) [الرحمن : ٣٩]؟
قلنا : الجواب عنه من وجهين :
أحدهما : قد ذكرناه في مثل هذا السؤال في سورة هود.
والثاني : أن المراد هنا أنهم يسألون سؤال توبيخ وهو سؤال لم فعلتم؟ والمراد ثم إنهم لا يسألون سؤال استعلام واستخبار وهو سؤال هل فعلتم؟
أو يقال : إن في يوم القيامة مواقف ، ففي بعضها يسألون ، وفي بعضها لا يسألون ، وتقدم نظيره.
سورة النحل
[٥٣٦] فإن قيل : لم قدمت الإراحة وهي مؤخرة في الواقع على السروح وهو مقدم في الواقع في قوله تعالى : (حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) [النحل : ٦]؟
قلنا : لأن الأنعام في وقت الإراحة وهي ردها عشيا إلى المراح تكون أجمل وأحسن ، لأنها تقبل ملأى البطون حاملة الضروع متهادية في مشيها يتبع بعضها بعضا ، بخلاف وقت السروح وهو إخراجها إلى المرعى فإن كل هذه الأمور تكون على ضد ذلك.
[٥٣٧] فإن قيل : قوله تعالى : (لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ) [النحل : ٧] إن أريد به لم تكونوا بالغيه عليها إلا بشق الأنفس فلا امتنان فيه ، وإن أريد به لم تكونوا بالغيه بدونها إلا بشق الأنفس فهم لا يبلغونه عليها أيضا إلا بشق الأنفس ، فما فائدة ذلك؟
قلنا : معناه وتحمل أثقالكم ، أي أجسامكم وأمتعتكم معكم إلى بلد بعيد قد علمتم أنكم لا تبلغونه بدونها بأنفسكم من غير أمتعتكم إلا بجهد ومشقة ، فكيف لو حملتم أمتعتكم على ظهوركم؟ والمراد بالمشقة : المشقة التي تنشأ من المشي ، أو من المشي مع الحمل على الظهر لا مطلق مشقة السفر ، وهذا مخصوص بحال فقد الإبل ، فظهر فائدة ذلك.
[٥٣٨] فإن قيل : قوله تعالى : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) [النحل : ٥] يقتضي حرمة أكل الخيل كما اقتضاه في البغال والحمير من حيث أنه لم ينص على منفعة أخرى فيها غير الركوب والزينة ، ومن حيث أن التعليل بعلة يقتضي الانحصار فيها كقولك : فعلت هذا لكذا ، فإنه يناقضه أن تكون فعلته لغيره أوله مع غيره ؛ إلا إذا كان أحدهما جهة في الآخر.
قلنا : ينتقض بالحمل عليها والحراثة بها ، فإن ذلك مباح ؛ مع أنه لم ينص عليه.
[٥٣٩] فإن قيل : إنما ثبت ذلك بالقياس على الأنعام ، فإنه منصوص عليه فيها بقوله تعالى : (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ) [النحل : ٥] والمراد به كل منفعة معهودة منها عرفا لا كل منفعة ، فثبت مثل ذلك في الخيل والبغال والحمير.
قلنا : لو كان ثبوته فيها بالقياس على ثبوته في الأنعام لثبت حل الأكل في الخيل بالقياس على ثبوته في الأنعام أيضا ، ولو ثبت حل الأكل في الخيل بالقياس لثبت في البغال والحمير ، كما ثبت الحمل والحراثة ثبوتا شاملا للكل بالقياس على ثبوته في الأنعام.
والجواب عن الجهة الثانية في أصل السؤال أن هذه اللام ليست لام التعليل بل لام التمكين ، كقوله تعالى : (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) ومع هذا يجوز في الليل غير السكون.
[٥٤٠] فإن قيل : كيف قال الله تعالى في وصف ماء السماء (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) [النحل : ١١] ولم يقل كل الثمرات ؛ مع أن كل الثمرات تنبت بماء السماء؟
قلنا : كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة ، وإنما ينبت في الدنيا بعض منها أنموذجا وتذكرة ، فالتبعيض بهذا الاعتبار ، فيكون المراد بالثمرات ما هو أعم من ثمرات الدنيا ، ومن يجوّز زيادة «من» في الإثبات يحتمل أن يجعلها زائدة هنا.
[٥٤١] فإن قيل : قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ) [النحل : ١٧] المراد بمن لا يخلق الأصنام بدليل قوله تعالى بعده : (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) [النحل : ٢٠] فكيف جيء بمن المختصة بأولي العلم والعقل؟
قلنا : خاطبهم على معتقدهم ؛ لأنهم سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم ، ونظير هذا قوله تعالى في الأصنام أيضا : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها) [الأعراف : ١٩٥] الآية ، فأجرى عليهم ضمير أولي العلم والعقل لما قلناه.
ويرد على هذا الجواب أن يقال : إذا كان معتقدهم خطأ وباطلا فالحكمة تقتضي أن ينزعوا عنه ويقلعوا ، لا أن يبقوا عليه ويقروا في خطابهم على معتقدهم إيهاما لهم أن معتقدهم حقّ وصواب.
وجوابه : أن الغرض من الخطاب الإفهام ، ولو خاطبهم على خلاف معتقدهم ومفهومهم فقال : أفمن يخلق كما لا يخلق ، لاعتقدوا أن المراد من الثاني غير الأصنام من الجماد.
الثاني : قال ابن الأنبازي : إنما جاز ذلك لأنها ذكرت مع العالم فغلب عليها حكمه في اقتضاء «من» كما غلب على الدواب في قوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ) [النور : ٤٥] الآية ، وكما في قول العرب : اشتبه عليّ الراكب ، وجمله : فما أدري من ذا ومن ذا.
[٥٤٢] فإن قيل : هذا إلزام للذين عبدوا الأصنام وسموها آلهة تشبيها بالله فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق ، فظاهر الإلزام يقتضي أن يقال لهم : أفمن لا يخلق كمن يخلق؟
قلنا : لما سووا بين الأصنام وخالقها سبحانه وتعالى في تسميتها باسمه وعبادتها كعبادته فقد سووا بينها وبين خالقها قطعا ، فصح الإنكار بتقديم أيهما كان ، وإنما قدم في الإنكار عليهم ذكر الخالق ، إما لأنه أشرف ، أو لأنه هو المقصود الأصلي من هذا الكلام تنزيها له وإجلالا وتعظيما.
[٥٤٣] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى في وصف الأصنام (غَيْرُ أَحْياءٍ) [النحل : ٢١] بعد قوله تعالى : (أَمُوتُ) [النحل : ٢١]؟
قلنا : فائدته أنها أموات لا يعقب موتها حياة احترازا عن أموات يعقب موتها حياة. كالنطف والبيض والأجساد الميتة ، وذلك أبلغ في موتها ، كأنه قال : أموات في الحال غير أحياء في المآل.
الثاني : أنه ليس وصفا لها بل لعبادها ؛ معناه : وعبادها غير أحياء القلوب.
الثالث : أنه إنما قال غير أحياء ، ليعلم أنه أراد أمواتا في الحال ، لا أنها ستموت كما في قوله تعالى : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [الزمر : ٣٠].
[٥٤٤] فإن قيل : كيف عاب الأصنام وعبادها بأنهم لا يعلمون وقت البعث فقال تعالى : (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) [النحل : ٢١] والمؤمنون الموحدون كذلك؟
قلنا : معناه وما يشعر الأصنام متى يبعث عبادها ، فكيف تكون آلهة مع الجهل؟
أو معناه : وما يشعر عبادها وقت بعثهم لا مفصلا ولا مجملا ؛ لأنهم ينكرون البعث ، بخلاف الموحدين فإنهم يشعرون وقت بعثهم مجملا أنه يوم القيامة وإن لم يشعروه مفصلا.
[٥٤٥] فإن قيل : قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [النحل : ٢٤] كيف يعترفون بأنه من عند الله تعالى بالسؤال المعاد في ضمن الجواب ثم يقولون هو أساطير الأولين؟
قلنا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة الحجر في قوله تعالى : (وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) [الحجر : ٦].
[٥٤٦] فإن قيل : كيف قال هنا (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [النحل : ٢٥] وقال في موضع آخر : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام : ١٦٤]؟
قلنا : معناه ومن أوزار إضلال الذين يضلونهم ، فيكون عليهم وزر كفرهم مباشرة ووزر كفر من أضلوهم تسببا ، فقوله تعالى : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً) [النحل : ٢٥] يعني أوزار الذنوب التي باشروها. وأما قوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام : ١٦٤] فمعناه : وزر لا مدخل لها فيه ولا تعلق له بها مباشرة ولا تسببا ، ونظير هاتين الآيتين الآيتان الأخريان في قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) [العنكبوت : ١٢] إلى قوله تعالى : (وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) [العنكبوت : ١٣] وجوابهما مثل جواب هاتين الآيتين.
[٥٤٧] فإن قيل : قوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ) [النحل : ٤٠] الآية ، يدل على أن المعدوم شيء ، ويدل على أن خطاب المعدوم جائز ، والأول منتف عند أكثر العلماء ، والثاني منتف بالإجماع؟
قلنا : أما تسميته شيئا فمجاز باعتبار ما يئول إليه ، ونظيره قوله تعالى : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) [الحج : ١] وقوله تعالى : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [الزمر : ٣٠] وأما الثاني فإن هذا خطاب تكوين يظهر به أثر القدرة فيمتنع أن يكون المخاطب به موجودا قبل الخطاب ، لأنّه إنما يكون بالخطاب فلا يسبقه ، بخلاف خطاب الأمر والنهي.
[٥٤٨] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ) [النحل : ٤٩] كيف لم يغلب العقلاء من الدواب على غيرهم كما في قوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ) [النور : ٤٥] الآية ، بل أولى لأنه ثم وصف ما لا يعقل بخصوصه بلفظ «من» وهو الحية والأنعام ، وهنا لو قال من في السموات ومن في الأرض لا يلزم وصف ما لا يعقل بخصوصه وتعيينه بلفظة «من» بل المجموع؟
قلنا : لأنه أراد عموم كل دابة وشمولها ، فجاء بما التي تعم النوعين وتشملهما ، ولو جاء بمن لخصّ العقلاء.
[٥٤٩] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ) [النحل : ٦١] يقتضي أنه لو آخذ الظالمين بظلمهم لأهلك غير الظالمين من الناس ، ولأهلك جميع الدواب غير الناس ، ومؤاخذة البريء بسبب ظلم الظالم لا يحسن بالحكيم؟
قلنا : المراد بالظلم هنا الكفر ، وبالدابة الظالمة وهي الكافر ، كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل معناه : لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء.