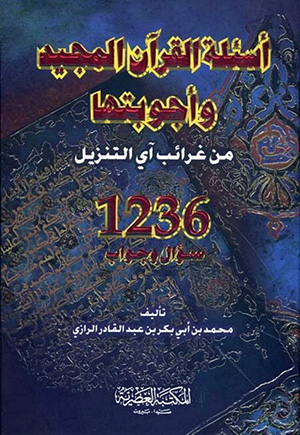محمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: المكتبة العصريّة للطباعة والنشر
الطبعة: ١
ISBN: 9953-34-026-9
الصفحات: ٤٠٨
الخلق ، والإعادة أهون بالنسبة إلينا لزمهم الاعتراف بها ، فصاروا كأنهم مسلّمون وجودها من حيث ظهور الحجة ووضوحها.
[٤٢١] فإن قيل : كيف قال تعالى : (فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ) [يونس : ٤٦] رتب كونه شهيدا على أفعالهم على رجوعهم إليه في القيامة ، مع أنه شهيد على أفعالهم في الدنيا والآخرة؟
قلنا : ذكر الشهادة وأراد مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب والجزاء ، فكأنه قال : ثم الله يعاقب على ما يفعلون أو مجاز على ما يفعلون. كما قال تعالى : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ) [البقرة : ١٩٧] ونظائره في القرآن العزيز كثيرة.
[٤٢٢] فإن قيل : كيف قال تعالى : (بَياتاً أَوْ نَهاراً) [يونس : ٥٠] ولم يقل ليلا أو نهارا وهو أظهر في المطابقة استعمالا مع النهار في القرآن العزيز وغيره؟
قلنا : لأن المعهود المألوف في كلام العرب عند ذكر البطش والإهلاك والوعيد والتهديد ذكر لفظ البيات سواء قرن به النهار أو لا ، فلذلك لم يقل ليلا.
[٤٢٣] فإن قيل : كيف قال تعالى : (ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس : ٥٠] أي ما ذا يستعجلون منه ، وأول الآية للمواجهة؟
قلنا : أراد بذكر المجرمين الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام ، لأن من حقّ المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويفزع من مجيئه ، وإن أبطأ فضلا عن أن يستعجله.
[٤٢٤] فإن قيل : كيف قال تعالى : (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) [يونس : ٥٨] ولم يقل فبذينك ، والمشار إليه اثنان الفضل والرحمة.
قلنا : قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة البقرة في قوله تعالى : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) [البقرة : ٦٨].
[٤٢٥] فإن قيل : قوله تعالى : (وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [يونس : ٦٠] تهديد ؛ لأن فيه محذوفا تقديره : وما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم ، فكيف يناسبه قوله تعالى بعده (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) [البقرة : ٢٤٣]؟
قلنا : هو مناسب لأن معناه أن الله لذو فضل على الناس حيث أنعم عليهم بالعقل والوحي والهداية وتأخر العذاب وفتح باب التوبة ، فكيف يفترون على الله الكذب مع توافر نعمه عليهم؟
[٤٢٦] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ) [يونس : ٦١] فأفرد ثم قال : (وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ) [يونس : ٦١] فجمع ، والخطاب للنبي صلىاللهعليهوسلم؟
قلنا : قال ابن الأنباري : إنما جمع في الفعل الثالث ليدل على أنّ الأمة داخلون مع النبي صلىاللهعليهوسلم في الفعلين الأولين. وقال غيره : المراد بالفعل الثالث أيضا النبي صلىاللهعليهوسلم وحده ، وإنّما جمع تفخيما له وتعظيما كما في قوله تعالى : (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ) [البقرة : ٧٥] على قول ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وكما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ) [المؤمنون : ٥١] والمراد به النبي صلىاللهعليهوسلم ، كذا قاله ابن عباس والحسن وغيرهما ، واختاره ابن قتيبة والزّجّاج.
[٤٢٧] فإن قيل : كيف قدم الأرض على السماء في قوله تعالى : (وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) [يونس : ٦١] وقدم السماء على الأرض في قوله تعالى في سورة سبأ : (عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) [سبأ : ٣]؟
قلنا : حق السماء أن تقدم على الأرض مطلقا لأنها أشرف ، لكنه كما ذكر هنا في صدر الآية شهادته على شئون أهل الأرض وأقوالهم وأعمالهم ثم أردفه بقوله : (وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ) [يونس : ٦١] ناسب ذلك تقديم الأرض على السماء.
الثاني : أن العطف بالواو نظير التثنية وحكمه حكمها ، فلا يعطى رتبة كالتثنية.
[٤٢٨] فإن قيل : كيف قال تعالى هنا (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) [يونس : ٦٥] وقال في موضع آخر [(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون : ٨]؟
قلنا : أثبت الاشتراك في نفس العزة التي هي في حقّ الله تعالى القدرة والغلبة ، وفي حق الرسول صلىاللهعليهوسلم علو كلمته وإظهار دينه ، وفي حقّ المؤمنين نصرهم على أعدائهم ، وقوله تعالى : (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) [يونس : ٦٥] أراد به العزة الكاملة التي يندرج فيها عزة الإلهية والخلق والإماتة والإحياء والبقاء الدائم وما أشبه ذلك فلا تنافي.
[٤٢٩] فإن قيل : إذا كانت السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات وما وراءهما كل ذلك لله تعالى ملكا وخلقا ، فما فائدة التخصيص في قوله تعالى : (مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) [يونس : ٦٦]؟
قلنا : إنما خص العقلاء المميزين بالذكر وهم الملائكة والثقلان ، ليعلم أن هؤلاء إذا كانوا عبيدا له وهو ربهم ، ولا يصلح أحد منهم للربوبية ولا للشركة معه ، فما وراءهم مما لا يعقل كالأصنام والكواكب ونحوهما أحق أن لا تكون له ندا وشريكا.
[٤٣٠] فإن قيل : كيف قال لهم موسى عليهالسلام : (أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا) [يونس : ٧٧] على طريق الاستفهام ، وهم إنما قالوا ذلك على طريق الإخبار أو التحقيق المؤكد بإن واللام لا على طريق الاستفهام ، قال الله تعالى : (فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ) [يونس : ٧٦].
قلنا : فيه إضمار تقديره : أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. ثم قال أسحر هذا إنكارا لما قالوه ، فالاستفهام من قول موسى عليهالسلام لا مفعول لقولهم.
[٤٣١] فإن قيل : كيف نوّع الخطاب في قوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [يونس : ٨٧] فثنى أولا ، ثم جمع ، ثم أفرد؟
قلنا : خوطب أولا موسى وهارون أن يتبوءا لقومهما بيوتا ويختاراها للعبادة ، وذلك مما يفوض إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ثم سبق الخطاب عاما لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها ، لأن ذلك واجب على الجمهور ، ثم خص موسى عليهالسلام بالبشارة تعظيما لها أو تعظيما له عليهالسلام.
[٤٣٢] فإن قيل : كيف قال تعالى : (قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما) [يونس : ٨٩] أضافها إليهما ، والدعوة إنما صدرت من موسى عليهالسلام ، قال الله تعالى : (وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً) [يونس : ٨٨] إلى آخر الآية؟
قلنا : نقل أن موسى عليهالسلام كان يدعو وهارون كان يؤمن على دعائه ؛ والتأمين دعاء في المعنى فلهذا أضاف الدعوة إليهما.
الثاني : أنه يجوز أن يكون هارون دعا أيضا مع موسى ، إلا أن الله تعالى خص موسى بالذكر ؛ لأنه كان أسبق بالدّعوة أو أحرص عليها أو أكثر إخلاصا فيها.
[٤٣٣] فإنه قيل : لو كان كذلك لقال تعالى دعوتاكما بالتثنية؟
قلنا : لما كانت الدعوة مصدرا اكتفى بذكرها في موضع الإفراد والتثنية والجمع بصيغة واحدة كسائر المصادر ، ونظيره قوله تعالى : (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ) [البقرة : ٧].
[٤٣٤] فإنه قيل : كيف قال تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) [يونس : ٩٤] وإن إنما تدخل على ما هو محتمل الوجود ، وشك النبي صلىاللهعليهوسلم في القرآن منتف قطعا؟
قلنا : الخطاب ليس للنبي صلىاللهعليهوسلم بل لمن كان شاكّا في القرآن وفي نبوّة محمد صلىاللهعليهوسلم ، فكأنه قال : «فإن كنت أيها الإنسان في شك».
[٤٣٥] فإن قيل : قوله تعالى : (مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) [يونس : ٩٤] يدل على أن الخطاب للنبي صلىاللهعليهوسلم لا لغيره.
قلنا : لا يدل ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً) [النساء : ١٧٤] وقال تعالى : (يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ) [التوبة : ٦٤].
الثاني : أن الخطاب للنبي صلىاللهعليهوسلم والمراد غيره كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ
اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) [الأحزاب : ١] ويعضده قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) [النساء : ٩٤] ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعده : (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي) [يونس : ١٠٤].
الثالث : أن تكون إن بمعنى ما ، تقديره : فما كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. المعنى لسنا نأمرك أن تسأل أحبار اليهود والنصارى عن صدق كتابك ، لأنك في شك منه ، بل لتزداد بصيرة ويقينا وطمأنينة.
الرابع : أن الخطاب للنبي صلىاللهعليهوسلم مع انتفاء الشك منه قطعا أو المراد به إلزام الحجة على الشاكين الكافرين كما يقول لعيسى عليهالسلام : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) [المائدة : ١١٦] وهو عالم بانتفاء هذا القول منه لإلزام الحجة على النصارى.
[٤٣٦] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) [يونس : ٩٩] ما فائدة ذكر (جَمِيعاً) بعد قوله (كُلُّهُمْ) وهو يفيد الشمول والإحاطة؟
قلنا : كل يفيد الشمول والإحاطة ، ولا يدل على وجود الإيمان منهم بصفة الاجتماع. وجميعا يدل على وجوده منهم في حالة واحدة ، كما تقول جاءني القوم جميعا ، أي مجتمعين ، ونظيره قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر : ٣٠].
[٤٣٧] فإن قيل : قوله تعالى : (قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [يونس : ١٠١] كيف يصح هذا الأمر ؛ مع أنّا لا نعلم جميع ما فيهما ولا نراه؟
قلنا : هو عام أريد ما ندركه بالبصر مما فيهما ، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والمعادن والحيوانات والنبات ونحو ذلك مما يدل على وجود الصانع وتوحيده وعظيم قدرته ، فيستدل به على ما وراءه.
[٤٣٨] فإن قيل : قوله تعالى : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ) [الأنعام : ١٧] الآية ما الحكمة في ذكر المس في الضر والإرادة في الخير؟
قلنا : لاستعمال كل من المس والإرادة في كل من الضر والخير ، وأنه لا مزيل لما يصيب به منهما ولا رادّ لما يريده فيهما ، فأوجز الكلام بأن ذكر المس في أحدهما والإرادة في الآخر ليدل بما ذكر على ما لم يذكر ؛ مع أنّه قد ذكر المس فيهما في سورة الأنعام. وإنما عدل هنا عن لفظ المس المذكور في سورة الأنعام إلى لفظ الإرادة ، لأن الجزاء هنا قوله تعالى : (فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ) [يونس : ١٠٧] والرد إنما يكون فيما لم يقع بعد ، والمس إنما يكون فيما وقع ، فلهذا قال ثم (وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [الأنعام : ١٧] ومعناه فإن شاء أدام ذلك الخير ، وإن شاء أزاله ، فلا يطلب دوامه وزيادته إلا منه تعالى.
سورة هود عليهالسلام
[٤٣٩] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) [هود : ٣] مع أن التوبة مقدمة على الاستغفار؟
قلنا : المراد استغفروا ربكم من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة ، كذا قاله مقاتل. وهذا الاستغفار مقدّم على هذه التّوبة.
الثاني : أن فيه تقديما وتأخيرا.
الثالث : قال الفراء : ثم هنا بمعنى الواو ، وهي لا تفيد ترتيبا فاندفع السؤال.
[٤٤٠] فإن قيل : من لم يستغفر ولم يتب فإن الله يمتعه متاعا حسنا إلى أجله ، أي يرزقه ويوسع عليه كما قال ابن عباس ، أو يعمره كما قال ابن قتيبة ، فما فائدة قوله تعالى : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) [هود : ٣]؟
قلنا : قال غيرهما المتاع الحسن المشروط بالاستغفار والتوبة هو الحياة في الطاعة والقناعة ، ومثل هذه الحياة إنما تكون للمستغفر التائب التقي.
[٤٤١] فإن قيل : قوله تعالى : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ) [هود : ٦] كيف لم يقل على الأرض ؛ مع أنه أشد مناسبة لتفسير الدابة لغة فإنها ما يدب على وجه الأرض؟
قلنا : في هنا بمعنى على ، كما في قوله تعالى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) [طه : ٧١] وقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ) [الطور : ٣٨].
الثاني : أن لفظة «في» أعم وأشمل ، لأنها تتناول كل دابة على وجه الأرض وكل دابة في باطن الأرض بخلاف على.
[٤٤٢] فإن قيل : كيف خص الدّابة بذكر ضمان الرزق ، والطير كذلك رزقه على الله تعالى ، وهو غير الدّابة ، بدليل قوله تعالى : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) [الأنعام : ٣٨]؟
قلنا : إنما خص الدابة بالذكر ؛ لأنّ الدواب أكثر من الطيور عددا ، وفيها ما هو أكبر جثة من كل فرد من أفراد الطير كالفيل والحوت ، فيكون أحوج إلى الرزق ، فلذلك خصه بالذكر.
[٤٤٣] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها) [هود : ٦] وعلى
للوجوب ، والله تعالى لا يجب عليه شيء وإنما يرزقها تفضلا منه وكرما.
قلنا : على هنا بمعنى من ، كما في قوله تعالى : (إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) [المطففين : ٢].
الثاني : أنه ذكره بصيغة الوجوب ليحصل للعبد زيادة سكون وطمأنينة في حصوله.
[٤٤٤] فإن قيل : كيف قال تعالى : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [هود : ٧] والخطاب عام للمؤمنين والكافرين ، فإنه امتحن الفريقين بالأمر بالطاعة والنهي عن المعصية ، وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى أحسن وأحسن ، فأما أعمال الفريقين فتفاوتها إلى حسن وقبيح.
قلنا : قوله تعالى : (لِيَبْلُوَكُمْ) [هود : ٧] عام أريد به الخاص وهو المؤمنون ؛ تشريفا لهم وتخصيصا ؛ فصح قوله أحسن عملا.
[٤٤٥] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ) [هود : ١٢] ولم يقل وضيّق؟
قلنا : ليدل على أن ضيقه عارض غير ثابت ، لأن النبي صلىاللهعليهوسلم كان أفسح الناس صدرا ، ونظيره قولك : زيد سائد وجائد ، فإذا أردت وصفه بالسيادة والجود الثابتين المستقرين قلت : زيد سيد وجواد ، كذا قال الزمخشري.
[٤٤٦] فإن قيل : قال تعالى : (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ) [هود : ١٣] أمرهم بالإتيان بمثله وما يأتون به لا يكون مثله ، لأن ما يأتون به مفترى والقرآن ليس بمفترى.
قلنا : أراد به مثله في البلاغة والفصاحة وإن كان مفترى. وقيل معناه : مفتريات ، كما أن القرآن مفترى في زعمكم واعتقادكم فيتماثلان.
[٤٤٧] فإن قيل : كيف قال تعالى : (قُلْ فَأْتُوا) [هود : ١٣] فأفرد في قوله (قُلْ) ثم جمع فقال : (فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا) [هود : ١٤]؟
قلنا : الخطاب للنبيّ صلىاللهعليهوسلم في الكل ، ولكنه جمع في قوله : (لَكُمْ فَاعْلَمُوا) [هود : ١٤] تفخيما له وتعظيما.
الثاني : أن الخطاب الثاني للنبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه ، لأن النبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه كانوا يتحدونهم بالقرآن ، وقوله تعالى في موضع آخر (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ) [القصص : ٥٠] يعضد الوجه الأول.
الثالث : أن يكون الخطاب في الثاني والثالث للمشركين ، والضمير في يستجيبوا لمن استطعتم ؛ يعني فإن لم يستجب لكم من تدعونه المظاهرة على معارضته لعجزهم فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله ، وهذا وجه لطيف.
[٤٤٨] فإن قيل : قوله تعالى : (وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها) [هود : ١٦] يدل على
بطلان عملهم ، فما فائدة قوله بعده (وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [هود : ١٦]؟
قلنا : المراد بقوله تعالى : (وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها) [هود : ١٦] أي بطل ثواب ما صنعوا من الطاعات في الدنيا (وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [هود : ١٦] من الرياء.
[٤٤٩] فإن قيل : كيف قال نوح عليهالسلام : (وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) [هود : ٢٩] بالواو وقال هود عليهالسلام : (يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) [هود : ٥١] بغير الواو؟
قلنا : لأن الضمير في قولهما عليه لتبليغ الرسالة المدلول عليه بأول الكلام في القصتين ، ولكن في قصة نوح عليهالسلام وقع الفصل بين الضمير وبين ما هو عائد عليه بكلام آخر ، فجيء بواو الابتداء. وفي قصة هود عليهالسلام لم يقع بينهما فصل فلم يحتج إلى واو الابتداء ، هذا ما وقع لي فيه ، والله أعلم.
[٤٥٠] فإن قيل : قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) [هود : ٤٣] لا يناسبه المستثنى في الظاهر وهو قوله : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ) [هود : ٤٣] لأن المرحوم معصوم ، فظاهره يقتضي لا معصوم إلا من رحم ، أي لا معصوم من الغرق بالطوفان إلا من رحمة الله بالإنجاء في السفينة؟
قلنا : عاصم هنا بمعنى معصوم ، كقوله تعالى : (مِنْ ماءٍ دافِقٍ) [الطارق : ٦] مدفوق ، وقوله تعالى : (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) [الحاقة : ٢١] ، أي مرضية ، وقول العرب : سر كاتم ، أي مكتوم.
الثاني : أن معناه : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، أي إلا الرّاحم وهو الله تعالى ، وليس معناه المرحوم ، فكأنه قال : لا عاصم إلا الله.
الثالث : أن معناه : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مكان من رحم الله من المؤمنين
__________________
[٤٥٠] قال العكبري : «قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ) فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه اسم فاعل على بابه ، فعلى هذا يكون قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ) فيه وجهان : أحدهما ، هو استثناء متصل و (مَنْ رَحِمَ) بمعنى الرّاحم ، أي لا عاصم إلّا الله ، والثاني ، أنه منقطع ، أي لكن من رحمهالله يعصم.
والوجه الثاني : أن عاصما بمعنى معصوم ، مثل (ماءٍ دافِقٍ) أي مدفوق ؛ فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا ، أي إلّا من رحمهالله.
والثالث : أن عاصما بمعنى ذا عصمة على النسب ، مثل حائض وطالق ، والاستثناء على هذا متصل أيضا ، فأما خبر لا فلا يجوز أن يكون اليوم ، لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة ؛ بل الخبر من أمر الله ، واليوم معمول من أمر ، ولا يجوز أن يكون اليوم معمول عاصم ، إذ لو كان كذلك لنوّن».
إملاء ما منّ به الرحمن ، ج ٢ ص ٣٩.
ونجاهم وهو السفينة ، ويناسب هذا الوجه قوله تعالى : (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [هود : ٤١] وهذا لأن ابن نوح عليهالسلام لما جعل الجبل عاصما من الماء رد نوح عليهالسلام ذلك ، ودله على العاصم وهو الله تعالى ، أو المكان الذي أمر الله بالالتجاء إليه وهو السفينة.
[٤٥١] فإن قيل : كيف صح أمر السماء والأرض بقوله تعالى : (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي) [هود : ٤٤] وهما لا يعقلان ، والأمر والنهي إنما يكون لمن يعقل ويفهم الخطاب؟
قلنا : الخطاب لهما في الصورة ، والمراد به الخطاب للملائكة الموكلين بتدبيرهما.
الثاني : أن هذا أمر إيجاب لا أمر إيجاد ، وأمر الإيجاد لا يشترط فيه العقل والفهم ، لأن الأشياء كلها بالنسبة إلى أمر الإيجاد مطيعة منقادة لله تعالى ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : ٤٠] وقوله تعالى : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) [فصلت : ١١] كل ذلك أمر إيجاد.
[٤٥٢] فإن قيل : كيف قال تعالى هنا (وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِ) [هود : ٤٥] بالفاء ، وقال في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام : (إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا قالَ رَبِ) [مريم : ٣ ، ٤].
قلنا : أراد بالنداء هنا إرادة النداء فجاء بالفاء الدالة على السببية ، فإن إرادة النداء سبب للنداء ، فكأنه قال : وأراد نوح نداء ربه فقال كيت وكيت ، وأراد به في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام حقيقة النداء ، فلهذا جاء بغير فاء لعدم ما يقتضي السببية.
[٤٥٣] فإن قيل : هود عليه الصلاة والسلام كان رسولا ولم يظهر معجزة : ولهذا قال له قومه (يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ) [هود : ٥٣] فبأي شيء لزمتهم رسالته؟
قلنا : إنما يحتاج إلى المعجزة من الرسل من يكون صاحب شريعة لتنقاد أمته لشريعته ، فإن في كل شريعة أحكاما غير معقولة فيحتاج الرسول الآتي بها إلى معجزة لتشهد بصحة صدقه ، فأما الرسول الذي لا تكون له شريعة ولا يأمر إلا بالعقليات فلا يحتاج إلى معجزة ؛ لأن الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل ، وهود كان كذلك.
الثاني : أنه نقل أن معجزة هود كانت الريح الصرصر فإنها كانت سخرت له.
[٤٥٤] فإن قيل : على الوجه الأول لو كان أمره لهم مقصورا على العقليات لما خالفوه وكذبوه ونسبوه إلى الجنون بقولهم : (يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ) [هود : ٥٣] إلى قوله : (بِسُوءٍ) [هود : ٥٤].
قلنا : إنما صدر ذلك القول من قاصري العقول أو المعاندين المكابرين ، كما
قيل ذلك لكل رسول ، بعد إتيانه بالمعجزات الظاهرات والآيات الباهرات.
[٤٥٥] فإن قيل : هلا قال : إنّي أشهد الله وأشهدكم ، ليتناسب الجملتان.
قلنا : لأن إشهاد الله تعالى على البراءة من الشرك إشهاد صحيح مفيد تأكيد التوحيد وشد معاقده ، وأما إشهادهم فما هو إلا تهكم بهم وتهاون ودلالة على قلة المبالاة ؛ لأنهم ليسوا أهلا للشهادة ، فعدل به عن اللفظ الأول وأتى به على صورة التهكم والتهاون ، كما يقول الرجل لصاحبه إذا لاحاه : أشهد إني لأحبك ، تهكما به واستهانة له.
[٤٥٦] فإن قيل : قوله تعالى : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ) [هود : ٥٧] ؛ جعل التولي شرطا ، والإبلاغ جزاء ، والإبلاغ كان سابقا على التولي.
قلنا : ليس الإبلاغ جزاء التولي ، بل جزاؤه محذوف تقديره : فإن تولوا لم أعاتب على تفريط في الإبلاغ أو تقصير فيه ، ودلّ على الجزاء المحذوف قوله : (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ) [الأعراف : ٩٣].
الثاني : قال مقاتل تقديره : فإن تولوا فقل لهم قد أبلغتكم.
[٤٥٧] فإن قيل : ما فائدة تكرار التنجية في قوله تعالى : (وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) [هود : ٥٨]؟
قلنا : أراد بالتنجية الأولى تنجيتهم من عذاب الدنيا الذي نزل بقوم هود ، وهو سموم أرسلها الله تعالى عليهم فقطعتهم عضوا عضوا ، وأراد بالتنجية الثانية تنجيتهم من عذاب الآخرة الذي استحقه قوم هود بالكفر ولا عذاب أغلظ منه ولا أشد.
[٤٥٨] فإن قيل : (بُعْداً) [هود : ٦٠] معناه عند العرب الدعاء عليهم بالهلاك بعد هلاكهم.
قلنا : معناه الدلالة على أنهم مستأهلون له وحقيقون به ، ونقيضه قول الشاعر :
|
إخوتي لا تبعدوا أبدا |
|
وبلى والله قد بعدوا |
أراد بالدعاء لهم بنفي الهلاك ، بعد هلاكهم ، الإعلام بأنهم لم يكونوا مستأهلين له ولا حقيقين به.
[٤٥٩] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ) [هود : ٨٤] نهى عن النقص فيهما ، والنهي عن النقص أمر بالإيفاء معنى ، فما فائدة قوله تعالى بعد ذلك (وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ) [هود : ٨٥]؟
__________________
[٤٥٨] البيت لفاطمة بنت الأحجم الخزاعية. وهو في الحماسة شرح المرزوقي ٢ / ٩١٢.
قلنا : صرح أولا بنهيهم عن النقص الذي كانوا يفعلونه لزيادة المبالغة في تقبيحه وتغييرهم إياه ، ثم صرح بالأمر بالإيفاء بالعدل الذي هو حسن عقلا لزيادة الترغيب فيه والحث عليه.
[٤٦٠] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [هود : ٨٥] والعثو الفساد ، فيصير المعنى : ولا تفسدوا في الأرض مفسدين؟
قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه في سورة البقرة. وجواب آخر معناه : ولا تعثوا في الأرض بالكفر ، وأنتم مفسدون بنقص المكيال والميزان.
[٤٦١] فإن قيل : كيف قال : (بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [هود : ٨٦] فشرط الإيمان في كون البقية خيرا لهم ، وهي خير لهم مطلقا ؛ لأن المراد ببقية الله ما يبقى لهم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن وذلك خير لهم وإن كانوا كفارا ؛ لأنهم يسلمون معه من عقاب البخس والتطفيف؟
قلنا : إنما شرط الإيمان في خيرية البقية ؛ لأن خيريتها وفائدتها مع الإيمان أظهر ، وهو حصول الثواب مع النجاة من العقاب ، ومع فقد الإيمان أخفى لانغماس صاحبها في عذاب الكفر الذي هو أشد العذاب.
الثاني : أن المراد إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم وأنصح.
[٤٦٢] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ) [هود : ٨٩] ولم يقل ببعيدين والقوم اسم لجماعة الرجال ، وما جاء فى القرآن الضمير العائد إليه إلا ضمير جماعة ، قال الله تعالى : (أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ) [نوح : ١] وقال تعالى : (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ) [الحجرات : ١١].
قلنا : فيه إضمار تقديره : وما هلاك قوم لوط أو مكان قوم لوط ، ومكان قوم لوط كان قريبا منهم ، وإهلاكهم أيضا كان قريبا من زمانهم.
الثاني : أن فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ، قال الجوهري : يقال ما أنتم منا ببعيد ، وقال الله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ) [التحريم : ٤] ، وقال : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ) [ق : ١٧].
[٤٦٣] فإن قيل : قولهم : (وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ) [هود : ٩١] كلام واقع فيه وفي رهطه وأنهم الأعزة عليهم دونه ، فكيف صح قوله : (أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ) [هود : ٩٢]؟
قلنا : تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله ، فحين عز رهطه عليهم دونه كان رهطه أعز عليهم من الله ، ألا ترى إلى قوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ)
[النساء : ٨٠] وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ) [الفتح : ١٠].
[٤٦٤] فإن قيل : قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته ، ثم أتبعه بذكر عاقبة العاملين منه ومنهم ، فكان المطابق والموافق في ظاهر الفهم أن يقول : من يأتيه عذاب يخزيه ؛ حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إليهم ، ومن هو صادق إليه.
قلنا : القياس ما ذكرت ، ولكنهم لما كانوا يدعونه كاذبا قال : ومن هو كاذب ، يعني في زعمكم ودعواكم تجهيلا لهم.
[٤٦٥] فإن قيل : كيف قال تعالى : (إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ) [هود : ١٠٢] والقرى لا تكون ظالمة ؛ لأن الظلم من صفات من يعقل أو من صفات الحيوان دون الجماد؟
قلنا : هو من الإسناد المجازي ، والمراد به أهلها ، كما قال تعالى ، في موضع آخر : (أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها) [النساء : ٧٥] ؛ لكن لما أمن اللبس أسند الظلم إلى القرية لفظا كما في قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : ٨٢].
[٤٦٦] فإن قيل : كيف التوفيق بين قوله تعالى : (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [هود : ١٠٥] وقوله : (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) [النحل : ١١١] وقوله : (هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) [المرسلات : ٣٥ ، ٣٦] فإن الآية الثالثة تناقض الآية الأولى بنفي الإذن ، وتناقض الآيتين جميعا بنفي النطق!
قلنا : أما التوفيق بين الآيتين الأوليين فظاهر ؛ لأن معناه تجادل عن نفسها بإذنه فتوافقت الآيتان ، وأما الآية الثالثة فإنها لا تناقض الآية الأولى بنفي الإذن ، إن قلنا إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات ؛ لأن الآية الأولى لا تقتضي وجود الإذن حينئذ ؛ بل تقتضي نفي الكلام عند انتفاء الإذن ، فأما إن قلنا إن الاستثناء من النفي إثبات ناقضت الآية الثالثة الأولى ، ولا تناقض الآيتين بنفي النطق ؛ لأن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف ومواطن ؛ ففي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم فيه ، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون ، وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم ، وهذا جواب عام عن مثل هذه الآيات ويرد على هذا أن يقال قوله تعالى : (هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ) [المرسلات : ٣٥] نفي النطق عنهم يوم القيامة ، فيقتضي انتفاءه في جميع أجزاء ذلك الزمان عملا بعموم النفي ، كما يعم النفي جميع أجزاء المكان في قولنا لا وجود لزيد في الدار ، فاندفع الجواب باختلاف المواقف والمواطن ، فيكون الجواب أن الآية الثالثة أريد بها طائفة خاصة غير الطائفتين الأوليين فلا تناقض.
[٤٦٧] فإن قيل : كيف قال تعالى : (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) [هود : ١٠٥] وكلمة من للتبعيض ، ومعلوم أن الناس كلهم إما شقي أو سعيد ، فما معنى التبعيض؟
قلنا : التبعيض هنا على حقيقته ؛ لأن أهل القيامة ثلاثة أقسام : قسم شقي وقسم سعيد وهم أهل النار والجنة كما ذكر في هذه الآية مفصلا ، وقسم لا شقي ولا سعيد وهم أهل الأعراف.
الثاني : أن معنى الكلام : فمنهم شقي ومنهم سعيد ، وهذا يقتضي أن يكون الشقي بعض الناس والسعيد بعض الناس ، والأمر كذلك ، ولا يقتضي أن يكون الشقي والسعيد كلاهما بعض الناس ؛ بل كل واحد منهما بعض ، وكلاهما كل كما تقول من الحيوان إنسان ، ومن الحيوان غير إنسان ، وكل الحيوان إما إنسان أو غير إنسان.
[٤٦٨] فإن قيل : كيف قال تعالى : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) [هود : ١٠٧] وأراد به بيان دوام الخلود ، مع أن أهل الجنة وأهل النار مخلدون فيهما خلودا لا نهاية له ، والسموات والأرض ودوامهما منقطع لأنهما يوم القيامة ينهدمان ، قال الله تعالى : (كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) [الفجر : ٢١] وقال تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) [الانفطار : ١] وقال تعالى : (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) [الأنبياء : ١٠٤] ونظائره كثيرة مما يدل على خراب السموات والأرض؟
قلنا : للعرب في معنى الأبد ألفاظ تعبر بها عن إرادة الدوام دون التأقيت منها ، هذا ، يقولون : لا أفعل كذا ما اختلف الليل والنهار ، وما دامت السماء والأرض ، وما أطمت الإبل ، ويريدون بذلك لا أفعله أبدا مع قطع النظر عن كون المؤقت به له نهاية أولا نهاية له.
الثاني : أنه خاطبهم على معتقدهم أن السموات والأرض لا تزول ولا تتغير.
الثالث : أنه أراد به كون الفريقين في قبورهم إما منعمين أو معذبين ، كما جاء في الحديث أن «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». ومن كان في روضة من رياض الجنة فهو في الجنة ، ومن كان في حفرة من حفر النار فهو في النار ، فعلى هذا يكون المراد بالتأقيت بدوام السموات والأرض مدة الخلود إلى يوم القيامة.
الرابع : أن المراد بها سماوات الآخرة وأرضها ، قال الله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) [إبراهيم : ٤٨] وتلك دائمة لا تزول ولا تفنى ، ولأنه لا بد لأهل الجنة مما يقلهم ويظلهم ، إما سماء يخلقها الله تعالى ، أو العرش ، كما جاء في الأخبار أن أهل الجنة تحت ظل العرش ، وكل ما أظلك فهو سماء ، وجاء في الأخبار أيضا في صفة الجنة أن ترابها من زعفران ، فدل أن لها أرضا ، والمراد تلك السموات وتلك الأرض.
[٤٦٩] فإن قيل : إذا كان المراد بهذا التأقيت دوام الخلود دواما لا آخر له ،
فكيف يصح الاستثناء في قوله تعالى : (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) [هود : ١٠٧]؟
قلنا : قال الفراء «إلا» هنا بمعنى غير وسوى ، فمعناه : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) [هود : ١٠٧] سوى ما شاء الله تعالى من الخلود والزيادة ؛ فكأنه قال : خالدين فيها قدر مدة الدنيا غير ما شاء الله من الزيادة عليها إلى غير نهاية ، وهذا الوجه إنما يصح إذا كان المراد سماوات الدنيا وأرضها. قال ابن قتيبة : ومثله في الكلام قولك : لأسكننك في هذه الدّار حولا إلا ما شئت ، يريد سوى ما شئت أن أزيدك على الحول.
الثاني : أنه استثناء لا يفعله كما تقول : لأهجرنك إلا أن أرى غير ذلك ، وعزمك على هجرانه أبدا وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ، إلا ما شاء ربك وقد شاء أن يخلدوا فيها.
قال الزجاج : وفائدة هذا الاستثناء إعلامنا أنه لو شاء أن لا يخلدهم لما خلدهم ، ولكنه ما شاء إلا خلودهم.
الثالث : أنه استثناء لزمان البعث والحشر والوقوف للعرض والحساب ، فإن الأشقياء والسعداء في ذلك الزمان كله ليسوا في النار ؛ ولا في الجنة.
الرابع : أن «ما» بمعنى من ، والمستثنى من يدخل النار من الموحدين فيعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ، وهذا الوجه يختص بالاستثناء من الأشقياء فقط.
الخامس : أن المستثنى زمان كون أهل الأعراف على الأعراف قبل دخولهم الجنة ، وهذا الوجه يختص بالاستثناء من السعداء ، لأنهم لم يدخلوا النار ؛ لأن مصيرهم إلى الخلود في الجنة.
السادس : أنه استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنة ، الأشقياء لا يخلدون في عذاب النار بل يعذبون بالزمهرير وغيره من أنواع العذاب سوى النار وهو سخط الله عليهم فإنه أشد ، وكذلك السعداء لهم سوى نعيم الجنة ما هو أجل منها ، وهو الزيادة التي وعدهم الله تعالى إياها بقوله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) [يونس : ٢٦] ورضوان الله كما قال تعالى : (وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) [التوبة : ٧٢] وقوله تعالى : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) [السجدة : ١٧] فهو المراد بالاستثناء ، ويعضد هذا الوجه قوله تعالى ، بعد ذكر الاستثناء : (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [هود : ١٠٧] وقوله تعالى بعد ذكر السعداء : (عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) [هود : ١٠٧] ، يعني أنه يفعل بأهل النار ما يريد من أنواع العذاب ، ويعطي أهل الجنة أنواع العطاء الذي لا انقطاع له ، فاختلاف المقطعين يؤكد صرف الاستثناء إلى ما ذكرنا ، فتأمل كيف يفسر القرآن بعضه بعضا.
[٤٧٠] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (غَيْرَ مَنْقُوصٍ) [هود : ١٠٩] بعد قوله :
(وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [هود : ١٠٩] والتوفية والإيفاء إعطاء الشيء وافيا ، أي تاما ، نقله الجوهري وغيره ، والتام لا يكون منقوصا؟
قلنا : هو من باب التأكيد.
[٤٧١] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) [هود : ١١٩] إشارة إلى ما ذا؟
قلنا : هو إشارة إلى ما عليه الفريقان من حالي الاختلاف والرحمة ، فمعناه أنه خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة ، وقد فسره ابن عباس ، رضي الله تعالى عنهما ، فقال : خلقهم فريقين : فريقا رحمهم فلم يختلفوا ، وفريقا لم يرحمهم فاختلفوا.
وقيل : هو إشارة إلى معنى الرحمة وهو الترحم ، وعلى هذا يكون الضمير في خلقهم للذين رحمهم فلم يختلفوا.
وقيل : هو إشارة إلى الاختلاف والضمير في خلقهم للمختلفين ، واللام على الوجه الأول والثالث لام العاقبة والصيرورة لا لام كي وهي التي تسمى لام الغرض والمقصود ؛ لأن الخلق للاختلاف في الدين لا يليق بالحكمة ، ونظير هذه اللّام قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) [القصص : ٨] وقول الشاعر :
|
لدوا للموت وابنوا للخراب |
|
فكلّكم يصير إلى التّراب |
وقيل : إنها لام التمكين والاقتدار كما في قوله تعالى : (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) [يونس : ٦٧] وقوله تعالى : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها) [النحل : ٨] والتمكن والاقتدار حاصل وإن لم يسكن بعض الناس في الليل ولم يركب بعض هذه الدواب ، ومعنى التمكين والاقتدار هنا أنه سبحانه وتعالى أقدرهم على قبول حكم الاختلاف ومكنهم منه.
وقيل : اللام هنا بمعنى على ، كما في قوله تعالى : (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) [الصافات : ١٠٣] وقوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً) [الإسراء : ١٠٧].
[٤٧٢] فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ) [هود : ١٢٠] وقوله تعالى : (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) [النساء : ١٦٤]؟
قلنا : معناه وكل نبأ نقصه عليك من أنباء الرسل هو ما نثبت به فؤادك فما في موضع رفع خبر لمبتدإ محذوف ، فلا يقتضي اللفظ قص أنباء جميع الأنبياء ، فلا تناقض بين الآيتين.
__________________
[٤٧١] البيت لأبي العتاهية من ديوانه ، وقد تقدم.
] [٤٧٢] البيت في ديوان لبيد.
ـ الحديث أخرجه أحمد في مسنده : ٢ / ٢٤٨.
الثاني : أن المراد بالكل هنا البعض ، كما في قوله تعالى : (ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) [البقرة : ٢٦٠] وقوله تعالى : (وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ) [يونس : ٢٢] وقوله تعالى : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) [النمل : ٢٣] وقوله تعالى : (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) [الإسراء : ١٣] وقول لبيد الشاعر :
|
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل |
|
وكلّ نعيم لا محالة زائل |
وكثير من الأشياء غير الله تعالى حقّ ، كالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان والجنة وغير ذلك ، وكذلك نعيم الجنة والآخرة ليس بزائل ، ولبيد صادق في هذا البيت لقوله صلىاللهعليهوسلم : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» :
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل
إلى آخره.
[٤٧٣] فإن قيل : ما فائدة تخصيص هذه السورة بقوله تعالى : (وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُ) [هود : ١٢٠] مع أنّ الحق جاء في كل سور القرآن؟
قلنا : قالوا فائدة تخصيص هذه السورة بذلك زيادة تشريفها وتفصيلها مع مشاركة غيرها إياها في ذلك كما في قوله تعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) [الجن : ١٨] وقوله تعالى : (وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) [البقرة : ٩٨] بعد قوله : (وَمَلائِكَتِهِ) [البقرة : ٩٨] وقوله تعالى : (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) [البقرة : ٢٣٨] بعد قوله : (الصَّلَواتِ) [البقرة : ٢٣٨] ووجه المشابهة بينهما أنه حمل قوله تعالى : (وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) [البقرة : ٩٨] على التشريف والتفضيل عند تعذر حمله على تعليق العداوة به لئلّا يلزم تحصيل الحاصل ، وكذا في المثال الأخير تعذر حمله على إيجاب المحافظة لما قلنا ، وهنا تعذر حمله على حقيقته وهو الجنس بأن حقيقته انحصار كل حقّ في هذه السورة وهو منتف ، أو حمل الحق على معهود سابق وهو منتف ، وحمله على بعض الحق يلزم منه وصف هذه السورة بوصف مشترك بينها وبين كل السور ، وأنه لا يحسن كما لو قال : وجاءك في هذه الحق آيات الله أو كلام الله أو كلام معجز ، فجعل مجازا عن التفضيل والتشريف.
وقيل : الإشارة بهذه إلى الدنيا لا إلى السورة ، والجمهور على القول الأول.
ولا يقال إنما خصت هذه السورة بذلك ؛ لأن فيها الأمر بالاستقامة بقوله تعالى : (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [هود : ١١٢] والاستقامة من أعلى المقامات عند العارفين ، لأنا نقول الأمر بالاستقامة جاء أيضا في سورة حمعسق قال الله تعالى (وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) [الشورى : ١٥] ولا يصلح هذا علة للتخصيص ، والله أعلم.
سورة يوسف عليهالسلام
[٤٧٤] فإن قيل : كيف قال : (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) [يوسف : ٤] ولم يقل ثلاثة عشر كوكبا وهو أوجز وأخصر ، والذي رآه كان أحد عشر كوكبا غير الشمس والقمر؟
قلنا : قصد عطفهما على الكواكب تخصيصا لهما بالذكر وتفضيلا لهما على سائر الكواكب لما لهما من المزية والرتبة على الكل ، ونظيره تأخير جبريل وميكائيل عن الملائكة عليهمالسلام ثم عطفهما عليهم ، إن قلنا إنهما غير مرادين بلفظ الملائكة ، وكذا قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) [البقرة : ٢٣٨] إن قلنا إنّها غير مرادة بلفظ الصلوات.
[٤٧٥] فإن قيل : ما فائدة تكرار رأيت؟
قلنا : قال الزمخشري : ليس ذلك تكرارا ؛ بل هو كلام مستأنف وضع جوابا لسؤال مقدر من يعقوب عليهالسلام ، كأنه قال له بعد قوله تعالى : (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) [يوسف : ٤] كيف رأيتها سائلا عن حال رؤيتها؟ فقال مجيبا له (رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) [يوسف : ٤] وقال الزّجاج : إنّما كرر الفعل تأكيدا لما طال الكلام كما في قوله تعالى : (وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ) [الروم : ٧] (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ) [الأعراف : ٤٥] وقال غيره ، إنما كرره تفخيما للرؤية وتعظيما لها.
[٤٧٦] فإن قيل : كيف أجريت مجرى العقلاء في قوله : (رَأَيْتُهُمْ) ، وفي قوله : (ساجِدِينَ) ، وأصله رأيتها ساجدة؟
قلنا : لما وصفها بما هو من صفات من يعقل وهو السجود أجرى عليها حكمه كأنها عاقلة ، وهذا شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه فيعطى حكما من أحكامه إظهارا لأثر الملابسة المقارنة ، ونظيره قوله تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا) [النمل : ١٨] وقوله تعالى ، في وصف السماء والأرض : (قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) [فصلت : ١١].
[٤٧٧] فإن قيل : كيف قال : (يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ) [يوسف : ١٢] وكانوا عاقلين بالغين وأنبياء أيضا في قول البعض ، وكيف رضي يعقوب عليهالسلام لهم بذلك؟
قلنا : على قراءة الياء لا إشكال ، لأن يوسف عليهالسلام كان يومئذ دون البلوغ فلا يحرم عليه اللعب ، وعلى قراءة النون نقول كان لعبهم المسابقة والمناضلة ليعودوا أنفسهم الشجاعة لقتال الأعداء لا للهو وذلك جائز بالشرع ، ويعضد هذا قولهم (إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ) [يوسف : ١٧] وإنما سمّوه لعبا لأنه في صورة اللّعب. ويرد على أصل السؤال أن يقال : كيف يتورعون عن اللعب وهم قد فعلوا ما هو أعظم حرمة من اللعب وأشد وهو إلقاء أخيهم في الجب على قصد القتل.
[٤٧٨] فإن قيل : كيف اعتذر إليهم يعقوب عليهالسلام بعذرين أحدهما : (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) [يوسف : ١٣] لأنه كان لا يصبر عنه ساعة واحدة ، والثاني : خوفه عليه من الذنب ، فأجابوه عن أحد العذرين دون الآخر؟
قلنا : حبه إياه وإيثاره له وعدم صبره على مفارقته هو الذي كان يغيظهم ويؤلمهم فأضربوا عنه صفحا ولم يجيبوا عنه.
[٤٧٩] فإن قيل : كيف قال : (وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ) [يوسف : ١٥] وهو يومئذ لم يكن بالغا ، والوحي إنما يكون بعد الأربعين؟
قلنا : المراد به وحي الإلهام لا وحي الرسالة الذي هو مخصوص بما بعد الأربعين ؛ ونظيره قوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ) [القصص : ٧] وقوله تعالى : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) [النحل : ٦٨].
[٤٨٠] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) [يوسف : ٢٢] ، وقال في حقّ موسى عليهالسلام : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) [القصص : ١٤].
قلنا : المراد ببلوغ الأشد دون الأربعين سنة على اختلاف مقداره ، والمراد بالاستواء بلوغ الأربعين أو الستين ، وكان إيتاء كل واحد منهما الحكم والعلم في ذلك الزمان فأخبر عنه كما وقع.
[٤٨١] فإن قيل : كيف وحد الباب في قوله (وَاسْتَبَقَا الْبابَ) [يوسف : ٢٥] بعد جمعه في قوله : (وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ) [يوسف : ٢٣].
قلنا : لأن إغلاق الباب للاحتياط لا يتم إلا بإغلاق جميع أبواب الدار ، سواء كانت كلها في جدار الدار أو لا ؛ وأما هربه منها إلى الباب فلا يكون إلا إلى باب واحد إن كانت كلها في جدار الدار ، ولأن خروجه في وقت هربه لا يتصور إلا من باب واحد منها ، وإن كان بعض الأبواب داخل بعض فإنه أول ما يقصد الباب الأدنى لقربه ، ولأن الخروج من الباب الأوسط والباب الأقصى موقوف على الخروج من الباب الأدنى فلذلك وحد الباب.
[٤٨٢] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها) [يوسف : ٢٦] ولم يكن قوله شهادة؟
قلنا : لما أدى معنى الشهادة في ثبوت قول يوسف عليهالسلام وبطلان قولها سمي شهادة ، فالمراد بقوله شهد : أعلم وبيّن وحكم.
[٤٨٣] فإن قيل : (قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ) [يوسف : ٢٨] يدل على أنها كاذبة وأنها هي التي تبعته وجذبت قميصه من خلفه فقدّته ، وأما قدّه من قبل فكيف يدل على أنها صادقة؟
قلنا : يدل من وجهين :
أحدهما : أنه إذا كان طالبها وهي تدفعه عن نفسها بيدها أو برجلها فإنها تقد قميصه من قبل بالدفع.
الثاني : أنه يسرع خلفها وهي هاربة منه فيعثر في مقادم قميصه فيشقه. ويرد على الوجه الثاني أنه مشترك الدلالة من جهة العثار الذي هو نتيجة الإسراع ؛ لأنه يحتمل أن يكون إسراعا في الهرب منها وهي خلفه فيعثر فينقد قميصه من قبل.
[٤٨٤] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ) [يوسف : ٣١] ، وإنما يقال خرجت إلى السوق وطرقت عليه الباب فخرج إلي؟
قلنا : إذا كان الخروج بقهر وغلبة أو بجمال وزينة أو بآية وأمر عظيم فإنما يعدّى بعلى ، ومنه قولهم خرج علينا في السفر قطّاع الطريق ، وقوله تعالى : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) [القصص : ٧٩] وقوله تعالى : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ) [مريم : ١١].
[٤٨٥] فإن قيل : كيف شبهن يوسف عليهالسلام بالملك فقلن : (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) [يوسف : ٣١] وهن ما رأين الملائكة قط؟
قلنا : إن كن ما رأين الملائكة فقد سمعن وصفها.
الثاني : أن الله تعالى قد ركز في الطباع حسن الملائكة كما ركز فيها قبح الشيطان ، ولذلك يشبه كل متناه في الحسن بالملك ، وكل متناه في القبح بالشيطان.
[٤٨٦] فإن قيل : كيف قال يوسف عليهالسلام : (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) [يوسف : ٣٧] وترك الشيء إنما يكون بعد ملابسته والكون فيه ، يقال ترك فلان شرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك إذا كان فيه ثم أقلع عنه ، ويوسف عليهالسلام لم يكن على ملة الكفار قط؟
قلنا : الترك نوعان : ترك بعد الملابسة ويسمى ترك انتقال ، وترك قبل الملابسة ويسمى ترك إعراض كقوله تعالى في قصة موسى عليهالسلام : (وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ) [الأعراف : ١٢٧] وموسى عليهالسلام ما لابس عبادة فرعون ولا عبادة آلهته في وقت
من الأوقات وما نحن فيه من النوع الثاني ، وسيأتي نظير هذا السؤال في سورة إبراهيم عليهالسلام في قوله تعالى : (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) [الأعراف : ٨٨].
[٤٨٧] فإن قيل : كيف قال تعالى : (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [يوسف : ٤٠] فسر الأمر بالنهي أو بما جزؤه النهي وهما ضدان؟
قلنا : فيه إضمار أمر آخر تقديره أمر أمرا اقتضى أن لا تعبدوا إلا إياه وهو قوله تعالى : (فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) [العنكبوت : ٥٦] فإنه باعتبار تقديم المفعول في معنى الحصر كما قال في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) [الفاتحة : ٥].
الثاني : أن فيه إضمار نهي تقديره : أمر ونهي ، ثم فسر الأمرين بقوله تعالى : (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [يوسف : ٤٠].
الثالث : أن قوله تعالى : (أَلَّا تَعْبُدُوا) [يوسف : ٤٠] وإن كان مضادا للأمر من حيث اللفظ فهو موافق له من حيث المعنى ، فلم قلتم إن تفسير الشيء بما يضاده صورة ، ويوافقه معنى غير جائز. وبيان موافقته معنى من وجهين :
أحدهما : أن النهي عن الشيء أمر بضده ، وعبادة الله ضد عبادة غير الله.
الثاني : أن معنى مجموع قوله تعالى : (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [يوسف : ٤٠] اعبدوه وحده فيكون تفسيرا للأمر المطلق بفرد من أفراده وأنه جائز.
[٤٨٨] فإن قيل : الأنبياء عليهمالسلام أعظم الناس زهدا في الدّنيا ورغبة في الآخرة ، فكيف قال يوسف ، عليهالسلام : (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ) [يوسف : ٥٥] ؛ طلب أن يكون معتمدا على الخزائن متوليا لها وهو من أكبر مناصب الدنيا؟
قلنا : إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط العدل ونحوه مما يبعث له الأنبياء ، ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك ، فطلب التولية ابتغاء لوجه الله تعالى وسعيا لمنافع العباد ومصالحهم لهم لا لحب الملك والدنيا ، ونظيره قوله تعالى : (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ) [الأعراف : ١٨٨] يعني لو كنت أعلم أي وقت يكون القحط لادّخرت لزمن القحط طعاما كثيرا ، لا للحرص ؛ لكن لأتمكن من إعانة الضعفاء والفقراء وقت الضرورة والمضايقة ، ويحتمل أن يكون علم تعينه بذلك العمل فكان طلبه واجبا عليه.
[٤٨٩] فإن قيل : كيف جاز ليوسف عليهالسلام ، أن يأمر المؤذّن أن يقول : (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) [يوسف : ٧٠] وذلك بهتان وتسريق بالصّواع لمن لم يسرقه ، وتكذيب للبريء واتهام من لم يسرق بأنه سرق؟
قلنا قوله : (إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) تورية عما جرى منهم مجرى السرقة ، وتصور بصورتها ، من فعلهم بيوسف ما فعلوه أولا.
الثاني : أن ذلك القول كان من المؤذن بغير أمر يوسف عليهالسلام ، كذا قاله بعض المفسرين.
الثالث : أن حكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية ، كقوله تعالى لأيوب عليهالسلام : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) [ص : ٤٤] وقول إبراهيم ، عليهالسلام ، في حق زوجته هي أختي لتسلم من يد الكافر ، وما أشبه ذلك.
[٤٩٠] فإن قيل : كيف تأسف يعقوب عليهالسلام على يوسف دون أخيه بقوله : (يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ) [يوسف : ٨٤] والرزء الأحدث أشد على النفس وأعظم أثرا؟
قلنا : إنما يكون أشد إذا تساوت المصيبتان في العظم ولم يتساويا هنا ، بل فقد يوسف كان أعظم عليه وأشد من فقد أخيه ، فإنما خصه بالذكر ليدل على أن الرزء فيه مع تقادم عهده ما زال غضا طريا.
[٤٩١] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ) [يوسف : ٨٤] والحزن لا يحدث بياض العين لا طبا ولا عرفا؟
قلنا : قال ابن عباس ، أي من البكاء ؛ لأن الحزن سبب البكاء ، فأطلق اسم السبب وأراد به المسبب. وكثرة البكاء قد تحدث بياضا في العين يغشى السواد ، وهكذا حدث ليعقوب عليهالسلام.
وقيل : إذا كثرت الدموع محقت سواد العين وقلبته إلى بياض كدر.
[٤٩٢] فإن قيل : كيف قال يعقوب عليهالسلام : (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) [يوسف : ٨٧] مع أن من المؤمنين من ييأس من روح الله ، أي من فرجه وتنفيسه أو من رحمته ، على اختلاف القولين ؛ إما لشدة مصيبته أو لكثرة ذنوبه ، كما جاء في الحديث في قصة الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروا رماده في البر والبحر ففعلوا به ذلك ، ثم إن الله غفر له كما جاء مشروحا في الحديث المشهور ، وهو من الصحاح ؛ مع أنه يئس من رحمة الله تعالى ، وضم إلى يأسه ذنبا آخر وهو اعتقاده أنه إذا أحرق وذري رماده لا يقدر الله على إحيائه وتعذيبه ، ومع هذا كله يغفر له ، فدلّ على أنه لم يمت كافرا؟
قلنا : إنما ييأس من روح الله الكافر لا المسلم عملا بظاهر الآية ، وكل مؤمن يتحقق منه اليأس من روح الله فهو كافر في الحال حتى يعود إلى الإسلام بعوده إلى رجاء روح الله ، وأما الرّجل المغفور له في الحديث فلا نسلم أنه لم يكفر ، ثم إن الله تعالى لما أحياه في الدنيا عاد إلى الإسلام بعوده إلى رجاء روح الله تعالى فلذلك غفر له ، وقد يكون قد عاد إلى رجاء روح الله تعالى قبل موتته الأولى ، ولم يتسع له الزمان