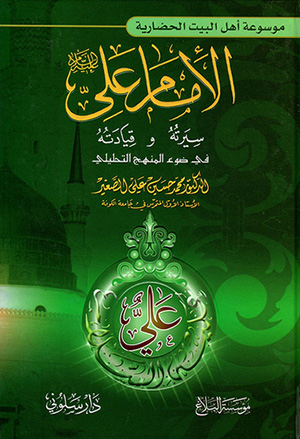الدكتور محمد حسين علي الصّغير
الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٠
ولك أن تسترسل في سيرة هذا الرجل وإستقامته ، وتنظر إلى تحرجه وتأثمه ، وتتوغل في تورعه وتشدده ، وتتردد إلى محاسبته لنفسه ومراقبته لها ، يستسهل الصعب ، ويتوخى العسر فيما فرض عليها ، وما استن لها من ضروب الترويض : « ولئن أبيت على حسك السعدان مسهداً ، أو أجرّ في الأغلال مصفداً ، أحب إلي من أن ألقى الله ، وأنا ظالم لبعض العباد ، أو غاصب لشيء من الحطام ».
ولا كبير أمر في ذلك تستغربه عند الإمام ، وإن استغربته عند سواه ، فليس للظالم في مسيرته ظل ، ولا للحيف في معجمه مفهوم ، وإنما هو منهج الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلاً أعلى وقدوة حسنة.
وقد كان أمير المؤمنين محتاطاً لنفسه ، ومحتاطاً لدينه ، ومحتاطاً للمسلمين ، أخذ نفسه بمعالي الأمور وابتعد عن صغائرها ، زهداً وتقشفاً وعبادة
« لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها ».
لم يجنح إلى الترف ، ولم يمل إلى اللين وخفض العيش ، اخشوشن في ذات الله ، وضحّى في سبيل الله ، ونصب نفسه علماً لدين الله ، ما وقف بين أمرين إلا اختار أصعبهما مراماً ، وأصلبهما شكيمة ، ما أراح نفسه قط ولا إستراح.
وكان محتاطاً لدينه ، فقد أدى الأمانة بأدق معاني هذه الكلمة وأضيقها ، لم يرزأ المسلمين شيئاً في مالهم ، ولا تناول من فيئهم إلا بقدر زهيد شأنه فيه شأن الآخرين لا أكثر ولا أقل ، فلم يصبُ إلى تزيد أو كفاية ، ولم يحاول توسعاً أو إضافة ، وكانت قبل خلافته يقوم على أرض بينبع ، يلتمس من عيشها الكفاف ، ويصرف ما فضل في فقراء بني
هاشم ، وينفق ما تبقّى في احتياجات إخوانه من المؤمنين ؛ حتى إذا نهض بالأمر كان واحداً من أدنى المسلمين ـ وهو أميرهم ـ له ما لهم من حقوق ، وعليه ما عليهم من واجبات ، تحقيقاً لمبدأ العدل السياسي المفقود ، وتنفيذاً لمبدأ العدل الأجتماعي المنشود.
واحتاط للمسلمين ، فلم يطلق أيدي عماله في الغنائم ، ولم يخولهم تخويلاً مطلقاً في الحكم ، وإنما أخذهم بكثير من الجدّ والحزم ، وشدد عليهم في الرقابة والحساب ، يستمع إلى شكوى الرعية ، ويقتص لهم من عماله ، ويتفقد الشؤون العامة بنفسه ، فكان الله بذلك رقيباً عليه ، وهو رقيب عليهم ، يثيب المحسن ، ويعاقب المسيء ، حتى إذا لمس من أحدهم خيانة أو جناية أخذه بها أخذ الناظر الحثيث كما رأيت فيما سبق.
وكان أمير المؤمنين إلى جنب ما تقدم ، رجلَ مجابهة وتحدٍ ، ورجلَ تمهل وأناة ، رجل مجابهة حين تتهيأ له الأسباب وتواتيه الظروف ، ورجل أناة حين يغدر به الحدثان ولا يصفو له الزمان. وهو بين هذين يضع الأمور في مواضعها ، لا يخرجه تحديه عن القصد ، ولا يسلمه تمهلّه إلى الضياع ، ينظر بعين الناقد البصير إلى الأحداث فيما حوله ، فيجيل فيها فكره ، ويتبعها بنظرته الثاقبة ، فلا يحيد عن المنهج الذي رسم لنفسه قيد أنمله قط ، مترصداً بذلك مرضاة الله تعالى في اليسر والعسر ، لم يقعده عن الحق تفرق الناس عنه ، ولم يوقعه في الباطل اجتماع الناس عليه ، يأنس بالوحدة لأنها تذهب به إلى التفكر في ذات الله ، ويرغب بالعزلة لأنها تذكره بما وراء الطبيعة. وقد يلم بالناس إلماماً للقيام بأمر الله « لا يزيدني اجتماع الناس حولي عزاً ، ولا تفرقهم عني وحشة ». ولم يكن منقطعاً إلى ذاته ، أو مغترباً في حياته ، وإنما كان
بين الناس في فرائضهم ومجالسهم وأسواقهم وحياتهم العامة ، يوجه هذا ويرشد ذاك ، ويستمع إلى هؤلاء ويعني بأولئك ، والوازع هو الوازع لا يتغير ولا يحيد ، الحياة لله في السر والعلن ، والنصح للمسلمين في الشدة والرخاء ، والعمل بالكتاب والسنة شاء الناس أم أبوا ، لا يخدعه خادع عن مسلكه هذا ، ولا يغتّر به مغتّر فيقترح غير هذا ، فقد عرف نفسه فعرف ربه.
وهذا الرجل في قيادته للأمة يعود بالسياسة إلى عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نقية خالصة ، لا تشوبها شائبة ، طريقها واضحة ، وأعلامها شارعة ، لا التواء فيها ولا اعوجاج ، ولا أمت ولا انحراف ، يسلك سبيله فيها سبيل القادة الأفذاذ ، فلا دجل ولا زيف ، ولا إيهام ولا إبهام ، ولا زيغ ولا غموض ، يجريها على سننها فشل فيها أم نجح ، فهي أداة للحق ومسرجة للهدى ، والحق والهدى يبصران ، ودونهما رقيب من الله ، وإيحاء من الضمير الحي المتيقظ ، فلا الضلال يقيم الهدى ، ولا الباطل يحيف الحق ، وإنما هو القصد والاعتدال يصاحبهما الصدق والوضوح ، فلا لبس ولا شبهة وإن حققا نفعاً موقوتاً لأن النفع الموقوت زائل ، وتبقى صحائف الأعمال قائمة.
ليس لدى الإمام في هذا المذهب تفكير السياسيين التقليديين القائم على أساس التسوية والغاية ، فهذان أمران مرفوضان تأباهما له صرامته في الحق ، وعدالته في المسعى ، الحق وإن جحد والمسعى وإن أخفق. ولماذا هذا ، وكل هذا ، الإمام يفلسف ذلك : « قد يجد الحُوَّل القُلَّب وجه الحيلة ، ودونها حاجز من تقوى الله ، فينتهزها من لا حريجة له في الدين ».
ولا أعلم أحداً في العرب سبقه إلى استعمال مادة « الانتهازية »
بمعناها الدقيق كما استعملها في هذا النص. ومن هنا نجد قوله فيصلاً في الحكم رداً على المتنطعين :
« والله ما معاوية بأدهى مني ، ولكنه يغدر ويفجر ، وكل فجرة غدرة ، وكل غدرة كفرة ، وكل كفرة في النار ».
الدهاء في منطق الإمام هو الحكمة التي لا تستطال بفسق وفجور ، فالفاجر غادر ، والغادر كافر ، والكافر في النار.
ولا يستقيم لأول القوم إسلاماً ، وأقدمهم إيماناً أن يسلك هذا النهج ؛ كيف وقد تربى في حجور الإيمان ، وترعرع في ظلال الوحي ، وألهم معالم القرآن.
السياسة الواضحة عند الإمام ، كتب لها النجاح إيمانياً ، وكتب لها الخلود تأريخياً ، ففي سيرة هذا الرجل من الأمثال ما لم يتهيأ لأحد من الناس ، وقد يقال بأنها أخفقت ، وقد يصح هذا القول عكسياً ، لأن أمير المؤمنين كان يريد أن يعود بالناس إلى عهد رسول الله ، وكان عهده قد استطال عليه الزمان ، ومرت بالناس ظروف وأحداث وأزمات التمسوا فيها الرفاهية واللامبالاة ، فمن العسير انقيادهم لهذا الرجل العائد بهم إلى عهود الدين ، وقد حثت الأحداث بهم السير نحو شؤون الدنيا ، فهم عن الدين أبعد ، وهم إلى الدنيا أقرب ، وإذا كان الأمر كذلك ، فهم الذين أخفقوا في الانقياد لسياسة الإمام ، ولم تخفق سياسة الإمام لعدم انقيادها إليهم.
نموذجان بسيطان أضعهما بين يدي الباحث الموضوعي نموذج خاص ، ونموذج عام ، على سلامة هذين النموذجين وبراءتهما ، تجد أن سياسة الإمام الخاصة بذاته وبأمته سياسة أنبياء وأوصياء ، لا سياسة أشدّاء وأدعياء.
كان عدل الإمام واسماحه وتواضعه وإسجاحه شاملاً متسعاً لا يضيق بذلك صدره ، فقد دعا إليه غلامه مرة فلم يجبه ، ودعاه ثانياً فلم يجبه ، وناداه ثالثاً فلم يجبه ، فقام الإمام عليهالسلام فرآه مضطجعاً ، فقال : ألم تسمع يا غلام؟ فقال : نعم ، قال عليهالسلام : فما حملك على ترك جوابي؟ قال : آمنت عقوبتك فتكاسلت ، فقال عليهالسلام أمض فأنت حر لوجه الله تعالى.
السياسي التقليدي قد يقتل هذا الغلام ، وقد يأدبه أو يسجنه أو يعزله من الخدمة ، أما الإمام فقد حرره لوجه الله تعالى.
وهذا نموذج خاص في السياسة ، ونموذج عام بسيط مثله :
دخل على أمير المؤمنين اثنان من أصحابه ، ولعلهما طلحة والزبير قبل نكث البيعة ، والإمام في بيت المال ، وبدءا يحاورانه في شيء من شؤونهما ، فيطفىء الإمام السراج ، ويخرج بهما بعيداً عن بيت المال وإلى داره ، لأن زيت السراج يتقد من أجل مصلحة أو منفعة لبيت مال المسلمين ليس غير. وهما في مسألة قد تكون خاصة فيهما ، فليذهب عليٌّ بهما إلى خارج هذا المقر الرسمي ، وليكن لهما ما شاءا ، أما أن ينفق وقته معهما على حساب هذا الزيت ـ وإن كان ضئيلاً ـ فليس إلى ذلك سبيل.
ووجد القادمان أن لا حياة لهما مع الإمام في هذه السياسة.
وكان رحيماً بالمسلمين رؤوفاً بهم ، عطوفاً عليهم ، يبسم لهذا ويهش لذاك ، يواسي أهل العوز والفقر والفاقة ، ويجالس المضنى والمتعب والمستفيد ، ليس بينه وبين الرعية حجاب ، قائماً بشؤونهم : في الصلاة إماماً ، وعلى المنبر خطيباً ، وفي الحروب متقدماً ، ولدى
الأسواق آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر ، حاملاً درتّه حيناً ، ومخصرته حيناً آخر ، تالياً لقوله تعالى : ( وَيلٌُ لِلمُطَفِّفِينَ ) في عدّة آيات.
وكان عنيفاً مع رحمته ، وشديداً مع رقته ، لا يعطل لديه حدّ ، ولا يتهاون في فرض ، ولا يتجافى عن سنة ، وهو إلى ذلك يدبر أمور هذه الدولة المترامية الأطراف ، ويتابع شأن هذه النفوس المتشتة الأهواء ، يخوض المشكلات خوضاً مباشراً ، يرتق هذا الفتق ، ويصلح ذاك الخرق ، وهو يجاري من أصحابه من لا يجارى ولا يدارى إلا بعسر ومرارة ، وهو يتجرع الغصص ويسيغ الشجا ، عالماً بأنها أيام سينقضي بؤسها وشرها ، ويبقى خيرها وأجرها ، فعنده « الدهر يومان : يوم لك ويوم عليك ، فإذا كان لك فلا تبطر ، وإن كان عليك فاصبر ، فكلاهما سينحسر ».
وهؤلاء المعارضون من ناكثين وقاسطين وخوارج ، والمتمردون من انتهازيين ونفعيين وأصحاب مطامع ، تجمعوا عليه من كل صوب وحدب لا لأمر نفسوا به عليه ، ولا لموجدة أُحتقبت بحقهم ، ولكنها الأهواء المتناثرة ، والأحقاد المتأصلة ، والأهواء لا سيطرة عليها ، والأحقاد لا سبيل لاقتلاعها ، ولكنه يعاملها جميعاً بأناة الحكيم ، ويترصدها بعقلية القائد المتلبث ريثما تنجلي الغبرة ، ينفس عنها شيئاً فشيئاً ، ولكنها بمجموعها المتزاحم ، وبزخمها المتراكم تبقى في النفس ألماً ، وفي القلب جراحاً ، وما أكثر آلام الإمام ، وما أبلغ جراحه.
وهذا السواد الأعظم ، في تناقض نزعاته ، وعجيب أولاعه ورغباته ، وكثرة خروجه ونزعاته ، مناخ غوغائي مستفيض ، لا بد من مداراته حيناً ، وضبطه حيناً آخر ، وتوجيهه بعض الأحيان ، وهم همج
رعاع يتبعون كل ناعق ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
هؤلاء السواد الذين تحركت في نفوسهم النخوة ، وعادت إليهم الجاهلية ، فالثأر من جهة ، والأحقاد من جهة أخرى ، وتضييع النظام الإسلامي والشرع الجديد بين عشية وضحاها كل أولئك عقبات في طريق المسيرة ، ولكنه يذللها بحكمته ، ويتداركها بعظيم حنكته وسياسته ، فهو إذن في جهد دائم مضني ، وعمل دؤوب مستمر ، والحبل على الغارب ، فالمشاكل آخذة بالازدياد ، والمستجدات بغير حساب.
وإن تعجب ، ولا ينتهي العجب في سيرة هذا الرجل العملاق ، إدعاؤهم « الدعابة » فيه ، إذ لم يجدوا عليه مطعناً ، ولم يصلوا إلى مغمز ، فأخذوا عليه يسره وإسماحه ، واستوحشوا نبله وأخلاقه ، فقد كان رقيق الحاشية ، ليّن الجانب ، طيّب المعاشرة ، دون غلظة أو جفاف أو قسوة ـ شأن الأولياء الصالحين ـ يهش لهذا أو يبسم لذلك ، مع شدة هيبته ، وجلالة وقاره وسمته ، فقال عمرو بن العاص أن في علي دعابة « لقد زعم ابن النابغة أن فيّ دعابة ، وأنني رجل تلعابة ».
وما كان عليّ عليهالسلام هازلاً يوماً ، ولا لاعباً أو عابثاً حيناً ما ، فجدّه وحزمه يأبيان هذا الإتهام الفضفاض الذي لم ينخدع به أهل البصائر ، فما وجد أذناً صاغية حتى عند سواد الناس ، ولكنه كان خاشعاً متواضعاً مع خشية الله لا جبروت في نفسه ، ولا طاغوت في حكمه حتى قال من وصفه « كان بيننا كأحدنا ، وكنا لا نكلمه هيبة له ». وقد صدق ضرار ( ضمرة ) بن أبي ضمرة حينما وصفه لمعاوية :
« كان والله شديد القوى ، بعيد المدى ، ينطق فصلاً ويحكم عدلاً ». وشدة قواه ، وبعد مداه ، لم يسمحا له بدعابة ، ونطقه الفصل ،
وحكمه العدل ، لم تتهيأ بهما له الفكاهة ، ولكنها الاعتداءات التي لا تستند إلى المنطق ، فتسحق الضمير والنزاهة والعفاف. وأنى تستقيم هذه الدعوى ، ولا بينة عليها ولا شواهد في قول ولا عمل ، وهو القائل في نصيحته لولده الإمام الحسن :
« وإياك أن تذكر في الكلام ما كان مضحكاً ، وإن حكيت ذلك عن غيرك ».
وليتهم وصفوة في جديته وصرامته وخشونته لوجدوا إلى ذلك سبيلاً ، ولكنهم ألصقوا به ما هو بعيد عنه بعد السماء عن الأرض ، اللهم إلا صفاء المؤمن ، وسلامة الورع التقي ، ومرونة العارف بعواقب الأمور ، فلا تبطره الدولة ، ولا تطغيه السلطة ، وإنما هو رجل من الناس لا يتعالى ولا يتطاول ، قد خفض جناحه للمسلمين ، وألان أكتافه لعامة الناس في دعة وتواضع ، في رقة من لهجة ، وبسمة من ثغر ، وطلاقة من محيا.
وهذا كله شيء ، والدعابة المدعاة شيء آخر.
وظاهرة أخرى ؛ فمتى بسم الدهر لعلي عليهالسلام حتى يستخّفه الأنس مع الحاضرين ، ومتى سالمه حتى يجد السبيل إلى البطالة والفراغ ، ومتى سايره حتى يساير هذا النمط من العاطلين ؛ وإنما هي المحن والفتن التي واجهها بالصبر والجلد والثبات ، مشمّراً عن ساعد الجهاد ، وداعياً إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة شأنه في ذلك شأن الشهداء والصالحين والصديقين ، وحسن أولئك رفيقاً.
(١٢)
المهمات القيادية السياسية والتعليمات
العسكرية لأمير المؤمنين
وكان عليٌّ عليهالسلام في تدبيره سياسة الدولة ، لا يكافح العصبية القبلية وحدها ، ولا يسوي القضية المالية فحسب ، ولا يعالج النفوس المتشتتة ليس غير ، وإنما أراد أن يعود بالإسلام إلى ينابيعه الأولى في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد ابتعد الناس عن هذا العهد طيلة ثلاثين عاماً ، ومهمة العودة بالمسلمين إلى الإسلام الصحيح مهمة شاقة ، فقد اعتاد الناس حياة البذخ والترف ، وقد بدأت الدنيا تقترب منهم أو يقتربون منها ، بدأ حب الجاه والسلطان يشق طريقه إلى قلوب القوم ، وبدأ حب المال يسيطر على التفكير ، وبدأت الطباع جافة غليظة متغطرسة ، واستبد بالمسلمين الميل إلى الدعة ، والرضا بالهوان ، وكان لا بد للإمام أن يصلح هذا كله ، وأن يتدارك هذا كله ، وقد بدأ الإصلاح والتدارك بسيرته الذاتية ، فكان أحد المسلمين وإن كان أميرهم ، فلم يستأثر بفيء ، ولم يمل إلى رفاهية ، ولم يتكلف سعة ، بلف ضيّق على نفسه وأهله وولده كل التضييق ، ليتأسى به الفقير ولا يزري به فقره ، وكان حريضاً أن يشيع العدل بين الرعية فساوى بالعطاء ، ولم يجامل أحداً بالحباء ، وهو بين هذا وذاك يتفقد أهل الحاجة ، ويطعم الجائعين بنفسه ، ويتعهد ذوي العوز تعهداً حثيثاً ، وقد صدّق بهذا عمله قوله :
« أأقنع من نفسي ، بأن يقال : هذا أمير المؤمنين ، ولا أكون لهم أسوة بجشوبة العيش ومكاره الدهر ».
وكان يخلو إلى نفسه آناء الليل وأطراف النهار متهجداً مصلياً مناجياً ربه ، فما إن يؤدي ما عليه للمسلمين ، حتى يتفرغ للعبادة تفرغاً تاماً ، وهو يقول : « إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنتك ، ولكن رأيتك أهلاً للعبادة فعبدتك ».
وهكذا تكون عبادة الأحرار ، قوة قلب وبصيرة نافذة. فإذا لاحت زبارج الدنيا خاطبها : إليك عني يا دنيا غري غيري فحبلك قصير ».
وكانت هذه الشخصية الزاهدة يقظة متحركة صامدة تجمع إلى الزهد القوة والإدارة فكان تدبير الجيوش ، وإدارة شؤون الأقاليم ، وإلزام الأمراء والعمال والولاة بجوهر تعليماته الخالدة ، من أشتات مهمات الإمام التي جمعها الله له سيرة وقيادة ، فأعذر في التبليغ ، وأحسن صروف الآراء ، وبذلك جعل دولته نموذجاً فذاً للحكم الإسلامي الخالص الذي إتسم بالقوة والإسماح بوقت واحد ، ونأى عن الطغيان والجبروت والأثرة ، فقد التزم الإمام عليهالسلام معايير التدبير المنظّم ، وأنس معالم التنظير الدقيق ، كل ذلك يجيء بعد فوضى في الحكم ، وعنتٍ من السلطان ، وتباين في الأهواء والآراء ، وطبيعي أن إمساك الأمر بروية وأناة في مثل هذه الظروف ينبعث عن حكمه متناهية.
فمن وصية له عليهالسلام لعسكره بصفين قبل لقاء أهل الشام ينهى فيها عن البغي ، ويمنع من قتل المدبر ، والإجهاز على الجريح ، ويأمر فيها بالتريث في الحرب وعدم الابتداء بها ، ويلزم جنده بالتغاضي عن تهييج النساء ، وإن سببن الأمراء أو شتمن الأعراض ، مما يعد منهجاً حربياً متميزاً ، قال :
« لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم ، فإنكم بحمد الله على حجة ، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم عليهم ، فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً ، ولا تصيبوا معوراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تهيجوا النساء بأذى ، وإن شتمن أعراضكم ، وسببن أمراءكم ، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول ؛ إنا كّنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات ، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة ، فيعيّر بها وعقبه من بعده ».
وهذه السنن الحربية التي خطط لها الإمام تنطلق من مبدأ الدفاع عن النفس ، ولا تنجرّ إلى إرادة شهوة الحرب ، وتنبعث من صميم تعاليم الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم في العفو والتغاضي ، وتنسجم وطبيعة النظام الإسلامي في التوصل إلى معالي الأمور ، والابتعاد عن توافه الأغراض.
ولك في هذا المجال أن تنظر في وصيته لأحد قواد جيشه وهو معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له :
« اتقِ الله الذي لا بد لك من لقائه ، ولا منتهى لك دونه ، ولا تقاتلن إلا من قاتلك ، وسرّ البردين ، وغور بالناس ، ورفّه في السير ، ولا تسر أول الليل فإن الله جعله سكناً ، وقدره مقاماً لا ظعناً ، فأرح فيه بدنك ، وروّح ظهرك ، فإذا وقفت حين ينبطح السحر ، أو حين ينفجر الفجر ، فسر على بركة الله. فإذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطاً ، ولا تدنُ من القوم دنوَ من يريد أن ينشب الحرب ، ولا تباعد عنهم تباعد من يهاب الناس ، حتى يأتيك أمري. ولا يحملنكم شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم ».
وهذه الوصية النادرة جامعة لشؤون تدبير الجيش المقاتل في مراقبة الله وتقواه ، وفي مسيرة وحركته وتوقفه عند مقامه ولدى ظعنه ، وفي اتخاذ الموقع المناسب دون الاقتراب الذي يؤدي إلى الحرب ، ودون التباعد الذي ينم عن الخور والضعف ، وأن تتحكم الضمائر دون الأحقاد ، فلا يدعو الشنآن إلى القتال قبل الدعوة إلى السلم ، والإعذار في الدعاء.
هذه التعليمات لم تتجاوزها التعليمات الحربية العادلة القائمة على أسس الدراسات العسكرية المتطورة في الحروب العالمية العامة.
والإمام لا يقف عند هذا الحد من التوجيه الناهض ، بل يتعداه إلى الإنضباط العسكري الدقيق في تقويم أمراء الجيوش ، واختيار الأصلح من قواد الحرب ، وإناطة القيادة العامة بالأكفاء من ذوي الخبرة والدراية بشؤون الحرب ، فهو يضع الأمور في نصابها ، ويعطي كل ذي حق حقه ، آخذاً بالحزم ، وصادعاً بالحقائق دون محاباة لأحد. فمن كتاب له عليهالسلام إلى أميرين من أمراء الجيش ، وقد أمرّ عليهما مالكاً الأشتر ، قال : « وقد أمرّت عليكما وعلى من في حيّزكما مالك بن الحارث الأشتر ، فأسمعا له وأطيعا ، واجعلاه درعاً ومجناً ، فإنه ممن لا يخاف وهنه ولا سقطته ، ولا بطؤه عما الإسراع إليه أحزم ، ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل ».
ويتجاوز الإمام عليهالسلام هذه الحدود إلى اختيار الموقع العسكري الأمثل ، والتدبير الحربي الأسلم ، والزمان القتالي الأولى ، فيرسم بذلك الخطط السليمة ، ويهيىء الفرص المتكافئة ، ويوجه نحو الإعتصام والمنعة ، ويحذر من الأنقسام والفرقة. فمن وصية له عليهالسلام وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو ، قال :
« فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم ، فليكن معسكركم في قُبُل الاشراف ، أو سفاح الجبال ، أو أثناء الأنهار ، كيما يكون بكم ردءاً ، ودونكم مردّاً ، ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين ، وأجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ، ومناكب الهضاب ، لئلا يأتيكم العدو من مكان مخافةٍ أو أمن. واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم ، وعيون المقدمة طلائعهم ، وإياكم والتفرق ، فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً ، وإذا ارتحلتم إرتحلتم جميعاً ، وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة ، ولا تذوقوا النوم إلا غِراراً ، أو مضمضمة ».
فإذا قامت الحرب على ساق ، والتقت حلقتا البطان ، وجدت علياً على رأس الجيش ، وذو الفقار بيده ، وهو يقول : « اللهم إليك أفضت القلوب ، ومدّت الأعناق ، وشخصت الأبصار ، ونقلت الأقدام ، وأنضيت الأبدان.
« اللهم قد صرح مكنون الشنّان ، وجاشت مراجل الأضغان ، اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا ، وكثرة عدونا ، وتشتت أهوائنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ».
وهذا المجال متسع في إدارة الإمام العسكرية ، وما أوردناه كان على سبيل المثال والتنظير ، ليقاس عليه ما سواه :
وإذ انتهى علي عليهالسلام من هذا بقي عليه تدبير شؤون الأقاليم في اصطناع الولاة ، وإدارة اقتصاد البلاد في الصدقات والخراج ، وإقامة سنن العدل في المواساة والمساواة. وكان الإمام حريصاً على هذه القيم كل الحرص وأشدّه.
فمن كتاب توجيهي لبعض عماله يدعوه فيه إلى الرفق فيما الرفق
به أجدر ، وإلى الحزم فيما الحزم به أنفع ، وإلى لين الجانب ، وخفض الجناح ، وبسط الوجه ، والمساواة بين الرعية حتى في النظرة واللحظة والإشارة والتحية ، لئلا يطمع قوي في حيفه ، ولا ييأس ضعيف من عدله ؛ ولا ينسى الإمام أن يمتدح العامل بما فيه من إقامته للدين ، وقمع الأثيم ، وسداد الثغر ، قال عليهالسلام :
« أما بعد فإنك ممن استظهر به على إقامة الدين ، وأقمع به نخوة الأثيم ، وأسدّ به لهاة الثغر المخوف.
فاستعن بالله على ما أهمك ، واخلط الشدة بضغث من اللين ، وارفق ما كان الرفق أرفق ، واعتزم بالشدة حين لا تغني عنك إلا الشدة.
واخفض للرعية جناحك ، وابسط لهم وجهك ، وألن لهم ، جانبك ، وآسي بينهم في اللحظة ، والنظرة ، والإشارة ، والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ، ولا ييئس الضعفاء من عدلك والسلام ».
وهكذا كان الإمام عليهالسلام يراقب عماله ، وينكر عليهم التقصير ، يعنّفهم حيث يجد العنف بهم أجدر ، ويحرضهم حيث يجد التحريض أجدى ، فمن كتاب له إلى كميل بن زياد النخعي عامله على هيت ، وقد اجتاز به العدو مغيراً ، أبان فيه ميزان الحزم والكفاية للوالي ، في حفض ما فيه يديه ، والسيطرة على مصره ، وعدم تكلف ما كفي ، واليقظة والحذر من الأعداء ، والحرص على هيبة السلطان ، وكسر شوكة العدو ، قال عليهالسلام :
« أما بعد : فإن تضييع المرء ما وُلّي ، وتكلفه ما كفي ، لعجز حاضر ، ورأي متبر ، وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا ، وتعطيلك مسالحك التي وليناك ـ ليس لها من يمنعها ولا يردّ الجيش عنها ـ لرأي
شعاع ، فقد صرت جسراً لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك ، غير شديد المنكب ، ولا مهيب الجانب ، ولا سادٍ ثغرة ، ولا كاسر لعدو شوكة ، ولا مغن عن أهل مصره ، ولا مجز عن أميره ».
ومن كتاب له عليهالسلام إلى قثم بن العباس عامله على مكة ، يوصيه بالحزم واليقظة ، ويلزمه بالقصد والإعتدال ، بعد أن أعلمه عينه بالمغرب أن معاوية وجه إلى الموسم طائفة من المخربين ، قال : « فأقم على ما في يديك قيام الطبيب الحازم ، والناصح اللبيب ، التابع لسلطانه ، المطيع لإمامه ، وإياك وما يعتذر منه ، ولا تكن عند النعماء بطراً ، ولا عند البأساء فشلاً. والسلام ».
وقد بلغته عن بعض عماله بعض الهنات في احتجان المال ، وتجريد الأرض ، وخيانة الأمانة ، فكتب إليه محذّراً ومنذّراً ومحاسباً :
« أما بعد : فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك ، وعصيت إمامك ، وأخزيت أمانتك ، بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك ، وأكلت ما تحت يديك ، فأرفع إليّ حسابك ، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام ».
وكان الإمام عليهالسلام حريصاً على توجيه عماله الوجه الذي يريده الله ، رأفة بالرعية ، ورعاية لسنن العدل ، فطالما كان يوصي عماله على الصدقات بوصايا جليلة منها :
« انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعّن مسلماً ، ولا تجتازن عليه كارهاً ، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله ، فإذا قدمتَ على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار ، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ... ».
والإمام عليهالسلام يوضح لعامل الصدقة في الصدقات حق الله وحق الناس وحقه ، فلا يتجاوز ذلك مستهيناً بالأمانة ، أو راتعاً في الخيانة ، فمن ذلك قوله عليهالسلام :
« وإن لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً ، وحقاً معلوماً ، وشركاء أهل مسكنة ، وضعفاء ذوي فاقة ، وإنّا موفوك حقك ، فوفهم حقوقهم ، وإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة ، وبؤسي لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل. ومن استهان بالأمانة ، ورتع في الخيانة ، ولم ينزه نفسه ودينه عنها ، فقد أحلّ بنفسه الذلّ والخزي في الدنيا ، وهو في الآخرة أذلّ وأخزى وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة ، وأفظع الغش غش الأئمة ».
ولم يكن الإمام عليهالسلام متهاوناً في فروض الدين ، ولا متسامحاً في سنن العبادة ، بل كان حدباً على إقامتها ، مشفقاً من إضاعتها ، يوصي بذلك أمراء البلاد ، وقادة البعوث ، وولاة الأمور. فمن كتاب له في معنى الصلاة إليهم يقول :
« أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس مثل مريض العنز ، وصلوا بهم العصر والشمس بضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان ، وصلوّا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى ، وصلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل ، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتانين ».
ولم يكن الإمام ليحتجن الرأي لنفسه ، أو يحتجز السر لذاته ، بل يشارك قيادته بذلك ، ويشاور مستشاريه به ، ويعرضه على ذوي الرأي
السديد ، وطالما نجده يعرض على أمراء الجيوش ما فيه تقويم الجيش ، ومن ذلك قوله :
« ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سراً إلا في حرب ، ولا أطوي دونكم أمراً إلا في حكم ، ولا أدخر لكم حقاً عن محله ، ولا أقف به دون مقطعه ، وأن تكونوا عندي في الحق سواء ، فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ، ولي عليكم الطاعة ، وألا تنكصوا عن دعوة ، ولا تفرطوا في صلاح ، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق ، فإن لم تستقيموا على ذلك ، ولم يكن أحد أهون عليّ ممن إعوجّ منكم ، ثم أعظم له العقوبة ، ولا يجد عندي فيها رخصة ».
ويبدو جلياً مما تقدم مدى إحكام الإمام لأمره ، مع عماله وولاته توجيهاً وأمراً واستصلاحاً ، لا يدع فرصة إلا ويبين بها مقطع الحق ، ومشرع العدل في ضوء ما أستنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولعل عهد الإمام إلى مالك الأشتر لما ولآه على مصر حين اضطرب الأمر على أميرها محمد بن أبي بكر يعد أطول عهد كتبه ، وأوفاه إدارياً وسياسياً ، وأجمعه للمحاسن.
وهذا العهد من مفاخر التراث الإسلامي في مصادره ، ومن عيون التراث الإنساني في مقاطعه ، وهو صفحة من صحائف الإمام الخالدة في إدارة الحكم ، وشؤون السياسة ، وحقوق الراعي على الرعية ، وواجبات الرعية تجاه الراعي ، وبيان السنن ، وإحكام الفرائض ، وإعمار البلاد ، واستصلاح الناس ، وجهاد الأعداء ، واختيار الأكفاء ، وإشاعة العدل ، وحفظ النظام ، واستئصال شأفة الضلال.
فقد ولاه الإمام مصر رئيساً لها ، وأناط به وزارة المالية : « جباية
خراجها ». ووزارة الدفاع « جهاد عدوها ». ووزارة الداخلية « استصلاح أهلها » ووزارة الزراعة والإعمار : « عمارة بلادها » في حين لم تكن هذه المصطلحات معروفة ، ولا هذا الاستيعاب مشاعاً.
ولدى إلقاء الضوء على هذا العهد تجد الإمام فيه : قد أمر بتقوى الله ، وأن يكسر الوالي من نفسه عند الشهوات ،
و« إشعار قلبه الرحمة للرعية ، والمحبة لهم ، واللطف بهم ».
فلا يندم على عفو ، ولا يتبجح بعقوبة ، وأمره بأن ينصف الله والناس من نفسه ومن خاصة أهله ، وليكن أحب الأمور إليه أوسطها في الحق ، وأعمها في العدل ، وأمره بإبعاد من يطلب معايب الناس ، وأن لا يدخل في شؤونه بخيلاً ولا جباناً ولا حريصاً وعلل ذلك بأنها غرائز يجمعها سوء الظن بالله. وأمره بإبعاد وزراء السوء فإنهم أعوان الأئمة ، وإخوان الظلمة. واستخلاص خيرة الوزراء والحاشية ممن لا أصر له ولا وزر. وأمره بجعل خاصته أهل الورع والصدق ، ولا يكونن المحسن والمسيء بمنزلة سواء لديه ، ووجهه بالإحسان إلى الرعية وتخفيف المؤن عنهم ، وتعدي ذلك أن ألزمه بعلية القوم علماً وحكمة « وأكثر مدارسة العلماء ، ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ، وإقامة ما استقام به الناس قبلك ».
وما أوضحه الإمام فيما سبق دستور متكامل لكل رئيس دولة ، وحاكم أمة بالعدل ، في جعل الله نصب عينه سراً وعلناً ، واختيار وزراءه وقواده وأمراءه في ضوء ما القى الإمام من ملكات ، واصطفاء الديوان والحاشية والمرافقين ممن لا وزر فيه ، ولا سوابق مشينة لديه ، وأن يكون ذوو التخصص الدقيق هم أصحاب الرأي في شؤون البلاد.
وبحث الإمام في هذا العهد أمر طبقات الرعية ، وأصناف الناس ، وذوي المهن وأرباب الحرف والصناعات ، وأوصاه بكل صنف وطبقة بما يناسب ذلك ، وجمع هذه الأصناف بقوله عليهالسلام :
« واعلم أن الرعية أصناف ، ولا يصلح بعضها إلا ببعض ، ولا غنى لبعضها عن بعض ، فمنها جنود الله ، ومنها كتاب الخاصة والعامة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمال الإنصاف والرفق ، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ، ومنها التجار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجات والمسكنة ، وكل قد سمى الله له سهمه ، ووضع على حده وفريضته في كتابه أو سنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عهداً منه عندنا محفوظاً ».
ثم بدأ الإمام يفصل القول في حقوق هؤلاء جميعاً وواجباتهم مما لهم وعليهم ، فيما لم تتوصل إلى مفاهيمه أرقى الأمم ثقافة ، وأعرق الدول حضارة ، وأكثر المتحضرين سياسة.
ولست بصدد الوقوف على جزئيات هذا العهد العظيم ، ولا بسبيل بيان كلياته الكبرى ، فهذا مما يطول معه الحديث ، ولا يستوعبه هذا البحث ، واكتفينا بما ألمعنا إليه ، بما يعد أفضل وثيقه عالمية لصيانة حقوق الإنسان مما لم يسبق إليه الإمام من قريب أو بعيد.
ولم أكن لأتتبع جميع فصول هذا العهد الرائع ، ولكنني ألقيت عليك منه بعض الفقرات ، واستخلصت منه جملة من النظرات لتستكشف ما خفي عليك بما أظهرت ، وتستقرئ منه المجهول ، وتستدل بما ذكرت على ما لم أذكر.
وأشير هنا أن الاستاذ توفيق الفكيلي رحمهالله ، قد شرح هذا
العهد شرحاً وافياً قبل أكثر من خمسين عاماً ، وسماه « الراعي والرعية » في جزأين ، وقد أحدث إصداره حينذاك ضجّة علمية ، لما إشتمل عليه من مُثُل وقِيم وأبعاد سياسية. ولا عجب في ذلك فهو نفحة من نفحات أمير المؤمنين عليهالسلام ، وجذوة من قبسات أفكاره الرائدة.
هذه هي هموم علي الكبرى ، وتلك هي تطلعاته الغراء ، في إقامة السنن ، وإرساء دعائم الحكم ، وتشييد أركان السياسة الإسلامية ، ولكن القدر لم يمهل علياً عليهالسلام في استكمال المسيرة وتحقيق الأهداف.