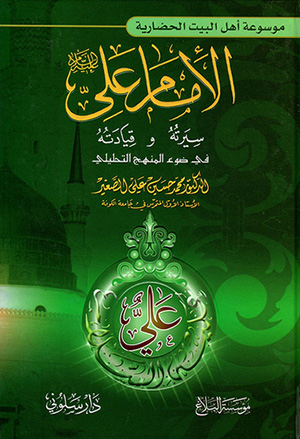الدكتور محمد حسين علي الصّغير
الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٠
فضائلهم في الإسلام ، وكان أنصحهم لله ولرسوله خليفته ، ثم خليفة خليفته ، ثم الخليفة الثالث ، فكلهم حسدتَ ، وعلى كلهم بغيتَ ، عرفنا ذلك من نظرك الشزر وقولك الهجر ، وتنفسك الصعداء ، وإبطائك عن الخلفاء في كل ذلك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش ، ولم تكن لأحدٍ أشدّ حسداً منك لابن عمّك. وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك لقرابته وفضله ، فقطعت رحمه ، وقبحّت حسنه ، أظهرت له العداوة ، وأبطنت له الغش ، وألبّت الناس عليه ، حتى ضربت أباط الإبل إليه من كل وجه ، وقيدت الخيل من كل أفق ، وشهر عليه السلاح في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقتل معك في المحلة ، وأنت تسمع الهائعة لا تدرأ عنه بقول ولا فعل. ولعمري يا ابن أبي طالب لو قمت في حقه مقاماً تنهى الناس فيه عنه ، وتقبح لهم ما اهتبلوا منه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحداً ، ولمحا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجانبة له والبغي عليه. وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان ظنين ، إيواؤك قتلته ، فهم عضدك ويدك وأنصارك ، وقد بلغني أنك تنتفي من دم عثمان وتتبرأ منه ، فان كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتلهم به ، ثم نحن أسرع الناس إليك. وإلا فليكن بيننا وبينك السيف ، والذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أروحنا بالله. والسلام ».
والطريف في هذا الكتاب أن يفتخر معاوية برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عليّ عليهالسلام وهو نفسه ، وعلي نفس محمد بصريح القرآن ، فهو أولى بالفخر ، وأن يسمي معاوية لعلي عليهالسلام أعوان محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنصاره الذين أيدّ الله بهم الإسلام ، وعليٌّ عليهالسلام أولهم ، وأقدمهم سابقة ومناصرة ومجاهدة ، وأن يصنّف له الخلفاء وليس معاوية هناك ، وأن يتهمه بحسدهم والبغي عليهم ، عسى أن تبدر من عليّ كلمة بحقهم
فيرفعها شعاراً كما رفع قميص عثمان شعاراً ، وأن يصمه بحسد عثمان والإجلاب عليه والاتهام بقتله.
ويتضح من هذا الكتاب أن معاوية لا يريد إصلاحاً ولا صلاحاً بل اشتط به كل الشطط لإيراء الحرب ، واتكأ في ذلك على أن علياً عليهالسلام آوى قتلة عثمان ، ولم يكن الأمر كذلك ، إذ كان علي عليهالسلام يخذل الناس عن عثمان ، وينهاهم ويزجرهم ، ونصح لعثمان ـ كما سبق ـ نصحاً أرضى به ربّه ونفسه حذر الفتنة.
وحقٌّ لعلي أن يقول لهذا ولأمثاله :
« أنزلني الدهر حتى قيل عليٌ ومعاوية ». فيا له من حرج في النفس ، ويا له من مقياس عند الناس ، ويا له من هوان يتأثم منه التقي ، ويتحرج ذو الدين.
ومهما يكن من شيء فقد أنهى أبو مسلم الكتاب إلى أمير المؤمنين ، وجمع علي عليهالسلام الناس في المسجد ، وقرىء الكتاب ، فتنادى الناس من جوانب المسجد « كلنا قتلة عثمان ، وكلنا كان منكراً لعمله ». واتضح لأبي مسلم أن علياً لا يستطيع أن يسلم هذا الجمع من الناس ، فهم يحكمونه الآن وهو لا يحكم ، كما اتضح له أن قاتليه رأوا في قتله صلاح أمر الدين ، فجعل أبو مسلم يردد ، مع وضوح الأمر لديه إعذاراً : الآن طاب الضراب.
وبهذا فقد بلغ معاوية قصده ، فهدفه أن يجعل المترددين موقنين بمشروعية طلبه للثأر المزعوم ، والغريب ـ كما هو متوقع ـ أن الحكم حينما صفا لمعاوية لم يذكر عثمان ، ولا دم عثمان ، ولا ثأر عثمان ، ولا أبناء عثمان ، وكان كل ذلك نسياً منسياً ، وإنما شهر كل ذلك سلاحاً في
وجه أمير المؤمنين طلباً للسلطان ليس غير.
وقد سفّه عليٌّ عليهالسلام أحلام معاوية في هذا الكتاب ، وغيره من الكتب ، فردّه رداً عنيفاً ، جاء في جزء منه :
« وزعمتَ أني للخلفاء حسدتُ ، وعلى كلهم بغيتُ ، فأن كان ذلك كذلك فليست الجناية عليك ليكون العذر لك ، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. وقلت إني أقاد كما يقاد الفحل المخشوش حتى أبايع ، فلعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحتَ ، وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكّاً في دينه ، ولا مرتاباً في يقينه ، وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ، وأما ما كان من أمري وأمر عثمان ، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه ، فأينّا كان أعدى له ، وأهدى إلى مقالته ، أمن بذل له نصرته فاستقعده وأستكفّه ، أمن استنصره فتراخى عنه ، وبث المنون إليه حتى أتى قدره عليه ، وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثاً ، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فربَّ ملوم لا ذنب له ، وقد يستفيد الظنة المتنصحُ ، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ».
وفي رسالة أخرى ردّه الإمام بقوله :
« وأما ما ذكرت من أنه ليس لي ولأصحابي إلا السيف ، فلقد أضحك بعد استعبار ، متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين ، وبالسيوف مخوفين ، فالبث قليلاً يلحق الهيجا جمل ، وسيطلبك من تطلب ، ويقرب منك ما تستبعد ، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ، شديد زمامهم ، ساطع قتامهم ، متسربلين سربال الموت ، أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم ، وقد صحبتهم ذرية بدرية ، وسيوف هاشمية قد عرفت مواقع نصالها بأخيك
وخالك وجدك وأهلك وما هي من الظالمين ببعيد ».
وهكذا توالت الرسائل بين الإمام ومعاوية ، ومعاوية يكيد ويريد الحرب طلباً للملك ، وعليٌ عليهالسلام يريد الإصلاح واستقرار الإسلام ، وأخيراً كان لا بد مما ليس منه بد ، فقد قدّم علي طلائعه إلى صفين ، وأمرهم أن لا يبدأوهم بقتال حتى يأتيهم ، وسار علي عليهالسلام ببقية جيشه حتى وصل إلى صفين. وسار معاوية بجيوش الشام حتى انتهى إلى صفين أيضاً ، وكان وصول معاوية اسبق فاستولى على الماء واهتلك شريعه الفرات يريد أن يحلئ علياً واصحابه عن الماء وجرت خطوب كثيرة ، واشتد القتال على المشرعة فامتلكها علي عليهالسلام ، وأراد أصحابه منع أهل الشام الماء ، فأبى الإمام ذلك لأن دينه يمنعه ، فالماء من المباحات المشتركة بين الناس ، عسى أن لا يتعجل حرباً ، ولا يسفك دماً ، يأتلف المخالف ، ويعفو عن المسيء ، ويلتمس العذر للآخرين ، ولكن للحرب بوادر ، ولها مظاهر ، ما نفع معها الجدل الهادىء ولا العنيف ، ولا أطفأ نائرتها التغاضي والصفح الجميل ، وإنما قامت على ساق رغم الظروف السياسية المتينة التي سيّرها أمير المؤمنين بحكمته ودرايته وتجربته لإخماد اللهيب ، ورغم الجهود التي أوجدها لإحلال الأمن والسلام.
ذهبت كل المؤشرات الخيرة التي بذلها الإمام أدراج الرياح ، وحل محلها العنت والتزمت والعدوان ، فاستمسك الإمام بالأمر ما استمسك ، فلما فلت الزمام قامت الحرب.
(٨)
معركة صفّين ... وإنحياز الخوارج
امتلك عليٌّ عليهالسلام مشرعة الفرات في صفين فأباح الماء لأهل الشام كما رأيت ، وقد أصبح جيشه وجهاً لوجه مع جيش معاوية ؛ وكان ذو الحجة من عام ستة وثلاثين للهجرة ، ومحرم من عام سبعة وثلاثين مجالاً للمحاورة وسجالاً بالسفراء ، عسى أن يجديا نفعاً كما أراد عليٌّ عليهالسلام ، فلم يعكر صفواً ، ولم يتصنع غضباً ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويذكر أهل الشام بمنزلته وسابقته ، وكان معاوية يشحنهم بدعوى الطلب بثأر عثمان ، وكثرت الرسل بين الطرفين ، وعلا الإختصام والإحتجاج ، ولم يبلغ أحد من أحد شيئاً ، وكان لا بد بعد فشل الخصام باللسان أن يتطور إلى الخصام بالسيف ، فكانت الكتيبة من جيش الإمام تخرج إلى الكتيبة من جيش معاوية ، وكان الفريق من أهل الشام يقاتل الفريق من أهل العراق ، وكانت الحرب سجالاً نهاراً أو بعض النهار ويحجز بينهما الليل ، وكان لا بد لهذه الحالة أن تتصاعد ، ولهذا الصراع أن يستحكم ، ولهذه المجابهة أن تتحفز ، وما مضى شطر من صفر إلا استقتل هؤلاء وهؤلاء ، ودنا أولئك من أولاء ، فكانت الحرب الطاحنة الشاملة التي يشيب لهولها الوليد.
وكان الجيشان على نحو من الكثرة والعدد ، فبين مبالغ فيه من المؤرخين ، وبين معتدل ، فجيش علي مائة ألف مقاتل فيما يزعمون ،
وجيش معاوية سبعون ألف مقاتل فيما يزعمون.
جيش علي عليهالسلام يشتمل على عدد كبير من المهاجرين والأنصار في طليعتهم عمار بن ياسر الذي قال عنه النبي وله : « يا عمَّار تقتلك الفئة الباغية ». وفيهم خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي سماه الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم بذي الشهادتين ، وفيهم ابن التيهان الصحابي الجليل ، وفيهم هاشم بن عتبة المرقال ، وقيس بن سعد بن عبادة ، والأحنف بن قيس ، ومالك الأشتر ، وجمهرة من أعلام بدر وأعيان أحد ، وأمثالهم كثير.
وجيش معاوية يشتمل على جملة من رؤساء القبائل الشامية كذي الكلاع الحميري ، وعلى أبناء الذوات كعبيد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وعلى طائفة من الموتورين والإنتهازيين كمروان بن الحكم وعمرو بن العاص وأضرابهم.
وتمثل هذه الأسماء قيادة الجيشين ، وأركان الحرب فيهما ، والتقى الجيشان فكانت ملحمة كبرى ، استمرت أياماً طويلة وليالي ، ندرت فيها الرؤوس ، وطاحت الأيدي ، وتهاوت الأجساد ، وزهقت الأرواح ، حتى إذا كانت ليلة الهرير كانت ليلة فاصلة في القتال ، هبت فيها رياح النصر مع أمير المؤمنين ، وعليّ عليهالسلام يلتجىء إلى مسيرته من ربيعة ، فتستقتل دونه استقتالاً مريراً ، وتتحالف أفخاذها على الموت ، وقائلهم يقول : « لا عذر لكم عند العرب إن أصيب أمير المؤمنين وهو فيكم » وتُبلي همدان بلاءً حسناً ، أهونه أن تقاتل في صبر وحمية وإباء ، فيرتجّ الميدان وتزلزل البيد.
وميمنة أمير المؤمنين يقودها مالك الأشتر من نصر إلى نصر ، وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص يرقل بالراية إرقالاً ، ويستنزل الظفر
استنزالاً بحد السيوف ، ويقول :
|
أعورُ يبغي أهلَهُ محلاّ |
|
قد أكثرَ القولَ وما أقلاّ |
|
وعالجَ الحياةَ حَتى ملاّ |
|
لا بدَّ أن يَفلَّ أو يُفَّلا |
أشلُهُم بذي الكعوبِ شلاّ
وعمار بن ياسر يصرخ في المقاتلين ، ويهيب بالمرقال والأشتر قائلاً : « الجنة تحت ظلال الأسنة » « غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه » ... وهو يرتجز مزمجراً :
|
نَحنُ ضَرَبناكُم على تَنزيلِهِ |
|
واليومَ نضربُكُم على تَأويلِهِ |
|
ضَرباً يزيلُ الهامَ عن مَقيلِهِ |
|
ويُذهلُ الخَليلَ عن خَليلِهِ |
أو يَرجعُ الحَقّ إلى سَبيلِهِ
ويقاتل عمارٌ عمرو بن العاص ، وينظر إلى رايته الضالة فيقول :
والله لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاث مرات ، وهذه الرابعة وما هي بأبرّهن.
وهو القائل بين الصفين : والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق ، وأنهم على الباطل.
ويستقتل ويقتل هو وصاحب اللواء هاشم المرقال ، ويستسقي عند مصرعه ، فيسقى لبناً فيكبر ويقول :
« أنبأني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن آخر زادي من الدنيا ضياح من لبن ».
وحينما يقتل عمار ، ينادي خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين معرّضاً بأصحاب معاوية : الآن استبانت الضلالة ، لأنه وأمثاله من الصحابة يروون الحديث المتواتر عن النبي :
« يا عمار تقتلك الفئة الباغية ».
وقد شاع هذا الحديث في صفوف الشاميين ، ورواه لهم : عمرو بن العاص وسواه منهم ؛ فلما قتل عمار ، اشتد الخطب على معاوية والتجأ إلى المرواغة وتزييف الحقائق ، فقال : ما نحن قتلنا عماراً ، وإنما قتله الذي أخرجوه ، فردّهم الإمام علي رداً بديهياً وقال على سبيل الإنكار ، فرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل عبيدة لأنه أخرجه إلى بدر ، وقتل حمزة لأنه أخرجه إلى أحد ، وقتل جعفراً لأنه أخرجه إلى مؤتة.
وقتل في اشتداد القتال وعند مصرع عمار وذو الكلاع الحميري من أهل الشام ، وكان يستقصي أخبار عمار فيوهمه معاوية بأنه سيلتحق بنا ويقاتل علياً ، وكان ذو الكلاع ينظر عاقبه عمار ، ولكنهما قتلا بوقت واحد ، فقال معاوية : لست أعلم بأيهما أشد فرحاً بقتل عمار أو بقتل ذي الكلاع ، لأنه حاذر أنه يلتحق بعلي مع قبيلته لو أدرك مصرع عمار.
وقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب ، قتله بغيه وتطاوله ، واستوهبت زوجته جثته فلم يمتنع الإمام من ذلك.
ونجا عمرو بن العاص ، حينما برز إليه الإمام علي عليهالسلام فحينما أدركه كشف سوأته ، فصرف الإمام بوجهه عنه ، وغض طرفاً ، وعيّر عمرو بذلك كثيراً حتى من معاوية فما أكترث.
وتداعت صفوف أهل الشام في الإنهزام والفرار والقتل ن وبدا عليهم الخذلان التام ، وكاد معاوية أن يفر لولا أن تذكر قول ابن الاطنابة ، وقد أعدت له فرس للفرار :
|
أبت لي همتي وأبى بلائي |
|
وَأخذُ الحمدِ بالثمنِ الربيحِ |
|
وإجشامي على المِكروهِ نَفسي |
|
وضَربي هامةِ البطلِ المُشيحِ |
|
وقولي كلما جَشَأت وجَاشَت |
|
مَكَانَكِ تُحمدِي أو تُستريحِي |
ويزعم المؤرخون أن جيش معاوية قد تضعضع بش كل لا يمكن إلتأمه ، وأن أركان حربه يلوذون بالفرار ، وأن الأشتر يزحف بالكتائب حتى يصل إلى فسطاط معاوية ، ومن خلفه الجيش العراقي يتجحفل بهجومه الكاسح على مقرّ قيادة الجيش الشامي ، وهنا يستنجد معاوية بعمرو بن العاص ، فيدبران المكيدة برفع المصاحف ، وإذا بمنادي أهل الشام يقول :
« هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته ، اللهَ اللهَ في العرب ، الله الله في الإسلام ، الله الله في الثغور. من لثغور الشام إذا هلك أهل الشام؟ ومن لثغور العراق إذا تفانى أهل العراق ».
وكانت ليلة الهرير بما صاحبها من إنتصار ساحق لأهل العراق ، وإندحار شامل لجيش الشام مقدمة التفكير في هذه المكيدة.
ولم تكن هذه الخديعة الكبرى وليدة ساعتها ، ولا بنت ليلتها ، وإنما سبقها عمل مستمر وكيد قائم على قدم وساق من قبل معاوية وقيادته ، فلقد ملّ معاوية الحرب الخاسرة التي يخوضها ، وقد أُخذَ عليه بالمخنق بها ، ولا أمل له بالنصر أو الخلاص فما هي إلا السقوط في المعركة أو الهزيمة الكبرى ، لا سيما بعد تناثر آلاف القتلى التي مني بها جيشه ، فقد ذكر المؤرخون أن قتلى أهل الشام قد بلغوا خمسة وأربعين ألفاً ، كما أن قتلى أهل العراق قد بلغوا خمسة وعشرين ألفاً ، وهب أن هذا العدد من المعسكرين مبالغ فيه ، فلو تنزلنا معه إلى نصفه لكان عدداً هائلاً ، وخسارة فادحة.
كان بين أهل العراق عدد لا يستهان به من رؤساء القبائل ممن استهواهم معاوية بالمال والوعود وكان في طليعتهم الأشعث بن قيس
الكندي الذي قال عنه ابن أبي الحديد : « كل وهن لحق بخلافة أمير المؤمنين فمصدره الأشعث بن قيس ».
وهذا يعني أن الأشعث ومن على شاكلته من أهل الدنيا لم يخلصوا النية للإمام ، ولم ينصحوا له سراً ولا علانية ، فهم أهل هوى لا أهل ورع ، والهوى يقود صاحبه إلى الضلال لا الهدى ، فكان هؤلاء يريدون الموادعة ، ولا يريدون نصراً لعلي عليهالسلام ، يسير بعده بسيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكان جيش الإمام مزيجاً من أقوام أخلص بعضهم إخلاصاً فذّاً ، وغدر بعضهم غدراً مبيّناً ، ووقف آخرون موقف المحايد المستفيد. فمن تابعه من المهاجرين والأنصار ومن إتبعوهم بإحسان يقاتلون ببصيرة نافذة ، ودوافع دينية محضة لأنهم يرون الحق مع علي وعلياً مع الحق ، وكذلك كان خيار أهل الكوفة ، وجملة من أهل البصرة. وأما من لحق به من أهل الجمل فكان فيهم المنهزم والدخيل والمعتزل. ولم يكن إخلاصهم للإمام خالصاً ؛ وهناك طائفة كبيرة من الإنتهازيين والوصوليين يظهرون الولاء لأمير المؤمنين ويضمرون الكيد له ، يغازلون معاوية سراً ، ويشايعون علياً علناً ، وليس من الصعب على معاوية استدراج هؤلاء لأغراضه ، وإستقطابهم في مخططاته الكبرى ، فما إن رفعت المصاحف حتى انتقض جيش الإمام على نفسه ، وطلبوا إلى الإمام إيقاف الحرب ، وأحاط به أكثر من عشرين ألفاً شاهري السيوف ، وقد يقال بأن بعضهم طلب من الإمام القبول بحكم القرآن وإلا لحق بعثمان ، والإمام كان يقاتل من أجل حكم القرآن ، ونظام القرآن ، وأوضح لهم أن معاوية وأشياعه ليسوا بأهل دين وإنما هم طلاب ملك ودنيا ، وأنها خديعة الطفل عن اللبن ، فكان أشد الناس عليه الأشعث بن قيس
وأضرابه في جماعة من الغوغائيين ، تنادوا بالتحكيم ، واكثروا اللغط في الجيش ، وفتّوا في عضد الإمام حتى ألجأوه إلى التحكيم كرهاً.
وقد تكون لهذا الأمر أبعاده التّآمرية المنظّمة من قبل معاوية والمندسين في جيش الإمام من أنصاره ، فما أسرع ما استجاب العراقيون للتحكيم دون رويّة ودراية ، وما أسرع ما نهض الأشعث بالمهمة بدّقة متناهية ، وما أسرع ما تجمع حول الإمام من لا يستطيع أن يتفاهم معهم ، فأكرهوا الإمام على كفّ القتال مع غضب قيادته ، ومعارضة أصحاب الجباه السود الذين غضبوا على التحكيم حتى ثاروا بالأشعث وأرادوا قتله.
وقد كان الإمام عليهالسلام برماً بهذا الخليط العجيب من أصحابه ، وهذا المناخ الجديد في تسيير الأمور جزافاً ، فهو محكوم عليه بهذا النفر ، يمتلكون عليه أمره ، ولا يملك أمرهم ، وقد أوضح لهم بلين وأناة تارة ، وشدة وغضب تارة أخرى أن معاوية كره حد السيف ، وأنه على أبواب الهزيمة ، وليس هو ولا أصحابه بأهل قرآن حتى يحكم بينهم القرآن ، فما استمعوا لهذا ، وركبوا رؤوسهم عناداً وخلافاً وفرقة ، فأوعز الإمام للاشتر بالكف عن القتال وإيقاف الحرب ، فاستمهله فواق ناقة ليأتيه برأس معاوية ، ولكن الأشعث ورجاله المشبوهين قد أحدقوا بالإمام وهددوه بالقتل إن استمرت الحرب ، فوقفت الحرب.
ونظر عليٌّ عليهالسلام إلى المأساة تتجدد عليه ، وإلى السواد يغالبه على أمره ، ولم يترك الإمام ليدبّر الأمر بحكمته ، ولا أن يسير بالحرب إلى أهدافها القريبة ، ولا أن يأخذ بكظم الباطل فيصرعه ، مُنِيَ بهؤلاء الغوغائيين وذوي المآرب الخفيّة والجليّة ، وذهبوا إلى التحكيم دون إحكام للأمر ، وما تركوا للإمام فرصة من يمثله في هذا التحكيم ،
وأشرأبت العصبية القبلية بعنقها المهزوز لتفرض أبا موسى الأشعري ممثلاً عنه في هذه المحنة ، وأبو موسى هو صاحبه بالأمس الذي خذّل عنه الكوفيين ، وأراد الإمام ابن عباس أو الأشتر للتمثيل ، ولكن الأشعث أبى ذلك ، فكان الأشعري ممثل الإمام ، وكان عمرو بن العاص ممثل معاوية ، وكان الإمام مكرهاً بقبول الهدنة ، ومكرهاً في اختيار ممثله ، وسارت الأمور كما شاء أعداؤه ، فتولى الأمر من ليس جديراً به ، ولم يستطع الإمام حتى ترشيح الأحنف بن قيس ليكون تالياً لأبي موسى.
وهكذا اجتمع الفريقان بعد خطوب وخطوب ، فكتبوا صحيفة بوضع الحرب ، وتشخيص الحكمين ، وتحديد الزمان والمكان ، للبتّ في الأمر ، وتأليب المسلمين على من خالف بنود هذه الصحيفة ، وكان جوهرها :
« أننا ننزل عند حكم الله ، وبيننا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته ، نحيي ما أحيا ، ونميت ما أمات » كان هذا لب الحكومة ، وفحوى الصحيفة ، وفيها : « فما لم يجداه في كتاب الله ، عملا فيه بالسنة الجامعة غير المفرّقة ».
وكان كل هذا حبراً على ورق ، وبيتاً من ثلج ، فكتاب الله يدعو إلى قتال الفئة الباغية صراحة حتى تفيء إلى أمر الله ، وسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تؤخذ من علي عليهالسلام فهو وريثها الشرعي ، والسنّة لا تهادن باطلاً ، ولا تدفع حقاً ، ولا تؤوي باغياً ، وواضح من نصوص الصحيفة التي كتبت دون مراجعة الإمام أن كتابّها لم يحكموا الأمر ، وإنما أوقفوا الحرب ، وقد تناست هذه الصحيفة أهم ما قامت عليه الحرب : امتناع معاوية عن بيعة الإمام أولاً ، ومطالبة معاوية بدم عثمان ثانياً.
وقد طوي هذان الموضوعان المهمان طياً عجيباً ، فكانت الصحيفة تنبي عن مكر وغدر عظيمين ذهب ضحيتهما كيان الإسلام.
وهنا بدرت شعيرة الخوارج « لا حكم إلا الله » واعترضوا على تحكيم الرجال في دين الله. وكان شعار الإمام كما أرادوا استمرار القتال للفئة الباغية وجوهره « لا حكم إلا لله » ما في ذلك شك ، ولكنه كان مغلوباً على أمره ، فرفق بهم ، ورآهم قلة لا تغني مع الكثرة الساحقة ، فنصح لهم وأمرهم بالهدوء ، وهدأوا حيناً ما ، ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة كما سنرى.
وقد ضاق الإمام ذرعاً بأصحابه ، فألقى الحبل على الغارب ، وأبان لهم : أن إمامهم يطيع الله وهم يعصونه ، وأن إمام أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه ، وتمثل بقول دريد بن الصمة :
|
أمَرتُهُمُ أمَري بِمُنعَرجِ اللِوى |
|
فلم يَستبينوا النصحَ إلاّ ضُحى
الغَدِ |
|
فَلَمَّا عصوني كنتُ فِيهم وقد أرى |
|
غِوايَتهم ، وأنني غيرُ مُهتدي |
|
وَهَل أنا إلاّ مِن غُزِيَةَ إن غَوَت |
|
غَويتُ ، وإن تُرَشَد غُزَية أرشد |
إستكره عليّ عليهالسلام على ترك القتال ، وإستكره أيضاً على قبول الحكومة ، وإستكره أيضاً ولم يشاور في كتابة الصحيفة ، وأنكر الخوارج التحكيم ، واعتزلوا الفريقين ، وأنحازوا إلى حروراء ، ولم يدخلوا الكوفة بعد الحرب ، وكان هناك جدل وتطاول وإحتجاج بين الذين اتبعوا الإمام مسلمين ، وبين هؤلاء الخارجين ؛ وكان عليٌّ عليهالسلام يصرح بأنه استكره على ترك القتال ، وإنما الناس أرادوا العافية وكرهوا القتال ، وأراد الإمام أن يرجع الخوارج إلى الجماعة ، وأن يجنبهم سوء المنقلب ، وأن يستصلح القسم الأوفر منهم ، فكانت مناظرات انتصر الإمام في أغلبها ، وأصلح ما استطاع منهم ، وأبان أن الله قد حكمّ في
الصيد الناس ، وحكمّ في الشقاق الناس ، وكانت آية التحكيم في كل منهما سبيلاً إلى إعذاره عندهم ، وقالوا قد محوتَ أنك أمير المؤمنين ، كأنك شككت في إمرتك لهم ، فأبان أن رسول الله محا في صحيفة الحديبية وصفه بأنه رسول الله ، وهو رسول الله حقاً ، فثاب منهم جماعة ، ورجع آخرون ، ودخلوا الكوفة ، وأصرت طائفة كبيرة منهم على العناد ، فأرسل الإمام إليهم ابن عباس استصلاحاً لشأنهم ، وأمره بأن لا يحاججهم بالقرآن فإنه حمّال ذو وجوه ، وإنما يحاججهم بالسنة ، فناظرهم ابن عباس بهما مناظرة مقنعة ، فثاب إلى الرد منهم جماعة تقدر بألفين أو ثلاثة آلاف ، وعادوا مع ابن عباس إلى الكوفة.
وحينما أنكر الخوارج تحكيم الرجلين ؛ أبان لهم الإمام بأنه أخذ عليهما العهد أن يحكما بما في كتاب الله ، فإن حكما بذلك فالحكم لله ، وإن خالفا عما في كتاب الله فلا حكم لهما ولا طاعة.
وقد تأثر القوم بما ساقه الإمام من الحجج الدامغة ، فانصاعت منهم طائفة كبيرة ، فقال لهم الإمام : « ادخلوا مصركم رحمكم الله ». فدخل القوم بانتظار أمر الحكمين ، ودفع الإمام بالتي هي أحسن ، ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة.
وعاد علي عليهالسلام إلى الكوفة ، ومعه جمهرة لا يستهان بها من هؤلاء ، قد إعتقد بأنه أصلحهم أو أقنعهم أو أفحمهم ، ولكن قسماً منهم لم يكن كذلك ، فما لبثوا أن حكموا في المسجد يقاطعون خطب الإمام بشعارهم : « لا حكم إلا لله » فكان يقول : « كلمة حق أُرِيدَ بها باطل » إذ لا بد للناس من حاكم بأمر الله.
وقد ظهرت معارضة هؤلاء في الكوفة على أشدّها حتى خرج بعضهم منها منابذاً ومغاضباً ، وترك لهم الإمام الحرية وقال :
إن سكتوا تركناهم ، وإن تكلموا حاججناهم ، وإن أحدثوا فساداً قاتلناهم ».
وكان السكوت حيناً ، والإحتجاج حيناً آخر ، والقتال أخيراً لأنهم أفسدوا في الأرض.
ومحنة هؤلاء الذين طلبوا الحق فأخطأوه ، أنهم لا تهدأ لهم ثائرة ، ولا تخبو لهم نائرة ، وهم أصحاب جباه سود من كثرة السجود ، وهذه محنة أخرى ، يخدع فيها الجاهل ، ويتأثم عندها العارف ، ولهم في الليل دويٌ كدوي النحل في قراءة القرآن ، وتلك محنة ثالثة توهم بأنهم أهل عبادة ، وهم غلاظ شداد في هذا كله ، ولقد أخطأوا السبيل إلى الهدى فساقتهم الهلكة سوقاً ، وأسلمهم القدر إلى المصير المحتوم : القتل حيناً ، والتشريد حيناً آخر ، وأسلموا أنفسهم هم لقطع السابلة حيناً ، وللإفساد في الأرض حيناً آخر ، ولسفك الدماء في غير حلّها ثالثة. والإمام في هذا الوسط المحموم يعمل نهاره جاهداً ، ويسهر ليله مفكراً ، يأسى لهؤلاء ، ويكافح أولئك ، وينصح ما استطاع نصحاً ، وهو مع ذلك يمنحهم الحرية بأوسع مفاهيمها ، ولا يحرم أحداً عطاءً ، ولا يفرض على أحد إقامة ، ولا يكره أحداً على قتال ، وهم بين ذلك يتربصون به.
(٩)
الوفاء بشأن التحكيم ... ومعركة النهروان
وأشاع الخوارج في الكوفة أن علياً عليهالسلام يرى رأيهم في القتال ، وأنه رفض الحكومة ، فأرسل معاوية للإمام يستعجله الوفاء بأمر التحكيم.
فأشخص الإمام أبا موسى الأشعري ، ومعه أربعمائة من فرسانه ، وعليهم ابن عباس للصلاة ، وشريح بن هاني أميراً.
وأرسل معاوية ، عمرو بن العاص ومعه أربعمائة من أصحابه.
وقد حاول الحكمان استدراج من إعتزل الفريقين لحضور الاجتماع كسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وعبد الله بن الزبير ، فلم يستجب لهما أحد من هؤلاء فيما ذكر المؤرخون.
واجتمع الحكمان بدومة الجندل ، يتفاوضان في الأمر ، ويجيلان الرأي ، وكان عمرو بن العاص يتظاهر بالتضاؤل أمام أبي موسى ، ويقدمه للصلاة ، ويجلس بين يديه عند الطعام ، ويعطيه صدر المجلس ، فتراخى أبو موسى لهذا التصنع ، وطرب لهذه المظاهر ، وكان ذلك تمهيداً دقيقاً لخداع أبي موسى ، وأبو موسى هذا بعيد عن الإمام في
شعوره وتفكيره ودينه ، وقد عجمه الأحنف بن قيس وأعطى رأيه فيه للإمام ، وقد خذّل أبو موسى عن الإمام في حرب الجمل ، وقد عزله علي عليهالسلام عن إمارة الكوفة ، وقد تبعه المهوسون يستريحون إليه في حب السلامة ، وفي نفسه موجدة على عليّ نتيجة عزله ، وفيه أزورار عنه لتهاونه بشأنه ، وقد ظهر بمظهر الورع والتحرج وهو بعيد عنهما ، وقد تلهف على الشورى ، بل ونادى بالطيب بن الطيب عبد الله بن عمر على حد تعبيره ، وتمطى بسذاجة مخلة أو شيطنة مبطنة بوقت واحد ، فاستغل عمرو بن العاص كل هذه المخلفات استغلالاً كبيراً حتى أودى به وقلب له ظهر المجن.
كان الإجتماع بدومة الجندل حيناً ، وفي أذرح حيناً آخر ، وتفاوض الحكمان مدة مديدة في الأمر ، وقد كثرت آراء المؤرخين فيما تفاوضا فيه ، فذهبوا في ذلك أكثر من مذهب. ولكن المؤكد أن الحكمين قد اتفقا على خلع علي ومعاوية ، وجعل الأمر شورى بين المسلمين ، وواضح أن هذا الاقتراح كان مكيدة من عمرو ، واستغفالاً لأبي موسى ؛ إذ ما هو معيار هذه الشورى؟ وإلى من تعود؟ وفيمن يرشح لها؟ وكيف الحال عند المسلمين ، فالعراقيون يرشحون علياً ، والشاميون يرشحون معاوية ، فتعود جذعة كأن لم يصنعا شيئاً ، وإن رُدّت الشورى إلى أهل الحل والعقد ، فأهل الحل والعقد قد بايعوا علياً ؛ فلماذا الشورى حينئذٍ؟
في هذا المقترح ـ إذن ـ يكمن غدر ابن العاص ، وتغافل أبي موسى ، فابن العاص مخطط متمرس للقضية ، ومنظر دقيق لها ، وأبو موسى في خدعة مستمرة لا يستفيق ، عمرو يخدعه وهو يخادع نفسه ، ولا يرعوي بينهما إلى سند وثيق.
وفجأة ظهر الحكمان أمام الناس بعد احتجاب طويل استغرق عدة أشهر ، وأعلنا عن اتفاقهما بما فيه الرضا للمسلمين ، والنصح للدين ، واستمر الخداع هذا في هذا الموقف فقدم عمرو أبا موسى لإعلان ما اتفقا عليه ، وأشفق ابن عباس من هذا التقديم ، وأشار بإصرار على أبي موسى بالتأخر ريثما يعلن ابن العاص ما عنده ، فما استجاب له أبو موسى ، ولا استمع إلى نصحه ، وإنما تقدم إلى المنبر ، وأعلن أنه وعمرو بن العاص اتفقا على خلع علي ومعاوية ، ورد الأمر شورى بين المسلمين ، ثم قام عمرو بن العاص ، وقال : إن هذا قد خلع صاحبه ، وأنا أخلعه كما أخلع خاتمي هذا ، وأثبت صاحبي كما أثبت هذا الخاتم.
فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الله ، غدرت وفجرت ، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، فأجابه عمرو بن العاص : إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً.
وانتهت مهزلة الحكمين بهذا الشكل المريع ، فماج الناس واضطربوا ، وتراشقوا بالكلام والسياط ، وأدرك أبو موسى خزيه فضرب راحلته ورمى بها مكة ، وأقبل عمرو بن العاص وأهل الشام وسلّموا على معاوية بأمرة المؤمنين ، وعاد أهل العراق بخفيّ حنين ، وأدرك المسلمون أن الحكمين جارا في الحكم ، وعدلاً عن القصد. وبلغ علياً ذلك فقال معاوداً : إن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن.
واغتبط معاوية لهذه النتيجة ، فقد كسب الموقف ، وقد أراح أصحابه من الحرب ، وقد ثبّته صاحبه بالخلافة.
وأفاق العراقيون بعد سكرة موقتة ، فرأوا الأمور تدار في صالح
الضلالة ، وأن الحق مغلوب على أمره ، وإن إصرارهم على الإمام بقبول التحكيم كان خطأ العمر الذي لا يتداركه شيء إلا الحرب والقتال عوداً على بدء ، فعادوا إلى الكوفة يستعدون للقتال فيما يزعمون ، وكان الإستعداد قضية مؤقتة أيضاً ، إذ انشغل الإمام بما هو أفدح من ذلك ، فقد انشق عليه فريق من أصحابه بالأمس ، ونجم قرن الخوارج حينما تحقق نبأ الحكمين فأعجله ذلك عن أهل الشام ، لمعالجة الخرق الجديد.
وكان الإمام عليهالسلام قد خطب أصحابه بعد أخبار الحكمين فقال :
« الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد :
فان معصية الناصح الشفيق المجرب تورث الحسرة وتعقب الندم. وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري ، ونخلت لكم رأيي لو يُطاع لقُصير رأي ، ولكنكم أبيتم إلا ما أردتم ، فكنت واياكم كما قال أخو هوازن :
|
أَمَرتُهُمُ أَمرِي بِمُنعَرِجِ
الِلوى |
|
فَلَم يَستَبِينُوا الرُشدَ إلاّ
ضُحَى الغَدِ |
ألا إن الرجلين اللذين اخترتوهما حكمين قد نبذا حكم الكتاب وراء ظهورهما ، وإرتأيا الرأي من قبل أنفسهما ، فأماتا ما أحيا القرآن ، وأحييا ما أمات القرآن. ثم إختانا في حكمهما فكلاهما لا يرشد ولا يسدد. فبريء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين ، فاستعدوا للجهاد ، وتأهبوا للسير ، وأصبحوا في معسكركم يوم الاثنين إن شاء الله ».
وغدا الناس إلى معسكرهم كما أمر الإمام ، وسرح إليه ابن عباس كوكبة من جنود البصرة ، واستقر رأي الإمام على النهوض بجيشه إلى
الشام ، إلا أن طلائع الخوارج في النهروان قد عرقلت المسيرة ، وأرجأت الزحف ، فقد تداعوا سراً وعلناً وعادوا إلى التحكيم ، وخرجوا زرافات ووحداناً إلى النهروان ، وإنهم لفي طريقهم إذ أدركوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت ، وهو وأبوه من المعذبين في الإسلام على أيدي طواغيت قريش ، التقوا بعبد الله هذا ، وفي عنقه كتاب الله تعالى طلباً للأمان ، ومعه امرأته وهي حامل استدراراً للعطف والرحمة ، فقتلوه ذبحاً ، وقتلوا زوجته وولدها ذبحاً أيضاً ، وتركوهم قتلى مجردين على شاطىء الفرات ، ذلك أنهم استطلعوا رأيه في الإمام فأثنى عليه خيراً ، وقال حقاً.
ووصل النبأ إلى الإمام عليهالسلام فأرسل إليهم يستنكر هذا الإفساد في الأرض ، ويطلب إليهم تسليم القتلة ، فامتنعوا عن ذلك ، وأجابوا : كلنا قتلة ابن خبّاب ، وسار إليهم الإمام بنفسه فوعظهم ما شاء له الوعظ ، وحذرهم ما استطاع إلى التحذير سبيلاً ، فركبوا رؤوسهم ، وطلبوا إليه أن يشهد على نفسه بالكفر فقال لهم :
« بعد إيماني بالله وهجرتي ، وجهادي مع رسول الله ، أشهد على نفسي بالكفر ، لقد ضللت إذن ، وما أنا من المهتدين ، وَيحَكُمْ بم إستحللتم قتالنا والخروج عن جماعتنا؟ » فما كان جوابهم إلا أن امتشقوا السيوف ، وشهروا الرماح وتنادوا من كل جانب « هل من رائح إلى الجنة » ويجيب بعضهم بعضاً « الرواح إلى الجنة » وإذا بهم يشدّون على ميمنة الإمام وميسرته ، فينفرق لهم الجيش ، ويستقبلهم الرماة بالنبل ، وتحتدم المعركة ، ويندلع لهيبها عالياً ، ويباشر الإمام القتال بنفسه ، وإذا بالقوم صرعى كأمس الدابر.
وكان عليّ عليهالسلام قد أخبر أصحابه عند القتال بأنه : لا يقتل