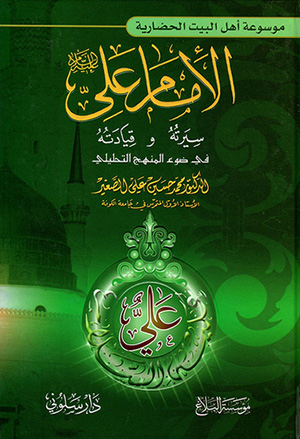الدكتور محمد حسين علي الصّغير
الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٠
( ١١ )
تفاقم الأمر على عثمان ومصرعه
وتفاقم الأمر على عثمان ، فقد تألبت عليه الأمصار ، وقد أجلب عليه البعيد والقريب ، وقد ملّ الناس وعده الماطل ووعيده النازل ، وقد ترك نصح بقية المهاجرين والأنصار ، وقد نصحه علي عليهالسلام وبالغ في الجهد فما إنتصح ، فما عليه إلا أن يشاور رجاله الأثيرين عنده والمقربين لديه ، وكان يلتقي عماله وولاته في الموسم من كل عام فيسمع منهم ويسمعون منه ، فلما لقيهم سنة أربع وثلاثين جمعهم للمشورة ؛ وكان في طليعتهم : معاوية ، وعبد الله بن عامر ، وابن أبي سرح ، وسعيد بن العاص ، فقال لهم عثمان :
« إن لكل أمير وزراء ونصحاء ، وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي ، وقد صنع الناس ما قد رأيتم ، وطلبوا إليّ أعزل عمالي ، وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون ، فاجتهدوا رأيكم ».
وكان أمر هذا الشيخ عجباً في أوله وآخره ، كيف يترك رأي عليّ وذوي السابقة في الإيمان والهجرة ، ويستند إلى هؤلاء ممن عرف بالغدر والمكر والدخل ، ممن لا يغنون عن الحق شيئاً ، ولا يتألمون من الباطل إقترافاً وإجتراحاً ، وليسوا بأمناء على دنيا ولا دين ، وممن نقم عليه الناس إستهتارهم واستئثارهم ، وهم الداء فكيف يتطلب منهم الدواء.
ومهما يكن من أمر ، فقد أشار عليه معاوية أن يكفيه امراءُ الأجنادِ الناس ، وأن يكفيه هو الشام.
وأشار ابن أبي سرح أن يعطي الناس المال ويتألفهم.
وأشار سعيد بن العاص عليه أن يقتل قادة المعارضة فإن لكل قوم قادة متى يهلكوا يتفرقوا ، ولا يجتمع لهم أمر.
وأشار عبد الله بن عامر : أن يشغل الناس بالجهاد ويوجههم للثغور.
وبهذا الرأي الأخير عمل عثمان ، ورد العمال إلى أمصارهم ، وأمرهم بالشدة وإرسالِ الناس إلى الغزو والحرب ، وأمرهم بتجهيز البعوث ، وحرمان الناس من أُعطياتهم إن عصوا.
فاستقبل المسلمون ذلك بالنقمة ، ورأوا فيه شراً مستطيراً ، فلما دخلت سنة خمس وثلاثين ، تكاتب أعداء عثمان وبني أمية في البلاد ، وحرّض بعضهم بعضاً على خلع عثمان عن الخلافة ، وعزل عماله عن الأمصار على حد تعبير الطبري. وتداعى الناس لذلك فدعا عثمان علياً وطلحة والزبير فحضروا وعنده معاوية فتكلم كلاماً لم يرضِ المجتمعين ، فنهره علي فسكت مغضباً ، ورفق عثمان وهدّأ الموقف بتلبية طلب الجماعة باسترداد ما أعطى لعبد الله بن خالد بن أسيد من مبلغ قدره خمسون ألف دينار لبيت المال ، وماأعطى لمروان من مبلغ قدره خمسة عشر ألف دينار ، كبداية لردّ الظلامات وإستصلاح الحال ، فهدأت الخواطر شيئاً ما ، ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. فقد قدم المدينة ثائرون من الكوفة كما أسلفنا ، وتبعهم ثائرون من البصرة ، وإذا بالمصريين يرسلون وفداً ضخماً في رجب سنة خمس وثلاثين ليناظر
عثمان ، والتقوا به في قرية خارج المدينة فناظروه وحكّموا المصحف بينه وبينهم ، فأقنعهم عثمان ظاهراً ، وخرج إلى المسجد الجامع ، وخطب فأثنى على المصريين ، وانصرف المصريون راضين أول الأمر.
واستنجد عثمان بعلي عليهالسلام ومحمد بن مسلمة ، فأنجداه بالوساطة الكريمة ، ووعدهم برفع المظالم ، وقضاء الحوائج ، والإنتصاف من العمال والولاة ، ولكن مروان أفسد الحال ، ورّد الناس ردّاً عنيفاً ، وكانت هنالك أحداث ومحاججات ، وكان هناك غدر بالعهود والمواثيق ، حتى بلغ السيل الزبى ، فخرج المصريون في ستمائة فارس فأتوا علياً ، فصاح بهم وطردهم ، وأتى البصريون طلحة فشايعهم بذلك ، وأتى الكوفيون الزبير فمالئهم.
وتعقدت الأمور تعقداً عجيباً وسريعاً أيضاً ، فقد تداعى الثائرون من أهل الأمصار بالمدينة ، ونادوا بالأمان لمن كفَ يده ، وحصروا عثمان في الدار ، فاستنجد عثمان بأمراء الأجناد للمنع عنه ، والذب دونه ، فتراخى معاوية ، وتربص ابن أبي سرح ، وتثاقل عبد الله بن عامر ، وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو لنجدة عثمان ، فلما انتهى الخبر إلى الثائرين ، جمعوا أمرهم ، واستقر رأيهم على خلع عثمان وعلى قتل عثمان أيضاً.
وخرج عثمان يوم الجمعة يصلي بالناس ، فوعد وأوعد وهدد وأنذر ، ووعظ وذكر ، فجبهه حكيم بن جبلة ، وقتيرة بن وهب ، وثار القوم بعثمان وحصبوه حتى صُرع مغشياً عليه ، وأدخل داره ، واستقتل نفر دونه ، منهم : الحسن بن علي عليهماالسلام ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت كما يقول ابن أبي الحديد.
وأقبل عليّ عليهالسلام ، وطلحة والزبير ، فدخلوا على عثمان يعودونه من صرعته ، فأساء مروان لعلي فقام مغضباً هو ومن معه.
وتدهورت الحالة ، وساءت الأوضاع جداً ؛ فقد مُنِعَ عثمان من الصلاة ، وأقام الثائرون أبا حرب الغافقي زعيم المصريين للصلاة ، ثم منعوا الماء عن عثمان حتى إشتد به العطش هو واهله ، ثم إن أهل المدينة تفرقوا عنه ، ولزموا بيوتهم ، فكان لا يخرج أحد منهم إلا بسيفه يمتنع به ، واستمر حصار عثمان أربعين يوماً كما يقول الطبري.
وزجر عليّ عليهالسلام الثائرين فقال : إن الذي تصنعون ليس صنيع المؤمنين ولا صنيع الكافر ، وإن الفرس والروم ليأسرون فيطعمون ويسقون. واستطاع عليّ بالقوة والزجر ، ولمكانته في النفوس ، أن يدخل الماء على عثمان ومن في الدار. وهي نجدةُ ما بعدها نجدةٌ في عرف القوم.
وتداعى جماعة بني أمية لحماية عثمان ، واستقلت طائفة من أبناء المهاجرين والأنصار في الدفاع عن عثمان ، وكان في طليعتهم الحسن والحسين عليهماالسلام ، وعبد الله بن عمر ، وعبد بن الزبير ، ومحمد بن طلحة ، وكان أميرهم ابن الزبير.
وكان علي عليهالسلام يدفع عن عثمان قدر المستطاع ، ولكن الثورة كانت عارمة ، والمدينة محكومة بالثوار ، والثوار لا يحكمهم أحد ، واستجار به عثمان ، وقال له : لك منزلة عند الناس ، وهم يسمعون منك ، وأحب أن تركب إليهم فتردهم عني ، فإن في دخولهم عليّ وهناً
لأمري وجرأة عليّ ، فقال عليهالسلام :
إني كلّمتك مرة بعد أخرى ، فكل ذلك تخرج وتقول ، وتعد ثم ترجع ، وهذا من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد ، فإنك أطعتهم وعصيتني.
فقال عثمان : فإني أعصيهم وأطيعك.
وتدارك عليٌّ ما استطاع من الفتنة ، فأمر الناس أن يركبوا معه ، فركب ثلاثون من المهاجرين والأنصار ، فكلم عليّ الناس ، فاستمع إليه أغلبهم ، وأمر عثمان : بأن يتكلم بكلام يسمعه الناس ، ويعدهم به بالتوبة ، وقال له عليّ :
« إن البلاد قد تمخضت عليك ، ولا آمن أن يجيء ركب من جهة أخرى ، فتقول لي يا علي : إركب إليهم ، فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك ، وإستخففت بحقك ».
فاستجاب عثمان لتوجيه علي عليهالسلام ، وخطب الناس ، ووعد بتنحية مروان وذويه ، وتداعى الناس إلى باب عثمان ، لردّ الظلامات ودفع الحقوق كما وعد ، فنهاه مروان عن ذلك ، واستقبل الناس بالزجر والسباب ، ورجع الناس خائبين.
ووجم الإمام علي لما حدث ، فقال :
« أي عباد الله ، يالله للمسلمين ، إني إن قعدت في بيتي قال لي : تركتني وخذلتني ، وإن تكلمت فبلغت له ما يريد ، جاء مروان فتلعب به ، حتى صار له سيقة ، يسوقه حيث يشاء ، بعد كبر السن وصحبة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقام مغضباً من فوره حتى دخل على عثمان ، وقال له :
« أما يرضى مروان منك إلا أن يحرفك عن دينك وعقلك ، فأنت معه كجمل الضعينة يقاد حيث يسار به ، والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا عقله ، وإني لأراه يوردك ولا يصبرك ، وما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك ، أفسدت شرفك ، وغُلبت على رأيك ... ثم نهض.
وكان هذا آخر دخول لعلي على عثمان.
ولقد صح ما توقعه الإمام ، فقد سلّم عثمان الأمر كله إلى مروان ، فَتلعبَ به مروان كما قال الإمام ، وأورده موارد الهلكة ولم يصدره ، فلم يكن ذا دين ، ولم يكن ذا رأي ، ولم يكن ذا منزلة.
وتطورة الأحداث تطوراً سريعاً ، فالمصريون يكتشفون أنبوبة رصاص مع رسول عثمان إلى مصر ، وفي الأنبوبة صحيفة تأمر الوالي بالقتل أو الصلب وبالنفي والتشريد لجملة من المصريين ، وعثمان بين ذلك يثني على المصريين ويعد علياً بأن ينصف الناس من نفسه ومن عماله ، ومروان يفسد الأمر عليه ، وعثمان يقول لعلي : لست آمن الناس على دمي فارددهم عني ، فإني أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي ومن غيري ، فيقول له علي عليهالسلام :
« إن الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك ، وإنهم لا يرضون إلا بالرضا ، وقد كنت أعطيتهم من قبل عهداً فلم تفِ به ، فلا تغرر في هذه المرة ، فإني معطيهم عنك الحق ».
قال عثمان : إعطهم فوالله لأفين لهم. فما أعطاهم عثمان شيئاً ولا وفى لهم.
وعلم الثائرون أن لا شيء بيد عثمان ، لا عزل ولا منع ، ولا دفع مظلمة ، وإشتدّ الحصار بعثمان ، وإشتدّ الثائرون بمطالبهم ، وإستعجل
الأمويون القتال ، واستعجل الثائرون القتال أيضاً ، فقد بلغهم أن الإمداد في طريقه إلى المدينة ، وإذا وصل الإمداد من الأقطار إلى المدينة ، فسيدخلون حرباً مع أنصار عثمان لا مع عثمان.
والحق أنه عمال عثمان قد غدروا بعثمان ، فقد تباطؤوا عنه دون شك ، وقد أسلموه للقتل راغبين ، فكأنهم جميعاً قد تواطؤوا على ذلك ، ويمكن أن تكون تلك خطة مدروسة مبرمجة يترأسها معاوية ، ليتسلم الحكم فيما بعد ، فيُقتل عثمان ويطالب هو بدم عثمان ، فيكون ولي الدم المسفوك ، وهكذا كان ، وإلا فما يدرينا ما مغزى قول معاوية لحبيب بن مسلمة الفهري ، وهو يجهزه للخروج إلى نصرة عثمان ، فيأمره بالمرابطة حول المدينة ، ويعهد إليك مؤكداً أن لا يتقدم عن ذلك شبراً ، ويقول له :
« هذا أمري فلا تتقدم وتقول : يرى الحاضر ما لا يرى الغائب ، فأنا الحاضر وأنت الغائب ».
وما بال المسلمين في الموسم لم يهبوا لنجدة عثمان وهو محصور ، وكان عثمان قد أمر ابن عباس على الحج على الحج وكتب معه كتاباً يستنجد به الناس ، وما بال والي مكة من قبل عثمان لم يسعفه بشيء على قرب المسافة.
لا أشك أن مؤامرة سرية بقيادة معاوية بن أبي سفيان كانت وراء هذا التقاعس الغريب عن نصرة عثمان أو الدفاع عنه ، وكان الأمر يدار بخفاء وكتمان حتى يقتل عثمان ، وينهض من ينهض بطلب ثأره ، وقد كان الأمر هكذا ، فقد علم معاوية أن الناس لا يعدلون بعلي أحداً ، وإذا كان كذلك كان الطلب بثأر عثمان ، وسيلة من الوسائل للإستيلاء على الحكم ، وقد أنطلت هذه اللعبة على المغفّلين ، ورفع معاوية ـ فيما
بعد ـ قميص عثمان ، ولكنه بعد إستيلائه على الحكم لم يذكر عثمان بشيء ، ولا طالب بدم عثمان ، بل لم يعرف حتى أبناء عثمان ، واستأثر بالملك وحده.
ومهما يكن من أمر ، فقد تَسَوَرَ الثائرون على عثمان الدار ، وقد دعاه رجل يسمى نيار بن عياض الأسلمي ، وهو صحابي ، دعا عثمان ووعظه ونصحه وأعذر إليه ، وأمره بخلع نفسه ، وإنه لفي ذلك إذ رمي بسهم أو حجر فقتل.
فنادى الثائرون : ادفع لنا يا عثمان قاتل صاحبنا فنقيد منه ، فقال عثمان : ما أعرف له قاتلاً فأدفعه إليكم ، أأدفع إليكم رجلاً ذبّ عني وأنتم تريدون قتلي.
فاستشاط الثائرون غضباً ، واقتحموا الدار اقتحاماً مروعاً من غير بابها ، لأن الإمام الحسن بن علي عليهماالسلام كان مرابطاً في باب الدار يحامي عن عثمان ، وهجم الثائرون هجوماً جنونياً على الدار ، ينهبون ما فيها ، ويحرقون أبوابها ، وخرج أهل الدار يقاتلون ، فجرح عبد الله بن الزبير جراحات بليغة ، وصرع مروان حتى ظن به الموت ، وقتل آخرون وهم يدافعون عن عثمان ، وانتهى الأمر بقتل عثمان بصورة شنيعة لا أسيغ تفصيلها.
وبقتل عثمان فتح على المسلمين باب شر عظيم ، فقد أنقسم المسلمون شِيّعاً وأحزاباً ، وتضعضعت هيبة الحكم ، ووهن سلطان الإسلام ، وأصبح حكم المدينة بيد الثائرين لا طول لأحد فيها ولا حول.
وقد أوجز عليّ عليهالسلام أمر عثمان والناس بقوله :
« استأثر فأساء الأثرة ، وجزعتم فأسأتم الجزع ، ولله حكم واقع في المستأثِر والجازع » (١).
وهذا من أبلغ الكلام وأفصحه في تصوير الحال.
__________________
(١) ظ : في نصوص هذا الفصل ووقائعه التأريخية والسياسية كلاً من :
ابن الأثير / الكامل في التأريخ + الأمين الحسيني العاملي الشقرائي / أعيان الشيعة + البلاذري / أنساب الأشراف + الجاحظ / البيان والتبيين + إبن حجر / الصواعق المحرقة + ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة + هاشم معروف / سيرة الأئمة الأثني عشر + ابن خلدون / تأريخ ابن خلدون + إبن سعد / الطبقات + الطبراني / المعجم الكبير + الصدوق / الخصال + الطبرسي / مجمع البيان + الطبري / تأريخ الرسل والملوك + طه حسين / الفتنة الكبرى + إبن أبي طيفور / بلاغات النساء + عبد الفتاح عبد المقصود / الإمام علي + أبو الفدا / المختصر في أخبار البشر + ابن قتيبة / الإمامة والسياسة + قدامة بن جعفر / الخراج وصنعة الكتابة + القندوزي / ينابيع المودة + الدسوقي / أيام طه حسين + المسعودي / التنبيه والأشراف + المفيد / الإرشاد + المفيد / الافصاح في إقامة علي بن أبي طالب + أبو نعيم / حلية الأولياء + الواقدي / المغازي / اليعقوبي / التأريخ.
الفصل الثالث
عليٌّ في قيادته للأمة
١ ـ الثورة ترشح الإمام للخلافة ... والإمام يستقرئ الغيب المجهول
٢ ـ إستقبال خلافة الإمام بين المحرومين والارستقراطيين
٣ ـ المتمردون في مجابهة الإمام متظاهرين بالثأر لعثمان
٤ ـ قيادة الناكثين بين الترددّ وإقتحام مشارف البصرة
٥ ـ حربُ الجمل ... وهزيمة المتمردين
٦ ـ عليٌّ في البصرة ... وسيرة رسول الله (ص)
٧ ـ عليٌّ يتخذّ الكوفة عاصمةً ... ويقدّم طلائعه إلى صفين
٨ ـ معركة صفين ... وإنحياز الخوارج
٩ ـ الوفاءُ بشأن التحكيم ... ومعركة النهروان
١٠ ـ معاوية والخوارج يقتسمان الأحداثَ الدموية
١١ ـ ظواهر العدل الإجتماعي عند الإمام تقلب الموازين
١٢ ـ المهمات القيادة السياسية ... والتعليمات العسكرية لأمير المؤمنين
١٣ ـ تهذيب النفس الإنسانية لدى الإمام في إرادة الحكم الإسلامي
١٤ ـ عليٌّ ومناوؤه ... حتى إستشهاد الإمام عليهالسلام
(١)
الثورة ترشح الإمام للخلافة ...
والإمام يستقرىء الغيب المجهول
إِستيقظت المدينة المنورة صبيحة مقتل عثمان (رض) شاحبة الظلال ، باهتة الألوان ، يسودها الفزع والقلق ، ويغشاها الهول والإضطراب. فالحدث خطير في أبعاده ، وجرأة الثوار كبيرة فيما أقدمت عليه ، والناس في حيرة من أمرهم ، ينتاب بعضهم تأنيب الضمير في خذلان عثمان ، ويستبشر آخرون بمقتل عثمان ، ويأسى سواهما لما حلّ بعثمان ، بينما يفكر نفرٌ يسير بمصير الإسلام وحرمة البلد الذي يحكمه الثائرون ، فالأهواء ـ كما ترى ـ متباينة ، والوضع العام في شقاق مرير ، واللغط يشق عنان السماء.
والحاجة الآنية أن لا بد للناس من إمام يخلف الخليفة المقتول ، وقائد تلتقي برحابه أفئدة الناس ، والأمر كله في المدينة لأبي حرب الغافقى زعيم المصريين ، يؤم الناس في الصلاة ، ويتصدر القيادة الثائرة ، ويشرف على إدارة الحكم العرفي دون كفاية أو خبرة ، وينظر في الناس وهم يلتفون حول طلحة والزبير تارة ، ويهتفون باسم الإمام علي تارة أخرى ، ولا رأي سوى هذين.
ولكن أصابع الاتهام تشير إلى طلحة والزبير بكثير من الحذر والشفقة ، تحذر منهما ، وتشفق على المسلمين من إمارتهما ، فكلٌ منهما
قد أجلب على عثمان حتى قتل ، وقد حاولا رفع هذه التهمة بكثير من الدوران الذي لم يخفَ على الناس قريبهم وبعيدهم ، فهما صاحبا عثمان بالأمس ، كثّرا عليه ، وخذّلا عنه ، وألبّا الناس وأسلماه ، فهما في حرج من نصب أنفسهما ، وترشيح ذاتيهما لمقامه.
وكان المصريون ـ وهم زعماء الثورة ضد عثمان ـ أكثر الناس حذراً ، وأشدّهم تحرزاً ، فضيقوا على طلحة والزبير فسحة الأمل ، وبادروا إلى إتخاذ القرار المناسب ، وتوجهوا إلى أهل الحل والعقد من بقية المهاجرين والأنصار في المدينة ، وقالوا : يا أهل المدينة : إنكم أهل الشورى ، وأنتم تعقدون الإمامة ، فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع ».
فهتف الناس في ذلك الحشد « عليّ لنا رضى ، نحن به راضون ».
قالوا ذلك جميعاً بما فيهم طلحة والزبير ، لم ينافس علياً أحد في الترشيح ، ولم ترشح الجماهير سواه للخلافة ، وقال ممثلهم عمار بن ياسر :
« أيها الناس : إنا لن نألوكم خيراً وأنفسنا إن شاء الله ، وإن علياً من قد علمتم ، وما نعرف مكان أحد أحمل لهذا الأمر منه ، ولا أولى به ».
ورضي الناس بهذا العرض وأمنوا عليه ، وانطلقوا إلى أمير المؤمنين وهو في عزلته ، وقالوا :
« يا أبا الحسن : إن هذا الرجل قد قتل ، ولا بد للناس من إمام ، ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك ، ولا أقدم سابقة ، ولا أقرب من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وتأبّى عليٌّ على القوم ، ورّد الطلب برفق وأناة قائلاً :
« دعوني والتمسوا غيري ، فأنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً ».
وازداد الإصرار ، وتكرر الطلب ، فعاود عليّ الامتناع قائلاً : « اتركوني فأنا كأحدكم ، بل أنا أسمعكم وأطوعكم لم وليتموه أمركم ».
وكان عليّ عليهالسلام زاهداً في الخلافة ، وهو يتطلع إلى الأفق البعيد فيجد المناخ السياسي مضطرباً ، ويلحظ الناس في اندفاع وغضب ، ويشاهد أولي الأمر بين رغبة ورهبة ، ويرى الوازع الديني ضعيفاً ، والعنف الثوري قائماً ، فيقول لهم : « لا حاجة لي في أمركم أيها الناس ، أنا معكم ، فمن اخترتم فقد رضيت به ». ويعجب الجمع من هذا الإباء ، ويعزّ عليهم هذا الرفض القاطع ، ويشعر الإمام بحيرة القوم ، فيعلل لهم سبب امتناعه ، ويوضح علة إصراره :
« دعوني والتمسوا غيري إيها الناس ، إنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان ، لا تثبت عليه العقول ، ولا تقوم له القلوب ».
وهنا يتجلى البعد السياسي الحصين عند الإمام ، فهو يغوص إلى الأعماق ، وهو يستقرئ الغيب المجهول ، وهو يتوجس من الأحداث القادمة ، ويستخرج دغلها وغشها ودناءتها ، وهو ينفذ إلى خفايا القلوب ويسبر أغوارها فلم يكن ليعجبه الحكم ، وهو مجهول المعالم ، ولم تكن تستهويه الخلافة وهي محفوفة بالتنازع ، وما كان ليستسلم لأهواء الناس وهي مشبوبة العواطف ، وإنما كان يريد أن يخضع لمنطق العقل ويخضع الناس له ، ويحكم بسلطان المنطق ويحمل الناس عليه ، وهو الآن يشاهد الثورة جامحة لا تني ، والاندفاع هادراً لا يهدأ ، والمدينة
يحكمها الثوار ، والناس تقترب من الفتنة ، وهو يريد أن يغير هذه الظواهر ، فيقطع مادة الثورة ، ويحمل الناس على الجادة ، ويستقبل بالأمر السبيل المستقيم ، ولكن الناس لم يتركوه ، وانثالوا عليه ، وتمسكوا به :
« فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ، ينثالون عليّ من كل جانب ، حتى لقد وطئ الحسنان ، وشق عطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم ».
هكذا صور الحال بدقة متناهية ، فما هذا الإصرار من الناس إلا إستنفاراً لا مناص عنه ، وما هذه الغضبة الصارخة إلا نتيجة الألم الدفين ، وما هذا التصوير البليغ إلا بياناً للحال ، فهو بين أن يستجيب للثقة النابعة من الصميم ، وبين أن يتنكب مزلقة النوازل القادمة ، وبين أن يلقي حبلها على غاربها ...
خيارات أهونها الصعب ؛ وبينا هو في هذا التفكير الجدي ، وإذا بالأشتر يندفع قائلاً :
« ننشدك الله ، ألا ترى ما نرى ، ألا ترى ما حدث في الإسلام ، ألا ترى الفتنة ، ألا تخاف الله ».
وكان صوت الأشتر جريئاً يستأهل التفكير ، ومجلجلاً يقطع الصمت ، وعنيفاً يدعو إلى الحسم ، وضع الإمام أمام مسؤوليته القيادية ، ليتدارك أمر الإسلام ، ويقطع دابر الفتنة ، فانطلق الإمام يستجيب معللاً ومقرراً :
« قد أجبتكم لما أرى منكم ، ألا فاعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ».
وكانت الاستجابة مقترنة بحملهم على سبيل رسول الله ليس غير ، وهو ما يعلمه الإمام.
استبشر الناس بهذا القرار الحاسم ، ووافقوا على النهج الذي يختطه الإمام ، وهبوا لمبايعته ، ولكنه أبى وقال : « إن كان لا بد من ذلك ففي المسجد ، فإن بيعتي لا تكون خفياً ، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ، وفي ملأ وجماعة ».
وكأن علياً أراد ببيعته الإصحار لا الإسرار حتى لا يدعي أحد الإكراه ، وكأنه أراد المهاجرين والأنصار حتى لا يتخلف أحد ، وكأنه أراد كما في بعض المرويات أهل بدر بخاصة ، فلم يبق بدري إلا أتى علياً ، وقالوا له جميعاً :
ما نرى أحداً أحق بها منك يا أبا الحسن. وكان ما قالوا عين الصواب فهم يعرفون عليّا وسابقته. وقد جاؤوا بعلي عليهالسلام إلى المسجد النبوي ، وتمت بيعته جهاراً على كتاب الله وسنة نبيه ، فقال علي : « اللهم إشهد عليهم ».
وكانت البيعة رضا للمهاجرين والأنصار ، وبمباركة أهل بدر خاصة ، وكانت رضا للثوار من الأمصار والأقاليم ، وتخلف عن البيعة من طمع بالخلافة ، أو انحرف عن الإمام ، أو أظهر الاعتزال ، وهم جماعة يعدون بالأصابع ، فما ألح عليهم الإمام ، وفي طليعتهم سعد بن أبي وقاص ، فقد أبى أن يبايع وقال للإمام « ما عليك مني من باس » وعبد الله بن عمر بن الخطاب أبى أن يبايع فطلب إليه الإمام أن يقدم كفيلاً ، فما وجد كفيلاً أو أبى أن يقدم كفيلاً ، فقال الإمام : خلوه وأنا كفيله ، والتفت إليه قائلاً : « ما علمتك إلا سيىء الخلق صغيراً وكبيراً »
وأبى البيعة زيد بن ثابت وهو عثماني الرأي فيما يزعم ، ومحمد بن مسلمة وهو يحب أن يعتزل فيما يرى ، وأسامة بن زيد ، وقد انحرف عن الإمام منذ أن أمّر ، والبيت الأموي بعامة وفي طليعتهم مروان بن الحكم ولم يكن هناك ، وحسان بن ثابت الذي هنأ الإمام بالغدير في حياة النبي ، وانحرف عنه ، وحرضّ الناس عليه.
ما استكره الإمام أحداً على البيعة ، وكف عنهم ، وأبى أن يعرض لهم أحد بسوء ، فما كانت البيعة لينقصها هذا العدد الضئيل ، وهي ليست من الضعف بأن يؤثر عليها هذا النفر المحدود.
تمت البيعة لعلي عليهالسلام ، وكانت رضا لعامة المسلمين إلا هذا النفر الشاذ ، وكان حرياً أن تستقيم له الأمور ، لأنه ما أرادها ولكنها أرادته ، وما تزين بها ولكنها إزدانت به ، فهو أكبر منها قدراً ، وأعلى منزلة. والجدير بالذكر أن الإمام قد أوجز الحال فيها على الشكل الآتي :
« بسطتم يدي فكففتها ، ومددتموها فقبضتها ، ثم تداككتم عليّ تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها ، حتى انقطعت النعل ، وسقطت الرداء ، ووطىء الضعيف ، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير ، وهدج إليها الكبير ، وتحامل نحوها العليل ، وحسرت إليها الكعاب ».
وقد تمت البيعة لأمير المؤمنين بعد مقتل عثمان بخمسة أيام وكان أمام أمير المؤمنين جملة من المشكلات المهمة ، والقضايا العاجلة التي يجب أن يبتّ فيها فوراً ، وقد يطول الحديث عنها ، ولكنه حسم قضيتين مهمتين :
الأولى : سياسة الحكم الجديد ، فقال في أول خطاب رسمي له :
« أيها الناس إنما أنا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما عليكم ، وإني حاملكم على منهج نبيكم ، ومنفّذ فيكم ما أمرت به ».
وقد وضح المنهج الإسلامي في اتجاه علي عليهالسلام وهو أنه كأحد المسلمين لا أكثر ولا أقل إلا أنه قائدهم ، وهو المنهج الديمقراطي الحديث بعينه هذا اليوم. والثاني أنه يحملهم على منهج النبي وسبيلة لا تأخذه في ذلك لومة لائم.
الثانية : إصلاح ما أفسده عثمان من المال ، واسترجاع ما اقطعه بغير حق ، فقد خطب الإمام في اليوم الثاني لبيعته وقال :
« ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان ، وكل مال أعطاه من مال الله ، فهو مردود في بيت المال ، فإن الحق القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته وقد تزوج به النساء ، ومُلِكَ به الإماء لرددته إلى حاله ، فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق ».
ثم نفّذ الإمام ما قال ، وأمر بقبض كل سلاح تقوّى به عثمان على المسلمين ، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة ، وأن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب أصحابها ، وبالكف عن أموال عثمان الخاصة به.
وقد وضحت سياسة الإمام في الحكم بأنه سائر على منهج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يحيد عنه ، وفي المال بأن يعود لبيت المال.
وهنا تنبه أصحاب المطامع والمآرب والإمتيازات السابقة أن لا حياة لهم مع الإمام ، فقد قال الإمام مباشرة :
« فأنتم عباد الله ، والمال مال الله ، يقسم بينكم بالسوية ، ولا فضل فيه لأحد على أحد ، للمتقين عند الله أحسن الجزاء ، فإذا كان الغد فاغدوا علينا إن شاء الله ، ولا يتخلفنّ أحد منكم عربي أو عجمي كان من أهل العطاء ».
وقد تحركت في هذا الإعلان الصريح مكائد القلوب ، واستوحشت منه ضمائر أهل الطمع ، وتنكر له أصحاب الملايين.
فبدأت الفتن تترى كقطع الليل المظلم ، وعليّ في أول الطريق.