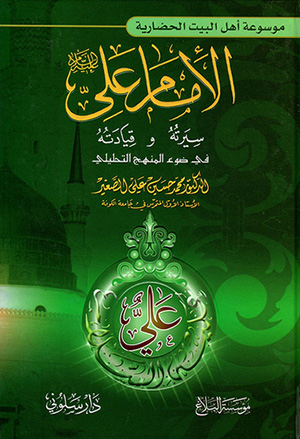الدكتور محمد حسين علي الصّغير
الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٠
ولكن كلمته هذه انتشرت في الآفاق انتشار النار في الحطب الجزل ، وألفت لها سامعين ومنفذين ، فيستقبلها المسلمون الغيارى بالأسف حيناً ، وبالتعليق السري حيناً آخر ، وبالإنكار العلني أحياناً ، فقد أدرك الناس فداحة ما أقدموا عليه ، وأيقنوا بإفلات الأمر ، وعلموا بما أنطوت عليه نيات القوم ، فبين متحمس صابر ، وبين متأفف ناقم ، وبين متخاذل صامت ، والكل بين بين ، وكان هذا بعد فوات الأوان ، فقد عض عثمان بناجذيه على السلطان ، وفوض أمور الدولة إلى بني أمية بعامة ، وإلى مروان بن الحكم بخاصة.
وبدأ انتهاك حرمة الإسلام في مسيرة عثمان ، وظهر ما كان خافياً من تصرف ولاة الأمور ، فالمانصب تقتسم بين المؤيدين والمقربين والأغمار ، والأموال تحتجن من حلها ومشتبهها ، والأحكام يتلاعب فيها دونما الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، والإرتجال في اتخاذ القرار لا يمّت إلى سيرة الشيخين من قريب أو بعيد ، والمسلمون بادئ الأمر بين هنات وهنات يقدمون رجلاً ويؤخرون آخرى والخليفه الجديد ينعم بالذهب والفضة ويجور بالاقطاع والعقار ، حتى نسي المسلمون شظف العيش وعسر الحياة ، وحتى انغمر شباب المسلمين بالبذخ والترف والإسراف ، فها هي الفتوح تتحفهم بالغنائم والجواري ، وها هي المدينة تتراقص باللهو والحياة الفارهة ، وها هم أبناء المهاجرين يتخذون الدور والقصور ، وها هم الأمويون في بلهنية من العيش والدعة ، حتى استفحل الأمر ، وضاق الإناء بما فيه ، فبدأت تباشير المحنة وطلائع الفتنة تقترب من الخليفة الذي لا يضع شيئاً ولا يرفع آخر إلا باستشارة مروان ، وقد يقضي مروان بما شاء دون علم منه ، وعليٌّ عليهالسلام يشاهد هذا كلّه ، ولا حول له ولا طول.
ولم يكن من علي عليهالسلام خلاف لعثمان (رض) فقد اعتاد مرارة الصبر ، وشجا التحمل والمكاره ، ولم يشأ أن يأخذ حقه بالعنف ، ولا استساغ أن يعلن الثورة ، وإنما كان كأحد الناس بايع عثمان فيمن بايعه ، وصبر على أعماله فيمن صبروا ، وإعتزل حياة الحكم والسلطان ، مؤثراً مصلحة الإسلام العليا ، وهي هدفه الأول والأخير ، يستشار لماماً فيشير سداداً ، ويتجاهل فيحلم كاظماً ، وتنتهك الحرمات فيحتج غضباً ، وتستلب حقوق المسلمين فيجاهر بالغضب لذلك ، ويتشاغل بنواضحه مرة ، وبمزارعه الموقوفة مرة أخرى ، إلا أنه حريص كل الحرص على أداء رسالته فقهاً وإفتاءً ما وسعه إلى ذلك السبيل ، كما حرص على النصح الكريم لعثمان في حدود لا تسمح له بأكثر مما أعطى ، ولكن السيل الجارف أتى على كل القيم التي من شأنها أن ترتفع بالإنسان إلى مستوى المسؤولية ؛ وكان مصدر هذا السيل المتدافع حاشية السلطان ، وأسرة السلطان ، وضعف السلطان ، فاحتجزوا لأنفسهم كل شيء دون المسلمين ، إستصفوا الأموال وتقاسموا الفيء ، واستبدوا بمراكز الدولة المهمة ، ونبذوا كتاب الله ظهرياً ، فتذكر الناس قول عمر عند الموت لعثمان : « كأني بك ؛ وقد قلدتك قريش هذا الأمر ، فحملت بني أمية ، وبني أبي مُعيط على رقاب الناس ، وآثرتهم بالفيء فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب ، فذبحوك على فراشك ».
وكأن عمر كان ينظر في مرآة الغيب لأعمال الرجل ، واستيلاء بني عمومته الأمويين على كل شيء ، وما ينتظر هذا الاستيلاء من مصير محتوم للخليفة المحكوم ، وكان الأمر كما تنبأ به عمر (رض).
لقد نقم المسلمون على عثمان جملة من القرارات الجائرة في المال والتولية والأثرة والإبعاد والتقريب والنفي واللامبالاة في كل شيء
مما ذكره جميع المؤرخين دون استثناء ، ومما يطول معه الكلام ، ولا يستوعبه البيان الموجز.
لذا رأيت أن أشير إليه في بعض المظاهر العامة دون الدخول في التفصيلات المضنية التي ارتسمت علائمها في التأريخ طيلة أيام عثمان في الحكم ، فلم تعد سراً حتى يذاع ، ولا لغزاً فيحل ، فهي من المتسالم عليه جملة وتفصيلاً ، والإشارة الهادفة إليه قد تغني عن الإسهاب بما هو متواتر مشهور.
في طليعة ما نقم المسلمون على عثمان ومنه ، هذه الإجراءات التي أصنفها على سبيل التنظير لا الحصر :
أولا : الأموال والفيء ؛ لم يسر عثمان على سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في بقسيم المال بالسوية ، ولا صرف الفيء في مستحقيه من الرعية ، ولا راعى في ذلك سيرة أبي بكر في التسوية ، ولا سيرة عمر في التفاضل ، وإنما خصّ بذلك أسرته ومقربيه دون مسوغ شرعي :
١ ـ إفتتح المسلمون أرمينية في عصره ، فأخذ خمس الغنائم كله ، وكان عظيماً ، ووهبه إلى مروان بن الحكم ، فقال عبد الرحمن بن جنيد الجمحي بيته المشهور :
|
وأُعطيتَ مروان خمسَ البلادِ |
|
فهيهات سعيكَ فِيمَن سعى |
٢ ـ افتتح المسلمون إفريقيا في عهده ، فأعطى عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة جميع ما أفاء الله به على المسلمين من الغنائم لتلك البلاد الواسعة.
وعبد الله هذا أسلم ظاهراً ، وكان يحرّف الوحي القرآني ، وارتد كافراً وعاد إلى مكة ، وأهدر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دمه يوم الفتح ، وتشفع فيه
عثمان عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسكت النبي بغية أن يقتله أحد المسلمين فهو مهدور الدم ، وتواكل المسلمون بذلك ، فأخذه عثمان وانصرف على كراهية من النبي.
٣ ـ قال ابن أبي الحديد : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تصدق بموضع سوق في المدينة يعرف بنهروان على المسلمين ، فأقطعه عثمان إلى الحرث بن الحكم شقيق مروان ، وأقطع عثمان مروان فدكاً ، وكانت لفاطمة الزهراء عليهاالسلام.
٤ ـ أعطى عثمان أبا سفيان بن حرب مائة ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بمائة ألف ، فاحتج زيد بن أرقم صاحب بيت المال ، وجاء بالمفاتيح ووضعها بين يدي عثمان ، وقال : والله لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً عليه ؛ فقال عثمان : ألق المفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك ، فألقى زيد بن أرقم مفاتيح بيت المال.
٥ ـ أتاه أبو موسى الأشعري بخراج العراق والسواد وكان مالاً عظيماً ، فوزعه عثمان على بني أمية كله.
٦ ـ حمى عثمان المراعي حول المدينة المنورة كلها ، ومنع عنها مواشي المسلمين ، وأباحها لمواشي بني أمية خاصة.
٧ ـ طلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد شيئاً من المال ، فأعطاه أربعمائة ألف درهم من بيت مال المسلمين.
٨ ـ أنكح عثمان الحرث بن مروان ابنته عائشة ، وأعطاه مائة ألف درهم من بيت المال.
هذا ما كان معروفاً علناً لدى المسلمين كنماذج من البذخ والسرف بالمال والحقوق ، أما صلاته السرية وعطاياه من وراء الستار فكانت
تكلف بيت المال مئات الآلاف سنوياً ، وما كان يوصله مروان إلى الحاشية غير معدود بالحساب فبيت المال بيد مروان.
ثانياً : في المجال السياسي والإداري ؛ اشتد غضب المهاجرين والأنصار على مخالفة عثمان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما قضى من شؤون إدارية ، وأخرى سياسية كان أبرزها :
١ ـ ما تم من إرجاعه للحكم بن أبي العاص ، وكان يؤذي رسول الله ويشتمه ويحكي مشيته مستهزئاً ، ويخلج بأنفه وفمه ويقلد بحركاته النبي ، فالتفت النبي إليه يوماً وأبصر ما يصنع فقال : « كن هكذا ». فبقي إلى أن مات يختلج في مشيته وحركاته.
وأطلع على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في بعض حجر نسائه اختلاساً ، فخرج إليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مغضباً ، وقال : « من عذيري من هذه الوزغة اللعين ، لو أدركته لفقأت عينه ، والله لا يساكنني وولده في بلد واحد ».
وأخرجهم جميعاً إلى الطائف ، فرده عثمان إلى المدينة جهاراً هو وولده وأسرته ، فأنكر ذلك المسلمون ، وعظم عليهم كثيراً ، ولم يكتف عثمان بهذا القرار بل ولاّه صدقات قضاعة فبلغت ثلاثين ألفاً فوهبها له.
وقد رفض ابو بكر وعمر إرجاع الحكم هذا إلى المدينة بشفاعة عثمان ، وقال كل منهما : ما كنت لآوي طريد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٢ ـ وصف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأنه : عدو الله وعدو رسوله ، وأمر بقتله ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة ، فلما تولى عثمان ولاه على مصر سنة خمس وعشرين وبقي فيها إلى سنة أربع وثلاثين حينما ثار عليه محمد بن أبي حذيفة بن عتبة فتولى عنه إلى عسقلان ، وأقام فيها حتى قتل عثمان.
وكان ابن أبي سرح في مصر ، يعيش حياة الترف والبذخ ، ويحيا ليالي المجون والخلاعة ، ويقتنص ما لذ وما طاب من غنائم المسلمين ، ويحتجز ذلك لنفسه ولحاشيته طيلة عشر سنوات من الحكم الرخي اللذيذ.
٣ ـ ولّى عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط حاضرة الكوفة وكان يعرف هو وإخوته بصبية النار ، وسبب ذلك أن النبي قد أمر بقتله وكان أسيراً في غزوة بدر ، فقال : أأقتل دون قريش؟ فمن للصبية يا محمد؟ فقال النبي : النار.
والوليد أخ لعثمان من أمه ، وقد نشأ في أحضانه ، وأسلم يوم الفتح ظاهراً ، وتولى للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صدقات بني المصطلق ، وما لبث أن عاد إلى المدينة ، وأخبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإرتداد هؤلاء عن الإسلام زوراً وبهتاناً ، واستطلع النبي الحال فوجدهم بخلاف ذلك ، ونزل فيه قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (١).
فسمي يومئذ بالفاسق ، فقربه عثمان ، وأعلا منزلته ، وكان يجلس مع عثمان على سريره ، وولاه الكوفة وعزل عنها سعد بن أبي وقاص ، فلما دخل على سعد ومعه كتاب الولاية ، قال سعد : « والله لا أدري أكست بعدنا ، أم حمقنا بعدك » فقال الوليد : « لا تجزعن أبا إسحاق ، إنه الملك يتغداه قوم ، ويتعشاه آخرون » وكان حرياً إلى أن يكشف ما هو الواقع في الأمر فهو الملك لا أكثر ولا أقل فما كاس يوماً ولا حمق سعد.
__________________
(١) سورة الحجرات ، الآية : ٦.
وتسلم الوليد ولاية الكوفة ، وكان خليعاً ماجناً يتجاهر بالخمرة ، ولا يفيق من السكر ، وهو إمام القوم وصلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات ثم تهوع بالمحراب ، وأضاف إلى ذلك الأفاعيل وأتبعها بالأباطيل ، فضج أهل الكوفة عليه وعلى عثمان ، وتشدد عليّ عليهالسلام فأمر بإقامة حد السكر عليه ، وعزله عثمان بعد اللتيا والتي ، وأخلفه بسعيد بن العاص ، فكان أدهى وأمر ، وأنكى وأشر ، فجرت بينه وبين أهل الكوفة خطوب انتهت بالثورة المسلحة على عثمان.
٤ ـ أقر عثمان معاوية على الشام كلها بما فيها حمص وفلسطين ، فاستهتر بالحكم ، وإستبد بالولاية ، وسار في الناس سيرة ملوك الروم حتى عدّ من الجبارين في الأرض ، وعمد إلى بيت المال فانتهبه انتهاباً ، وأسرف على نفسه إسرافاً كثيراً ، وتحين إلى شراء الضمائر بالمال ، وإمتلاك الذمم بالإمارات الصغيرة وخنق الأنفاس بالإرهاب وهو يتصنع الحلم ، وبذر أموال المسلمين وهو يتظاهر بالكرم ، وبنى الخضراء وأنفق على بنائها عائدات الفيء والخراج بملايين الدراهم أو الدنانير الذهبية ، وكان يكثر من القول : « إن الأرض لله ، ونحن خلفاء الله في أرضه ، فما أخذناه من الأموال فهو لنا ، وما تركناه فهو جائز لنا ».
وأنكر المسلمون هذا القول ، وأنكروا منه تلك الأعمال التي أرتكبها مخالفاً بها الشريعة ، وأنكروا منه التلاعب بحقوقهم والإعتداء على ممتلكاتهم ، والإستهانة بأقدارهم ، وشكوه إلى عثمان فما غير ولا بدل ، ووسطوا له علياً ، فما استمع ولا أقال.
٥ ـ أطلق عثمان لبني أمية ومسلمة الفتح العنان في تخير آفاق الدنيا ، وتولي شؤون الحكم ، فالوليد بن عقبة على الكوفة فسعيد بن العاص ، وعبد الله بن عامر بن كريز ابن خالته على البصرة ، وعبد الله بن
سعد على مصر ، ويعلى بن أمية على اليمن ، وأضرابهم في الولايات الأخرى ممن لم يكونوا في عداد المسلمين قَدماً وقُدماً ، فهم بين الناس من أغمار الناس ، وظل أبناء المهاجرين والأنصار تبعاً لهم وعالة على أنفسهم ، لا يتمتعون بطائل ، ولا ينعمون بنائل ، فهم من سواد الناس بلا عمل مناسب ، ولا مركز محسود ، واستبد أبناء الطلقاء بكل شيء.
ثالثاً : ضعف السلطان ؛ كان ابو بكر (رض) ليناً في غير ضعف ، وكان عمر (رض) شديدا في عنف وغير عنف ، وكان أبو بكر يمزج لينه بصرامة وحزم ، وكان عمر يمزج شدته بصيحته ودرته ؛ وقد اعتاد الناس هذا اللون من الحكم ، فالحاكم هو الآمر الناهي ؛ وحينما ولي عثمان (رض) أختلفت الحال ، فقد كان رفيقاً مع أسرته ، متسامحاً مع حاشيته ، حتى عاد بين هذه الرقة وذلك التسامح ضعيفاً مستضعفاً ، ولم يبق لعثمان في الحكم إلا الأسم ، وصار رمزاً شاخصاً للخلافة ليس غير ، وسيطر مروان بن الحكم سيطرة تامة على السلطان ، فادار الحياة السياسية والإدارية كما يشاء وبما يشاء ، حتى ظهر للعيان أن الخليفة محكوم عليه ، وأن الشؤون العليا للدولة يستبد بها مروان استبداداً تاماً حتي قيل أن ختم عثمان الذى يمضى به الامور كان بيد مروان وأفاق المسلمون على هذه الحقيقة ، فرأوا التولية والعزل يصدران عن مروان ، ورأوا المال والفيء يقسم بإشارة مروان ، ورأوا الأوامر تنفذ عن رأي مروان ، ولم يكن مروان محبباً للنفوس ، ولم يكن ورعاً في أمانته ، ولم يكن قديراً على إدارة دفة الحكم ، وما زال المسلمون ينظرون إليه وإلى أبيه بأنه طريد رسول الله وابن طريده ، وما زالت النظرة إلى مسلمة الفتح فيها كثير من الإستهانة ، فهو ليس هناك كما يقال.
وتوسع المسلمون في الفتوح ، وترامت أطراف الدولة ، وكثرت
الحاجة إلى الخبراء والإداريين ، وإذا بمروان يعيّن من يشاء ، ينصب من يشاء ويعزل من يشاء. وكان المقربون لمروان أكثر الناس عائدية في المناصب والدواوين والإقطاع ومراكز السلطة ، وكان المستهينون بمروان أبعد الناس عن الحباء والعطاء ومواطن القوة ، فتمتع المستغلون لمروان بما وسعهم من الأثرة والنفوذ والتقلّب بأحضان الإمتيازات ، وحرم المستضعفون من أبسط حقوقهم في الجاه والمال والمنافع ، وكان المستغلّون هم القلة من الناس ، وكان المحرومون هم الأغلبية العظمى من المسلمين.
وأدرك المسلمون هذا التفاوت ، وعز عليهم هذا الاستئثار ، وجحفهم ذلك الاستبداد ، وكان مروان وراء ذلك كله أو جلّه ، فاستعانوا على تغيير ذلك بعلي ، فسفر بينهم وبين عثمان ، فما استمع عثمان للنصح ، ولا استبعد مروان عن التسلط ، ونعت نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان على عثمان تفويض الأمر إلى مروان ، وطلبت إليه العمل بما يشير عليه علي عليهالسلام ، ولكن الرجل كان رحيماً بذوي رحمه ، رقيق القلب معهم ، كثير الحدب عليهم ؛ فما غيّر ولا بدّل ، ولا أجاب ولا استجاب.
وتناهى إلى المسلمين كل ذلك ، وأكثر من كل ذلك ، فغضب منهم من غضب ، ونقم على عثمان من نقم ، وتعكر الجو ، ودبت في النفوس بوادر الثأر لما يحدث ، وانطوى تفكير الناس على كثير من التخطيط المنظم وغير المنظم ، وكانت الجمرة تتقد من وراء الرماد.
وكان مروان يسمع ويرى ، فما تغير موقفه ، ولا نظر في أمره وأمر الخليفة المحكوم ، بل ازداد إمعاناً في الأثرة ، وتولى تسفيه آراء المعارضة لدى عثمان ، وأمّن له عثمان ، وأيد بنو أمية ، وتراكم السوء
على السوء ، وتعقدت الأحوال حراجة ، واندفع المرجفون بعثمان في المدينة يستقبلون المرجفين به في الأمصار ، يسمعون منهم ويستمعون إليهم ، وعثمان في غفلة أو تغافل مما يراد به ومنه ، حتى انتقض عليه الداخل ؛ وتألب عليه الخارج ، واستحكمت بوادر الفتنة ، وبدت علائم الثورة ، فقد وعن المسلمون أن الخليفة مسيّر لا مخيّر ، وأن مروان وحده وليّ الأمر ، وأن الكتب تصدر عن مروان بختم عثمان ، وأن الحرمات تنتهك بإرادة مروان ، فمروان كل شيء عند عثمان ، ولا شيء لعثمان مع مروان.
وقد صور أمير المؤمنين إثرة عثمان ، واستئثار بني أمية خير تصوير ، وعزا إلى ذلك انتقاض أمر عثمان فقال : « إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع ، إلى أن إنتكث فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته ».
وقد أشار علي عليهالسلام مضافاً لما تقدم إلى حياة الرفاهية ، ومصادر الثروة ، ودواعي البطنة ، مما تقدم بعض ذكره ، ويأتي بعضه الآخر ، وهذا ما جرّ إلى الدواهي التي افتتن بها الصحابة ، وتوجهوا معها إلى اكتناز الأموال ، وتبني الإقطاع ، وتعدد الضياع ، وتملك العقار ، مما لم يكن من نظام الإسلام في شيء ، ولا من سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم التي ألفها الناس ، ولا من سيرة الشيخين التي اتسمت بالكفاف ، وهذا الملحظ هو الظاهرة الرابعة التي سنتحدث عنها.
رابعاً : التفاوت الطبقي وتضخم الملكية الفردية ؛ أطلق عثمان العنان للملكية أن تتضخم ، وللثروة أن تتكاثر ، وللإستقراطية القرشية أن
تتحكم في المال ، وقد مهدّ لهذا الحدث بقرارين مهمين ما كانا من ذي قبل :
الأول : سماحه لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار أن يتنقلوا بين الأقاليم والبلدان ، وألغى الحضر السياسي الذي اتخذه الشيخان عليهم من ذي قبل في مغادرة المدينة.
الثاني : وسع عثمان على ذوي الثروة بأن لهم الحق المشروع بنقل فيئهم إلى حيث يقيمون من البلاد ، وكان أثر هذا أن تم استبدال مال بمال ، وضياع بضياع ، وعقار بعقار ، وتنافس الصحابة في ذلك ، فمن أراد بيع أرض في الحجاز تم له ذلك بشراء أرض في العراق ، ومن رغب بتضخم ماله في الحجاز ، باع سهمه من فيئه في الأقاليم واستثمره فيما يشاء ، وكان هذا يستدعي الأيدي العاملة والطبقة الناهضة بالمهمات الجديدة ، وما إن وضع هذا القرار موضع التنفيذ حتى رأينا الصحابة يسارعون باستبدال ما كان لهم من أراضٍ في الأقاليم المفتوحة ، بالأراضي في الحجاز والعراق واليمامة ، وكانت مهمة استصلاحها زراعياً تلقى على عاتق أولئك النفر من الموالي والرقيق والأسارى ، فانتشروا في بلاد العرب ، وحققوا لأمراء العرب ما أرادوا حرثاً واستثماراً وعائدية أملاك عريضة ، ونجم عن ذلك تسرب تقاليد لم تكن ، وحضارات لم تعرف ، إلى إلى هذه البلاد وتلك ، وكثر العبيد والموالى فافسدوا ذائقة العرب فى عاداتهم فانتثر الترف والبذخ وشاع الغناء والمجون ، فانتقل المسلمون من مناخ الدعة إلى الإضطراب ، ومن حياة الكفاف إلى الإسراف ، ومن الإعتماد على النفس ولأبناء في إدارة الأعمال إلى التوكل على الرقيق الذي أضحى يدير شؤونهم ، ويشرف على حياتهم ، ويتولى زراعة أرضهم ، وخدمة نسائهم ، وتصريف أموالهم.
كان من شأن القرار الأول لعثمان أن تفتحت عيون المسلمين على حياة جديدة في الأمصار المفتوحة ، وما كان كل المسلمين يستطيع أن يتطلع لهذه الحياة ، بل كان أكثرهم قدرة على السياحة والإستثمار والتجارة أن يتمتع بها ناعماً فارهاً ، وكان جملة من الصحابة قد بارك هذا المناخ الجديد ، ونقل معه رؤوس الأموال فأبتاع بها ما شاء من متاع في الأرض والعمارة ، وألحق بذلك ما شاء من الرقيق القائم بهذا العمل أو ذاك ، فتحرك في النفوس ما كان هادئاً من الترف والرخاء ، وتماشى الزهو والبطر في الإستزادة من الذهب والفضة والعقار ، وإذا بالأموال تنمي الأموال ، وإذا بالثراء يضاف إلى الثراء ، فإزداد الشر وإزداد النكر ، ووقف فقراء المسلمين ينظرون إلى كل هذا ولا يملكون شيئاً منه ، ويتابعون هذا التحول الخطير ولا يزودون بلماضة فيه ، فيسارعون إلى النقمة ، ويتحولون إلى الإنكار ، فتنطوي الصدور على الاحقاد والأوغار ، وتشتمل الأفكار على ابتداع الخطط والمؤامرات ، عسى أن ينعموا بالمساواة ، أو يهتبلوا الفرصة بالمواساة ، ولم يكن هذا ولا ذاك.
وكان من شأن القرار الثاني أن يدعم القرار الأول في كل جزئياته المتناثرة هنا وهناك ، فالمال في الحجاز غير الأرض في العراق ، والإستثمار بخيبر غير الإستثمار بالطائف ، والتقوقع في مكان واحد غير الإنتشار في الأقاليم المفتوحة ، والسبق إلى التنافس غير الجمود والقناعة ، إتسعت الملكية الخاصة ، وتطورت الثروة المشروعة وغير المشروعة ، وتهامس الناس هنا وهناك عن مصادر هذا الثراء الفاحش ، وموارد هذا الإستئثار القائم ، وهناك الطبقات المحرومة من الأعراب وصغار الملاكين ، وهناك المستضعفون من المسلمين الزاهدين ، وهناك من لا نصيب له بتجارة ، ولا عهد له بزراعة ، وهناك أكثر من هذا كله ،
من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص ، وكان من شأن هذا أن يألب الناس على صاحب القرارين ، وأن يوجه عنايتهم إلى التغيير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
ولم يكن المجتمع ليغفر هذا التفاوت الطبقي ، فقد عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يحقق العدل الاجتماعي ، كما عهد صحابته زاهدين في حطام الدنيا ، ونظر في أهل بيته فوجدهم مواسين بما لديهم من فضول أموالهم البؤساء والفقراء ، أما هذا التمحض للمال ، والتفرغ التام للدنيا ، فلم يخطر على بال أحد منهم ، وعسى أن يكون مظهر إرتداد عن منهج الشرع المستقيم ، وأن يبدو مظهر جزع وفزع لدى السواد الأعظم من الناس ، ككان صغار المسلمين يتهافتون على الحروف ، ويتنافسون على الفتوح ، وكان كبارهم يتنافسون على تشييد القصور ، وإحتجان الأرباح ، ومن أمثلة مظاهر هذا الترف المسرف ، وهذا الإسراف المترف ما يذكره المؤرخون مجمعين عليه قالوا :
فلما بنى عثمان قصره ( طمار والزوراء ) صنع طعاماً نفيساً ، ودعا إليه الناس ، وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف الذي صفق على يديه مبايعاً له على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين ؛ فلما نظر عبد الرحمن إلى عظمة البناء ، وألوان الطعام ، قال : يا ابن عفان : لقد صدقنا عليك ، ما كنا نكذب فيك ، وإني أستعيذ بالله من بيعتك ، فغضب عثمان ، وقال : أخرجه عني يا غلام ، فأخرجوه ، وأمر الناس ألا يجالسوه ، فلم يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس ، كان يأتيه فيتعلم منه القرآن والفرائض ، ومرض عبد الرحمن فعاده عثمان ، وكلّمه فلم يكلّمه حتى مات.
وعبد الرحمن هذا المنكر على عثمان بذخه في القصور ، لم ينكر
على نفسه تلك الثروة الهائلة التي تمتع فيها بما شاء في الحياة ، وترك منها ميراثاً عظيماً ، فكان له ألف بعير ، وثلاثة آلاف شاة ، وكان يزدرع في الجرف على عشرين ناضحاً وترك أربع زوجات ، كان نصيب كل واحد منهن من الثمن يقوّم ما بين ثمانين ألف دينار إلى مائة ألف دينار. وذهب بعض المؤرخين أن عبد الرحمن بن عوف ترك من الذهب ما يقطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه ، وترك من الضياع والأراضي ما لا يقدر بثمن ، ومن جياد الخيل مائة فرس لا نظير لها عند العرب.
وطلحة بن عبيد الله كان أول من استنبت القمح في الحجاز ، ولم مات كانت تركته ثلاثين مليون من الدراهم ، وكان النقد السائل منها مائتي ألف دينار ، ومليونين من الدراهم الفضية ، وكان سائرها عروضاً وعقاراً كما يرى ذلك أبن سعد في الطبقات ، ومع هذا الثراء الفاحش فإنه اقترض من عثمان خمسين ألفاً ، فقال لعثمان : قد حضر مالك ، فأرسل من يقبضه. قال عثمان : هو لك معونة على مروءتك ، ووصله أيضاً بمائتي ألف ، ولعل ذلك أول البداية في الثروة الهائلة التي عززّها عثمان بكثير من العقود والصفقات التجارية ، فقد ذكر المؤرخون أن بين عثمان وطلحة مبايعات على مستوى رفيع ، يبيع طلحة ويشتري عثمان في الحجاز ، ويبيع عثمان ويشتري طلحة في العراق.
والزبير بن العوام ذو السيف الذي طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ذا ثروة طائلة ، وغنى مستفيض ، فله ضياع في البصرة ، وضياع في السواد من أرض العراق ، وخطط في الفسطاط وخطط في الاسكندرية ، وكانت له عروض ضخمة ، وغلاّت متزايدة ، وكانت تركة الزبير تركة جبّارة تتراوح بين خمسة وثلاثين مليوناً ، واثنين
وخمسين مليوناً ، وهي أرقام خيالية يذكرها المؤرخون بكثير من التأكيد ، فمن قائل إنها خمسة وثلاثون مليوناً ، ومن قائل إنها أربعون مليوناً ، ومن قائل إنها اثنان وخمسون مليوناً ، ولا ندري أكان ذلك الميراث دراهم أو دنانير.
وهذا الذي قد اعتزل الفتنة فيما زعم ، ولم ينصر الحق وهو الأمثل به ، ولم يخذل الباطل وهو من واجبه ، أعني به : سعد بن أبي وقاص ، فقد رثى لحاله المؤرخون ، واعتبروه ذا ثروة متواضعة إذ ترك ما بين مائتي ألف وثلاثمائة ألف ، وهو شيء يسير بالنسبة لما ترك أصحاب الشورى كما رأيت قريباً.
كان رأي الناس أن المسؤول عن هذا الثراء المقيت هو عثمان ، لأنه فتح له الأبواب ، وخص به طبقة دون طبقة ، فأضيف ذلك إلى ما نُقم عليه به من ذي قبل.
(٩)
سياسة عثمان من الصحابة والمعارضة
لم تكن السياسة المالية التي انتهجها عثمان وحدها مما نقم بها عليه الناس ، ولم تكن الأثرة في السلطان وإدارة التولية والعزل وحدها مما أخذ به المسلمون عثمان ، ولم يكن ضعف السلطان أيضاً ، ولا التفاوت الطبقي وتضخم الملكية الخاصة مما أجلب على عثمان فحسب ، فهناك عامل مهم نشأ في ظلال ذلك ، وترعرع في أحضان هذه السياسة بمجموعها ، هو عامل الإنتقام من الخصوم تارة ، والنفي والتشريد لمعارضيه تارة أخرى ، ولست أدري هل يجوز للحاكم الانتقام والثأر لنفسه بمجرد نصحه والإنكار عليه؟ وما هو الحد الذي يباح للسلطان في تغريب معارضيه؟ ونفي المنكرين عليه عن ديارهم وأوطانهم ؛ وما هو حق الولاة في خنق الأنفاس وكبت الحريات ، ومؤاخذة الناقمين بآرائهم؟ هذا إذا كان الحاكم حاكماً بتفويض من الشعب ، وكيف به إذا كان ـ فيما يزعم ـ متجلبباً برداء ألبسه الله إياه؟ وقد كان عثمان يقترف كل ذلك ، وولاة عثمان يقترفون ذلك وأكثر من ذلك ، فالبصري ينفى إلى الشام ، والكوفي ينفى إلى الحجاز ، والمكي ينفى إلى الربذة ، ولستُ بإزاء إحصاء ذلك فقد يطول ذكره ، ولكني بسبيل متابعة ما نقمه المسلمون على عثمان تجاه ثلاثة من كبار الصحابة إنشقوا على حكمه ، ونعوا عليه تصرفاته بكثير من الإصرار ، وهؤلاء
الثلاثة هم : أبو ذر الغفاري ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر ، ولكل حديثه الخاص به ، ولكل عقابه الذي إبتكره عثمان.
أولاً : أبو ذر الغفاري :
هو جندب بن جنادة ، ممن سبق إلى الإسلام ، وكان في بداية نشأته بأرض كنانة يلفحهُ حرّها ومناخها الجاف ، ويعصره زمهريرها وبردها القارس ، عاش في شظف من القوت لا يكاد يسد رمقه ، وتقلب في مكاره الدهر حتى ألفها ، أسلم في مكة طائعاً ، وهاجر إلى المدينة راغباً وشهد مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المشاهد كلها وكان الى جنب علي عليهالسلام في حياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد وفاته ، ومن السابقين إلى موالاته والقول بإمامته ، وكان حبيباً لرسول الله ، مقدماً عنده ، مشهوراً بصدقه وصراحته ، معروفاً باستقامة الفطرة ، وصفاء السجية ، حتى قال فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
« ما أقلت الغبراء ، ولا أظلت الخضراء رجلاً أصدق لهجة من أبي ذر ».
وما ذلك إلا لصرامته في الحق ، وجديته في الصدق ، فهو لا يخشى أحداً ، ولا يجامل أحداً ، ولا تأخذه في الله لومة لائم.
هذا البدويُّ الذي عركته الصحراء بمناخها ، ووهبته البادية صلابة طبيعتها ؛ إصطرع أيام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع حياة التقشف والزهد فألفها ، وذاق مرارة العسر فأساغها ، ورأى النبي عليهماالسلام يشدّ حجر المجاعة على بطنه فيستن بسنته ، ويرى من سياسة أبي بكر وعمر (رض) في المال ما يعجبه حيناً ، أو يناقشه حيناً آخر ، ولكن ما يراه كان ملائماً لفطرته النقية بضم بعضه إلى بعضه الآخر ، وإذا به يفجأ في عصر عثمان
بالممتلكات العريضة لطلحة والزبير في الحجاز والعراقيين ومصر ، وينظر بذخ معاوية وسرفه في المال والبناء في الشام ، ويشاهد مروان بن الحكم يحتجز من الفيء ما لا يوفيه الحساب ، ويلفي ابن أبي سرح يتمتع بخمس إفريقيا كله ، وينظر عثمان بجزل العطاء دون بصيرة ، فيعطي الحارث بن الحكم طريد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثمائة ألف درهم ، ويعطي زيد بن ثابت مائة ألف درهم ، ويعطي هذا وذاك مئات الألوف بغير مقياس يقيده ، ولا ميزان يزن به حقائق الأشياء ، وينظر ثروة ابن عوف ذهباً وفضة وكراعاً وماشية وعقاراً ، ويلاحظ ترف طلحة في التأنق والعبيد والإماء وعائدات خيبر ، ويستمع لأنباء ممتلكات الزبير في العراق والفسطاط ضياعاً وإقطاعاً ، فيبهت لهذا كله ، وينكره أشد الإنكار ، ويتلو قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (١).
ويشكو مروان نكير أبي ذر لعثمان ، وينهاه عثمان عن ذلك فيحتج قائلاً : أي أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله ، لأن أرضي الله بسخط عثمان ، أحب إليّ من أن أرضي عثمان بسخط الله.
وتشيع هذه المقالة في الآفاق ، وتتوتر العلاقة ببين أبي ذر وعثمان ، ويكثر نقد أبي ذر ويزداد غضب عثمان ، ويقول أبو ذر ويجيب عثمان ، وتتعالى صيحات أبي ذر فيجزع عثمان ، ويحاول إليه السبيل فيجده مغلقاً.
فقد كان كعب الأحبار يحتل الصدارة من مجلس عثمان ، فيقول أبو ذر لعثمان وكعب حاضر : لا ينبغي لمن أدى الزكاة أن يقنع حتى يطعم الجائع ، ويعطي السائل ، ويبّر الجيران ؛ فيقول كعب : من أدى
__________________
(١) سورة التوبة ، الآية : ٣٤.
الفريضة فحسبه ؛ فغضب أبو ذر ، وقال لكعب : أتعلمنا ديننا يا ابن اليهودية. فأثار ذلك عثمان ، وأمره أن يلحق بالشام ، وألتحق أبو ذر بالشام برقابة مشددة من معاوية ، وأنكر على معاوية في الشام ، ما أنكره على عثمان في المدينة ، وكان معاوية يقول : المال مال الله ، ونحن أمناء الله على ماله. وما أراد أبو ذر أن يجبهه بأنه قد خان الأمانة ، ولكنه جبهه بأنه قال : إنما هو مال المسلمين.
وكان الناس يجتمعون في الشام إلى هذا الصحابي الجليل ، فيقول : ويلٌ للأغنياء من الفقراء. وكثرت تصريحات أبي ذر في هذا المجال ، حتى إذا بنى معاوية قصر الخضراء ، قال له أبو ذر : « إن كنت إنما بنيتها من مال المسلمين فهي الخيانة ، وإن كنت إنما بنيتها من مالك فإنما هو السرف ».
وأدرك معاوية أن أبا ذر بإشاعته المفاهيم الإسلامية في المال وسواه سيفسد عليه الشام فيما يزعم ، فكتب إلى عثمان : إن كانت لك حاجة في الشام فسير عنها أبا ذر ، فما كان من عثمان إلا أن استجاب لهذا النداء ، وكتب إلى معاوية :
أن أحمل إليّ جندباً على أغلظ مركب وأوعره ، فحمله على أشد مركب ، ووصل المدينة أبو ذر ، وقد تساقط لحم فخذيه كما يقول المؤرخون ، وأدخل على عثمان فقال له : لا أنعم الله بك علينا يا جنيدب ؛ فقال أبو ذر : أنا جندب وسماني رسول الله عبد الله ، فاخترت اسم رسول الله الذي سماني به على اسمي ، فقال له عثمان ، أنت الذي تزعم أنا نقول : يد الله مغلولة ، وأن الله فقير ونحن أغنياء ، فقال أبو ذر : لو كنتم لا تقولون ذلك لأنفقتم مال الله على عباده ؛ وأنا أشهد أني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول :
« إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً ، جعلوا مال الله دولاً ، وعباده خولاً ، ودينه دخلاً ».
فقال عثمان لمن كان حاضراً : أسمعتم ذلك من رسول الله؟ فأنكروا سماعه ، فاستدعى عثمان علياً وسأله ، فقال الإمام علي عليهالسلام إني لم أسمع ذلك من رسول الله ، ولكن أبا ذرّ صادق فيما يقول ، لأني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول فيه :
« ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر ».
فقال كل من حضر : أما هذا فقد سمعناه من رسول الله.
ولم يجد عثمان في هذا سبيلاً على أبي ذر ، فعمد إلى سياسته في النفي والتغريب ، فأمر أبا ذر بالرحيل إلى الربذة منقطعاً عن الناس ، ومنع الناس من توديعه ، وأشرف مروان بن الحكم على تنفيذ الأمر ، فلم يخرج إلى توديعه إلا الإمام علي عليهالسلام وأخوه عقيل ، وابناه الحسن والحسين عليهالسلام وعمار بن ياسر ، وكان مشهد الوداع مثيراً ، إذ تكلم كل واحد من المودعين بما يناسبه ، وقال علي أمير المؤمنين :
« يا أبا ذر ؛ إنك غضبت لله فارجُ من غضبت له ، إن القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك ، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه ، واهرب منهم بما خفتهم عليه ، فما أحوجهم إلى ما منعتهم ، وما أغناك عما منعوك ، لا يؤنسك إلا الحق ، ولا يوحشك إلا الباطل ، فلو قبلت دنياهم لأحبوك ، ولو قرضت منها لآمنوك ».
وانتهى المطاف بمعارضة أبي ذر أن عاش ما بقي من حياته شريداً في الربذة ، حتى أدركه الموت غريباً لا يجد كفناً ، وشهدت وفاته عصابة